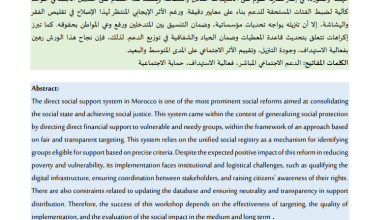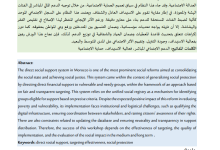الإطار القانوني لتصنيف التنظيمات المسلحة والجرائم الإرهابية الدكتور محمد نور عبد الرؤوف قطب
الإطار القانوني لتصنيف التنظيمات المسلحة والجرائم الإرهابية
الدكتور محمد نور عبد الرؤوف قطب
الأستاذ المساعد في كلية الحقوق كليات الأصالة بالمملكة العربية السعودية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
رابط تسجيل البحث في DOI
https://doi.org/10.63585/XJPG8381
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665




























الملخـــص
تهدف هذه الدراسة إلى وضع معايير قانونية واضحة للتمييز بين الجماعات المسلحة غير المشروعة، مثل التنظيمات الإرهابية، والجماعات ذات الأهداف المشروعة التي تعمل في إطار القانون الدولي لمناهضة الاستعمار بقصد تقرير المصير، وتعتمد الدراسة على مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي لتحديد الفروقات الجوهرية بين هذه الكيانات من حيث الأهداف، الأساليب، والشرعية القانونية.
ويتناول البحث التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في تعريف الإرهاب وتصنيف الجماعات المسلحة، مع التركيز على أهمية التمييز بين الأعمال المشروعة التي تدعمها القوانين الدولية والأعمال غير المشروعة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، كما تقدم تحليلاً للتطور التاريخي لمفهوم الشرعية في استخدام القوة، وتستعرض الطبيعة القانونية للجماعات المسلحة وخصائصها.
*الكلمات المفتاحية:* القانون الدولي الإنساني، الإرهاب، الشرعية الدولية، القانون الجنائي الدولي، حق تقرير المصير.
The legal framework for classifying armed organizations and and terrorist crimes
Dr. Mohamed Nour Abdelraouf Kotb
Assistant Professor, College of Law Asalah Colleges, Kingdom of Saudi Arabia
Abstract
This study aims to establish clear legal criteria to distinguish between unlawful armed groups, such as terrorist organizations, and motivated groups operating within the framework of international law Anti-colonialism for the purpose of self-determination. The research relies on principles of international humanitarian law and international criminal law to identify the fundamental differences between these entities in terms of objectives, methods, and legal legitimacy.
The study addresses the challenges faced by the international community in defining terrorism and classifying armed groups, emphasizing the importance of distinguishing between lawful actions supported by international laws and unlawful acts that threaten global peace and security. It also analyzes the historical evolution of the concept of legitimate use of force and examines the legal nature and characteristics of armed groups.
*Keywords:* International Humanitarian Law, Terrorism, International Legitimacy, International Criminal Law, purpose of self-determination ..
مـقدمــــــــة
لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع أو نشاهد عن وقوع حوادث إرهابية مختلفة هنا وهناك في أرجاء المعمورة ، وبشكل يدعونا إلى القول بأن البشرية انزلقت في حقبة من هوس الإرهاب، حتى أضحى “الإرهاب” في وقتنا الراهن ملئ الأسماع والأبصار ، وأصبح – وبحق – سرطان العالم الحديث الذي يستشري في جسد المجتمع الدولي ، وينهش في أمنه واستقراره ليحيله إلى خراب ودمار، وصار يمثل أعظم المصائب الدولية التي تواجه البشرية.
وعلى الرغم من اهتمام المجتمع الدولي بهذه الظاهرة اهتماما خاصا، وبذل الأسرة الدولية جهودا كبيرة من أجل وضع تعريف عالمي موحد لهذه الكلمة، إلا أنه – ومما يُؤسف له – تحطمت هذه الجهود والمساعي جميعها على صخرة الخلاف حول تعريف عالمي وموحد للإرهاب، وذلك في ظل تعمد بعض الدول الكبرى – والتي لها أطماع استعمارية – الوقوف في وجه أية دعوة صادقة وجادة لوضع الحدود الفاصلة بين الإرهاب ومقاومة الإرهاب أو مقاومة الاحتلال ، وذلك حتى يبقى ” الإرهاب الدولي ” شعاراً سياسياً بين هذه الدول تشهره – بدون وجه حق – كيفما تشاء في وجه من تشاء، بغية تأديبه ومعاقبته فيما إذا خرج عن الدوران في فَلَك مصالحها أو ناهض سياستها أو قاوم تصرفاتها.
أهميـــة البحث:
ومن هنا تأتي أهمية البحث التي يعني بالتمييز بين الحركات المشروعة التي كفل لها القانون الدولي العديد من الحقوق في سعيها لتقرير المصير وبين غيرها من الحركات الارهابية- في ظل ندرة الكتابات الأجنبية المتخصصة بل وحتى العربية التي تعنى بهذا الموضوع الدقيق- حيث تعد حروب التحرير التي تخوضها تلك الحركات من أهم المحطات التاريخية في حياة الشعوب والأمم والدول التي شهدت احتلالات من قبل قوى أجنبية.
إشكاليات البــــحث:
تكمن مشكلة البحث والدراسة في حدود التمييز بين حركات النضال ضد الاستعمار الاجنبي التي كفل لها القانون الدولي الشخصية القانونية الدولية وأسبغ عليها حمايته، وبين غيرها من حركات ومجموعات تخرج من عباءة حماية القانون الدولي ولا تنتفع بأية حقوق مقررة للأولى، وذلك يرجع لعدم وجود – حتى الآن- تعريف جامع مانع لمفهومي النضال والإرهاب اتفقت عليه الدول وما استتبع ذلك من محاولة قلب الحقائق، ومن قبيل ذلك ماتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 من إلغاء قرارها السابق المتخذ عام 1975 والذي كان يساوي بين الصهيونية والعنصرية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، رغم أن الأسباب الداعية لاتخاذ القرار عام 1975 لا تزال موجودة وقائمة حتى تاريخه..!!
منهج البحــــث:
آثرت أن نتبع في دراستنا لهذا الموضوع المنهج العلمي الموضوعي الملتزم بأصول البحث العلمي والقانوني.
وقرّنا ذلك بالمنهج الوصفي التحليلي المستند على الرصد المتوالي لقواعد القانون الدولي وغيرها من القواعد المتعارف عليها دولياً.
ترتيباً على ما تقدم فإنه قد يكون من الملائم تقسيم الدراسة بوضع ملامح التيارات والحركات المناهضة للاستعمار وفق صحيح القانون الدولي لتمييزها عن غيرها من تنظيمات غير مشروعة في هذا البحث على النحو التالي:
الفصل الأول: المفهوم والأسس القانونية للحركات الوطنية المناهضة للاستعمار
المبحث الأول: ماهية الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار.
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للحركات الوطنية المناهضة للاستعمار.
الفصل الثاني: تمييز الحركات المناهضة للاستعمار عن غيرها من التنظيمات
المبحث الأول: التفرقة بين المقاومة الشعبية المسلحة والمقاومة التلقائية والمقاومة المدنية ضد الاحتلال.
المبحث الثاني: التفرقة بين الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار والإرهاب.
المبحث الثالث: التفرقة بين الحركات المناهضة للاستعمار والحركات العنصرية والانفصالية.
المبحث الرابع: التفرقة بين الحركات الوطنية والميليشيات العسكرية والشركات الأمنية.
المبحث الخامس: التفرقة بين الحركات الوطنية والمرتزقة والجواسيس.
الفصل الأول
المفهوم والأسس القانونية للحركات الوطنية المناهضة للاستعمار
اهتمت المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية بإبراز الآثار المدمرة للحروب ، حيث أجرت مؤسسة كارينجى للسلام عام 1940 دراسة متكاملة عن الحروب التى نشبت فى العالم على مر التاريخ خلصت فيها إلى أن سنوات الحرب فى تاريخ البشرية أكثر بكثير من سنوات السلام ، فقد تبين -من تلك الدراسة- أنه منذ عام 1946ق.م وحتى عام 1861م أى ما يعادل ( 3357) عاماً شهدت البشرية (227) عاماً سلاماً فقط.
وفى دراسة أخرى لذات المؤسسة تبين أنه خلال (5560) عام حدثت (14,531) حرباً أى بما يقارب ثلاثة حروب كل عام ([1])، وفى إحصائيات أخرى تبين أنه على مدى الخمسة اَلاف سنة المنصرمة حدثت (14555) حرباً نتج عنها وفاة خمسة مليارات من بنى البشر ، وعلى مدى الـ (3400) سنة الأخيرة لم يعرف العالم سوى (250) عاماً سلاماً فقط([2]).
كما قضت الحرب العالمية الأولى على عشرة ملايين نسمة، بالاضافة إلى إحدى وعشرون مليون نسمة لقوا حتفهم نتيجة الأوبئة التى خلفتها الحروب، كما قُتل فى الحرب العالمية الثانية أربعون مليون نسمة ، ومنذ الحرب العالمية الثانية شهد العالم ما يقرب من (250) نزاعاً مسلحاً دولياً وداخلياً بلغ عدد ضحاياها (170) مليون شخص، بمعدل كل خمس شهور تقريباً ينشأ نزاع مسلح([3]).
وقد وُجِدت حركات تقرير المصير المناهضة للاستعمار كظاهرة سياسية فى خمسينيات القرن العشرين كرد على احتلال بعض الدول فى الكثير من أنحاء العالم، وهى تقود حروباً ثورية للوصول إلى أهداف سياسية كاملة بوسائل عسكرية، وتعد فى مضمونها أو جوهرها سياسية اجتماعية، وتملك المقومات الأساسية للتحرر وأهم تلك المقومات على الإطلاق الإرادة الوطنية([4]).
ولقد عُرِفَت حركات المقاومة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وازداد نشاطها بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لتضافر عوامل داخلية وخارجية، وقد ساعد قرار تصفيه الاستعمار عام 1960 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514/ د-15 المؤرخ فى 14 كانون الأول 1960 على نمو وفعالية تلك الحركات التى كانت هدفها الاستراتيجى تحرير الوطن وجلاء المحتل([5]).
لابد لنا لتحديد مفهوم تلك الحركات أن نتعرض لمفهوم المقاومة الشعبية المسلحة، حيث نجد أن الآراء فى تحديد ذلك المفهوم قديماً كانت تتجه إلى حصر ذلك النشاط الذى تقوم به عناصر شعبية باستخدام القوة المسلحة فى مواجهة قوة أو سلطة تقوم بغزو الوطن واحتلاله ، وهذا المفهوم يربط بين المقاومة وبين الغزو والاحتلال الحربى، وقد سيطر هذا المفهوم على المناقشات التى دارت حول هذا الموضوع فى مؤتمرات بروكسل 1874، ولاهاى 1899 ، وجنيف 1949([6]).
وقد تعاقبت قرارات وإعلانات وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة على التأكيد على ذلك المفهوم الواسع، وبناءً على هذا المفهوم عرف الأستاذ الدكتور صلاح الدين عامر المقاومة الشعبية المسلحة على أنها: “عمليات القتال التى تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة الوطنية وكذا النظامية ، دفاعاً عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية، سواء كانت تعمل بناءً على مبادرتها الخاصة، وسواء باشرت هذا النشاط فوق الإقليم الوطنى أو من قواعد خارج هذا الإقليم” ([7]).
وهذا المفهوم الواسع للمقاومة الشعبية المسلحة هو ما يعبر عنه أحياناً فى بعض الكتابات القانونية بحروب التحرير الوطنية Wars of national liberation، التى تخوضها حركات النضال الوطني لنيل حرية شعوبها .
المبحث الأول
ماهية حركات تقرير المصير المناهضة للاستعمار
قبل إندلاع الحرب العالمية الثانية ، كانت الدول الاستعمارية التقليدية تسيطر على مناطق شاسعة من العالم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وتعد أبرز تلك الدول على الإطلاق بريطانيا حيث كانت تسيطر على 30 مليون كيلو متر من الأراضى الأسيوية والأفريقية ويقطن بها 500 مليون نسمة، تأتى بعدها فرنسا التى كانت تسيطر على 13 مليون كيلو متر مربع معظمها فى أفريقيا ويقطن بها 110 مليون نسمة ، ثم تأتى بعدها الدول الأوروبية الأخرى مثل البرتغال وأسبانيا ودول أخرى ، وقد نتج عن هذه السيطرة وما ترتب عليها من قمع ظهور ما بات يعرف بحركات النضال الوطنية التى تخوض حروباً دفاعية تسمى بحروب التحرر الوطنية([8]).
وقد دأب كثير من الكتاب على تناول موضوع تلك الحركات وما لها وما عليها دون عنايه بتعريفها ، ولا شك أن ذلك مصدر من أكبر مصادر الغموض والخلط الذى يحيط بها ولا يميزها عن غيرها من الحركات([9])، وهو الأمر الذى نحاول فى بحثنا جاهدين أن نجلِّيه ونوضحه وصولاً لمعرفة مدى مشروعية تلك الحركات من عدمه ، لتمييزها عن غيرها من حركات وكيانات غير مشروعة ، أُسوةً ببعض الفقهاء القلائل الذين اهتموا بتعريف تلك الحركات.
ومن الفقهاء الذين عرفوا تلك الحركات الوطنية هو الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمى والذى عرفها بأنها: ” حركات تستند إلى حق الشعب فى إستعادة إقليمه المغتصب وتستمد كيانها من تأييد الجماهير الغاضبة لطرد المغتصب، وتتخذ عادة من أقاليم البلاد المحيطة حرماً لها، وتستمد منها تموينها وتقوم عليه بتدريب قواتها، ثم إنها بسبب إمكانياتها تركز مجهودها على تحدى الإرادة الغاصبة لا على هزيمة جيوش الاحتلال فى حرب منظمة”([10]).
ويتضح هذا الأمر جلياً عندما أصدر “هتلر” أمراً فى سبتمبر 1941 بإطلاق النار على مائة من السكان المدنيين فى مقابل كل جندى ألمانى واحد يقتله رجال المقاومة ، وإعدام خمسين من المعتقلين أو الأهالى فى مقابل كل جندى ألمانى تجرحه المقاومة([11]).
ويمكننا – من جانبنا – تحديد مفهوم حركات تقرير المصير المناهضة للاستعمار بأنها:
“هى تلك المجموعات الوطنية التى تحتمى بظهير شعبى، وتتخذ من المقاومة المسلحة وسيلة لها لتنفيذ عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال، بهدف استنزاف الإرادة المستعمرة، وتباشر نشاطها فوق إقليمها المحتل وصولاً لتقرير المصير”.
مما سبق يتضح لنا أن هناك مميزات لحركات المقاومة الوطنية تميزها عن غيرها وهى:
[1] من حيث توافر المجال الداخلى والخارجى:
فهي عبارة عن تنظيم ينشأ فى الأقاليم الواقعة تحت سيطرة قوى الاحتلال لتقود معركة الشعب ضد تلك السيطرة، وتوجد هذه السيطرة الاستعمارية حين لا يستطيع الشعب التعبير بحرية عن إرادته وتقرير مصيره، وهذا هو المجال الداخلى، أما المجال الخارجى فيعنى حصول الحركة على قواعد خلفية فى البلدان المجاورة تمكنها من تنظيم قواتها وإطلاق فعالياتها.
[2] من حيث الأهداف:
فنجد أن تلك الحركات تستهدف بصورة وحيدة تحقيق الاستقلال السياسى والوطنى للأقاليم المستعمرة ، وصولاً لتشكيل دولة مستقلة، وهذا الهدف تحديداً هو ما يميز حركات التحرر الوطنى عن بقية التشكيلات الأخرى التى تقبل التعاون مع السلطة المستعمرة وتقبل بالتالى حلولاً وسطية.
[3] من حيث أساليب الكفاح:
حيث تستخدم حركات المقاومة أسلوب الكفاح المسلح بكافة الوسائل العسكرية المتاحة ضد المستعمر وهو ما يسمى (بالحرب الشعبية) ، مع إمكانية استخدام أسلوب النضال السياسى فى ذات الوقت، وقد يكون مصدر الأسلحة التى تستخدم فى هذا الكفاح هى الأسلحة المستولى عليها من العدو نفسه أو أسلحة محلية الصنع، ولعل أبرز تلك الأمثلة هو ما فعلته حركة التحرير الوطنية الجزائرية التى باشرت كفاحها عن طريق استيلائها على بنادق الصيد من الفرنسيين المحتلين([12]).
[4] من حيث التنظيم:
حيث تضم تلك الحركات جناحين أحدهما عسكرى لخوض حروب التحرير باستخدام الكفاح المسلح ، والجناح الآخر سياسى فى شكل هيئة تنفيذية تعمل بنشاط على الصعيدين الداخلى والخارجى.
[5] من حيث التمثيل للشعبى:
وهذا الشرط تحديداً هو ما يميزها عن الحركات الانفصالية والعنصرية، ويمكن استجلاء حقيقة تمثيل تلك الحركات الوطنية للشعب من عدمه عن طريق اعتراف قوى الشعب المنظمة الفاعلة كالاتحادات الشعبية من قطاعات العمال والطلاب والمرأة والكتاب والحقوقيين وغيرهم([13])، أو بواسطة المظاهرات العارمة أو مشاركة المدنيين فى بعض أعمال تلك الحركات.
وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الخصيصة الأخيرة تحديداً هى أهم الشروط الواجب توافرها فى الحركة للقول بأنها حركة تحررية وطنية، وهو مادفع السيد (بال) نائب وزير الخارجية الأمريكية فى 30 سبتمبر 1966 بجامعة نورستوستيرن إلى الاعتماد على هذا الشرط ، حينما أدلى بتصريحات مفادها أن الحركة التحررية المنظمة والمشروعة هى فقط التى تمثل شعبها أو جزءاً واضحاً من هذا الشعب ، محاولاً إخراج حركة التحرر الفيتنامية (الفيت كونغ) من نطاق تلك الحركات الوطنية ، فعاب عليها أنها لا تمثل شعب جنوب فيتنام بل واتهمها أنها صنيعة حكومة هانوى على غير الحقيقة([14]).
المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لحركات تقرير المصير الوطنية
تختلف خصائص الحركات الوطنىة النضالية من حيث الزمان والمكان وفى طبيعة الاستعمار والاحتلال وطرقه وأساليبه، إلا أنها تشترك جميعها فى خصائص مشتركة يمكن تجميعها فى الآتى: ” نشاط شعبى ، بالقوة المسلحة ، ضد قوى أجنبية ، بدافع وطنى” ([15]).
وما وجدت حركات تقرير المصير إلا للدفاع عن الوطن ضد احتلال الأرض ونهب الثروات، وهى فى سبيل ذلك تبذل الجهد لنصرة الحق ودفع الظلم وإقرار العدل والسلام وصولاً للتعايش السلمى بين كافة الأمم([16]).
ولقد ميَّز القانون الدولى الإنسانى بين أربعة أصناف من المقاتلين الشرعيين الذين يقومون بعمليات عسكرية، أسبغ عليهم وصف القاتل القانونى أو أسير الحرب إذا ما توافرت شروط محدودة، حيث نصت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب:-
أولاً: أسرى الحرب بالمعنى المقصود بهذه الاتفاقية هم الأفراد الذين يتبعون إحدى الفئات الآتية، ويقعون فى أيدى العدو، (1)…………..
(2) أفراد الميليشيا الأخرى وأفراد الوحدات المتطوعة الأخرى بما فى ذلك الذين يقومون بحركات مقاومة نظامية ويتبعون أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج أراضيهم، حتى لو كانت هذه الأراضى محتلة، بشرط أن تتوفر فى هذه الميليشيا أو الوحدات المتطوعة بما فيها تلك المقاومات المنظمة الشروط الآتية:
- أن تكون تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه.
- أن تكون لها علامة مميزة معينة يمكن تمييزها عن بعد.
- أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.
- أن تقوم بعملياتها الحربية طبقاً لقوانين وتقاليد الحرب.
(6) سكان الأراضى غير المحتلة الذين يحملون السلاح باختيارهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية دون أن يكون لديهم الوقت الكافى لتشكيل أنفسهم فى وحدات نظامية مسلحة، بشرط أن يحملوا السلاح بشكل واضح وأن يحترموا قوانين وتقاليد الحرب..” ([17]).
- الشروط الواجب توافرها لدى أفراد حركات التحرر الوطنى:
باستقراء نص المادة 42 من البروتوكول الإضافى الأول نجد أن تلك الشروط تتلخص فى الآتى:-
- الالتزام بقواعد القانون الدولى واحترام أعراف الحرب، واكتفى البروتوكول الإضافى الأول([18]) بأن يكون هذا الالتزام بصفة جماعية بمعنى أنه إذا خالف أحدهم القواعد لا تنزع عنه صفة المقاتل أو أسير الحرب.
- أن يلتزموا بالتعليمات التى تصدر من قادتهم فى إطار حركة منظمة ويكونوا مسئولين عنهم وعن أفعالهم.
- تمييز أنفسهم كمقاتلين أثناء القتال المسلح بحيث يسهل تصنيفهم بعيداً عن المدنيين ، وترك لهم نص المادة 44 فقرة “3” حرية إتباعهم لأى وسيلة يختاروها من ارتداء زى عسكرى موحد أو حمل علامة مميزة معروفة أو حمل السلاح بشكل ظاهر ، ونجد أن الأمر فى هذا البروتوكول قد جاء بكثير من المرونة بعكس ما تم النص عليه سلفاً فى اتفاقيات جنيف 1949 واتفاقيات لاهاى، التى اشترطت كل تلك الوسائل جميعها لتمييز المقاتلين عن المدنيين، مما مكن -البروتوكول- هؤلاء الأفراد المقاتلين من إتباع أسلوب التخفى والتموية فى جميع الأحوال ، إلا أن تلك المادة اشترطت حمل السلاح علانية فى حالتين:
- أثناء أى اشتباك عسكرى.
- طيلة الوقت الذى يتم فيه الانتشار العسكرى قبل الهجوم ،على أن يكونوا معرضين لرؤية الخصم على مدى البصر([19]).
مما سبق يتضح مدى التساهل والمرونة التى تعامل بها هذا البروتوكول الأول مع الشروط التقليدية الأربعة استجابةً لآراء الفقهاء المطالبة بإطلاق حق المقاومة من كل قيد أو شرط، استجابةً للتطورات العسكرية والسياسية بالمقارنة باتفاقيات لاهاى وجنيف، ونجد أن كل ما عناه هذا البروتوكول هو ترسيخ قاعدة “ضرورة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين” بحيث تقتصر العمليات العسكرية على الأطراف المتحاربة فحسب وفى ميدان المعركة فقط.
وترتيباً على ما سبق – أخذاً بالمفهوم الواسع للمقاومة فى ظل البروتوكول الأول- افترضت الفقرة الأولى من المادة 45 صفة “أسير الحرب” فى كل شخص يشارك فى الأعمال العدائية ويقع فى قبضة الخصم، واستُبِعِدَ من عداد فئة أسرى الحرب بعض الطوائف نذكرها على النحو التالى:-
- الجواسيس: وقد نصت على ذلك صراحة المادة 46 من البروتوكول الإضافى الأول فى الفقرة الأولى منها حيث اعتبرت أن كل من يقع من أحد أطراف النزاع فى قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس يفقد التمتع بوضع أسير الحرب([20])، واستثنت من ذلك بعض الحالات كفرد القوات المسلحة إذا توافرت فيه بعض الشروط([21]).
- المرتزقــة: وهؤلاء نصت عليهم المادة 47 من البروتوكول الأول فى الفقرة الأولى أنه: “لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب”([22]) ، وقد ذهبت لجنة القانون الدولى إلى أن ظاهرة المرتزقة تشكل جريمة ضد سلم وأمن الإنسانية إذا كانت عائقاً أمام حركات التحرير الوطنية فى الوصول لحقها فى تقرير المصير، وهو ما يوضح مدى تجرد هذه الفئة من المشاعر السامية بتكريس أعمالهم الإجرامية لخدمة مصالحهم المادية الدنيئة.
- الوطنيون الملحقون بقوات العدو “الخونة” : ويعتبر هذا الاستبعاد منطقياً لأن صفة أسرى الحرب تعطى للمناضلين الشرفاء وليس لمن يتخابر مع الأعداء ضد وطنه وأبناء جلدته ، لأن مآله المحاكمة أمام محاكم بلده بجريمة الخيانة لا أن يمنح ميزه “أسير الحرب”.
- مجرمو الحرب : وهؤلاء هم أفراد المقاومة والقوات المسلحة الذين خالفوا بإراداتهم المنفردة قوانين وأعراف الحرب ضد الطرف الخصم وبالتالى فلا يستفيدوا من صفة أسير الحرب، لمخالفتهم لهذا الشرط بداءةً.
ولابد أن نشير هنا إلى أنه – واتساقاً مع هذه النظرية الحديثة الموسعة لمفهوم المقاومة- تبنى المجتمع الدولى فى أغلبه وجهة النظر السوفيتية التى تعتبر الحروب التى تشنها الشعوب للتحرر من الاستعمار حروباً ذات طابع دولى تخضع بالتالى للقواعد القانونية التى تحكم مثل هذه النزاعات الدولية([23])، وذلك يعد تطور غير مسبوق فى العلاقات الدولية حيث تم اعتبار تلك الشعوب التى تكافح ضد الاستعمار وبالأحرى حركات التحرر الوطنى هى أحد أشخاص القانون الدولى لأنها بمثابة الدولة فى طور التكوين والتشكيلL’Etatenvoie de formation([24]).
وتم النص على ذلك صراحة فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977 على أنه يعد من قبيل النزاعات المسلحة الدولية “… المنازعات المسلحة التى تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبى…” ([25]).
وخلاصــة القـــــــــــــول..
يتضح لنا- وبجلاء- أن هناك شرطين مهمين يمكن قبولهما والعمل بهما وهما: العمل فى تنظيم هرمى تحت قيادة مسئولة ، وكذا الالتزام بقواعد الحرب، أما الشرطين الآخرين المتعلقين بالشارة المميزة ، وحمل السلاح بشكل ظاهر هما قيدين شكليين يؤدى التقيد بهما لإلحاق أضرار عملية كبيرة بحركات المقاومة لتعارضهما مع طبيعة الحرب الحديثة والتى تعتمد على عنصر السرية والمفاجأة.
الفصل الثاني
تمييز الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار عن غيرها من التنظيمات
فرق فقهاء القانون الدولى بين حركات تقرير المصير وبين بعض المصطلحات التى قد تتشابه معها رغم صعوبة تلك التفرقة لتداخل العوامل السياسية مع المفاهيم لقانونية فى التأثير على تحديد ماهية المقاومة وحروب التحرير الوطنية وضبط مضمونها وحدودهما([26])، ومن أجل إبراز تلك الفروقات رأينا إجراء مقارنة بين حركات تقرير المصير وتلك التشكيلات والمصطلحات الأخرى.
المبحث الأول
التفرقة بين المقاومة الشعبية المسلحة والمقاومة التلقائية والمقاومة المدينة ضد الاحتلال
ورث الفقه التقليدى التفرقة بين المقاومة الشعبية المسلحة المنظمة والتى تتشكل على هيئة الحركات الوطنية، والتى اشترطت لهم الاتفاقيات الدولية شروطاً محددة لاسباغ قواعدها عليها، وبين الهبة الجماهيرية التلقائية والتى عالجتها المادة الثانية من لائحة لاهاى عن عامى 1899 ، 1907 وكذا المادة العاشرة من مشروع بروكسل 1874 ، فتساهلوا فى الحالة الأخيرة باعتبار أن المقاومة لا تكون إلا فى مرحلة الغزو قبل أن يتمكن المحتل من تثبيت وضعه وإحكام سيطرته على إقليم الدولة المحتلة، ولم يشترطوا فى هذه الحالة إلا شرط واحد هو إحترام هؤلاء المقاومين لقوانين وأعراف الحرب، وتشددوا كثيراً فى الحالة الأخرى التى يتمكن فيها العدو الغاصب من إحتلال الإقليم بالفعل وتأسيس سلطاته وذلك بتضييق الخناق على المقاومة المنظمة بأن تمسكوا بحرفية الشروط الأربعة الواردة بالاتفاقيات الدولية([27])، ويعد ذلك ترديداً لتعليمات السيد “فرانسيس ليبير” الذى أقام التفرقة بين المقاومة فى مرحلة الغزو وبين المقاومة فى ظل الاحتلال، فأباح تلك المقاومة فى الأولى وجرمها فى الثانية([28]).
ومع تطور النظرية الحديثة فى الأزمنة المعاصرة تلاشت الفوارق تدريجياً بين المقاومة التلقائية والمقاومة المنظمة وذلك فى إطار تأكيد المجتمع الدولى على حق الشعوب فى تقرير مصيرها بشتى الوسائل ، إلا أنه ظهرت التفرقة بينهما كمقاومة مسلحة من ناحية والمقاومة المدنية من ناحية أخرى، وسنحاول فى هذا المبحث أن نتناول ثلاث أنواع من المقاومة.
المطلب الأول
المقاومة التلقائية “الهبة الجماهيرية”
تُعرَّف الهبة الجماهيرية Levée en masse La بأنها وسيلة من وسائل النضال للدفاع عن أرض الوطن حينما يتعرض للغزو، بمعنى أنها تنشأ فى الأقاليم الجارى غزوها والتى لم تزل خاضعة للسيادة القانونية لحكومة الإقليم الشرعية([29])، وتهب جموع الشعب لحمل السلاح من تلقاء أنفسهم عند إقتراب العدو لمقاومة تلك القوات الغازية دون أن يتوافر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة منظمة([30]).
ومن هنا فإن الهبة الجماهيرية التلقائية لا يمكن أن تعتبر وسيلة من وسائل تسيير الحرب لكنها لا تعدو كونها وسيلة من وسائل مقاومة الغزو تحركها مشاعر وطنية وعواطف مقدسة ، وهذا هو المبرر للخروج على المبدأ العام الذى يقضى بالفصل بين المقاتلين وغير المقاتلين وما يستتبعه ذلك من عدم اشتراط الشروط التقليدية الأخرى من إظهار العلامة المميزة وغيرها، لأن التمسك بالشكليات فى هذه الحالة سيكون مغالاة فى الظلم ونصرة للجانى على المجنى عليه.
وقد اختلف الفقه التقليدى فى حد العدد الذى يشترط للقول بوجود هبة جماهيرية، فالبعض منهم رأى أن يهب الشعب عن بكرة أبيه للدفاع عن أرضه، إلا أن الغالبية العظمى ذهبت إلى القول بأنه فى اللحظة التى تظهر فيها معارضة الشعب بأسره للغزو يمكن التسليم لمجموعة صغيرة من الأفراد بالحق فى الحصول على وصف الهبة الجماهيرية وامتيازاتها، واستدلوا بعدم ورود تحديد صريح بنص المادة الثانية من لائحة لاهاى فيما يتعلق بعدد المشتركين فى الهبة الجماهيرية.
واشترطوا أن تتم الهبة فى مرحلة الغزو وألا يكون هناك وقت أمام الجماهير الراغبة فى المقاومة استيفاء الشروط الكلاسيكية المنصوص عليها فى المادة الأولى من لائحة لاهاى ، فضلاً عن ضرورة احترامهم لأعراف وقوانين الحرب وذلك ترديداً لما ورد بالمادة الثانية من لائحة لاهاى، ولا يغير من الأمر شيئاً إن كانت تلك الهبة الجماهيرية بناء على دعوة الحكومة للأفراد لحمل السلاح أو هبة تلقائية بالمعنى الدقيق([31]).
ومع مرور الوقت واشتداد عود النظرية الحديثة تضاءلت أهمية التفرقة بين الهبة الجماهيرية التلقائية والمقاومة المسلحة المنظمة باعتبار أن الأولى مقدمة للثانية، خاصة فى ظل ظروف الحرب الحديثة والمتطورة على أساس أن استخدام الأسلحة الحديثة يتطلب قدراً عالياً من الخبرة والتدريب لا يتوافر لدى عامة الشعب الذى ينفرون لحمل السلاح ساعة الخطر، وهو ما يفسر ندرة وقائع الهبــــات الجماهيريـــة والتلقائيــة فى ظــــــل قانون جنيــــف([32])، والذى أدى فيما بعد إلى تحولها إلى شكل من أشكال المقاومة الشعبية المسلحة خاصة مع التوسع فى مفهوم المقاومة بربطها بكل وسيلة تؤدى إلى الحق فى تقرير المصير وهو ما قضى تماماً على التفرقة بين المقاومة التلقائية والمقاومة المنظمة.
المطلب الثانى
المقاومة الشعبية المسلحة
سبق لنا تعريف المقاومة من قبل([33])، إلا أنه يجدر بنا القول بأن ما يميز هذا النوع من المقاومة المسلحة أنها تمتاز بنشاطها الشعبى والدافع الوطنى والشكل الهرمى التنظيمى واستخدام القوة المسلحة، فضلاً عن أن نشأة حركات المقاومة المنظمة تكون فى الأقاليم الخاضعة للسيطرة الأجنبية سواء تجسدت تلك السيطرة فى الاحتلال أو مجرد سيطرة سياسية واقتصادية([34]).
وتتبع المقاومة الشعبية المسلحة وسيلتين هما:
[1] الوسيلة التكتيكية: وتتمثل فى توجيه ضربات موجعة بشكل متكرر لإلحاق أكبر قدر من الخسائر فى صفوف المحتل. [2] السيطرة العسكرية: على جزء من الإقليم المحتل لاستخدامه كركيزة لإطلاق هجماتها على العدو ومتابعة تحرير باقى الأراضى المحتلة([35]).المطلب الثالث
المقاومة المدنية
وتعنى كل مقاومة سلمية غير مسلحة تنتهج مبدأ اللاعنف([36]) من مظاهرات وإضرابات ومقاطعة منتجات العدو المحتل، ويتم اللجوء إليها بداءةَ أو فى حالة فشل خيار المقاومة المسلحة([37])، وقد تستخدم جنباً إلى جنب وبالتوازى مع المقاومة المسلحة([38])، فكلاهما يتفقان فى الغاية من حيث كونهما حاضنان لحق تقرير المصير ويوصلان لذات النتيجة، ويختلفان فى الوسيلة التى يلجأ إليها كل نوع فيهما.
وقد لجأت القيادة الفلسطينية لمثل هذا النوع من المقاومة المدنية حيث شرعت فى عام 2009 بمقاطعة كل منتجات المستوطنات الإسرائيلية بعد أن أصبحت السوق الفلسطينية أسيرة لسلطة الاحتلال على مدى عقود، مما دعا الكنيسيت الاسرائيلى بالتصديق على قانون المقاطعة الذى يعاقب أى شخص أو مؤسسة تدعو لمقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها بزعم عدم دستوريتها، فضلاً عن عدم السماح لهم بالمشاركة فى العطاءات الحكومية الاسرائيلية([39]).
ويلاحظ أن قاعدة المقاومة المدنية الشعبية أوسع من قاعدة المقاومة المسلحة ، لأنها تضم فى صفوفها شرائح مجتمعية، وقوى وطنية مختلفة، إلا أن الآله الإعلامية الصهيونية لا تفرق بين كلا النوعين من المقاومة وتعتبرهما تندرجان ضمن أعمال الإرهاب.
المبحث الثانى
التفرقة بين الحركات المناهضة للاستعمار والتنظيمات الإرهابية
تجد هذه التفرقة صعوبتها فى أن أغلب فقهاء القانون الدولى والمنظمات الدولية تجنبوا وضع تعريف محدد ودقيق للإرهاب على اعتبار أن البحث عن تعريف لهذه الظاهرة مضيعة للوقت والجهد، والأولى التركيز على الإجراءات الفعالة لمكافحته، ويتضح ذلك جلياً عندما أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 19/12/1985 لجميع أشكال الإرهاب وأغفلت تعريفه، وتكرر ذات الأمر في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وأيضاً المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين المنعقد فى هافنا 1990، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة التاسع المعقد فى القاهرة عام 1995([40]).
ولابد لنا أن نشير – بداءةً- إلى أهمية التمييز والتفرقة بين تلك الحركات الوطنية والإرهاب ونوجزها فى النقاط التالية:
[1] إن ضعف النظام السياسى لبعض الدول أدى إلى فشل تكوين جماعات وطنية متماسكة حول مشروع حضارى، مما نتج عنه جماعات لم تترسخ فى أذهانها قيمة المواطنة وأعطى للتدخلات الخارجية اليد الطولى فى توجيه حكومات تلك الدول مقابل دعم مادى أو معنوى ، وهو ما أدى إلى ظهور جماعات لا تعرف التمييز بين الإرهاب والمقاومة. [2] وجود عناصر وكتل سياسية أساءت إلى المقاومة الحقيقية مما أدى إلى تعطيل عمل المقاومة الشعبية الحقيقية ، فى ظل دور منظمات دولية وإقليمية اقتصر دورها على مجرد الشجب والاستنكار. [3] إبعاد الرأى العام العالمى عن القضايا الأساسية العالقة خارج إطار الحلول، حتى أصبح يُنظر إلى أصحاب هذه القضايا على أنهم إرهابيين وخصومهم المحتلين أصحاب حق الدفاع عن أنفسهم.ولتحديد الخطوط الفاصلة ما بين العنف النبيل المشروع المستخدم من قبل حركات المقاومة والعنف الشرير غير المشروع المستخدم من قبل الحركات الإرهابية، وللتأكيد على صحة الشعار القائل: “المقاومة بالإرهاب ضد الإرهاب ليست بإرهاب” ([41])، نجد لزاماً علينا تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية.
المطلب الأول
تعريف المقاومة والإرهاب
ينبغى قبل الشروع فى تحديد العناصر الفاصلة بين الإرهاب غير المشروع والمقاومة المشروعة وما يترتب على ذلك من نتائج عديدة منها جواز تسليم مرتكبيها فى النوعية الأولى “الأعمال الإرهابية”، وعدم جواز تسليم أفرادها فى النوعية الثانية “أعمال المقاومة المسلحة”([42])، أن نقف على تعريف محدد لكلا النوعين يمكننا من خلاله تحديد تلك الفواصل والمعايير اللازمة للتمييز بينهما.
فنجد أننا يمكن تعريف المقاومة بأنها: “صراع عسكرى مسلح تديره تنظيمات مسلحة وطنية ضد قوات احتلال أجنبية تهدف إلى تحرير البلد وتخضع عملياتها لقواعد القانون الدولى الإنسانى”([43])، ويلاحظ أن تلك التنظيمات تستخدم أسلوب حرب العصابات Gurerrella، أو ارتكاب أعمال التخريب ضد أهداف العدو التى يجوز لأفـراد الجيـوش النظامية ارتكابها([44]) لاستنزاف قوة الخصم وإنهاكه والتأثير على استعداده النفسى.
واستخدمت حركات المقاومة كذلك بعض الوسائل الإرهابية Terrorism Tactics فى تنفيذ عملياتها عن طريق تقسيم نفسها لمجموعات صغيرة تمارس فيها تكتيك الإرهابيين، وهو ما مارسه الشعب الأسبانى فى انتفاضته ضد نابليون، وحركات المقاومة الفرنسية فيما بين عامى 1940 – 1945 ([45]).
واختلف الفقه الدولى حول مدى شرعية لجوء أفراد المقاومة المسلحة إلى استخدام الأساليب الإرهابية فى تنفيذ عملياتهم ضد العدو، ما بين اتجاه مجيز لكافة الوسائل أياً كان نوعها لصد العدوان الواقع عليها والإرهاب الموجه ضدها أخذاً بمبدأ المعاملة بالمثل والثأر رداً على انتهاك الشرعية الدولية كوسيلة للضغط على المعتدى الذى لا يرتدع، وهى تمثل وجهة نظر غالبية دول العالم الثالث ودول عدم الانحياز فى الأمم المتحدة([46])، واتجاه آخر يحظر اللجوء إلى تلك الوسائل الإرهابية على سند من القول أن الوصول لغاية مشروعة
لابد له من وسيلة مشروعة([47])، وهو ما حاولت منظمة التحرير الفلسطينية التأكيد عليه فى إعلان القاهرة حول مراحل النضال الفلسطينى الصادر يوم 7 نوفمبر 1985 بتأكيدها على التفرقة بين الأعمال الإرهابية ومقاومة الاحتلال الاسرائيلى([48]).
ونحن من جانبنـــــــــــا نـــرى أنه لابد لتلك الحركات المُقاوِمة الالتزام بقوانين وأعراف الحرب تحت مظلة قواعد القانون الدولى الأنسانى بشرط إلتزام الخصم بذات المبادىء، إلا أنه يمكن تمييزها- بإعتبارها الطرف الأضعف فى المعادلة والمجنى عليها وصاحب الحق – بالسماح لها باللجوء لهذا النوع من الوسائل القتالية والهجومية فى أضيق الحدود فى حالتى الضرورات العسكرية ، وحالة استنفاذها لكل الوسائل والأساليب الأخرى القتالية وكل الخيارات الأخرى المفتوحة أمامها لردع العدوان، وذلك بهدف لفت انتباه الرأى العام العالمى إذا ما وقف ساكناً دون حراك إزاء جرائم العدوان، ولوضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته المفترضة لحماية السلم والأمن الدوليين، كل ذلك تأييداً للقاعدة القانونية التى تقضى ” بعدم تمكين المعتدى من جنى ثمار عدوانه”.
تعددت تعريفات الإرهاب باختلاف وجهات نظر فقهاء القانون الدولى فى تحديد تلك الظاهرة والعناصر المكونة للعمل الإرهابى([49]) ، وفى هذا الصدد يمكننا الاعتماد على تعريف الإرهاب الوارد فى بيان وزراء الداخلية والعدل العرب بجامعة الدول العربية فى 22 أبريل 1998 والذى أكد على أهمية التمييز بين الإرهاب وكفاح الشعوب المشروع من خلال استخدام القوة المسلحة بمختلف الوسائل من أجل تحرير أراضيها وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربى وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارتها ومبادئها([50]).
فقد عُرِّفَ الإرهاب وجرائمه على المستوى العربى فى ذلك المؤتمر على أنه: “هو كل جريمة أو الشروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابى فى أى دولة من الدول الأعضاء فى الجامعة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يُعاقب عليها قانونها الداخلى، ولا تعد جريمة حالات الكفاح المسلح بمختلف الوسائل بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد المحتل الأجنبى والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير وفقاً لمبادىء القانون الدولى، ولا يعد من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأى من الدول العربية”([51])، وهى ذات المبادىء التى أكد عليها مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته السابعة عشر التى عقدت فى الجزائر بتاريخ (29-30/1/2000).
وقد حدث هذا الخلط بين مفهومى المقاومة المشروعة التى تقوم بها الجماعات المسلحة ضد دولة الاحتلال الأجنبية من أجل نيل الاستقلال ومفهوم الإرهاب غير المشروع الذى يقوم به أفراد أو منظمات من أجل تحقيق أهداف معينة أيا كانت طبيعتها([52])، نتيجة قيام بعض تلك الجماعات النضالية لاستخدام أساليب قتال غير تقليدية كان لها أثرها فى المساس بحياة وسلامة المدنيين الأبرياء وبعض الأعيان المدنية وذلك لتقليل التفاوت الرهيب فى ميزان القوى بين حركات المقاومة المسلحة ويبين دول الاحتلال التى تجرى ضدها أعمال المقاومة([53])، فضلاً عن أن مصطلح الإرهاب- على وحد وصف البعض([54]) – مثل جبل الجليد لا تظهر للعيون إلا قمته أما باقى أجزائه تختفى تماماً تحت الماء وكل المحاولات لمكافحته تستهدف الجزء الظاهر فقط.
وجدير بالذكر أن المشرع المصرى لم يتعرض صراحةً للإرهاب إلا فى التعديل الذى أُجرِىَ بقانون العقوبات رقم 97 لسنه 1922 حيث نص فى المادة 86 على أن المقصود بالإرهاب: “هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر..” ([55]).
من جماع ما سبق يتضح لنا أنه لابد للعمل الإرهابى من عناصر رئيسية تميزه عن غيره من الأعمال الأخرى منها:
1- استخدام العنف أو مجرد التهديد به على وجه غير مشروع أو غير مألوف.
2- يقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد ضد المجتمع بأسره.
3- يهدف إلى خلق حالة من الرعب والفزع ، وعادة ما يتجاوز العمل الإرهابى صور الهدف المباشر الذى لا يكون له أدنى علاقة بقضية الإرهابيين([56]).
4- وتتعدد أسباب الإرهاب ودوافعه من أسباب أخلاقيه لتحقيق وضع سياسى لفئة تنتمى لدين أو لغة أو أصل أو أسباب شخصية مادية، أو لاعتناق عقائد سياسية والدفاع عنها، أو حتى لأسباب وطنية والتى تكمن فى بعض الوسائل الإرهابية التى قد تستخدمها بعض حركات التحرر الوطنى([57]).
المطلب الثانى
التمييز بين الإرهاب المشروع ضد الأهداف العسكرية والإرهاب غيرالمشروع ضد الأهداف المدنية
وُجِدَت نظريتان فى الفقه الدولى تنازعا فى قاعدة “الغاية تبرر الوسيلة” ما بين مؤيد ومعارض، وذلك للإجابة على السؤال المطروح وهو هل يجوز لحركات تقرير المصير أن تلجأ فى سبيل تحقيق أهدافها الوطنية المشروعة فى تقرير المصير والحرية والاستقلال إلى كافة الوسائل – بما فيها الأعمال الإرهابية- لصد العدوان غير المشروع الواقع عليها والدفاع عن نفسها..؟؟
تجدر الإشارة أولاً إلى أن أصحاب النظرية التى أقرت بحق الشعوب المقهورة فى اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لديها –بما فيها الارهاب- لردع المعتدى الذى ابتدأ بالعدوان الجائر، كما يقول بابيوف Baboeuf بأن ” كل الوسائل تصبح شرعية فى مواجهة الطغيان”([58])، انقسموا على أنفسهم عندما برز السؤال حول جواز استخدام وسيلة ” الإرهاب” ضد جميع الأهداف المعادية سواء كانت مدنية أو عسكرية أم أن ذلك لا يجوز إعمالاً لمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أو مبدأ التفرقة بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية؟ وذلك على النحو التالى([59]):
[1] ذهب فريق من الفقهاء أن الإرهاب كجزء من نضال مسلح لحركة تحرير وطنية يعتبر مبرراً من وجهة نظر ثورية بشرط ألا يصبح هذا الإرهاب عملاً رئيساً ووحيداً لحركة المقاومة التى تزعم الثورية والوطنية([60]). [2] وذهب آخرون إلى ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والتى يجوز توجيه كل الوسائل -بما فيها الأعمال الإرهابية- ضدها وتعتبر تلك الوسائل الإرهابية فى هذا الصدد مشروعة، وبين الأهداف المدنية والتى تصبح الوسائل الإرهابية ضدها عملاً غير مشروع، كل ذلك بغرض إضعاف القوة العسكرية للعدو، موضحين بأن استعمال القوة والإرهاب ضد الأهداف شبه العسكرية أو غير العسكرية للدولة الخصم لا علاقة لها بمسألة الإرهاب المنفصلة، أما استعمال القوة من قبل أفراد ينتمون إلى حركات التحرير الوطنى ضد أهداف مدنية خارج أراضى الدولة المحتلة ففيها اختلاط الكفاح الوطنى المسلح بالإرهاب الدولى اختلاطاً يصعب تفكيكه([61]). [3] بينما نادى فريق ثالث بإضفاء صفة المشروعية على جميع الأنشطة والعمليات العسكرية التى تقوم بها حركات المقاومة فى سياق كفاحها المسلح دفاعاً عن النفس وفى سبيل تقرير المصير بما فى ذلك أعمال الإرهاب التى تنفذها، لأنها تواجه إرهاب وعدوان الدولة المعتدية إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل([62])، وعلى ذلك رفض أنصار هذا الاتجاه ما زعمه بنيامين نتنياهو فى كتابهTerrorism : How the west can wine([63]) من أن المقصود بالأعمال الإرهابية التى قامت بها المنظمات الفلسطينية ضد إسرائيل كان هدفها الابتزاز ، لأن تلك الأعمال جاءت رداً على الإرهاب المتصاعد من قبل إسرائيل بحق سكان الأراضى المحتلة، ولأن الأخذ بالثأر أمر وارد فى العرف و القانون الدولى رداً على انتهاك الشرعية الدولية خارج الأراضى المحتلة كوسيلة للضغط على المعتدى الذى لا يرتدع([64]).وتأسيساً على ما تقدم نجد أن الفقه في أغلبه أجاز توجيه الأعمال الإرهابية المشروعة ضد نوعين من الأهداف أحدهما الأهداف العسكرية وشبة العسكرية وثانيهما الأهداف غير البريئة للعدو، بينما لا لم يجز توجيه الأعمال الإرهابية بشكل مباشر ومتعمد نحو الأهداف المدنية البريئة وذلك إعمالا لمبدأ “التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية” المستقرة فى قانون الحرب بغية توفير الحماية للسكان المدنيين، على النحو التالى: –
أولاً: الإرهاب المشروع الموجه ضد الأهداف العسكرية:
استقر الفقه الدولى على التسليم بحق أفراد المقاومة باستخدام أساليب العنف غير المألوفة ضد الأهداف العسكرية أو المصالح المادية للدولة المستعمرة أو دولة الاحتلال بما فى ذلك الجنود النظامية و المعدات بهدف مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض وصولاً لتقرير المصير، حتى ولو تم توجيه تلك القوة ضد المصالح المادية لدولة الاحتلال خارج الأراضى المحتلة بشرط عدم المساس بالأبرياء وفقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن([65])، وبمفهوم المخالفة فإن استخدام الأساليب الإرهابية ضد المدنيين العزل يعد عملاً غير مشروع ومستهجناً من قبل المجتمع الدولى ([66]).
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن استخدام الأساليب الإرهابية ضد هذه الأهداف يجب أن تتم تحت مظلة قوانين وأعراف الحرب، ويظل استعمالها مشروعاً طالما كانت على قدر من التمييز فى توجيهها نحو تلك الأهداف العسكرية وابتعادها عن الأهداف المدنية أما إذا تجاوزت ذلك فتفقد تلك الأعمال الإرهابية مشروعيتها وتضحى أعمال محظورة .
وقد رأى الأستاذ الدكتور صلاح الدين عامر جواز توجيه الأعمال الإرهابية المشروعة ضد الأهداف العسكرية المعادية سواء من أفراد تتوافر لديهم وصف المقاتلين القانونيين وفقاً لنصوص جنيف أو من أفراد لا تتوافر لديهم هذا الوصف، وذلك نزولاً على الروح العامة للنظرية الحديثة للمقاومة التى تؤكد على شرعية المقاومة بكافة أنواعها وعدم شرعية الاحتلال العسكرى لخصومها، فإذا ما سلمنا بأحقية أفراد المقاومة فى ممارسة أعمال الإرهاب لتقليل الفوارق فى توازن القوى بين المقاومة وبين العدو المحتل، فإنه من المتعين أن يكون مفهوماً أن ذلك الأسلوب يختلف عن أساليب القتال المعتادة تكون فيه الأهداف العسكرية أهدافاً مشروعة أياً ما كانت الوسيلة أو الأسلوب الذى يتبع فى إصابتها بهدف الوصول إلى إضعاف القوة العسكرية للعدو([67]).
ثانياً: الإرهاب المشروع الموجه ضد الأهداف غير البريئة بشكل عام:
لابد لنا الإشارة فى هذا الصدد أنه إزاء تهاوى مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين وتجميده خاصة فى ظل حرب الغارات الجوية على المدن الآهلة بالسكان والتى اتبعتها كلاً من قوات المحور والحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية ضد مدن الطرف الآخر فيما عرف “بالقصف الإرهابى للمدن”([68])، برزت الحاجة إلى التوصية التى أقرها المؤتمر الدولى العشرين للصليب الأحمر والمنعقد فى فيينا عام 1965 والتى كانت تحمل عنوان “حماية السكان المدنيين ضد أخطار القتال العشوائى”([69]) والتى أنشأت قاعدة ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية وشبه العسكرية غير البريئة والأهداف المدنية البريئة، إلى أن تم النص على هذا المبدأ صراحة فى المادة رقم 48 من البروتوكول الإضافى الأول([70])، وعلى هذا يمكن القول بجواز توجيه الأعمال الإرهابية ضد أهداف معادية غير بريئة بشكل عام، ويكون استخدام الإرهاب فى هذه الحالة استخداماً مشروعاً.
ثالثاً: الإرهاب غير المشروع ضد الأهداف المدنية والسكان المدنيين:
فنجد أن المادة 50 من البروتوكول الإضافى الأول عرفت السكان المدنيين على أنهم:-
[1] المدنى هو أى شخص لا ينتمى إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها فى البنود… وإذا ثار الشك حول ما إذا كان الشخص مدنياً أم غير مدنى فإن ذلك الشخص يعد مدنياً. [2] يندرج فى السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين. [3] لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية إذا وُجِدَ أفراد بينهم لا يسرى عليهم تعريف المدنيين.وهو ما يعنى أن البروتوكول قد أخذ بالتعريف السلبى للمدنيين وذلك لإسباغ الحماية على أكبر عدد من الأشخاص بعكس التعريف الايجابي للأهداف العسكرية والمنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 52 من البروتوكول المشار إليه، وهو ما يعنى كذلك أن الأهداف والأعيان المدنية هى: كافة الأعيان التى ليست أهدافاً عسكرية والمذكورة فى الفقرة الثانية من المادة 52 من البروتوكول الأول.
وأسبغت المادتان 51 ، 57 من البروتوكول الإضافى الأول 1977 حمايتهما على تلك الأهداف المدنية والسكان المدنيين وجَّرمت أى اعتداء عليهما أو حتى بث الذعر فى صفوف أولئك المدنيين([71])، وهو ما يعنى حظر استهداف السكان المدنيين والأعيان المدنية بالعمليات الإرهابية أو حتى مجرد التهديد بالعنف بشرط عدم مشاركتهم فى الأعمال العدائية بصورة مباشرة حسب نص المادة 52/3 من البروتوكول الأول.
الأمر الذى يُشَرِّع لعمليات المقاومة المسلحة المشروعة – التى يسميها البعض بالإرهابية – ضد المحتل وقواته وأفراده على اعتبار أن” ما أُخِذَ بالقوة والإرهاب لا يمكن أن يُسترد إلا بالطريقة التى أخذ بها”، وهى الحقيقة التى استنتجها “مارتن فان كريفلد” حيث قال: “أن من يقاتل الارهابين لأية فترة من الزمن ، من شأنه أن يصبح واحداً منهم ….” ([72]).
المطلب الثالث
معايير التمييز بين التنظيمات الإرهابية والحركات النضالية
عرضنا فيما سبق تعمد بعض الفقه الخلط بين مقاومة الاحتلال والإرهاب لاتخاذ ذلك ذريعة لتشوية الحقائق وتزييف الوقائع لضرب الشعوب والعدوان عليها، وكان لابد – إزاء هذا الواقع غير المنصف – استنتاج عدة معايير من صلب قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية والسوابق التاريخية والقضائية للتمييز بين الأعمال الإرهابية غير المشروعة وأعمال المقاومة المشروعة.
وسنجد أن مجموع هذه المعايير والفواصل تتداخل فيما بينها وتتضافر لتؤكد انتفاء شبهة الارهاب عن نضال الشعوب المقهورة التى تتدرج تحت نير الاستعمار ، ومن ضمن تلك الفواصل واهمها:
أولاً: من ناحية المشروعية:
ويعد محوراً أساسياً فى التمييز بين الإرهاب والمقاومة والذى يميز الأخيرة فى جميع أنشطتها، وهذا ما أكدته مبادىء القانون الدولى العرفى والاتفاقى ودعمته الاتجاهات الفقهية الدولية المعاصرة وبلورته خبرة العمل الدولى، ويؤكد من جديد أن الاستعمار هما السبب الرئيسى فى وجود المقاومة فلو انتفى الأول بطل الثانى([73])، فأى عنف تقوم به هذه الحركات يعتبر مشروع ما دام يهدف إلى الاستقلال.
وبناءً على ذلك فإن من حق المقاوم أن يستخدم القوة لدحر الاحتلال باعتبار عمله حقا من حقوق المصير، بعكس الإرهاب الذى لا مبرر له سواء كان ضد السلطة الحاكمة أو ضد الشعوب ويشكل جريمة دولية باعتباره فعلاً غير مشروع([74]).
ثانياً: من ناحية الدوافع والأهداف:
إن المقياس الفاصل بين الإرهابى المجرم والإرهابى المناضل، يتألف من عنصرين يشكلان مفهوماً واحداً وهما السبب الذى يدفع المناضل أو المجرم للقتال، والهدف الذى يسعى كل منهما إلى بلوغه([75]) ، فنجد أن أفراد المقاومة يلجأون للسلاح بدافع من مشاعرهم الوطنية بهدف تحرير أرض الأجداد من العدوان، بينما نجد أن طائفة الأفراد التى قد تقوم بأعمال العنف والإرهاب تقوم بذلك بقصد الحصول على مغانم خاصة أو للسلب والنهب حتى ولو جرت هذه الأعمال ضد العدو الأجنبى([76]).
وتعتمد المقاومة لتحقيق هدفها المشروع على الجانب المادى وقدرتها على تدمير العدو وحده، أما الإرهاب فيقوم على العنف لتمييز موازين العدل وإشاعة الرعب لقبول الظلم أو السكوت على الاعتداء وسلب الحقوق إلى جانب ما يعتمد عليه العمل الإرهابى من عامل نفسى بهدف بث الذعر وخلق الرعب لدى المجتمع إعلاءً لقاعدة ” ارهب عدوك وانشر قضيتك “([77]).
ثالثاً: من ناحية الطابع الشعبى:
إن عنصر الدافع الوطنى النبيل الذى تتبلور حوله وتعمل فى سياقه حركات تقرير المصير ضد الاحتلال، هو الذى يخلق نوعاً من التعاطف الشعبى لدى قطاعات كبيرة من الشعب بمختلف طبقاته وتوجهاته وفئاته، مما يولد رغبة عارمة ومتسعة للاقبال على الانضمام إلى صفوف المقاومة لمواجهة المعتدى أو على الأقل يبادر أفراد الشعب بتقديم الدعم اللوجستى والمساعدة المعنوية([78]).
وهو الأمر المفتقد فى جماعة الإرهابيين لأن المنخرطون والمنضمون لهم هم عادةً أشخاص ناقمون على الأوضاع فى المجتمع ولا يمثلون بحال من الأحوال سوى قطاع محدود من الشعب([79]).
رابعاً: من ناحية القوى التى تجرى ضدها عمليات القتال:
فنجد أنه لابد للحديث عن أعمال المقاومة أن تجرى ضد عدو أجنبى فرض وجوده بالقوة العسكرية ويكون هدف تلك الحركات المقاومة الاستقلال والخروج من نير الاستعمار.
أما الأعمال الإرهابية فإنها عادة ما توجه إلى أهداف داخل المجتمع أو حتى خارجه لتحقيق مكاسب شخصية وللتأكيد على مضمون ما تسعى إليه تلك الجماعات الإرهابية فى أوساط الحكومة أو النظام السياسى القائم فى مجتمع من المجتمعات.
خامساً: من ناحية السوابق التاريخية والقضائية:
فنجد أن الدول التى تتنكر لحق الشعوب المحتلة فى المقاومة هى ذاتها التى مارست هذا الحق فى فترة من الفترات ضد أعدائها، فلقد اعتبر قادة المقاومة الأمريكية قتل أصحاب “الستر الحمراء” أى الجنود الإنكليز والموالين لهم أفعالاً وطنية، كما أن اليهود شاركوا مشاركة فعالة فى مقاومة الاحتلال النازى للبلاد التى سكنوها فى الحرب العالمية الثانية([80]).
وينبغى التنويه هنا إلى التصريح الذى أدلى به إيهود باراك زعيم حزب العمل الاسرائيلى ورئيس الوزراء الإسرائيلى السابق عندما قال: ” لو كنت فلسطينياً لانضمت إلى منظمة إرهابية فى مرحلة معينة ” ([81])، وهو التصريح الذى يدل على الاعتراف الضمنى بشرعية مقاومة الاحتلال وهو ما أثار حفيظة باقى الأحزاب والمسئولين الإسرائيليين.
سادساً: المعيار المستمد من القانون الدولى الإنسانى:
وهذا المعيار ينقسم فى حقيقته إلى معيارين:
- يتعلق بوضع الشخص الذى يرتكب أعمال العنف : فأفراد القوات المسلحة التابعة لطرف فى نزاع مسلح لهم الحق فى الاشتراك فى الأعمال العدائية، وإذا لجأ للعنف غير المشروع فإن أفعالهم تعتبر آنذاك أفعالاً إرهابية.
- يتعلق بالقواعد المنظمة لحماية فئات محددة والقواعد المتعلقة بوسائل الحرب: فلكى يكون استخدام العنف فى الحرب مشروعاً لابد أن يُلتزم فيه بالقيود المفروضة فى قانون الحرب وإلا أصبح أفراد القوات المسلحة هم أنفسهم إرهابيين إذا انتهكوا قوانين الحرب.
ويلاحظ أن حركات المقاومة – في أغلبها – وأفرادها المنضويين تحت لوائها يلتزمون بكلا المعيارين، من حيث أنهم مقاتلون نظاميون وفقاً للاتفاقيات الدولية، كما أنهم يقومون بعملياتهم العسكرية ضد قوات الاحتلال وقفاً لقوانين الحرب مما يعطيها كامل الشرعية القانونية ، وهو ما يميزها عن سائر العمليات الإرهابية التى يقوم بها أشخاص غير منضمين لمثل هذه الحركات تحقيقاً لأغراض شخصية.
سابعاً: من ناحية القدرة على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية:
فانتهاك هذا المبدأ يفقد حق المقاومة شرعيته وتتحول الأعمال التى تجرى فى ظله وبسببه إلى أعمال إرهابية وذلك فى حال توجيه القتال ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية – كما أشرنا سلفاً- أما إذا تم توجيه القتال إلى الأهداف العسكرية أو شبه العسكرية أو حتى الأهداف الغير بريئة فلا تعد تلك الأعمال الموجهة آنذاك أعمالاً إرهابية.
ثامناً: المعيار المستمد من مفهوم الجريمة الدولية وأسباب إباحتها وموانع مسئوليتها:
إذا كانت الجريمة الدولية تمثل عملاً دولياً غير مشروع من حيث القاعدة العامة، فإننا نرى أن الإرهاب الدولى يقع تحت طائلة الحظر المفروض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبالتالى فإنه يعد جريمة دولية إلا إذا انتقت مسئولية فاعل الجريمة عنها، ومثال ذلك إذا انصبت موانع المسئولية على الركن المعنوى للجريمة أى على القصد والإرادة.
وتطبيقاً لذلك فإنه إذا لجأت حركات المقاومة إلى ممارسة الإرهاب ضد أعدائها الغزاة تحت تأثير بعض الضرورات العسكرية الملجئة، فإن مسئولية هذه الحركات عن مثل هذه الأعمال تنتفى نظراً لوقوعها تحت مظلة حالة الضرورة أو الإكراه المادى أو المعنوى ولتوافر المبرر القانونى والأخلاقى لتقرير المصير([82]).
تاسعاً: من ناحية العلنية والخفاء:
فالمقاومة عمل عسكرى منظم يخضع لقواعد قانونية دولية تعمل علناً ، والعمل العسكرى يتخذ شكل العمل العلنى، بينما العمل الإرهابى يعمل بالخفاء.
عاشراً: من ناحية النتائج المحققة:
فلا يمكن للإرهاب إلا أن يخلق جواً من الفوضى العارمة التى لا تحقق شيئاً، بينما المقاومة تحقق نوعاً من التوازن فى القوة بين أهل الحق وأهل الباطل وتؤدى إلى نوع من الاستقرار وتؤمن الناس فى أوطانهم ([83]).
هذه بعض المحددات والفواصل التى تميز الإرهاب غير المشروع عن المقاومة المشروعة التى يكون هدفها الحصول على الاستقلال وتقرير المصير.
المبحث الثالث
التفرقة بين حركات تقرير المصير الوطنية والحركات العنصرية والانفصالية
سنحاول تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين سنتناول فى المطلب الأول الحركة العنصرية، وفى المطلب الثانى الحركة الانفصالية.
المطلب الأول
الحركة العنصرية
إذا ما تناولنا الحركة العنصرية نجد أن الحركة الصهيونية تبرز إلى الواجهة كأبرز تلك الحركات على الاطلاق – على الأقل فى الوقت الراهن – ، وقد عرفتها دائرة المعارف اليهودية فى عام 1905 على أنها: “حركة تسعى إلى عزل الشعب اليهودى على أساس قوى فى وطن مستقل به ، وظهر ذلك جلياً فى الحركة الحديثة الساعية لكى تحقق لليهود وطناً مكفولاً قانونياً فى فلسطين حسبما دعا إلى ذلك تيودور هرتزل فى عام 1896”([84]).
وقد عَّرف الزعيم الصهيونى ناحوم جولدمان الصهيونية بأنها: “حركة استهدفت أمرين الأول: إنقاذ اليهود الذين يعانون التفرقة والشتات بإتاحة فرصة الحياة فى وطن خاص بهم، والثانى: كفالة بقاء الشعب اليهودى حياً فى مواجهة التفتيت والذوبان فى تلك البلاد من العالم التى يتمتع فيها اليهود بالمساواة التامة فى الحقوق”([85]).
ونجد – من خلال هذين التعريفين- أن الحركة الصهيونية تعمل بهدف تحقيق تقرير المصير القومى، وهى النقطة التى تتداخل فيها مع حركات التحرر الوطنى إلا أن الاختلاف بين كلا النوعين يتضح فى أن ما تسعى إليه هذه الحركة العنصرية هو إقامة دولة لذوى ديانة واحدة هم يهود العالم بالتحالف مع الاستعمار لاستعباد الشعوب، بمعنى أن مفهوم حق تقرير المصير القومى للصهاينة هو المناقض تماماً للمفهوم الذى تتبناه الأمم المتحدة ابتداء من قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) وما تلتها من قرارات([86]).
ومن ضمن الفوارق الأخرى التى تميز كلا الحركتين عن بعضهما “الصهيونية والوطنية” ، أن الحركة الصهيونية منذ نشأتها تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، بل وإخلاء تلك الأرض من سكانها الأصليين.
ولعل أهم المميزات الرئيسة التى تميز تلك الحركة العنصرية هى الطبيعة الاستعمارية للحركة الصهيونية ، وهو ما أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 11/11/1975 حيث اعتبرت الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصرى([87])، بما يعنى نشأة تلك الحركة وقيامها على اعتداء كامل على أهم حق من حقوق الشعوب وهو حق تقرير المصير وحرياته الأساسية، فهذه الحركة قامت على أساس الفكر الاستعماري “وعد بلفور 2/11/19717 ” وليس على أساس الفكر اليهودى”([88]).
ويترتب على هذه التفرقة بين كلا الحركتين، أن القوة المسلحة التى تستخدمها الحركات الوطنية بهدف الوصول لتقرير حق المصير هى مشروعة فى نظر القانون الدولى، بينما القوة المسلحة التى تستخدمها الحركة الصهيونية التى ليس لها سند قانونى فى القانون الدولى ليست مشروعة لأنها تمثل شكلاً من أشكال العدوان.
المطلب الثانى
الحركة الانفصالية
تعرف الحركة الانفصالية على أنها: “قيام أقلية من سكان دولة باستخدام القوة المسلحة ضد الحكومة الشرعية فى محاولة منها لإقامة دولة جديدة لها ضمن نطاق إقليم الدولة الأصلى، وتأسيس حكومة لها لإدارة شئونها”، وتقوم الحركة الانفصالية على فكرتين رئيستين([89]):
[1] فكرة إقامة كيان دولى جديد. [2] فكرة خوض الحركة كفاحاً مسلحاً فى إطار دولة واحدة ضد حكومة شرعية واحدة.وتتقاطع حروب الانفصال مع الحرب الأهلية فى نقاط عديدة منها أن كليهما تجريان فى إطار دولة واحدة، وضد حكومة شرعية، وبين طرفين أو أكثر من سكان الدولة لهم ميول سياسية مختلفة، وتستخدم فى نشاطها القوة المسلحة، ومبعثها الوصول للحكم، إلا أنه يمكن التمييز بينهما فى أن الحرب الأهلية لا تقوم من أجل إقامة كيان دولى جديد بل من أجل السلطة فحسب([90]).
وعلى ذلك فيثور هنا تساؤل مؤداه، هل يمكن القول بأن مثل هذا النوع من الحركات الانفصالية بمثابة حركات تحرر وطنية؟؟
والإجابة على ذلك السؤال هي بالنفي قطعاً لأن حروب الانفصال هي نوع من الحروب الأهلية لا تختلف عنها إلا من حيث الغرض الذى تسعى إلى تحقيقه وهو إقامة كيان دولى جديد، فنجد أن الاختلاف الجوهرى بين كلا الحركتين “الانفصالية والوطنية” ، هو فى كون الأخيرة توجه نشاطها العسكرى ضد سيطرة استعمارية أجنبية، بينما تقاتل الأولى ضد سلطة الحكومة الشرعية فى داخل الدولة، مثل الحركة الشعبية فى جنوب السودان التى تحققت لها أهدافها من خلال اتفاق سلام أبرمته مع الحكومة السودانية فى يناير 2005([91]).
وهناك العديد من الحركات الانفصالية التى نشأت استناداً إلى حق تقرير المصير نذكر منها:-
أولاً: الحركة القومية الباسكية فى أسبانيا:
وقد استند مشروع الحركة الباسكية حول إقليم الباسك على مبدأين أساسيين هما:
-
- الاعتراف بالحقوق التاريخية لشعب الباسك والمرتبطة بالسيادة.
- حق تقرير المصير القومى.
وقد خاضت الحركة نضالاً كبيراً ضد الحكومة المركزية فى أسبانيا للتسليم بأهدافها، إلى أن تمت الموافقة على نتيجة الاستفتاء المعروض على الشعب فى 25 أكتوبر 1979 بإقرار الحكم الذاتى لإقليم الباسك، وسار على ذات النهج إقليمى “كتالونيا” و”جاليس” وأُقِرَّ لهما الحكم الذاتى أسوةً بإقليم الباسك([92]).
ثانياً: الحركة الانفصالية فى باكستان:
تشكلت هذه الحركة بزعامة “حزب عوامى” ضد الحكومة المركزية الباكستانية عام 1971، حيث تمكنت فى نهاية المطاف- بدعم مباشر من الهند – من إقامة كيان دولى جديد فى باكستان الشرقية تحت اسم دولة البنجلاديش بعد قتال مسلح عنيف([93]).
ثالثاً: الحركة الانفصالية فى نيجيريا:
فى عام 1967 دار نزاع مسلح بين حكومة لاجوس المركزية من ناحية والحركة الانفصالية فى إقليم بيافرا من ناحية أخرى، واعترفت بعض الدول على إثره بالحكومة الانفصالية التى شكلتها الحركة فى هذا الإقليم ، ومن هذه الدول تنزانيا وزامبيا وساحل العاج، إلا أنه فى نهاية المطاف فشلت تلك الحركة عندما انتهى النزاع المسلح فى عام 1970 بسيطرة الحكومة المركزية النيجرية على الحركة الانفصالية وإخضاعها لسلطانها([94]).
ويُلاحظ مما سبق أن حركة التحرير الوطنى تتميز عن الحركة الانفصالية – بالإضافة إلى ما سبق ذكره- بأن الأولى تهدف إلى حق تقرير المصير الذى يحميه القانون الدولى وهو حق مقرر للشعوب دون أجزاء من الشعوب التى تعانى من سيطرة خارجية أجنبية ، بينما الثانية تعمل من أجل تقرير المصير الذى يحميه القانون الداخلى ودساتير الدول ومقرر لجزء من الشعوب.
المبحث الرابع
التفرقة بين الحركات الوطنية والميلشيات العسكرية والشركات الأمنية
استمرار للنهج الذى انتهجناه من ضرورة تمييز حركات المقاومة عن كل المتشابهات والمجموعات والجماعات التى قد تمارس نفس عملياتها المسلحة، وما يستتبع ذلك من أهمية إسباغ قواعد القانون الدولى الإنسانى عليها ومنحها كافة الحقوق القانونية وإلزامها ببعض الواجبات ، فإننا نجد لزاماً علينا التطرق فى هذا المبحث لفئتى الميليشيات العسكرية وكذا الشركات الأمنية فى مطلبين متتاليين وذلك على النحو التالى:
المطلب الأول
الميليشيات العسكرية
لم يكن مصطلح الميليشيات متداولاً فى أى حقبة من تاريخ الأمة العربية كما هو متداول الآن، وبخاصة فى وسائل الإعلام العربية والعالمية، ويمكن تعريفها على أنها: ” تنظيم عسكرى غير نظامى ينفذ أعماله بصورة حرب العصابات والإغارة ضد قوات عدو تفوقه عدداً وعدة” ([95]) منها على سبيل المثال ميليشيات البشمركة فى العراق، وميليشيات الجنجويد فى السودان فكلاهما ميلشيات مسلحة غير نظامية رغم اختلاف سبب نشأة كل منهما وآليات عمله([96]).
فنجد أن أهم الفوارق بين الميليشيات العسكرية وحركات التحرر الوطنية فى قتالهما المسلح هو الدافع من وراء ذلك النزاع، فبينما نجد الرغبة فى تقرير المصير هو السبب وراء قتال حركات المقاومة لصد العدوان، نجد أن المصالح الشخصية والمادية المحدودة هى الدافع وراء النزاعات التى تشترك فيها تلك الميلشيات.
ونجد أنه على سبيل المثال ظهرت فى إيطاليا ميلشيات إرهابية مثل المافياMAFIA على أساس العقيدة الماسونية للدفاع عن مصالحها ضد الملكية، ومنظمة الكامورا CAMORRA فى نابولى عام 1820 والتى تحولت بعد ذلك إلى الابتزاز ورشوة القضاة، ومنظمة الكاربونارى CARBONARI التى تكونت من عمال الأرض ضد تعسف ملاك الأراضى وانضم إليها بعض الفرنسيين بعد ذلك([97])، ومن ذلك أيضاً ميلشيات الهاجا والأرجون اليهودية المسلحة التى كانت تتخذ الإرهاب شعاراً لها وهدفاً ضد الشعب الفلسطينى قبل عام 1948([98]).
والأمر يدق فى حالة توجيه العصابات المسلحة أو الميليشيات العسكرية أعمالها المسلحة ضد دولة أجنبية أو عندما تلعب بعض تلك العصابات دوراً مزدوجاً تحقق فيه صالحها الخاص وتنال من أمن وقوة من يقف من الشعب موقف العداء، وكذلك قد يختلط عمل العصابات والميليشيات بأعمال حركات التحرر الوطنية فى بعض الحالات مثل أن يلجأ أفراد المقاومة إلى أعمال السطو لتوفير الموارد اللازمة لشراء المؤن والأسلحة والذخائر([99]).
إلا أنه يمكن الاعتماد على معيار الدافع الوطنى الذى يتوفر فى الحركات الوطنية دون الثانية، فحتى فى المثال الأخير لا يفقد هؤلاء الأفراد صفتهم إلا إذا تحولوا بالكلية عن الهدف الوطنى لصالحهم الخاص خاصة إذا كان ذلك بهدف الاستمرار فى نشاط المقاومة إعمالاً لمبدأ الضرورة([100]).
المطلب الثانى
الشركات الأمنية الدولية الخاصة
ظهر ذلك النوع على الصعيد الدولى فجأة خاصة بعد احتلال العراق وأفغانستان، وزاد من حدة ظهورها الفظائع والجرائم التى ارتكبها أفرادها مما أثار جدلاً واسعاً على كافة الأصعدة عن مدى مشروعيتها وشرعية أعمالها التى تأخذ من القتل والحروب تجارة لها.
وقد أُنشِأَت أول شركة أمنية عن طريق عضو سابق فى الفرقة البريطانية “جيم جونسون” ، ثم تلتها شركات أمريكية أهمها (كى بى آر) ، (بلاك ووتر) وكان يقتصر عمل تلك الشركات على توفير الحماية وتدريب الحراسات الخاصة ثم ما لبثت أن شاركت فى النزاعات والحروب كما حدث فى حرب الخليج الثانية 1991 واحتلال العراق 2003 وغيرها من حروب([101]).
وقد عرفها تقرير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الصادر فى مارس 2006 بأنها: “شركات تجارية تقدم خدمات متخصصة تتعلق بالحروب والنزاعات بما فيها العمليات القتالية وجمع المعلومات الاستخباراتية والتدريب وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية وصيانتها ولها هيكل تنظيى ويكون هدفها الربح بشكل أساسى وليس لها أهداف سياسية فهى تخوض حروب بالوكالة “([102]).
ونجد أن البنتاجون يستخدم حوالى (700.000) عنصر من هذه الشركات، وتدرّ صناعة الخصخصة العسكرية ربحاً سنوياً يقدر بـ (100 بليون دولار) من عمليات عسكرية أمريكية فى حوالى خمسين دولة ، وتشير بعض التقارير الصحفية أن حوالى ثلث الميزانية التى خصصت للعمليات العسكرية فى العراق وعمليات أخرى فى وسط آسيا (87 بليون دولار) تم إنفاقها على عقود مع الشركات الأمنية ([103])، وقد بلغت نسبة القوات البريطانية النظامية فى العراق إلى قوات المرتزقة هى (1 : 6) حيث يبلغ إجمالى عدد أفراد هذه الشركات بالعراق وحدها إلى 41 ألف([104])، موزعين على أكثر من خمسين شركة بعضها يمتلك أسطول من طائرات الهليكوبتر([105]).
مما سبق يتضح الفارق الضخم بين هذا النوع من الشركات التجارية غير المشروعة وحركات التحرر الوطنية من ناحية المشروعية والدافع ، فالأولى تهدف إلى الربح وفقط ، بينما الثانية لا تهدف إلا لتحرير أرض الآباء من براثن العدوان، وهو ما يعنى أن هذه الشركات تقع خارج دائرة الشرعية الدولية والقانون الدولى، وتقوم بأعمال تعد بمثابة جرائم دولية.([106])
المبحث الخامس
التفرقة بين الحركات الوطنية والمرتزقة والجواسيس
تعد أبرز نتيجة على أهمية التفرقة بين أفراد حركة المقاومة وأفراد المرتزقة أو الجواسيس، هو أن الآخرين هم من الأشخاص الذي لا ينطبق عليهم وصف أسرى الحرب إذا ما وقعوا فى الأسر أو فى قبضة الخصم.
والتجسس هو: “جمع معلومات أو محاولة جمعها فى إقليم تابع لطرف فى النزاع وذلك من خلال القيام بعمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفى بنية تبليغها للعدو، سواء ارتدى الجاسوس ثياب مدنية أو ارتدى الزى العسكرى للعدو، لكنه يستثنى المقاتلين الذين يقومون بجمع المعلومات وهم يرتدون زيهم الخاص “، و قد جرى تقنين هذا التعريف الآن فى البروتوكول الأول([107]).
أما المرتزقة فهم عبارة عن:” تشكيلات سرية يجرى تدريبها من الخارج ضد نظام من الأنظمة أو ضد حركات التحرر الوطنى أو لإجهاض ثورة من الثورات ، فقد عرفت الاتفاقية الدولية المناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم الصادرة عن الأمم المتحدة([108])فى المادة الأولى منها “المرتزق” هو أى شخص :
- يجند خصيصاً محلياً أو فى الخارج للقتال فى نزاع مسلح.
- ويكون دافعه الأساسى للاشتراك فى الأعمال العدائية هو الرغبة فى تحقيق مغنم شخصي.
ج-ولا يكون من رعايا طرف فى النزاع ولا من المقيمين فى إقليم خاضع لسيطرة طرف فى النزاع.
د- وليس من أفراد القوات المسلحة فى النزاع.
هـ- ولم توفده دولة ليست طرفاً فى النزاع فى مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة.
وقد وُضِعَ تعريف للمرتزقة -بذات المضمون المشار إليه- فى البروتوكول الأول عام 1977 فى المادة 47 منه، وقد اعتبر قرار الجمعية العامة الخاص بتعريف العدوان رقم (3314/ 29) إرسال المرتزقة للقيام بأعمال عنف عملاً من أعمال العدوان وأكد على عدم جواز تمتع المرتزق يوضع المقاتل أو أسير الحرب([109]).
ولاشك أن المرتزقة أو الشركات الأمنية فى نسختها المتطورة تعرقل حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة، وتتعارض مع مبدأ حظر التدخل فى الشئون الداخلية للدول مما يؤكد على عدم مشروعية تجنيدهم
أو استخدامهم أو جلبهم، بل وصل الأمر إلى أن مجرد الشروع أو الاشتراك فى تلك الجرائم الدولية يعد من الجرائم التى يجوز فيها تسليم المجرمين([110]).
والأمثلة على استخدام هؤلاء المرتزقة فى النزاعات المسلحة كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها على سبيل المثال: ذلك الهجوم الذى شُنَّ فى 25/11/1981 على دولة السيشل من عصابات المرتزقة “جماعة مايك المجنون” التى يقودها عسكرى يدعى (هوارى) بقصد قلب نظام الحكم وتنصيب “جيمس مانغام” الموجود خارج السيشل رئيساً للدولة، وهو الأمر الذى كشفته لجنة التحقيق التابعة لمجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار رقم 496/ 1981([111]).
وتأسيساً على ما تقدم نجد أن هناك عدة جوانب لتمييز المرتزقة والجواسيس عن الحركات الوطنية هى ([112]):-
الجانب الأول: اختلاف الباعث بين عصابات المرتزقة وحركات التحرر، فنجد أن حق تقرير المصير الوطنى هو الباعث للأخيرة ، بدليل أن الأولى تحاول زعزعة النظم القائمة بالفعل.
الجانب الثانى: يتمثل فى توجيه خارجى للنشاط العسكرى لعصابات المرتزقة وتدريبهم ومن ثم توجيههم للإقليم المراد الانقضاض عليه، بعكس حركات المقاومة التى تنشأ فى الأصل فى إقليمها الداخلى المعتدى عليه وتوجيه قوته للمحتل على ذات الإقليم.
الجانب الثالث: هدف حركات التحرر هو تحقيق الاستقلال لإقليمها المحتل، بينما تستهدف عصابات المرتزقة جنى الأموال والأرباح أو إسقاط أنظمة أو إجهاض ثورات.
ولا يفوتنـــــــا أخيــــــــــــــــراً أن نشير إلى الفارق بين التنظيمات والأحزاب السياسية من جانب والحركات المناهضة للاستعمار لتقرير المصير من جانب آخر، فالأحزاب السياسية هم جماعة من الناس لهم نظامهم الخاص وأهدافهم ومبادئهم التى يلتفون حولها ويدافعون عنها ولهم هدف رئيسى يتمثل فى الوصول إلى السلطة أو المساهمة فيها في البلد الذي نشأ فيها الحزب، لتحقيق أهداف الحزب ومبادئه وفق نضال سلمى غير مسلح فهي تستخدم أسلوب النضال السياسي([113])، بخلاف تلك الحركات الوطنية التي تقود كفاحها بنضال مسلح لتقرير مصير بلدانها الرازحة تحت الاستعمار.
خاتــمـــــــــــــــة
بعد هذه الدراسة التحليلية والتأصيلية القانونية … يمكننا الخروج ببعض النتائج والتوصيات، وسنحاول إيراد أهم تلك النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من دراستنا للموضوع.
1- كشفت الدراسة عن أن لوائح لاهاي لعامي 1899، 1907، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين المضافين لها عام 1977 هي من المكونات الأساسية لقواعد القانون الدولي العام ، وتمثل الخطوط العريضة للقانون الدولي الإنساني، إذ أن اتفاقيات جنيف في مضمونها تمثل الجانب الإنساني في ذلك القانون، بينما تمثل اتفاقيات لاهاي التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والضرورة العسكرية عن طريق الحد من شرورها، بحيث حظرت على الأطراف المتنازعة استخدام أساليب ووسائل القتال التي تزيد آلام الأشخاص أو الإضرار بالأعيان والممتلكات بما لا تقتضيه الضرورة العسكرية.
2- يتحتم أن يتمتع الأفراد الذين يقاتلون من أجل حق تقرير مصير شعوبهم الرازحة تحت الاحتلال الاستعماري والأجنبي بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني ، وهي حماية قررتها العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية ومنها قرارات الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.
3- إن ” حق تقرير المصير” يعتبر حقاً طبيعياً متأصلاً في قرارات الشرعية الدولية وعدد غير قليل من أحكام المحاكم الدولية ، تتفق مع الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والدينية ، فإذا كان للإنسان الفرد حق مقاومة الظلم والعدوان الواقع عليه ، فإن هذا الحق يكون أظهر وأوضح – من باب أولى – بالنسبة للشعوب والدول فيما إذا تعرضت لمثل هذا الظلم والعدوان ، والمتمثل في احتلال أراضيها واغتصاب حقوقها، وقد تكرس هذا الحق بالأمر الإلهي القائل في محكم تنزيله: ” أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ……” ، فالله – جلَّ في علاه – لا يرضى لنفسه ولا لعباده الاستكانة للظلم والعدوان، ومن هنا فقد شرَّع لهم – جلت حكمته – حق مقاومة هذه الأوضاع الفاسدة حيث قال تعالى: ” وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ” ، ولا يخفى ما لمدلول الكلمة القرآنية الواحدة ” ولا تعتدوا ” في أنها تعتبر وبحق تلخيص لكل قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة.
4- حاولنا – بشق الأنفس – على مدى صفحات الأطروحة إقامة الفواصل ونصب المعايير القانونية الموضوعية المجردة بين مفهومي المقاومة والإرهاب، ومن ثم التمييز بين حركات التحرير وبين غيرها من الحركات التي قد تختلط بها، من خلال عرض هذين المفهومين وهذه الحركات على قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة للحكم والفصل بينهما.
5-يوصي الباحث بضرورة العمل على إعتماد تعريف قانوني عالمي واضح المعالم لمفهوم المقاومة وتحديد أنواعه وصوره ولو على مستوى المنظمات الدولية، لتصب في النهاية في صالح إضفاء الشرعية القانونية الدولية على عمل حركات تقرير المصير من خلال تعريفها تعريفاً يميزها عن أقرانها من الحركات المتشابهة، تجسيداً لحقها في الدفاع الشرعي وتقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة.
6-كما يرى الباحث ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر دولي عالمي لوضع الضوابط القانونية لتلك الحركات، ويتم فيه مناقشة تلك القيود الأربعة المفروضة على حركات النضال الموجهة ضد الاستعمار من قبل الاتفاقيات الدولية المشار إليها سلفاً، ومحاولة كسر تلك القيود التي تقيد وتشل عمل تلك الحركات وإزاحتها جانباً، سيما وأن الدول في أغلبها تدعم تلك الحركات وتساندها.
ولعلني من خلال هذا البحث وتلك التوصيات أكون قد شاركت في توجيه الدعوة إلى جموع المهتمين بحقوق تلك الشعوب المقهورة والمغلوبة على أمرها للعمل على تحقيق ولو جزء مما ورد في هذا البحث، خاصة وأن الأوضاع التي يعيشها المجتمع الدولي تجعل الظروف مواتية للتعجيل بالاستجابة لتلك الدعوة.
المراجــــــــــــــــــــع
أولاً: المراجع العربية:
1. أ. د صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ، دار الفكر العربي ، ط1، القاهرة، 1976
2. د. السيد أبو الخير، مستقبل الحروب دراسات ووثائق، دار مصر العربية للنشر والتوزيع ،2009.
3. د. إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الانسانى الدولى ، كتاب القانون الدولى الإنسانى من اصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دار المستقبل العربى، عام 2003.
4. د. مصطفى طلاس وآخرون، الاستراتيجية السياسية العسكرية، الجزء الأول، مكتبة دار طلاس، دمشق، 2003 .
5. د. صباح نورى علوان العجيلى، استراتيجية حروب التحرير الوطنية، رساله دكتوراه، الأكاديمية العربية المفتوحة فى الدنمارك، كلية القانون والسياسة، 2010 .
6. د. رمزى حوحو، الحدود بين الإرهاب وحركات التحرر الوطنى وفقاً لأحكام القانون الدولى ، مجلة المفكر ، جامعة محمد خيضر، بسكره ، الجزائر ، العدد 3 ، 2008.
7. د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1983.
8. د. محمد طلعت الغنيمى ، الوسيط فى قانون السلام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1982.
9. عز الدين فوده ، شرعية المقاومة فى الأرض المحتلة، مقاله مستخرجه من المجلد الأول لدراسات فى القانون الدولى، المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد 1 ، القاهرة ، 1969.
10. د. عمر إسماعيل سعد الله ، تقرير المصير السياسى للشعوب في القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2002.
11. د. وقاف العياش، مكافحة الارهابيين بين السياسية والقانون، دار الخالدونية ، الجزائر ، ط1، 2006.
12. أ.د عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب، دراسة فقهية وتطبيقة فى نطاق القانون الدولى العام والشريعة الإسلامية ، عالم الكتب ، القاهرة .
13. د. هيثم موسى حسن، التفرقة بين الإرهاب الدولى ومقاومة الاحتلال في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى.
14. د.عبد الله الأشعل، ظاهرة المرتزقة وخطرها على العالم الثالث فى العلاقات الدولية ،( م.م.ق.د )، العدد39، 1983.
15. د. ويصا صالح، المركز القانونى الدولى لحركات المقاومة العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005.
16. نعيمة عمر، مركز حركات التحرر الوطنى، رسالة ماجستير فى القانون الدولى والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 1984
17. : د. عز الدين فوده ، شرعية المقاومة فى الأرض المحتلة ” دراسات فى القانون الدولى” ، سنة 1969، صادر عن الجمعية المصرية للقانون الدولى.
18. ناصر الريس، انتفاضة الشعب الفلسطينى فى ضوء القانون الدولى المعاصر، رسالة ماجستير، الجزائر، 1995.
19. نجاح مطر العبد دقماق، المركز القانونى للأسرى الفلسطينيين فى ضوء أحكام القانون الدولى الإنسانى ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة القدس ،2004 -2005
20. ناصر الريس، المقاومة في القانون الدولي: مشروعية الكفاح الفلسطيني المسلح، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، الطبعة الأولى، 2009
21. . عز الدين فودة، حق المدنيين بالأراضى المحتلة فى الثورة على سلطة الاحتلال الحربى في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006
22. د. نجاح مطر العبد دقماق، التحول فى مفهومى المقاومة والإرهاب في القانون الدولي العام، مجلة جامعة الأزهر – غزة (سلسلة العلوم الإنسانية)، المجلد 13، العدد 2، 2011
23. د. سعد عبد الرحمن قاسم زيدان، تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2002
24. د.عبد الرحيم صدقى، تسليم المجرمين فى جرائم الإرهاب، مجلة القضاء العسكرى، ديسمبر 1993
25. د. نور الدين هنداوى، السياسية الجنائية للمشرع المصرى فى مواجهة جرائم الإرهاب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993
26. د. إمام حسنين عطا الله، الإرهاب والبيان القانونى للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2004
27. د. مصطفى دبارة، الإرهاب مفهومه وأهم جرائمه فى القانون الدولى الجنائى، منشورات قاريونس، ط1، 1999
28. :* د. الشافعى محمد بشير، المعايير الدولية التى تميز حق الشعوب فى تقرير المصير والكفاح المسلح عن الإرهاب الدولى، مجلة الحق، السنة 19، العدد 201، 1998
29. د. محمد المجذوب، القانون الدولى الإنسانى وشرعية المقاومة ضد الاحتلال آفاق وتحديات، منشورات الحلبى الحقوقية ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2005 .
30. بيتر سي سيدربرج ، أساطير إرهابية، ترجمة عفاف معلوف، (د.ت) (د.د.ن) .
31. عبد العزيز عبد الهادى مخيمر، الإرهاب الدولى “مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية”، سلسلة دراسات القانون الدولى الجنائى، دار النهضة العربية، 1986. .
32. د.عائشة راتب، النظرية المعاصرة للحياد،القاهرة دون جهة نشر محددة، الطبعة الأولى.
33. الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مجلة معلومات دولية، مركز المعلومات القومى،العدد57 ،دمشق ،سوريا 1998 .
34. د. رجب عبد المنعم متولى، الفرق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة فى ضوء قواعد القانون الدولى المعاصر، المجلة المصرية للقانون الدولى، 2004
35. د. عادل عبد الله المسدى، الحرب ضد الإرهاب والدفاع الشرعى فى ضوء أحكام القانون الدولى “مع دراسة لمدى مشروعية استخدام القوة المسلحة من جانب الولايات المتحدة رداً على هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى ، 2006
36. ناعوم تشومسكى، الإرهاب الدولى- الأسطورة والواقع ، ترجمة لبنى صبرى ، تقديم مصطفى الحسينى، دار سينا للنشر، ط1، 1990
37. د. محمد السنارى، قانون العقوبات المصرى طبقاً لآخر تعديلات ، طبعة عام 2000
38. د. محمد الغنام ، جرائم التنظيمات غير المشروعة والإرهابية فى التشريع المصرى والقانون المقارن ، مجلة مصر المعاصرة، عدد 446 ، إبريل 1997
39. د.عبد الناصر حريز، النظام السياسى الإرهابى الإسرائيلى- دراسة مقارنة ،القاهرة، مكتبة مدبولى، ط1، 1997
40. د. محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة الإرهاب دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994
41. د. أسامة الغزالى حرب، الإرهاب كأحد مظاهر استخدام العنف عربياً ودولياً، بحث مقدم إلى ندوة “العنف والسياسة فى الوطن العربى” المنعقدة فى القاهرة بين 27- 28/2/1987 ومنشور فى مجلة المستقبل العربى، بيروت، السنة10،يوليو1987
42. أ.د صلاح الدين عامر، التكييف القانونى للعنف على الصعيدين العربى والدولى ، بحث مقدم إلى ندوة العنف والسيادة فى الوطن العربى.
43. بنيامين نتنياهو ، محاربة الإرهاب، الترجمة إلى العربية: عمر السيد، أيمن حامد، دار النهار للطباعة والنشر والتوزيع، (القاهرة) ، (الطبعة العربية الأولى): 1996.
44. د. إسماعيل الغزال، الإرهاب والقانون الدولى، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، 1990
45. شارل زور غبيب، مقاومة المحتل والقانون الدولى، مجلة الحق، السنه 23، العدد 2 ، أبريل 1972.
46. مارتن فان كريفلد، حرب المستقبل ، ترجمة د. السيد عطا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1995.
47. رمزى حوحو، الحدود الفاصلة بين الإرهاب وحركات التحرر الوطنى، مجلة المفكر ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر، العدد 3 ، 2008 .
48. أحمد أبو الوفا، دراسة لبعض جوانب ظاهرة الإرهاب الدولى، مجلة الدراسات الدبلوماسية ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، وزارة الخارجية السعودية ، العدد 6 ، 1990.
49. هيثم الكيلانى، إرهاب الدولة بديل الحرب فى العلاقات الدولية، مجلة الوحدة،الرباط، السنة6،العدد67، أبريل1990.
50. هيثم الكيلاني، الإرهاب يؤسس دولة نموذج إسرائيل ، دار الشروق ، القاهرة ، ط1 ،1997.
51. فرغلى هارون، لعبة خلط الأوراق مقاومة الإرهاب أم إرهاب المقاومة، دار الوافى للنشر، القاهرة، 2008 .
52. عبد الناصر حريز، النظام السياسى والإرهاب الإسرائيلى دراسة مقارنة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996 .
53. مصطفى مصباح دبارة، الإرهاب مفهومه وأهم جرائمه فى القانون الدولى الجنائى، جامعة قاريونس، بنغازي،1990، ط1.
54. سيد نوفل، الصهيونية السياسية بين الأساسين الاستعمارى واليهودى، مجلة الشرق الأوسط، ع1، يناير1975،
55. عبد الوهاب محمد المسيرى، الأيديولوجية الصهيونية ، القسم الثانى، الكويت، 1983.
56. مايكل جانسن، مقال بعنوان “القرارات الأمريكية الرئيسية الثلاثة حول فلسطين”، منشور بمجلة شؤون فلسطين رقم 15، تشرين الثانى (نوفمبر) 1972.
57. نوال موسى إبراهيم آل يوسف، الطبيعة السياسية والاجتماعية للميلشيات فى العالم العربى (الجنجويد والبشمركة كحالتين للدراسة) ، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة فى الدنمارك ، كوبنهاجن ، 2009
58. أحمد يوسف،” الانتفاضة ” قراءة أولية فى دروس الخبرة المقارنة لحركات التحرر الوطنى، ورقة قدمت إلى ندوة حركة التحرر الوطنى الفلسطينية فى دراسة مقارنة مع حركات التحرر الأفريقية، القاهرة 15 سبتمبر1991.
59. د.عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى، القاهرة، دار الشروق، 2001.
ثانياً: المراجع الأجنبية:
1- Led dimension internationles des humanitaaire, ED. Apedone, Paris. 1986.
-2Brownlie, Jan. International law and the activities of Armed Bands. The International and comparative law Quarterly (1956)
3-D’Arcy francois: Décentralisation en france et en Espange, ed Economica,Paris, 1986
4- Ce. R. Ainsztein, Jewish resistance in Nazi- Occupied eastern Europe- London-Paul Elek- 1974.
5- Wilkinson, “Political Terroism” Lonodn 1974
6- Bernard L.Brown, The proportionality principle in the humanitarian law of warfare.
7- D.Schindler and J. Toman, The laws of armed confects
8-Gaser Hans-Peter: Interdiction des actes de terrorisme terrorisme dans
9-ledroit international hymanitaire (R.I.C.R) 68 année. No- 760. Jullet- aout. 1986.
10-Lazarus C; Le Statut Juridique des movements Liberation nationai á L’O.N.U- (A.F.D.I) 1974
11- Renault (Louis). La Guerre et Le Droit des gens XXe siémics du Lundi 26 October 1914.
- ( ) أ. د صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة ، دار الفكر العربي ، ط1، القاهرة، 1976، ص3وما بعدها. ↑
- ( ) د. السيد أبو الخير، مستقبل الحروب دراسات ووثائق، دار مصر العربية للنشر والتوزيع ،2009، ص11. ↑
- ( ) د. إسماعيل عبد الرحمن، الأسس الأولية للقانون الانسانى الدولى ، كتاب القانون الدولى الإنسانى من اصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دار المستقبل العربى، عام 2003 ، ص 15. ↑
- ( ) د. مصطفى طلاس وآخرون، الاستراتيجية السياسية العسكرية، الجزء الأول، مكتبة دار طلاس، دمشق، 2003 ، ص 473. ↑
- ( ) د. صباح نورى علوان العجيلى، استراتيجية حروب التحرير الوطنية، رساله دكتوراه، الأكاديمية العربية المفتوحة فى الدنمارك، كلية القانون والسياسة، 2010 ، ص 121. ↑
- ( ) د. رمزى حوحو، الحدود بين الإرهاب وحركات التحرر الوطنى وفقاً لأحكام القانون الدولى ، مجلة المفكر ، جامعة محمد خيضر، بسكره ، الجزائر ، العدد 3 ، 2008 ، ص 159. ↑
- ( ) د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1983، ص 40.
وانظر تعريفات أخرى للمقاومة الشعبية:
– Aziz Hasbi: Les mouvements de leberation Nationale et le droit. International E. ditions staucky, Rabat. 1971. pp. 20 et seq. ↑
- ( ) اعتبر د. محمد طلعت الغنيمى حركات التحرير الوطنية وجهاً من أوجه المقاومة.. راجع مؤلف سيادته ، الوسيط فى قانون السلام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1982 ، ص611 . ↑
- ( ) لعل من أبرز هؤلاء Gerrard Petit الذى على الرغم من كونه خصص موضوع مؤلفه فى حركات التحرر إلا أنه تجنب تعريفها فى كتاباته. ↑
- ) أ. د محمد طلعت الغنيمى ، الوسيط فى قانون السلام ، مرجع سابق، ص 347 – 348 ↑
- ( ) أ. د عز الدين فوده ، شرعية المقاومة فى الأرض المحتلة، مقاله مستخرجه من المجلد الأول لدراسات فى القانون الدولى، المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد 1 ، القاهرة ، 1969 ، ص 23. ↑
- ( ) د. عمر إسماعيل سعد الله ، تقرير المصير السياسى للشعوب في القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2002، ص329 . ↑
- ( ) ومن أمثلة الاتحادات التى كانت مؤيدة لحركة التحرير الجزائرية ومتمسكة بها، تلك الاتحادات التى أنشئت فى عام 1956 ومنها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاتحاد العام للتجار الجزائريين، والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وغيرهم. ↑
- ( ) راجع بشأن حركات التحرر الوطنى، مقال:
– Gérrard PRTIT, Les mouvements de Iibération nationale et le droit, Annuaire du tiers monde, Paris, Berger, Levrault, 1976, P. 58 ↑
- ( ) د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة، مرجع سابق، ص 41. ↑
- ( ) د. وقاف العياش، مكافحة الارهابيين بين السياسية والقانون، دار الخالدونية ، الجزائر ، ط1، 2006، ص15. ↑
- ( ) لمزيد من الشرح والتفاصيل حول هذه الطوائف من الأفراد والذين يتمتعون بوصف أسرى الحرب فيما إذا وقعوا فى قبضة العدو.. المراجع التالية:
-Lapidoth. R’ Qui a droit au statut des prosonnier de guerre (R.G.D.I.P) No.-1-1987-PP.170.
– أ.د عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب، دراسة فقهية وتطبيقة فى نطاق القانون الدولى العام والشريعة الإسلامية ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1975، ص70 ومابعدها. ↑
- ( ) منصوص عليه فى المادة 44 فقرة “2” من البروتوكول الأول. ↑
- ( ) يؤخذ على هذه الفقرة “3” من المادة 44 أنها لم تحدد ما المقصود بالرؤية من قبل الخصم على مدى البصر هل هى الرؤية بالعين المجردة؟ أم تشمل الرؤيا عن طريق أجهزة الرصد الإلكترونية؟ ولم تحدد ما المقصود بالانتشار العسكرى؟
مشار إليه لدى د. هيثم موسى حسن، التفرقة بين الإرهاب الدولى ومقاومة الاحتلال في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2008، ص 326، 327. ↑
- ( ) راجع فى مفهوم الجاسوسية فى الحرب ومدى مشروعيتها أ.د. عبد الواحد يوسف الفار، مرجع سابق ،ص149. ↑
- ( ) راجع فى ذلك م46 فقرة، 2 ، 3 ، 4 من البروتوكول الإضافى الأول. ↑
- ( ) راجع: د.عبد الله الأشعل، ظاهرة المرتزقة وخطرها على العالم الثالث فى العلاقات الدولية ،( م.م.ق.د )، العدد39، 1983، ص67. ↑
- ( ) انظر بهذا المعنى:
– M.ch.Bassiouni; The legal effects of wars of liberation- (A.J.I.L) Vol. 62, January 1971-1,P.172. ↑
- ( ) انظر بهذا المعنى:
– Henri Meyorwitz; The law of war in Vietnamese condlict- in “Vitanam war and International law” Edited by R.Falk- vol II New york- 1969 – p,526. ↑
- ( ) وجدير بالذكر أن المؤتمر الدبلوماسى فى جنيف 1974-1977والذى دعت إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر صوتت الأغلبية فيه “60 دولة ” لصالح الفقرة الرابعة من المادة الأولى من البروتوكول الأول 1977 على اعتبار حروب المقاومة حروب دولية مقابل رفض”21 دولة” وامتناع “13 دولة”عن التصويت. ↑
- ( ) Lazarus C; Le Statut Juridique des movements Liberation nationai á L’O.N.U- (A.F.D.I) 1974- P.182. ↑
- ( ) د. ويصا صالح، المركز القانونى الدولى لحركات المقاومة العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2005 ،ص 616 ، 617. ↑
- ( ) انظر فى أهمية هذه التعليمات على الرغم من عيوبها:
– Renault (Louis). La Guerre et Le Droit des gens XXe siémics du Lundi 26 October 1914. Paris 1914. Typographile de Firmin Didot et Cie pp. 31-32. ↑
- ( ) ناصر الريس، انتفاضة الشعب الفلسطينى فى ضوء القانون الدولى المعاصر، رسالة ماجستير، الجزائر، 1995 ، ص119. ↑
- ( ) راجع المادة الرابعة الفقرة السادسة من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب لعام 1949. ↑
- ( ) فى هذا المعنى د. صلاح الدين عامر، المرجع السابق ، ص 199. ↑
- ( ) جدير بالذكر أن المقاومة الشعبية المصرية فى مدينة بورسعيد سنة 1956 ضد الغزو الانجليزى الفرنسى كانت بمثابة مثال نادر من أمثلة الهبات التلقائية فى الأزمنة الحديثة. ↑
- () يلاحظ أن بعض الفقه العربى يستخدم مترادفات للمقاومة الشعبية كحرب العصابات وغيرها للدلالة على ذات المعنى ، انظر على سبيل المثال: د. عز الدين فوده ، شرعية المقاومة فى الأرض المحتلة ” دراسات فى القانون الدولى” ، سنة 1969، صادر عن الجمعية المصرية للقانون الدولى وقد انفرد فى هذا المقال باستخدام تعبير “حروب الغوريللا”، ص19. ↑
- ( ) انظر نعيمة عمر، مركز حركات التحرر الوطنى، رسالة ماجستير فى القانون الدولى والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 1984 ، ص45 وما بعدها. ↑
- ( ) نجاح مطر العبد دقماق، المركز القانونى للأسرى الفلسطينيين فى ضوء أحكام القانون الدولى الإنسانى ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة القدس ،2004 – 2005 ، ص73. ↑
- ( ) استخدمها المهاتما غاندى، وانتصر على إمبراطورية الاحتلال البريطانى عن شبه القارة الهندية، حيث انتزع استقلال بلاده من أعظم قوة فى العالم آنذاك ، كما أن تلميذه مارتن لوثر كينغ الابن اتبع نفس الطريقة لتحرير السود فى الولايات المتحدة من العبودية والتمييز العنصرى بسبب اللون، من أجل تحقيق المساواة والحقوق المدنية الكاملة لهم.
انظر: رائد عوض أبو ساحلية، البديل اللاعنفى السلمى لاستمرار الانتفاضة، عن الصفحة الإلكترونية:
http: // www. Mabber. Org/nineth_issue/nonviolence_2a.htm. ↑
- ( ) وذلك مثلما حدث فى جنوب أفريقيا عندما أعلن المؤتمر الوطنى الأفريقى تخليه عن المقاومة المسلحة واستبدالها بأسلوب المقاومة المدنية… للمزيد راجع ناصر الريس، المقاومة في القانون الدولي: مشروعية الكفاح الفلسطيني المسلح، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، الطبعة الأولى، 2009، ص 121. ↑
- ( ) مثلما ما حدث إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 من خلال الإضراب الشامل وعدم فتح المحال التجارية وعدم دفع الضرائب فضلاً عن المواجهات اليومية مع قوات الاحتلال، انظر: د. عز الدين فودة، حق المدنيين بالأراضى المحتلة فى الثورة على سلطة الاحتلال الحربى في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006 ، ص981. ↑
- ( ) انظر د. نجاح مطر العبد دقماق، التحول فى مفهومى المقاومة والإرهاب في القانون الدولي العام، مجلة جامعة الأزهر – غزة (سلسلة العلوم الإنسانية)، المجلد 13، العدد 2، 2011 ، ص 627. ↑
- ( ) د. سعد عبد الرحمن قاسم زيدان، تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2002 ، ص 45 وما بعدها. ↑
- ( ) ينسب هذا القول إلى المندوب اليوغسلافى فى الأمم المتحدة واللجنة القانونية اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة، حيث جاء فى كلمته التى ألقاها أمام هذه اللجنة فى جلستها المنعقدة بتاريخ 26/11/1972 والمخصصة لبحث مشكلة الإرهاب الدولى بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة…للاستزادة انظر الوثائق الرسمية للأمم المتحدة ، الجمعية العامة 1972 وثيقة رقم: – G.A.1972A/C.6/SR-1357- P.6.
- ( ) انظر: د.عبد الرحيم صدقى، تسليم المجرمين فى جرائم الإرهاب، مجلة القضاء العسكرى، ديسمبر 1993 ، ص 46 وما بعدها…. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 4 من القانون رقم 97 لنسه 1992، تضمنت عدم تقادم الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب، حيث يكون التسليم فيها جائزاً مهما طالت المدة …. لمزيد من التفصيل راجع د. نور الدين هنداوى، السياسية الجنائية للمشرع المصرى فى مواجهة جرائم الإرهاب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993، ص116. ↑
- ( ) يراجع التعريف الوارد فى بحث الدكتور محمد على الأحمد، العناصر الفاصلة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ما يدخل فى نطاق المقاومة المشروعة وما يخرج عن نطاقها ، من بحوث المؤتمر العلمى السنوى لكلية الحقوق فى جامعة جرش الأهلية، بعنوان ” الإرهاب والمقاومة فى القانون الدولى والشريعة الإسلامية”. المنعقد فى 10 – 12 أيار 2005 ، ص 254. ↑
- ( ) د. إمام حسنين عطا الله، الإرهاب والبيان القانونى للجريمة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 2004 ، ص 5.
ونجد أن القائد الشيوعى الصينى ماوتسى تونغ وضع القواعد الإستراتيجية الأولى لحرب العصابات فى العصر الحديث، وحاول إجمال تلك القواعد بقوله:”إذا تقدم العدو اسحبوا، وإذا توقف هاجموه حتى يتعب، وحين ينسحب انصبوا له الكمائن”، وكان يؤمن أن “رجال حرب العصابات يجب أن يكونوا خبراء فى الفرار”، واستخدم هذا النوع من الحروب “حركة ماو ماو فى كينيا”، والفدائيون فى الجزائر.. راجع: http:||www.zuhlool.org ↑
- ( ) د. مصطفى دبارة، الإرهاب مفهومه وأهم جرائمه فى القانون الدولى الجنائى، منشورات قاريونس، ط1، 1999، ص306. ↑
- ( ) للمزيد حول حجج هذا الاتجاه راجع:* د. الشافعى محمد بشير، المعايير الدولية التى تميز حق الشعوب فى تقرير المصير والكفاح المسلح عن الإرهاب الدولى، مجلة الحق، السنة 19، العدد 201، 1998 ، ص 123.
* د. محمد المجذوب، القانون الدولى الإنسانى وشرعية المقاومة ضد الاحتلال آفاق وتحديات، منشورات الحلبى الحقوقية ، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2005 ، ص 314.
* بيتر سي سيدربرج ، أساطير إرهابية، ترجمة عفاف معلوف، (د.ت) (د.د.ن) ، ص186. ↑
- ( ) للاستزادة حول حجج هذا الاتجاه راجع: * أ. د أحمد رفعت، الإرهاب الدولى، دار النهضة العربية، 2006، ص154. =
=*أ.د. عبد العزيز عبد الهادى مخيمر، الإرهاب الدولى “مع دراسة للاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية”، سلسلة دراسات القانون الدولى الجنائى، دار النهضة العربية، 1986، ص 78-79. ↑
- ( ) من أهم مبادىء إعلان القاهرة التى أعلنتها المنظمة:-
1-إدانة المنظمة لجميع علميات الإرهاب سواء تلك التى تتورط فيها الدول أو التى يرتكبها أفراد ضد الأبرياء فى أى مكان.
2-تأكيد قراراها الصادر فى عام 1974 بإدانة جميع العمليات الخارجية وكل أشكال الإرهاب والتأكيد مجدداً بالتزام جميع فصائلها ومؤسساتها بهذا القرار، وأن المنظمة سوف تتخذ من تاريخ إعلان القاهرة كافة الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
3-مطالبتها المجتمع الدولى أن يلزم إسرائيل بوقف جميع الأعمال الإرهابية الخارجية والداخلية.
4-تمسكها بحق الشعب الفلسطينى فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى لأراضيه بكل السبل لتحقيق الانسحاب من هذه الأراضى.
5-اقتناعها بأن العمليات الإرهابية التى ترتكب فى الخارج تسىء إلى قضية الشعب الفلسطينى وتشوه كفاحه فى سبيل الحرية.
6-اعتقادها الراسخ بأن إنهاء الاحتلال ووضع حد لسياسته هو السبيل الوحيد لإقرار الأمن والسلام فى المنطقة.
انظر : د.عائشة راتب، النظرية المعاصرة للحياد،القاهرة دون جهة نشر محددة، الطبعة الأولى، ص239-242. ↑
- ( ) لمزيد من التفاصيل حول تعريف الإرهاب الدولى وصوره انظر:
– أ. د أحمد رفعت، الإرهاب الدولى فى ضوء أحكام القانون الدولى، فى الإرهاب الدولى ومشكلات التحرير والثورة فى العالم الثالث”، سلسلة حوار الشهر رقم 3 لمركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية ، ص 41، 42.
– Wilkinson, “Political Terroism” Lonodn 1974, P. 292. ↑
- ( ) الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، مجلة معلومات دولية، مركز المعلومات القومى،العدد57 ،دمشق ،سوريا 1998،ص291. ↑
- ( ) جريدة الأهرام، 5 ديسمبر 2001 ، الصفحة الثانية. ↑
- ( ) د. رجب عبد المنعم متولى، الفرق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة فى ضوء قواعد القانون الدولى المعاصر، المجلة المصرية للقانون الدولى، 2004 ، ص 271 وما بعدها. ↑
- ( ) د. عادل عبد الله المسدى، الحرب ضد الإرهاب والدفاع الشرعى فى ضوء أحكام القانون الدولى “مع دراسة لمدى مشروعية استخدام القوة المسلحة من جانب الولايات المتحدة رداً على هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى ، 2006 ، ص45. ↑
- ( ) ناعوم تشومسكى، الإرهاب الدولى- الأسطورة والواقع ، ترجمة لبنى صبرى ، تقديم مصطفى الحسينى، دار سينا للنشر، ط1، 1990 ، ص50. ↑
- ( ) د. محمد السنارى، قانون العقوبات المصرى طبقاً لآخر تعديلات ، طبعة عام 2000 ، ص 50.
وللمزيد حول الانتقادات التى وجهت لتلك المادة من توسعها المفرط فى تعريف الإرهاب راجع:
– د. محمد الغنام ، جرائم التنظيمات غير المشروعة والإرهابية فى التشريع المصرى والقانون المقارن ، مجلة مصر المعاصرة، عدد 446 ، إبريل 1997، ص110. ↑
- () د.عبد الناصر حريز، النظام السياسى الإرهابى الإسرائيلى- دراسة مقارنة ،القاهرة، مكتبة مدبولى، ط1، 1997، ص 26. ↑
- ( ) د. نبيل محمد خليل إبراهيم العزازى، مرجع سابق، ص 45. ↑
- ( ) نقلاً عن د. محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة الإرهاب دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994، ص 27. ↑
- ( ) د. هيثم موسى حسن، التفرقة بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال، مرجع سابق، ص 536. ↑
- ( ) د. أسامة الغزالى حرب، الإرهاب كأحد مظاهر استخدام العنف عربياً ودولياً، بحث مقدم إلى ندوة “العنف والسياسة فى الوطن العربى” المنعقدة فى القاهرة بين 27- 28/2/1987 ومنشور فى مجلة المستقبل العربى، بيروت، السنة10،يوليو1987،ص173. ↑
- ( ) أ. د محمد عزيز شكرى، الإرهاب الدولى دراسة قانونية ناقدة، مرجع سابق، ص180. ↑
- ( ) أ.د صلاح الدين عامر، التكييف القانونى للعنف على الصعيدين العربى والدولى ، بحث مقدم إلى ندوة العنف والسيادة فى الوطن العربى مرجع سابق، ص 170. ↑
- ( ) بنيامين نتنياهو ، محاربة الإرهاب، الترجمة إلى العربية: عمر السيد، أيمن حامد، دار النهار للطباعة والنشر والتوزيع، (القاهرة) ، (الطبعة العربية الأولى): 1996، ص101 وما بعدها.
– B .Netnyaho. Terrorism. How the west can win…? Op. cit. p.79. ↑
- ( ) أ. د الشافعى محمد بشير، المعايير الدولية التى تميز حق الشعوب فى تقرير المصير، مرجع سابق،ص123. ↑
- ( ) د. إسماعيل الغزال، الإرهاب والقانون الدولى، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، 1990، ص 58 ↑
- ( ) راجع.. شارل زور غبيب، مقاومة المحتل والقانون الدولى، مجلة الحق، السنه 23، العدد 2 ، أبريل 1972، ص21. ↑
- ( ) د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة، مرجع سابق، ص 497. ↑
- ( ) انظر فى ذلك:
– Bernard L.Brown, The proportionality principle in the humanitarian law of warfare..op.cit.138. ↑
- ( ) انظر فى ذلك:
– D.Schindler and J. Toman, The laws of armed confects- op. cit pp 259-260. ↑
- ( ) حيث نصت تلك المادة على أن:” تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجيه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية “. ↑
- ( )Gaser Hans-Peter: Interdiction des actes de terrorisme terrorisme dans ledroit international hymanitaire (R.I.C.R) 68 année. No- 760. Jullet- aout. 1986. P.212. ↑
- ( ) مارتن فان كريفلد، حرب المستقبل ، ترجمة د. السيد عطا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1995 ،ص228. ↑
- ( ) رمزى حوحو، الحدود الفاصلة بين الإرهاب وحركات التحرر الوطنى، مجلة المفكر ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر، العدد 3 ، 2008 ، ص 163. ↑
- ( ) أ. د أحمد أبو الوفا، دراسة لبعض جوانب ظاهرة الإرهاب الدولى، مجلة الدراسات الدبلوماسية ، معهد الدراسات الدبلوماسية ، وزارة الخارجية السعودية ، العدد 6 ، 1990، ص 66. ↑
- ( ) د.هيثم الكيلانى، إرهاب الدولة بديل الحرب فى العلاقات الدولية، مجلة الوحدة،الرباط، السنة6،العدد67، أبريل1990،ص44.
ولذات المؤلف ، الإرهاب يؤسس دولة نموذج إسرائيل ، دار الشروق ، القاهرة ، ط1 ،1997، ص33. ↑
- ( ) د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية، مرجع سابق، ص47. ↑
- ( ) فرغلى هارون، لعبة خلط الأوراق مقاومة الإرهاب أم إرهاب المقاومة، دار الوافى للنشر، القاهرة، 2008 ، ص134. ↑
- ( ) د. عبد الناصر حريز، النظام السياسى والإرهاب الإسرائيلى دراسة مقارنة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1996 ،ص37. ↑
- ( ) د. مصطفى مصباح دبارة، الإرهاب مفهومه وأهم جرائمه فى القانون الدولى الجنائى، جامعة قاريونس، بنغازي،1990، ط1، ص289. ↑
- ( ) راجع فى ذلك:
– Ce. R. Ainsztein, Jewish resistance in Nazi- Occupied eastern Europe- London-Paul Elek- 1974- p. xxi ↑
- ( ) نقلاً عن صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 7/3/1998 . ↑
- ( ) د. هيثم موسى، مرجع سابق، ص 627. ↑
- ( ) صباح درامنه ، العنف الدولى ، مرجع سابق، ص 58. ↑
- ( ) د. سيد نوفل، الصهيونية السياسية بين الأساسين الاستعمارى واليهودى، مجلة الشرق الأوسط، ع1، يناير1975، ص4 ↑
- ( ) للمزيد عن الحركة الصهيونية راجع: الدكتور عبد الوهاب محمد المسيرى، الأيديولوجية الصهيونية ، القسم الثانى، الكويت، 1983، وقد ألمح هذا الكاتب إلى العلاقة بين النازية كحركة عنصرية والصهيونية كحركة عنصرية، راجع ص342. ↑
- ( ) د. عمر إسماعيل سعد الله، تقرير المصير السياسى للشعوب، مرجع سابق، ص 335. ↑
- ( ) وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا القرار بأغلبية 72 صوت ضد 35 صوت وامتناع 32 صوت عن التصويت وتغيب 3 دول عن الاقتراع. ↑
- ( ) راجع فى هذا الشأن: مقال مايكل جانسن، بعنوان “القرارات الأمريكية الرئيسية الثلاثة حول فلسطين”، منشور بمجلة شؤون فلسطين رقم 15، تشرين الثانى (نوفمبر) 1972، ص 137 وما بعدها. ↑
- ( ) د. عمر إسماعيل سعد الله، مرجع سابق، ص 342. ↑
- ( ) راجع فى هذا المعنى د. محمود سامى جنينه، بحوث فى قانون الحرب، مرجع سابق، ص4. ↑
- ( ) د. عبد الرحمن بن عطيه الله الظاهرى ، الحرب على الإرهاب، مرجع سابق، ص 641. ↑
- ( ) للمزيد راجع د. عبد العليم محمد ، مفهوم الحكم الذاتى فى القانون الدولى، مرجع سابق، ص 43، 44.
وكذلك راجع: D’Arcy francois: Décentralisation en france et en Espange, ed Economica,Paris, 1986 ↑
- ( ) راجع بشأن هذا النزاع: د. عبد العزيز سرحان ، مقال له بعنوان: الولايات المتحدة الأمريكية ومشكلة الشرق الأوسط فى ضوء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، الصادرة عن جامعة عين شمس ، القاهرة، العدد الأول، السنة الرابعة عشر، يناير 1972، ص132… وراجع كذلك جريدة Monde Le الفرنسية ، عدد 6/12/1971. ↑
- ( ) د. عمر إسماعيل سعد الله، مرجع سابق، ص 343 ، 344 . ↑
- ( ) د. سيار الجميل، المشروع العراقى أجندة بلا أيه ميليشيات، موقع إيلاف، 21 يوليو 2008، على موقع: www.Sayyaralijami.Com. ↑
- () للمزيد حول طبيعة هذه الميلشيات وأنواعها راجع: د. نوال موسى إبراهيم آل يوسف، الطبيعة السياسية والاجتماعية للميلشيات فى العالم العربى (الجنجويد والبشمركة كحالتين للدراسة) ، رسالة ماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة فى الدنمارك ، كوبنهاجن ، 2009 ، ص 282 وما بعدها. ↑
- ( ) أحمد يوسف،” الانتفاضة ” قراءة أولية فى دروس الخبرة المقارنة لحركات التحرر الوطنى، ورقة قدمت إلى ندوة حركة التحرر الوطنى الفلسطينية فى دراسة مقارنة مع حركات التحرر الأفريقية، القاهرة 15 سبتمبر1991، ص 78. ↑
- () د.عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والعنف من بداية الاستيطان إلى انتفاضة الأقصى، القاهرة، دار الشروق، 2001، ص290. ↑
- (99) Brownlie, Jan. International law and the activities of Armed Bands. The International and comparative law Quarterly (1956) vol. 7. P. 713. ↑
- () د. صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية، مرجع سابق ، ص 71. ↑
- ( ) لمزيد من التفصيل: ألكسندر كوكبرن وحيفرى سانت كلير، التحالف الأسود وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات والصحافة ، ترجمة أحمد محمود، المشروع القومى للترجمة ، وزارة الثقافة ، العدد 446 ، ط1 ، القاهرة ، 2002 ، ص 5 وما بعدها. ↑
- () د. السيد أبو الخير، مستقبل الحروب، مرجع سابق، ص 100. ↑
- () أميمة عبد اللطيف، البنادق المؤجرة فى العراق(1) ، مجلة العصر، 1/5/2004. ↑
- () صحيفة الصنداى تايمز فى 28/11/2005م. ↑
- () صحيفة نيويورك تايمز فى 20/4/2004… وللمزيد حول طبيعة عمل هذه الشركات انظر: جيرمى سكيل، المرتزقة قادمون: بلاك ووتر كبرى شركات تصدير فرق الموت، ترجمة د. فاطمة نصر & وحسام إبراهيم ، دار السطور الجديدة ، القاهرة ، 2007، ص 19. ↑
- () أ. د أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، بحث منشور فى كتاب المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 2004 ، ص31 وما بعدها. ↑
- () د. نجاح مطر العبد دقماق، التحول فى مفهومى المقاومة والإرهاب، مرجع سابق، ص 782.
وقد نصت المادة 31 من لائحة لاهاى، والمادة 21 من إعلان بروكسل على أن” الجاسوس الذى يعود وينضم إلى القوات المسلحة التابع لها ويتم إلقاء القبض عليه فيما بعد، يعامل معاملة أسرى الحرب ولا يحمل أية مسئولية على أى من أعمال التجسس”، وورد ذلك أيضاً فى البروتوكول الإضافى الأول فى المادة 46 منه ونصَّ عليه عدد من كتيبات الدليل العسكرى. ↑
- () أ.د سعيد سالم جويلى، المدخل لدراسة القانون الدولى الإنسانى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 294 وما بعدها.
– Led dimension internationles des humanitaaire, ED. Apedone, Paris. 1986. ↑
- () د. السيد أبو الخير، مستقبل الحروب، مرجع سابق، ص316. ↑
- () فى هذا المعنى أ. د إبراهيم محمد العنانى، النظام الدولى الأمنى، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 1997 ، ص111. ↑
- () راجع: مضمون تقرير اللجنة فى مجلة الوقائع التى تصدرها الأمم المتحدة، السنة الثالثة، العدد الخامس ، مايو 1982، ص 28 وما بعدها. ↑
- () د. عمر إسماعيل سعد الله، المرجع السابق ، ص 348 ، 349. ↑
- () راجع الدكتور الشافعى أبو راس ، رسالة بعنوان: التنظيمات السياسية الشعبية ، دار الكتب ، القاهرة ، 1974، ص41 وما بعدها.
ألكسندر كوكبرن وحيفرى سانت كلير، التحالف الأسود وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات والصحافة ، ترجمة أحمد محمود، المشروع القومى للترجمة ، وزارة الثقافة ، العدد 446 ، ط1 ، القاهرة ، 2002.
جيرمى سكيل، المرتزقة قادمون: بلاك ووتر كبرى شركات تصدير فرق الموت، ترجمة د. فاطمة نصر & وحسام إبراهيم ، دار السطور الجديدة ، القاهرة ، 2007، ص 19.
أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، بحث منشور فى كتاب المحكمة الجنائية الدولية المواءمات الدستورية والتشريعية ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 2004
أ.د سعيد سالم جويلى، المدخل لدراسة القانون الدولى الإنسانى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
د إبراهيم محمد العنانى، النظام الدولى الأمنى، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 1997.
الشافعى أبو راس ، رسالة بعنوان: التنظيمات السياسية الشعبية ، دار الكتب ، القاهرة ، 1974. ↑