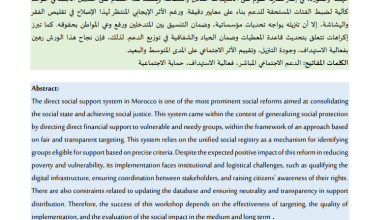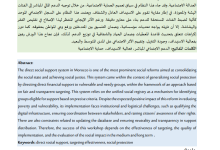الشــرط الجـــزائــي في عــقـــد الاســــتصـــنــــاع – محــــــــمد الحـــــفيــــــــــاني

الشــرط الجـــزائــي في عــقـــد الاســــتصـــنــــاع
من إعداد الطالب الباحث:
محــــــــمد الحـــــفيــــــــــاني
المقدمة:
إن تضمين العقود شروطا جزائية يشكل عاملا مهما لضمان السلامة العقدية، من حيث إن هذا الشرط أصبح يشكل تقنية ناجحة لحمل المتعاقدين على الوفاء بالتزاماتهم العقدية، إذ بالنظر للتعقيد الذي أصبح يطبع عالم التجارة والأعمال وبالنظر للصعوبات والتعقيدات وضياع الوقت الذي ينطوي عليه اللجوء إلى القضاء في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالالتزامات الناتجة عن العقد ظهرت الحاجة إلى تضمين العقود ذاتها بعض التقنيات الكفيلة بالحث على الوفاء بها.
ومن أهم هذه التقنيات الشروط الجزائية التي أصبحت بالنظر لما أبانت عنه من فعالية في هذا المجال تشكل أداة أساسية للسلامة العقدية في أنواع جديدة من العقود، حيث إن هذه العقود تعتمد أساسا على الشرط الجزائي كعامل لحمل المدينين على الوفاء بالتزاماتهم العقدية، بالنظر إلى أن طبيعة الخدمات التي توفرها المؤسسات المالية المختصة في مثل هذه العقود لا تسمح بالمخاطرة، وتحتم توفير الضمانات الكافية لتنفيذ العقد لأنه بدون ذلك سيتعرض نشاطها المالي والاقتصادي لهزات خطيرة قد تؤثر على سيرها واستمرارها.
من هنا كانت الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها الشروط الجزائية في الوقت الحالي هي توفير السلامة العقدية، أي دعم الضمانات الكفيلة بتنفيذ العقد والوفاء بالالتزامات العقدية، باعتبارها تشكل عامل تهديد وإكراه وحافزا للمدين على تنفيذ التزامه، إذ عندما يحدد مقدار الجزاء في مبلغ مرتفع، فإن المدين يكون مدفوعا للتنفيذ لتفادي أداء مبلغ يفوق مقدار الضرر المتوقع.
وعقد الاستصناع بما عليه اليوم من أهمية كبيرة في العديد من المجالات الحياتية، والذي أصبح احتياجا فعليا في سد متطلبات الحياة لأصحابها، كان من المهم وضع ما يحفظ حقوق الصانع والمستصنع له فيما لو تخلف في صنع ما طلب منه أو امتنع المستصنع من قبول سلعته المستصنعة، لأن ذلك يؤدي لوقوع التنازع والتخاصم وغير ذلك مما تكون نتيجته سلبية مثل ما أريد لهذه المعاملة. وبالتالي كان من اللازم اللجوء الى الشرط الجزائي للمحافظة على الثروات العامة والخاصة، ولبقاء الموازنة الاقتصادية مستقرة بما تحفظ حق الآخرين.
ومن هنا تظهر أهمية هذا الموضوع والذي سيتم من خلال محاولة تبيان حكم الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، وتبيان كذلك الضوابط التي تحكمه وفائدة هذا الشرط وأثره على ضمان تنفيذ عقد الاستصناع.
وتبعا لذلك فإن هذا الموضوع يطرح إشكالية محورية تتمثل في: ما حكم الشرط الجزائي في عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وما الضوابط التي تحكم مشروعيته وتطبيقه لتحقيق التوازن بين ضمان حقوق الأطراف ومراعاة العدالة في المعاملات؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سيتم إعتماد التصميم الآتي:
المطلب الأول: حكم الشرط الجزائي في عقد الاستصناع
المطلب الثاني: فعالية الشرط الجزائي في عقد الاستصناع وأسباب انقضائه
المطلب الأول: حكم الشرط الجزئي في عقد الاستصناع
إن الشرط الجزائي أحد مصطلحات القوانين المعاصرة، وقد انتشر في العصر الحديث نتيجة انتشار العقود الضخمة بين الأفراد والشركات، وذلك بهدف الضغط على المتعاقد للوفاء بالعقد وتنفيذه في الموعد المحدد.
ولما كان الأمر كذلك فإن من المناسب الحديث عن الشرط الجزائي كما ورد في الفكرة القانونية (الفقرة الأولى)، ثم من بعد ذلك تبيان حكمه في الفقه الإسلامي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الشرط الجزائي
عرف الأستاذ محمد شنا أبو سعد الشرط الجزائي، على أنه: ” بند عقدي يدرجه المتعاقدان في عقدهما أو في اتفاق لاحق لضمان احترام العقد وكفالة تنفيذه بحيث إذا أخل المتعاقد بالتزامه أدى مبلغا معينا للمتعاقد الآخر، فهو في الحقيقة تقدير اتفاقي للتعويض قد يتمثل في مبلغ نقدي أو في عمل أو امتناع عن عمل وقد يكون تقصيرا لميعاد أو تغيير لمكان تنفيذ الالتزام”.[1]
فيما عرفه الأستاذ أحميدو أكري، على أن:” الشرط الجزائي هو اتفاق سابق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم التنفيذ، أو التأخير فيه فهو تقدير اتفاقي للتعويض بنوعيه تقدير يتم الاتفاق عليه قبل وقوع الضرر بالفعل”.[2]
وعرف الفقيه أحمد ادريوش الشرط الجزائي كذلك: ” بأنه اتفاق بمقتضاه يحدد طرفا العقد مسبقا مقدار التعويض المستحق للدائن في حالة إخلال المدين جزئيا أو كليا بالتزاماته التعاقدية أو تأخره في تنفيذها؛ فهو إذن تقدير اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه للدائن في حالة تقاعس المدين عن الوفاء”.[3]
وبالرجوع الى الفصل 264[4] من قانون الالتزامات والعقود والتي نظم من خلالها المشرع المغربي أحكام الشرط الجزائي، نجد أنه لم يعرف الشرط الجزائي، لكن يمكن استنتاج من خلال قراءة هذه الفصل أن المدين يكون ملتزم بالتعويض عن الضرر الحاصل للدائن إما بسبب عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر عن تنفيذ الالتزام والأصل أن تقدير الظروف الخاصة لكل حالة يرجع إلى سلطة المحكمة التي ألزمها القانون بتقدير التعويض حسب درجة خطأ المدين أو تدليسه وهو المبدأ الذي أقرته الفقرة الأولى من الفصل السالف الذكر.[5]
وبالتالي فالشرط الجزائي يقصد به ذلك الاتفاق الذي يحدد فيه المتعاقدين سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه (سواء كان عدم التنفيذ كليا أو جزئيا أو تأخر في تنفيذه)، أي ذلك التعويض عن الضرر اللاحق بالدائن من عدم التنفيذ، وبالتالي فهو اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، ويشترط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو التأخر فيه، أي أنه اتفاق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن، ومن ثم فهو يدخل ضمن اتفاقات المسؤولية.[6]
وقد سمي الاتفاق على التعويض قبل وقوع الضرر بالشرط الجزائي لأنه يوضع عادة كشرط من شروط العقد، ولكن لا يعني ذلك أنه شرط فيه، وإنما هو اتفاق مستقل بين العاقدين، قد يدرج في العقد، أو يتم الاتفاق عليه في ورقة منفصلة عنه.
هذا وإن كان مفهوم الشرط الجزائي هو وليد الفكرة القانونية، فإن الفقهاء المعاصرين عند تناولهم الشرط الجزائي وبيان أحكامه لم تخلو بحوثهم من وضع تعريف له ليبينوا الشرط الذي يتحدثون عن حكمه، ولذا ورد عنهم أكثر من تعريف.
حيث عرفه اليمني محمد بن عبد العزيز على أنه: ” التزام زائد مضاف الى العقد، يلزم الطرف المخل بالتعويض المعين عند وقوع إخلال اختياري نتج عنه ضرر”.[7]
بينما عرفه الفقيه حسن الجواهري على أنه:” هو التعويض الذي يحدده المتعاقدان مقدماً في العقد جزاء على إخلال أحدهما بما تعاقد عليه أو التزم به أو تعهده في ضمن العقد، وقد يعبر عنه بالتعويض الاتفاقي”.[8]
وعلى نفس النهج عرف الفقيه محمد الزحيلي الشرط الجزائي على أنه: ” هو اتفاق سلفا على التزام معين يستحقه الدائن أو غيره على المدين، إذا لم يقم المدين بواجباته، أو تأخر في تنفيذها “[9].
فيما عرفه محمد قلعجي على أنه: ” نص المتعاقدين على مبلغ معين يدفعه من أخل بالالتزام “[10].
ومن التعريفات السابقة يظهر أن تعريف الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي متفق على أنه عبارة عن اتفاق مدرج في العقد أو لاحق له، ينص على التزام بدفع مبلغ معين عند الإخلال بتنفيذ العقد أو التأخر في تنفيذه.
وانظلاقا من هذا التعريف يمكن بيان الخصائص التي يتميز بها الشرط الجزائي، وهي:
- أن الشرط الجزائي اتفاق بين العاقدين على تقدير قيمة التعويض يكون سابقا على وقوع الضرر، ولذا يطلق عليه في القانون مسمى التعويض الاتفاقي وإذا كان الأصل أن يقوم القضاء بتقدير التعويض فإن العاقدين قد يتفقان على عدم ترك تقدير التعويض لقاضي الموضوع عند وقوع الضرر فيقدراته بما يريانه بأنفسهما قبل وقوع الضرر.[11]
كما يظهر من التعريف أن الشرط الجزائي ليست له صورة واحدة في الاتفاق عليه، فقد يرد في صلب العقد الأصلي الذي يربط بين المتعاقدين، كعقد الاستصناع أو التوريد مثلا، فينص العاقدان عليه كشرط من شروط ذلك العقد وقد يتفقان عليه في وثيقة لاحقة، بشرط أن يكون الاتفاق عليه قد تم قبل وقوع الإخلال بالالتزام.
- أن الشرط الجزائي – وكما سبق البيان – قد يحدد كجزاء لعدم قيام المدين بالتنفيذ أصلا، أو التنفيذ المعيب المخالف للمواصفات المتفق عليها في العقد، فيسمى حينئذ شرطا جزائيا لعدم التنفيذ أو التنفيذ المخالف، كما قد يرد كشرط للتأخر في التنفيذ عن الموعد المتفق عليه، فيسمى حينئذ شرطا جزائيا للتأخر في التنفيذ.[12]
- أن الشرط الجزائي ليس تقديرا موافقا للضرر الواقع، وإنما هو تقدير جزافي المبلغ من المال عن ضرر متوقع قد يلحق بالدائن عند عدم الوفاء بالدين أو التأخر فيه، ومن ثم قد يكون المبلغ المتفق عليه أكبر من قيمة الضرر، أو أقل منه، أو مساو له، حيث يعد في مفهومه عقوبة للمدين بالالتزام عند عدم التنفيذ أو التأخر فيه، وليس مجرد جبر الضرر الواقع كما في التعويض عن الضرر.[13]
- أن الشرط الجزائي التزام تبعي وليس أصليا، ويقصد بذلك أنه يبرم في عقد مستقل أو كشرط في العقد دون أن يتعلق بالالتزام الأصلي في العقد فالهدف منه ضمان تنفيذ الالتزام الأصلي، وبناء على هذا فإن وجود الشرط الجزائي معلق على وجود هذا الالتزام الأصلي وبقاؤه صحيحا، فإذا بطل الالتزام الأصلي بأي حال بطل بالتبع له الشرط الجزائي، وفي المقابل لا يؤثر بطلان الشرط الجزائي على الالتزام الأصلي بشيء.[14]
الفقرة الثانية: حكم الشرط الجزائي
يعتبر الشرط الجزائي من الشروط التي تكون بين أطراف العقد، وحقيقتها أنها من الشروط الجعلية التي يضيفها أحد أطراف العقد أو جميعهم لما فيه مصلحة لهم جميعا أو مصلحة لبعضهم.
ومبحث الشروط الجعلية يتطلب النظر في تقسيم الشروط عند الفقهاء والأصوليين، فالشروط إما أن تكون شروطاً شرعية أو جعلية، والشروط الشرعية إما أن تكون شروطا تكليفية أو وضعية ، والشروط الجعلية إما أن تكون شروطا تقييدية أو تعليقية ، ومحل بحثنا في الشروط الجعلية لا الشرعية، وفي الشروط التقييدية منها لا التعليقية.[15]
فالشروط الجعلية: هي الشروط التي يشترطها المكلف، كشرط المتعاقد في العقد. وشرط الواقف، وشرط الموصي، والتقييدية في مقابل التعليقية، ويكون محلها في التعاقد بالتزامن مع توقيع العقد واتفاقياته، والغرض من الشروط الجعلية التقييدية حماية المشروع أو أطراف العقد أو أحدهما، أو توضيح الالتزامات التعاقدية.[16]
وهذه الشروط التي هذا عرضها هي داخلة في عموم القاعدة التي يجري عليها العمل اليوم في البلاد الإسلامية مع تطور المنتجات المالية والعقود المستجدة، وهي أن الأصل في العقود والشروط الحل والإباحة، ولا يحرم منه أو يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا.
وقد قرر هذه القاعدة جمع من أهل العلم المحققين، ومن هؤلاء ما قرره الجصاص – رحمه الله – عند تفسيره لقوله تعالى: “يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود “[17] حيث قال: “واقتضى قوله تعالى: “أوفوا بالعقود” الوفاء بعقود البياعات والإجراءات والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقد، فمتى اختلفنا في جواز عقد أو فساده صحالاحتجاج بقوله تعالى: “أوفوا بالعقود ، لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجازات والبيوع وغيرها، وقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (والمسلمون عند شروطهم)[18] في معنى قول الله تعالى: “أوفوا بالعقود وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشترطه الإنسان على نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه “[19].
ومما استدل به القائلون بأن الأصل في الشروط الإباحة أيضا هو قول الرسول ﷺ: أَحَقُّ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ “.[20]
ووجه الدلالة هنا هو أن الحديث بمنطوقه أشار لاستحقاق الشروط في العموم للوفاء، وذلك أن لفظة “أحق الشروط”، تقضي أن بعض الشرط تقتضي الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له، وبالتالي فالشروط التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفاء، ويترجح على ما عدا النكاح.[21]
ومما يستدل به أيضا في اعتبار أن الأصل في الشروط الإباحة هو قول رسول الله ﷺ: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).[22]
ووجه الدلالة أن ذم الغادر فيه إشارة إلى أن كل من اشترط شرطا ثم نقضه فقد غدر، والشريعة أنت بوجوب الوفاء بجنس المواثيق والشروط والعقود، فدل هذا على أن الأصل هو صحتها مطلقا، إذ أن معنى الصحة هو حصول مقصودها، ولا يحصل إلا بالوفاء بها، وكذلك إذ لو كانت باطلة مطلقا لما صح أن يذم ناقضها مطلقا.[23]
ومن ثم فإن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم.
وعكس هذا القول الذي يرى بأن الأصل في الشروط هو الإباحة، نجد أن هناك من ذهب الى أن الأصل في الشروط هو التحريم والمنع.
ولقد بنوا ذلك على نهي النبي عن البيع المقترن بشرط، بحيث جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ: ” نهى عن بيع وشرط”.[24]
ووجه الدلالة هنا هو أن قد نهى عن البيع المقترن بشرط، والنهي يقتضي التحريم[25]، فالشروط المقترنة بالعقود فاسدة ولأن هذه الشروط لا تخلو أن تكون على البائع أو على المشتري. فإن كانت على البائع فقد منعته من استقرار ملكه على الثمن، وأدت إلى جهالة فيه، وإن كانت على المشتري فقد منعته من تمام ملكه للمبيع، وأضعفت تصرفه فيه، فبطل العقد بكل واحد منها[26].
وكذلك من قبيل ما استدل به أصحاب القول بأن الأصل في الشروط التحريم والمنع، هو حديث النبي: ” ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق “.[27]
ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أبطل الشرط، وعلل بطلانه بأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، فدل على أن الأصل المنع في هذا الباب.
إلا أن في الحديث هو كل شرط يخالف كتاب الله وكل ما كان حراما بدون الشرط، فالشرط لا يبيحه كالربا وكالوطء في ملك الغير، وكثبوت الولاء لغير المعتق، وأن ما أباحه الله فالشرط يوجبه ويلزم به[28].
وتبعا لذلك يمكن القول أن الأقرب للصواب هو القول الأول، لقوة أدلته ووجاهتها، واتفاقها مع مقصد التوسعة على المكلفين، ولاتساقها مع مبدأ الإباحة الأصلي، وخاصة في معاملات الناس وتجارتهم، وهو الأمر الذي ذهب إليه إبن القيم رحمه الله بقوله: ” وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه الله ورسوله، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله، وليس مع المانعين نص بالتحريم ،البتة، وإنما معهم قياس قد علم أن بين الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق، وأنّ القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مساواة الفرع لأصله، وهذا ما لا حيلة فيه، وبالله التوفيق “.[29]
وبالتالي فإن الأصل في الشروط هو الجواز والإباحة، وأنه لا يبطل فيها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا، وهو الأمر الذي ينطبق على الشرط الجزائي ابتداءا بحيث أنه لا يخرج عن الشرع في شيء، إذ يعتبر من الشروط التي من مصلحة العقد، بحيث هو حافز لاكمال العقد في وقته المحدود له.[30]
وعليه فإن الشرط الجزائي يأخذ حكم الشروط في أن الأصل فيه هو الإباحة، وهو ما جاء عليه قرار صادر عن مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الثانية عشرة في الرياض في المملكة العربية السعودية، بحيث نص على أنه: ” يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا ؛ فإن هذا من الربا الصريح “.[31]
وتبعا لهذا القرار نجد أن مجمع الفقه الإسلامي قد ميز في حكم الشرط الجزائي في العقود المالية وبين الشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، وذلك سيرا على نهج مجموعة من الفقهاء المعاصرين والذين ميزوا هم كذلك ما بين الشرط الجزائي في الديون ونظيره في الأعمال أو العقود.
فأما بالنسبة للشرط الجزائي في الديون فلقد اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم الشرط الجزائي المتضمن الاتفاق على تحديد العوض نقذا بمبلغ معين يعطى للدائن، أو بنسبة محددة، جزاء التأخير عن الوفاء في الوقت المحدد، لأنه هو الربا المحرم، وهو ربا النسيئة.[32]
واستدل العلماء على بطلان الشرط الجزائي وتحريمه في هذه الحالة بنصوص من القرآن الكريم والسنة الثابتة، وإجماع العلماء.
فمن القرآن قوله تعالى: ” ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ “.[33]
وهذا هو ربا الجاهلية المنهي عنه بأن يبيع الرجل شيئاً إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل، ولم يكن عند صاحبه قضاء، زاد وأخر ، وكلما أخر زاد في المال، وهو ربا النسيئة[34].
ومن السنة النبوية ما روى ابن مسعود رضي قال: ” لعن رسول الله ﷺ أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه“[35].
وروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ” سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، والبر بالبر والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عيناً بعين، فمن زاد أو استزاد فقد أربي“[36]، وهذا هو ربا الفضل.
وأجمعت الأمة على تحريم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، قال الجصاص رحمه الله عن ربا النسيئة: «ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة، فقال:” أجلني أردك منها درهما، لا يجوز لأن المسألة عوض عن الأجل، وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الأجال”[37].
وهو ما ذهب إليه أيضا الإمام الحطاب المالكي، فقال: ” إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إذا لم يوفه حقه في كذا ، فله عليه كذا وكذا ، فهذا لا يختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، سواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو من غيره، وسواء كان شيئا معينا أو سواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو من غيره، وسواء كان شيئاً معينا أو منفعة “.[38]
وهذا يدخل تحت القاعدة الفقهية المقررة، وهي ” كل قرض جر نفعا فهو ربا “[39].
وهذا ما سماه مجمع الفقه الإسلامي الدولي من ” العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا فإن هذا من الربا الصريح “.
وبالتالي فالشرط الجزائي غير جائز في العقود الذي يكون الالتزام الأصلي فيها هو الدين، وذلك على خلاف الأعمال أو العقود المالية، والتي يمكن أن يتم الاتفاق على مبلغ في العقد كشرط جزائي ملزم للمدين المماطل كتعويض عن الضرر الذي يتسبب في وقوعه على الدائن بسبب الامتناع أو التأخير في القيام بما التزم به من عمل في عقد المقاولة أو التوريد أو الاستصناع عن وقته، ولم يكن الالتزام دينا من الديون، كالسلم مثلا، أو قسط من الأقساط.[40]
واستدل الفقهاء الذين قالوا بجواز الشرط الجزائي في العقود بآيات عديدة منها:
- قول الله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ “.[41]
- قوله تعالى ” وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ “.[42]
- قوله تعالى ” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولا “.[43]
ووجه الدلالة هنا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر في هذه الآيات بالوفاء بالعقود، متى لم تخالف شرع الله تعالى، والشرط مما يرد في العقد فوجب الوفاء به، والشرط الجزائي بالصورة السابقة لا يخالف الشريعة فكان جائزا.[44]
وأما السنة فاستدلوا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع “[45].
ووجه الدلالة هو أن الحديث قد بين بوضوح أن المدين المماطل ظالم بمطله مع ملاءته، فكان ملزما بدفع الظلم الواقع على من ظلمه بالتعويض، وهو ما يحدث في الشرط الجزائي في هذه الحالة، خاصة وأن الفقهاء قد قرروا تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة مع رد الأصل، فدل على أن الشرط الجزائي صحيح.[46]
وتبعا لذلك فإن الشرط الجزائي في العقود المالية هو شرط جائز، والذي يدخل من ضمنها عقد الاستصناع، بحيث يجوز لطرفي عقد الاستصناع من إضافة شرط جزائي لضمان تنفيذ العقد، وهو الأمر الذي أكده القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي، في دورته السابعة في جدة، والذي جاء فيه: ” يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة”.[47]
هذا وإن كان المجمع قد أجاز اشتراط الشرط الجزائي في عقد الاستصناع، فلقد قيد ذلك بمجوعة من الضوابط التي تحكم والتي ترمي الى عدم الخروج به الى دائرة الحرام وأكل أموال الناس بالباطل، والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
أولا: ضرورة تحقق الضرر، بحيث أن حقيقة التعويض في الشرط الجزائي هو تعويض عن ضرر لاحق بسب عدم الالتزام بالعقد. فوجود الضرر يعد ركنا مهما في الشرط الجزائي، ولهذا فإن التعويض من غير وجود ضرر يعد من أكل المال بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه في قوله: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ “[48]، ولهذا صدر قرر المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعدم العمل بالشرط الجزائي إذا ثبت أن من شرط له لم يلحقه ضرر، فقد جاء فيه ما نصه:” لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه … أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد “.[49]
ثانيا: ألا يخرج التعويض عن حد المعقول، فإن كان كثيرا وجب رده إلى المعقول بما يتحقق معه العدل والإنصاف، حيث جاء في قرار هيئة كبار العلماء بخصوص الشرط الجزائي ما نصه: “وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من ضرر ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر.”[50]
ثالثا: ألا يكون الضرر ناتجا عن إخلال خارج عن إرادة من ثبت ضده الشرط الجزائي، ويكون عبء الإثبات عليه[51]، وهو الذي يمكن استسقاؤه من نص قرار المجمع الفقهي عند إجازته للشرط الجزائي في عقد الاستصناع، بحيث جاء فيه: ” يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا … ما لم تكن هناك ظروف قاهرة “.
رابعا: أن يكون الضرر محل الشرط الجزائي والذي يراد تعويضه منه ضررا ماديا حقيقيا دون الضرر المعنوي والأدبي أو الضرر عن تفويت فرصة كسب محتملة، فالقائلون بجواز الشرط الجزائي في العقود لا يلزم من قولهم موافقتهم في هذه الصورة[52]، ومن ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في قراره عن الشرط الجزائي: “خامسا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي “.[53]
وتبعا لما سبق فإن الشرط الجزائي في عقد الاستصناع جائز شرعا مع التقيد ببعض من الشروط، لأنه من قبيل الشرط الجزائي في الأعمال لا الديون، وفيه من المصالح المعتبرة لتحقيق مقصود العقد، وهو الأمر الذي سيتم محاولة التطرق إليه من خلال المطلب الثاني.
المطلب الثاني: فعالية الشرط الجزائي في عقد الاستصناع وأسباب انقضائه
من خلال هذا المطلب سيتم التطرق أولا، لدور الشرط الجزائي في ضمان تنفيذ عقد الاستصناع (الفقرة الأولى)، على أن يتم بعد ذلك التطرق الى أسباب انقضائه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: فعالية الشرط الجزائي كضمانة عقدية في الاستصناع
إن الشرط الجزائي بصفة عامة له عدة فوائد بالنسبة لمختلف العقود، بحيث يضمن تنفيذ العقد، وعدم الإخلال بالالتزامات الواردة فيه، مما يحمل المدين الجدية في تنفيذ العقد، وعدم التهاون فيه، أو التأخير في الالتزام الواجب عليه، وكذلك يعفي الأطراف من اللجوء إلى القضاء، وما يترتب عليه من مصروفات مالية وإجراءات طويلة، ونزاعات وخلافات وخصومات، كما أنه من خلاله يمكن الاتفاق مسبقا على تقدير التعويض المترتب على الضرر الذي سينتج بسبب الإخلال بالتنفيذ، أو التأخير فيه.[54]
وإن كانت هذه الفوائد تتحقق في جميع أنواع العقود، فإن للشرط الجزائي في عقد الاستصناع أهمية خاصة وفوائد جمة على حسن تنفيذه وكذلك ضمان حقوق كلا طرفي العقد.
بحيث نظرا لطبيعة هذا العقد والذي يقوم على أساس التزام شخص يسمى الصانع يلتزم بموجبه بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف شخص ثاني يسمى المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين.
وبما أن الصانع يقدم -باعتباره طرفا أساسيا-قضيتين رئيسيتين هما العمل والمادة في سبيل صناعة المطلوب منه بما أتفق عليه من وصف وهيأة مخصوصة، وبالتالي فمن الطبيعي أن ما يبذله ليس بالقليل من جانب، ومن جانب آخر قد يكون ما صنعه على تلك الكيفية المخصوصة لا يروق لأحد سوى من أرادها بسبب الطبيعة الذوقية، فعليه فلو نكل المستصنع لأي سبب كان، فإن مثل هذا يسبب في بعض الأحيان -إن لم يكن الغالب -الضرر البالغ على الصانع.[55]
ونفس الأمر ينطبق على المستصنع والذي قد يتعرض الى أضرار سواء جراء تخلف الصانع عن موعد التسليم نتيجة خطأ منه، كسوء التنظيم أو التقاعس في احترام المواعيد، أو جراء عدم تحقق المواصفات التي اشترطها هذا المستصنع في الشيء المصنوع، كما لو كان بجودة رديئة عن الجودة المتطلبة.
وبالتالي هنا يكون للشرط الجزائي بليغ الأثر على ضمان حق كل من طرفي عقد الاستصناع سواء على الصانع من خلال ضمان حصوله على تعويض عند إخلال المستصنع بالتزاماته سواء بتسلم المصنوع أو عدم أداء الثمن المتفق عليه، أو بالنسبة للمستصنع من خلال ضمان حصوله عن التعويض في حالة الـتأخر عن التسليم أو عدم مطابقة المصنوع للمواصفات المتفق عليها.
وعليه يكون الشرط الجزائي من أهم الضمانات التي تساعد على حسن تنفيذ عقد الاستصناع، خاصة وأن هذا العقد أصبح من أهم العقود ووسائل التمويل التي أصبحت تركن لها البنوك التشاركية في المغرب على وجه خاص، والبنوك الإسلامية على مستوى العالم بصفة عامة.
وبالتالي فالشرط الجزائي يعد من أهم الضمانات التي تشترطها البنوك التشاركية في عقود الاستصناع التي تبرمها سواء بصفتها مستصنعا أو صانعا أو هما معا فيما يعرف بالاستصناع الموازي، والذي يتحقق هذا الأخير في الصورة التي يبرم البنك عقد الاستصناع – بصفته صانعا – مع عميل يريد صنعة معينة، فيجري العقد على ذلك، ويتعاقد البنك مع عميل آخر باعتباره مستصنعا، فيطلب منه صناعة المطلوب بالأوصاف نفسها ، فيكون هناك طرف أول : وهو طالب عقد الاستصناع من البنك أو المصرف، وطرف ثان: وهو المصرف أو البنك، ودوره التمويل النقدي، وطرف ثالث: وهو الذي طلب منه البنك السلع المستصنعة.[56]
وعليه فإن الشرط الجزائي هو السبيل بالنسبة للبنوك التشاركية من أجل ضمان العقود الذي تبرمها، خاصة بالنسبة لعملية الاستصناع الموازي، والتي تحمي فيه نفسها، سواء من خلال العقد الأول الذي تبرمه بصفتها صانعا من خلال إدراج شرط جزائي يضمن تنفيذ العميل إلتزامه بتسلم المصنوع خاصة وأنها تعاقدت مع الطرف الثاني بناء على رغبته، أو من خلال العقد الثاني من خلال إدراج شرط جزائي تضمن من خلاله تسلم المصنوع في الوقت المحدد مع المواصفات التي اتفقت عليها مع العميل.
وتبعا لذلك فإن وجود الشرط الجزائي من مصلحة العقد؛ لأنه يحث المتعاقدين على الوفاء بالعقد، والالتزام به والمنع من مخالفته والتلاعب فيه، خاصة ومع ضعف الوازع الديني فإن الحاجة لوجود مثل هذا الشرط فيه إكمال للمقصد من العقد وتحقيق لغاية شرعية في منع الضرر عن أحد المتعاقدين، وسعي في آثار وجود عقد الاستصناع الذي له أثر اقتصادي حقيقي على المسلمين، ويكون التمويل بهذا العقد مجديا للبنوك الإسلامية ومتجاوزا للمخاطر التي تخشاها.
وهو الذي يتضح معه سماح المشرع بإشترط هذا الشرط في عقود الاستصناع التي تبرمها البنوك التشاركية، حيث جاء في المادة 69-10 من منشور والي بنك المغرب رقم 2 / و /2019[57]: ” يجوز للصانع أو المستصنع في عقد الاستصناع الحصول على الضمانات المناسبة من أجل ضمان حقوقه لدى الطرف الآخر، من بين الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.”
وبالتالي فاعتماد على هذه المادة يمكن للبنك من أن يتحصل على مختلف الضمانات التي تضمن حقوقه، والتي تم النص عليها في النصوص التشريعية المعمول به، والذي مما لا شك فيه أن الشرط الجزائي من أهم هذه الشروط، والذي يطبق عليها في هذه الحالة مختلف الأحكام التي أفردها المشرع للشرط الجزائي في الفصل 264 من قانون الإلتزامات والعقود.
الفقرة الثانية: انقضاء الشرط الجزائي
ينقضي الشرط الجزائي بالوفاء (أولا)، وكذلك ببطلان الالتزام الأصلي، وأيضا ينقضي بالاستحالة (ثالثا) والإقالة الاختيارية (رابعا).
أولا: انقضاء الشرط الجزائي بالوفاء:
يقصد بالوفاء قيام المدين بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه، وذلك عن طريق أداء محل هذا الالتزام[58]، وهو الأمر الذي يتحقق بالنسبة لعقد الاستصناع بوفاء المتعاقدين بالالتزامات الملقاة على عاتقهم والتي يرتبها العقد، حيث يلتزم الصانع بالوفاء بما عليه من التزامات، وذلك بإتمام صنع المادة الخام وتشكيلها طبقا للمعايير والمواصفات المتفق عليها بينه وبين المستصنع وتسليمها إلى هذا الأخير داخل المدة المتفق عليها، فيما يتحقق الوفاء بالنسبة للمستصنع بأداء الثمن المتفق عليه وتسلم المصنوع.[59]
وبالتالي فإن انقضاء عقد الاستصناع بالوفاء يترتب عنه انقضاء الشرط الجزائي كذلك، وذلك لكون أن هذا الشرط هو هدفه فقط ضمان تنفيذ الالتزامات المترتبة بموجب العقد على الطرفين، وما دام تم الوفاء بها فإنه تبعا لذلك لا يصبح للشرط الجزائي أي أثر.
ثانيا: انقضاء الشرط الجزائي ببطلان الإلتزام الأصلي
بطلان الالتزام الأصلي يقتضي بطلان الالتزامات التابعة، وذلك طبقا لما جاء في المادة 307 من ق ل ع: ” بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع.
بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي “.
والالتزام الأصلي هو الذي يقوم بذاته من دون حاجة إلى غيره[60]، وهو الذي يتمثل في عقد الاستصناع في التزام كل من الصانع والمستصنع في عقد الاستصناع، أما الالتزام التابع، فهو القائم بغيره والذي لا يتصور وجوده بدون التزام أصلي يرتكز عليه ويكون تابعاً له، وهو في هذه الحالة الشرط الجزائي.
وبالتالي فإن بطلان عقد الاستصناع يترتب عنه بطلان الشرط الجزائي، وهو نفس الأمر بالنسبة لإبطال عقد الاستصناع بحيث يأخذ الشرط الجزائي نفس الحكم.
ثالثا: انقضاء الشرط الجزائي نتيجة استحالة التنفيذ
يقصد باستحالة التنفيذ تلك الواقعة التي تقع بعد انعقاد العقد بسبب أجنبي، لا دخل الإرادة الأطراف في إحداثه مما يتعذر معها إتمام تنفيذ العقد، والاستحالة المقصودة هنا هي الاستحالة المطلقة كيفما كانت طبيعية أو قانونية، التي ترجع إلى الالتزام ذاته لا الى الأطراف[61].
ونص المشرع على حالة استحالة التنفيذ في الفصل 335 من ق ل ع: ” ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا، استحالة طبيعية أو قانونية بغير فعل المدين أو خطإه وقبل أن يصير في حالة مَطْـل.”
وبالتالي فإن نشأ عقد الاستصناع بشكل صحيح مستجمعا لجميع عناصره وأركانه، ومن ثم بعد ذلك صار تنفيذه مستحيلا نتيجة سبب أجنبي لا علاقة له بأطراف الإلتزام، فإنه ينقضي مع عقد الاستصناع، وعلى نفس المنوال ينقضي تبعا له الشرط الجزائي.
رابعا: انقضاء الشرط الجزائي بالإقالة الاختيارية
يقصد بالإقالة الاختيارية هو اتفاق المتعاقدين، بعد إبرامهما عقدا ما، على إقالة هذا العقد والتحلل من الالتزامات التي نشأت عنه[62]، وهو ما نص عليه الفصل 393 من ق ل ع: ” تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون “.
وتبعا لذلك في حالة ما اختار طرفا عقد الاستصناع إقالة عقد الاستصناع والتحلل من التزاماتهما فإنه يترتب عن ذلك انقضاء الشرط الجزائي.
خاتمة:
ختاما، يعد اشتراط الشرط الجزائي في عقد الاستصناع أمرا جائزا، بشرط الالتزام بالضوابط التي وضعها الفقهاء المعاصرون، والتي تهدف إلى تجنب استغلال هذا الشرط كوسيلة للربا أو لأكل أموال الناس بالباطل. فإذا روعيت هذه الضوابط، أصبح الشرط الجزائي صحيحا، مرتبا لآثاره القانونية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان تنفيذ العقد وحماية أطرافه.
خاصة وأن عقد الاستصناع لم يعد عقد الاستصناع مقتصرا على التعاملات الفردية فقط، بل بات يشكل أحد العقود الأساسية في أنشطة البنوك التشاركية، سواء بصيغة الاستصناع العادي أو الموازي. وهذا التطور جعل الشرط الجزائي أداة ضرورية لضمان حقوق هذه المؤسسات المالية وحمايتها من الأضرار المحتملة عند إبرام مثل هذه العقود.
لائحة المراجع:
- الكتب:
- أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، الجزء الثالث، دار الكتاب العربي، بيروت 1917.
- أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء الرابع، إدارة الطباعة المنيرة، القاهرة 1927.
- البدران كاسب عبد الكريم، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، دار الدعوة، الإسكندرية 1980.
- حسن الجواهري، بحوث في الفقه المعاصر، مجمع الذخائر، 2003.
- فارس فضيل عطيوي، عقد الاستصناع: دراسة فقهية مقارنة، العرف للمطبوعات، بيروت 2015.
- مأمون الكزبري، نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2020.
- محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن الحسين المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، تحقيق السيد يوسف أحمد، كتاب ناشرون، بيروت 2011.
- محمد شنا أبو سعد التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية دار الجامعة الجديدة للنشر. طبعة 2001.
- معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1988.
- المقالات:
- أحمد ادريوش الاجتهاد القضائي المغربي في ميدان الالتزامات والعقود، سلسلة المعارف القانونية، عدد 4 لسنة 1997.
- احميدو أكري، الشرط الجزائي من خلال الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، مجلة الاشعاع، عدد 10 لسنة 1994.
- الخالدي مبارك بن محمد، الشرط الجزائي في العقود المالية وتطبيقاته القضائية: دراسة فقهية مقارنة، مقال منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، عدد 203 لسنة 2022.
- السماعيل عبد الكريم بن محمد بن أحمد، مدى استحقاق مبلغ الشرط الجزائي عند إخلال الصانع بالالتزام في الفقه الإسلامي، مجلة الدراسات الإسلامية، عدد 2 لسنة 2015.
- عبد الرحمن بن خالد السعدي، الشرط الجزائي في عقد الاستصناع المصرفي: دراسة فقهية مقاصدية، مقال منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان، عدد 7 لسنة 2024.
- العجمي محمد بليه محمد، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، عدد 36 لسنة 2020.
- العصيمي محمد بن سعد، عقد الاستصناع: دراسة فقهية مقارنة، مقال منشور مجلة البحوث الإسلامية، عدد 122 لسنة 2020.
- محمد مصطفى الزحيلي، الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصرفية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، عدد 25 لسنة 2003.
- ملاحي أمل، سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي، مجلة الفقه والقانون، عدد 60 لسنة 2017.
- هشام علالي، الشرط الجزائي، مجلة المحاكم المغربية، عدد 155 لسنة 2017.
- الرسائل والأطاريح:
- عبد الكريم سوداني، عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2018/2019.
- اليمني محمد بن عبد العزيز بن سعد، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 2004/2005.
- – محمد شنا أبو سعد التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية دار الجامعة الجديدة للنشر. طبعة 2001، ص: .64. ↑
- – احميدو أكري، الشرط الجزائي من خلال الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، مجلة الاشعاع، عدد 10 لسنة 1994. ↑
- – أحمد ادريوش الاجتهاد القضائي المغربي في ميدان الالتزامات والعقود، سلسلة المعارف القانونية، عدد 4 لسنة 1997، ص: 143. ↑
- – نصت المادة 264 على ما يلي: ” الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه.
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه.
يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي.
يقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.”. ↑
- – ملاحي أمل، سلطة القاضي في تعديل الشرط الجزائي، مجلة الفقه والقانون، عدد 60 لسنة 2017، ص: 128. ↑
- – هشام علالي، الشرط الجزائي، مجلة المحاكم المغربية، عدد 155 لسنة 2017، ص: 100. ↑
- – اليمني محمد بن عبد العزيز بن سعد، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 2004/2005. ↑
- – حسن الجواهري، بحوث في الفقه المعاصر، مجمع الذخائر، 2003، الجزء الرابع، ص: 205، نقلا عن فارس فضيل عطيوي، عقد الاستصناع: دراسة فقهية مقارنة، العرف للمطبوعات، بيروت 2015، ص: 214. ↑
- – محمد مصطفى الزحيلي، الشرط الجزائي في المعاملات المالية والمصرفية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، عدد 25 لسنة 2003، ص: 115. ↑
- – معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1988، ص: 163، نقلا عن فارس فضيل عطيوي، م س، ص: 214. ↑
- -العجمي محمد بليه محمد، الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، عدد 36 لسنة 2020، ص: 545. ↑
- – نفس المرجع السابق، ص: 546. ↑
- – هشام علالي، م س، ص: 103. ↑
- – العجمي محمد بليه حمد، م س، ص: 546. ↑
- – عبد الرحمن بن خالد السعدي، الشرط الجزائي في عقد الاستصناع المصرفي: دراسة فقهية مقاصدية، مقال منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان، عدد 7 لسنة 2024، ص: 644. ↑
- – نفس المرجع السابق، ص: 645. ↑
- – الآية الأولى من سورة المائدة. ↑
- – أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم 3596، 322/3، وأخرجه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -في الصلح بين الناس، رقم 1352، 634/3، وقال عنه: “حديث حسن صحيح”. ↑
- – أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، الجزء الثالث، دار الكتاب العربي، بيروت 1917، ص: 286. ↑
- – صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقد النكاح، حديث 2721. ↑
- – الخالدي مبارك بن محمد، الشرط الجزائي في العقود المالية وتطبيقاته القضائية: دراسة فقهية مقارنة، مقال منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، عدد 203 لسنة 2022، ص: 188. ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم الحديث 2227، ج3/82. ↑
- – الخالدي مبارك بن محمد، م س، ص: 188. ↑
- – أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم 4361، ج4/335. ↑
- – العجمي محمد بليه محمد، م س، ص: 561. ↑
- – الخالدي مبارك بن محمد، م س، 186. ↑
- – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المكاتيب، باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه، رقم الحديث 2561، ج 3/152. ↑
- – الخالدي مبارك بن حمد، م س، ص: 187. ↑
- – أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء الرابع، إدارة الطباعة المنيرة، القاهرة 1927، ص: 162 و163. ↑
- – البدران كاسب عبد الكريم، عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، دار الدعوة، الإسكندرية 1980، ص: 212. ↑
- – قرار رقم 109 (3/12)، الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2000، أورده محمد بليه حمد عجمي، م س، ص: 564. ↑
- – محمد الزحيلي، م س، ص: 124. ↑
- – الآية 275 من سورة البقرة. ↑
- – محمد الزحيلي، م س، ص: 125. ↑
- – أخرجه الترمذي (1206)، وابن ماجه (2277) باختلاف يسير، والنسائي (3416) مطولا باختلاف يسير، وأحمد (3809) واللفظ له. ↑
- – خرجه أيوب السختيانى في (أحاديثه) (28)، وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (2/ 297) واللفظ لهما، والنسائي (4562)، وعبد الرزاق (14193) باختلاف يسير. ↑
- – أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، م س، الجزء الأول، ص: 467. ↑
- – محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن الحسين المعروف بالحطاب الرعيني المالكي، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، تحقيق السيد يوسف أحمد، كتاب ناشرون، بيروت 2011، ص: 766. ↑
- – محمد الزحيلي، م س، ص: 126. ↑
- – محمد بليه حمد العجمي، م س، ص: 553. ↑
- – الآية الأولى من سورة المائدة. ↑
- – الآية 91 من سورة النحل. ↑
- – الآية 24 من سورة الإسراء. ↑
- – محمد بليه حمد العجمي، م س، ص: 554. ↑
- – أخرجه الترمذي (1309)، وأحمد (5395) مطولاً، وابن ماجه (2404). ↑
- – محمد بليه حمد العجمي، م س، ص: 556. ↑
- – قرار رقم 65 (3/7)، أورده محمد بليه حمد عجمي، م س، ص: 564. ↑
- – الآية 29 من سورة النساء. ↑
- – قرار رقم 109 (3/12)، الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2000، أورده محمد بليه حمد عجمي، م س، ص: 564. ↑
- – القرار رقم 25، أبحاث هيئة كبار العلماء 1/295. ↑
- – عبد الرحمن بن خالد السعدي، م س، ص: 650. ↑
- – السماعيل عبد الكريم بن محمد بن أحمد، مدى استحقاق مبلغ الشرط الجزائي عند إخلال الصانع بالالتزام في الفقه الإسلامي، مجلة الدراسات الإسلامية، عدد 2 لسنة 2015، ص: 155. ↑
- – قرار رقم 109 (3/12)، الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2000، أورده محمد بليه حمد عجمي، م س، ص: 565. ↑
- – محمد الزحيلي، م س، ص: 116. ↑
- – فارس فضيل عطيوي، م س، ص: 220. ↑
- – العصيمي محمد بن سعد، عقد الاستصناع: دراسة فقهية مقارنة، مقال منشور مجلة البحوث الإسلامية، عدد 122 لسنة 2020. ↑
- – قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1448.19 صادر في 24 من شعبان 1440 (30) أبريل (2019) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2 / و /2019 الصادر في 26 مارس 2019 بتتميم منشور والي بنك المغرب رقم /1/ و /17/ الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتوجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء. ↑
- – مأمون الكزبري، نظرية الإلتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2020، ص: 298. ↑
- – عبد الكريم سوداني، عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2018/2019، ص: 67. ↑
- – مأمون الكزبري، م س، الجزء الأول، ص: 208. ↑
- – مأمون الكزبري، م س، الجزء الثاني، ص: 503. ↑
- – نفس المرجع السابق، ص: 596. ↑