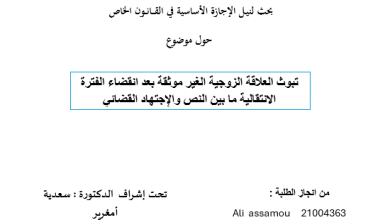العمل النقابي في المغرب وإشكالية الوساطة -حالة التنسيقيات في قطاع التربية والتكوين – حمزة الكرشالي – سلسلة الأبحاث الجامعية والأكاديمية الاصدار 62 شتنبر 2025
العمل النقابي في المغرب وإشكالية الوساطة -حالة التنسيقيات في قطاع التربية والتكوين – حمزة الكرشالي – سلسلة الأبحاث الجامعية والأكاديمية الاصدار 62 شتنبر 2025

مقدمة:
يتغير عالم العمل بوتيرة سريعة في سياقات متقلبة ومضطربة. بينما كان من المنتظر أن تشكِّل نهاية عام 2021 مناسبة لإعلان التعافي شبه التام من آثار الجائحة، استمر عدّاد الإصابات بفيروس كوفيد 19 في الارتفاع، وانتهى بتفاقم الضغوط التضخمية التي ظهر أنها أقوى وأكثر استدامة مما كان متوقعا بعد اندلاع الحرب الروسيّة – الأوكرانيّة وما خلفته من قَلب للأوضاع الدولية وتنامي تدهورها بشكل كبير. وبعدما كان هناك أمل في العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية جرّاء تخفيف القيود الصحية، وتسجيل تقدُّم ملموس في حملات التلقيح برز على العكس انكماش جديد للاقتصاد العالمي، ودخل إلى مرحلة من اللايقين والفوضى جعلت جميع بلدان العالم، وبخاصة النامية منها أو السائرة في طريق النمو، تعيش وضعا معقدا تحيط به المخاوف والمخاطر من كل جانب، ولا سيما بعد تراجع الوظائف الذي يؤدي بحسب منظمة العمل الدولية، في مجال التصنيع وتنامي العمل غير القياسي والمرن واستمرار ونمو الاقتصاد غير النظامي بالإضافة إلى التغيرات التي تحدث في لوائح التشغيل وسلوكه وتقليص حقوق النقابات العمالية وانتهاكها، يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات إنشاء النقابات في معظم الدول في كافة أنحاء العالم. وقد أصبح «النمط الجديد من عدم استقرار العمل» سمة مميزة لعلاقات العمل في القرن الواحد والعشرين وأصبح له آثار كبيرة على الحركة النقابية على مستوى العالم .
تاريخيا، شهدت هذه الحركة العديد من التحولات بعد انتقال المجتمع من النشاط الزراعي إلى النشاط الصناعي، والذي صاحبه تطور ملحوظ بالوسائل الإنتاجية والاختراعات والاكتشافات التي جعلت للأيدي العاملة دورا هاما في عملية الإنتاج. تزامن ذلك مع ظهور النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والساعي لتحقيق المنافع والمكاسب المادية بكل الطرق، متبنيا الفكر الرأسمالي الذي يقوم على مبادئ تتفق مع الطبقة الرأسمالية، وفق مبدأ حرية العمل الذي نادى به ادم سميث في كتابه ثروة الأمم، فرفض تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية، ونادى بوجوب تركه لقوى العرض والطلب . مما أدى إلى تسلط أرباب العمل واستغلالهم للطبقة العاملة بفرض شروط عمل مجحفة وأجور متدنية وساعات عمل طويلة.
لقد تأسس احتكاك واصطدام على المصالح والحقوق بين أرباب العمل والعمال، وتزامنا مع ذلك ظهرت البوادر الأولى للتنظيمات النقابية في أوروبا بداية من بريطانيا سنة 1970 ثم فرنسا وانجلترا. لكن التنظيم النقابي تجاوز الحدود الجغرافية والقومية، وأخد طابعا دوليا لحماية الطبقة العاملة. واستطاعت الحركة النقابية العربية أن تمتد بجذورها بين صفوف العمال العرب، وارتبط جزء من نضالها بمعارك التحرر والاستقلال الوطني، وضمنها المغربية التي عرفت بروز معالم التنظيم النقابي.
يتوفر المغرب على تجربة وتراكم في مجال الحرية النقابية والحق في التنظيم، وقد كرست الحقوق المرتبطة بهذين الحقين من خلال التنصيص عليهما دستوريا، سواء في دستور 2011، أو في الدساتير التي سبقته، وفي عدد من التشريعات التي تؤطر العمل النقابي والتنظيم المهني والعمل الجمعوي. فقد شكل موضوع الحق النقابي محور اهتمام المنظمات الدولية والسلطات التشريعية والتنظيمية، التي أحاطته بعدة قواعد وأحكام.
تعتبر حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية وأكدتها القوانين والتشريعات الوطنية، وتم التنصيص على الحق النقابي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، حيث أكدت فقرته الرابعة من المادة العشرين على حق كل شخص في حرية اشتراكه في إدارة الشؤون الخاصة للبلاد، فضلا عن تأكيد المادة الثالث والعشرون أن كل شخص من حقه الانضمام إلى نقابة معينة لحماية مصالحه . كما يقر الدستور المغربي عددا من البنود التي تصب في مصلحة تكريس الحق النقابي من خلال التأكيد على الدور الفعال في التأثير على السياسات العمومية، ناهيك عن المساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، وهذه الأخيرة تعمل كذلك على إحداث هيئات للتشاور من أجل إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية .
لقد شكل موضوع الحق النقابي محور اهتمام المنظمات الدولية والسلطات التشريعية والتنظيمية في مختلف الدول، التي أحاطته بعدة أحكام وقواعد، أصبحت تكون مع مرور الوقت ما يعرف اليوم بمبدأ الحرية النقابية ومبدأ الحق النقابي وذلك إما بواسطة المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية أو بواسطة الدساتير والقوانين الداخلية.
بهذا، يعد العمل النقابي ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، والعمل على تحقيق توازن بين أصحاب العمل والعمال ومراكز القرار من خلال الحوار الهادف والبناء، وبناء الوعي النقابي وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يساهم في خلق علاقات عمل متوازنة، وتكريس الثقافة العمالية .
ينبني العمل النقابي على مبادئ أساسية، تتجلى في القناعة بأهمية ممارسة العمل النقابي، وتقبل النقد الذاتي، والعمل الجماعي، والمراقبة والمحاسبة، والمسؤوليات الفردية والجماعية. غير أنه من أبرزها مبدأ الديمقراطية المتمثلة في أن تكون قيادة النقابة وجميع قراراتها صادرة وفقا على آليات ديمقراطية، ولا سيما اختيار المجموعة التي تقود العمل النقابي، وينبغي على كافة أعضاء النقابة الالتزام بالقرارات الصادرة عن القيادة النقابية .
ومن هنا، فدور العمل النقابي يتمحور حول خدمة الأعضاء والمجتمع بما يحقق مصالحهم ويحميهم من الاستغلال، وهنا يأتي دور القيادات النقابية التي تقود هذا العمل لتحقيق الأهداف بكل الطرق المشروعة بشكل ملموس ومنظم، وعلى قاعدة توزيع المهام وتقسيم العمل . إن أي عمل ناجح في علم الإدارة والمؤسسات لا يخرج الحكم عليه من مدى قدرته على القيام بدوره وتحقيق أهدافه، والوظيفة المنوطة إليه على أحسن وجه، والعمل النقابي كأي عمل له تداعيات وجوده ووظيفته تأتي في سياق الأهداف التي يرتكز عليها خدمة للأعضاء ودفاعا عن مصالحهم. ولا سيما الأدوار العديدة التي تقوم بها النقابة، ولعل أبرزها الوظيفة التمثيلية والدفاع عن المصالح، وحل المشاكل، باعتبار النقابة تقود مشعل الحوار الاجتماعي باسمهم.
أولا- أهمية الموضوع وأهدافه:
تنبع أهمية الموضوع من اعتبارات متعددة يمكن أن نوجزها في جانبين أساسيين:
الأول مرتبط براهنيته بالنظر إلى حدة الخلافات والتوترات بين أطر التدريس والنقابات الأكثر تمثيلية في المغرب وما تحيل عليه من ضعف الوساطة والثقة بين الجانبين، إذ تعكس طول مدة الإضرابات والتطورات التي صاحبتها الحاجة العلمية إلى فهم أدوار العمل النقابي ومدى قدرته على التوسط بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأساتذة بعد رفضهم للنظام الأساسي.
بينما يتعلق الجانب الثاني بقلة الإنتاجات الأكاديمية التي تناولت هذه التطورات من جانب العلوم السياسية، إذ يلاحظ طغيان الجانبين التاريخي والسوسيولوجيا على مختلف الكتابات التي حاولت تناول موضوع الحركة النقابية، والحال أن التحولات التي يشهدها العمل النقابي لا تقف فقط عند مساره وتطوره التاريخي أو أثره الاجتماعي، وإنما تمتد إلى فاعليته وقدرته على الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها.
وعليه، يسعى هذا العمل إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
– تتبع التطور التاريخي للحركة النقابية في المغرب والكشف عن أدوارها ووظائفها.
– إبراز مدى كفاءة المنظمات النقابية في الاضطلاع بأدوارها، مع التركيز على قدرتها على لعب دور الوساطة بالإشارة إلى التوتر الذي عرفته منظومة التربية والتكوين في السنة الدراسية الماضية.
– فهم طبيعة العلاقة بين الفاعل النقابي والشغيلة التعليمية، ورصد العوامل التي أدت إلى بروز التنسيقيات.
– اقتراح بعض المداخل لتعزيز تأثير الوساطة النقابية.
ثانيا- الإشكالية:
أخذا في الحسبان وظيفة العمل النقابي وضعف الثقة التي تحيط بفاعليته، وأبعاد الديمقراطية التشاركية وآفاقها، تنبثق إشكالية محورية يمكن صوغها كما يلي: إلى أي حد ساهم العمل النقابي في تفعيل الوساطة دفاعا عن مصالح الفئات التي تنتمي إليه؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة نرتبها على هذا النحو:
-كيف ظهرت الحركة النقابية في المغرب؟
– ما طبيعة العلاقة بين النقابة والحزب؟
-كيف نشأت التنسيقيات في قطاع التربية والتكوين؟
– وهل يمكنها أن تعوض العمل النقابي أو تحل محله؟
-أين تتجلى إكراهات العمل النقابي؟
– وكيف يمكن الارتقاء بأدوار المنظمات النقابية؟
ثالثا- المفاهيم الرئيسة:
يتكون الموضوع من مفاهيم أساسية يتعين تعريفها وتوضيح معناها في هذا العمل، بداية بمفهوم النقابة والوساطة في علاقتهما الضمنية مع الحوار الاجتماعي:
تعتبر النقابات “شخصيات معنوية، لا تهدف إلى تحقيق الربح مثل الشركات، بل إلى تحقيق غايات أخرى ذات طابع مهني. فالهدف الرئيس من خلق هذا النوع من الشخصيات المعنوية يتلخص في الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة للأعضاء المنتمية إليها. ومن ثم فإن المشرع يعترف لها بأهمية واسعة حتى تتمكن من الدفاع عن هذه المصالح وحمايتها” .وتعرف أيضا بـ «أنها سلطة وسيطة، وهي بهذا المعنى تعد نوعا من التدرج في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولعل هذا المفهوم كان واضحا في أذهان الثورة الفرنسية عندما ألغوا النظم النقابية لدعم العلاقة المباشرة بين الدولة والمواطن دون ما حاجة للوساطة النقابية” .
أما فيما يخص الوساطة، فهي تحيل على تسهيل لعمليات التفاوض يؤديه طرف محايد بين أطراف توترات قائمة للوصول إلى تسوية مرضية لهم. وهي أيضا عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل للمنازعة القائمة بينهم من خلال مساعدة وسيط واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة. تعد الوساطة إجراءات اختياريًة، تتسم بالسرية؛ إذ جميع ما يناقش ويتفق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارج عملية الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وتُعرف منظمــة العمل الدوليــة الحوار الاجتماعي بأنــه “جميــع أنــواع التفــاوض أو التشـاور أو تبـادل المعلومـات بيـن ممثلـي الحكومـات وأصحـاب العمـل والعمـال أو فيمــا بينهــم بشــأن القضايــا ذات الاهتمام المشــترك “.
رابعا- فرضية البحث
ينطلق هذا العمل من فرضية موجهة مفادها أن النقابات لم تُجد في الوساطة والتفاوض لفائدة أطر التدريس بالاستناد إلى الواقع وحصيلته والتوترات التي ما يزال الشارع العام المعبّر الرئيس عنها، وذلك رغم ما راكمته المنظمات النقابية من تجارب في تدبير الخلافات وإدارتها، وذلك لاعتبارات متعددة، ذاتية وموضوعية.
خامسا- المناهج المعتمدة
إن طموحا بحثيا على هذا القدر من التعقيد والتركيب من حيث تعدد انتظاراته والفاعلين فيه، علاوة على تقاطع تحليلاته مع أكثر من حقل معرفي، يجعل حظوظ البحث في قضاياه وإشكالاته أكثر وجوبا للتسلح بالاحتراز والتأني وعدم الجزم والاندفاع. وعيا بهذا التشبيك، كيف يمكن مقاربة الموضوع منهجيا، وأي طريقة ستسعفنا في وضع فرضيته على محك الاختبار وبلوغ نتائجه.
واعتبارا لكون العلوم السياسية والاجتماعية المعاصرة لا تستند على منهج واحد محدد صالح بعينه لمقاربة قضاياها وإشكالياتها، فكل موضوع يفرض طريقة تناوله انسجاما مع طبيعته ورهاناته. لذلك، سنحاول اعتماد المنهج التاريخي للتعرف على أبرز المراحل التي ميزت التجربة النقابية في المغرب، ثم المنهج الوصفي لتحديد أدوار ووسائل عمل المنظمات النقابية. إضافة إلى ذلك سنقوم بالاعتماد على تقنية تحليل المضمون لتفكيك مختلف البيانات والبلاغات والتصريحات ذات الصلة بمشكل الإضرابات واستمرارها وتجليات سوء الفهم الذي وقع بين الفاعلين في منظومة التربية والتكوين.
سادسا- خطة البحث
للإحاطة العلمية بالموضوع، وُزعت هيكلية العمل على فصلين. خصص الأول لمسار تطور الحركة النقابية في المغرب، بينما تناول الفصل الثاني إشكالية الوساطة بالإشارة إلى بروز التنسيقيات في قطاع التعليم وتأثيرها على العمل النقابي.