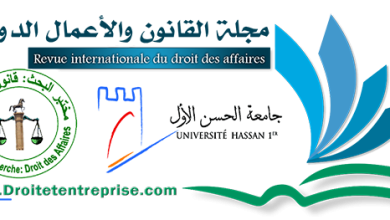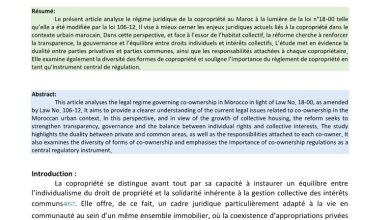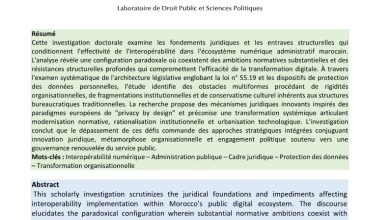تحفظات المرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع -دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الموريتاني والمغربي – الدكتور : ناصر محمد لغظف
تحفظات المرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع -دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الموريتاني والمغربي
الدكتور : ناصر محمد لغظف
دكتور في القانون الخاص
محام لدى المحاكم الموريتانية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665








تحفظات المرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع -دراسة تحليلية مقارنة في القانونين الموريتاني والمغربي
الدكتور : ناصر محمد لغظف
دكتور في القانون الخاص
محام لدى المحاكم الموريتانية
الخلاصة:
أرسى المشرعان المغربي والموريتاني أحكاما خاصة للتحفظات ، بهدف حماية حقوق كل من صاحب البضاعة والناقل و ذلك في سياق تنظيم العلاقة التعاقدية بين الناقل وصاحب البضاعة، وتكمن أهمية هذه الأحكام في كونها آلية قانونية استباقية تهدف إلى حماية الحقوق، وتوفير ضمانات قانونية للطرفين عند تسليم البضاعة في ميناء التفريغ ،غير أن تحديد أجل قصير للإدلاء بهذه التحفظات – ثمانية أيام في القانون المغربي و سبعة أيام في القانون الموريتاني- تحت طائلة سقوط الدعوى يطرح إشكالا حقيقيا قد يهدد مصالح الموردين الوطنيين وفي الوقت الذي يوفر فيه انضمام المغرب إلى اتفاقية هامبورغ للنقل البحري للبضائع دعامة قانونية موازية تعزز من فعالية الحماية، لا يزال المشرع الموريتاني خارج هذا الإطار الدولي، ما يستدعي إعادة النظر في المنظومة القانونية لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضرورات النجاعة الاقتصادية.
Consignee’s Réservations in the Contract of Maritime Carriage of Goods : A Comparative Analytical Study under Mauritanian and Moroccan Legislation
Nasser Mohamed Laghdaf
Attorney at Law before the Mauritanian Courts
Doctor in Private Law University of Sfax
Abstract
The Moroccan and Mauritanian legislators have established specific provisions regarding the consignee’s reservations, aiming to protect the rights of both the cargo owner and the carrier. However, the short timeframes imposed for making such reservations—seven days under Mauritanian law and eight under Moroccan law—under penalty of forfeiture, present a genuine challenge that may jeopardize the interests of national suppliers. While Morocco’s accession to the Hamburg Rules on the carriage of goods by sea provides a complementary legal framework that strengthens protection mechanisms, Mauritania has yet to adopt such an approach. This discrepancy calls for a reevaluation of the legal system in order to strike a fair balance between the demands of social justice and the imperatives of economic efficiency.
مقدمة
تلعب التجارة البحرية دورا محوريا في كل من المغرب وموريتانيا، حيث تشكل ركيزة أساسية في اقتصادهما الوطني، يتميز المغرب بشبكة موانئ حديثة ومتطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط الذي يعد من الأكبر في إفريقيا، مما يعزز موقعه كمركز لوجستي دولي. أما موريتانيا، فتمثل بوابة بحرية استراتيجية لدول الساحل الإفريقي الحبيسة مثل مالي والنيجر، ما يمنحها دوراً محورياً في سلاسل التوريد الإقليمية غير أن تعاظم هذا الدور يطرح أيضا إشكالات قانونية، خصوصا ما يتعلق بوصول البضائع للموانئ في حالة تالفة، مما يبرز أهمية التحفظات التي يبديها أصحاب البضائع لضمان حقوقهم وتحديد المسؤوليات.[1]
ويعد نظام التحفظات التي يقوم بها المرسل إليه عند اكتشاف ضرر في البضاعة من المواضيع المحورية في القانون البحري ، لما له من أثر مباشر على ترتيب المسؤولية بين الناقل والمرسل إليه، سواء تعلق الأمر بإثبات الضرر أو بالمطالبة بالتعويض، نظم كل من المشرع الموريتاني والمشرع المغربي هذا النظام ضمن إطار مدونة التجارة البحرية الخاصة بكل دولة، مستندين كذلك إلى المبادئ المستمدة من الاتفاقيات الدولية للنقل البحري، وعلى رأسها اتفاقية هامبورغ لعام 1978، التي تُعد مرجعا دوليا مهما، رغم أنها لم تعتمد رسميا في بعض التشريعات، مثل القانون الموريتاني.
وعموما فإن مسار المطالبة بالتعويض عن الاضرار في عقد النقل البحري لا يبدأ بالمرحلة القضائية، حيث أن جبر الأضرار الذي هو مناط غاية الدعوى لا يتم بالضرورة لدى القضاء بل يمكن أن يتم بوسائل غير تنازعية لذلك أوجب المشرع القيام ببعض الإجراءات قد تنهي النزاع في مهده ولا يتطلب حكما قضائيا، كما قد تمثل مفترضات أساسية لقيام النزاع ثم لانعقاد الخصومة
والمتعاقد له دعوى عقدية تجاه الناقل البحري استنادا الى المسؤولية العقدية بناء على عقد النقل البحري وكذلك دعوى تجاه المؤمن باعتبار ان عقد التأمين في أساسه مرتبط بعقد النقل البحري[2].
وإذ كانت الدعوى هي الحق نفسه في حالة الحركة أو الحق في حالة الاجبار، وأنه لا يوجد حق دون دعوى تحميه، ولا توجد دعوى دون حق، كما لا توجد للحق أكثر من دعوى، لأجل ذلك للمدعي المتضرر الخيار بين رفع دعوى تعويض على الناقل البحري أو دعوى خسارة تجاه المؤمن لجبر أضراره.
.
وترجع هذه الإجراءات إلى خصوصية التأمين البحري على البضائع والالتزامات المتبادلة التي تمكن المؤمن له من الحلول محل المؤمن له فيما لهذا الأخير من الحقوق والدعاوي ضد الغير نتيجة الخسائر والأضرار التي كانت سببا في ذلك الأداء[3].
فبين تطور التجارة البحرية وتعقيدات علاقات النقل الدولي، تبرز تحفظات صاحب البضاعة كوسيلة قانونية دقيقة لحماية حقوقه وتحديد مراكز الأطراف المتعاقدة.
وإذا كانت الاتفاقيات الدولية، قد وضعت إطارا عاما لتنظيم هذه التحفظات، فإن السؤال يظل مطروحا حول كيفية تنظيم التشريعات الوطنية لها، وخصوصا في القانونين المغربي والموريتاني ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية، سنتطرق أولا للطبيعة القانونية لتحفظات صاحب البضاعة (المبحث الأول) وثانيا آثار القانونية المترتبة على هذه التحفظات (المبحث الثاني).
.
المبحث الأول: الطبيعة القانونية للتحفظات
حرصا من المشرعين على إنهاء النزاعات البحرية بسرعة فقد أوجبا على الشاحن أو المرسل إليه إخطار الناقل البحري بالخسائر في الآجال المحددة غير أن المشرعين تبيانا في طبيعة واجال هذه الاحترازات وفي الخيارات التشريعية المتبعة.
المطلب الأول: الخيار التشريعي للمشرع الموريتاني:
لعل نظام دعوى المسـؤوليـة في النقل البحـري فريد في نوعـه بأخذه لنظـام الإخــطــار الـكـتـابـي الــذي يـوجـهه المـرسـل إليـه إلى الناقل ويقوم فيه بإدراج تحفظاته على البضاعة عند تسلمها في ميناء التفريغ[4] وان كان المشرع الموريتاني كرس مسألة التحفظات في عقد النقل البحري للبضائع إلا ان أحكامه لا تخلو من غموض في إجراءاته
الفقرة الأولى: غموض النص
بالتمعن في مقتضيات مدونة البحرية التجارية لا يمكن الا ان نكون مستغربين من مستوى التنافر التي تتسم بيه في موضوع التحفظات (الاحترازات) التي يقوم بها المرسل اليه أو من يقوم مقامه في حالة معاينة اضرار في البضاعة عند وصولها حيث اكتفى المشرع بالنص بالمادة 542 م ت ب أن “وكيل إيداع الحمولة الذي يعمل بوصفه وكيلا قانونيا باجر من قبل من لهم حق ملكية السلعة “يمكنه” إذا وجد أن حالة أو كمية السلعة لا تفي بمؤشرات سند الشحن ان يصدر ضد الناقل أو ممثله تحفظات على الظروف والشروط في والآجال المقررة في التشريع “.
في الواقع إن احكام هذ النص تثير عدة تساؤلات حول مصطلح ” الظروف والشروط والآجال المقررة في التشريع” فما المقصود بالتشريع في هذه الحالة وماهي الاثار المترتبة عند عدم القيام بتلك التحفظات.
مبدئيا فإن التشريع العام للعقود هو القانون المدني لكن الرجوع الى مدونة الالتزامات والعقود لا يحقق منفعة كبيرة حيث لم تتعرض أحكام الاجارة على الصنعة بوصفها القواعد العامة لعقد النقل لموضوع التحفظات او الاحترازات.
مع ذلك عند التمعن في مقتضيات مجلة التجارة وتحديدا المادة 1200 يتضح أنه “تسقط جميع الدعاوي ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ ومع ذلك إذا كان الضياع الجزئي والعوار تتعذر معرفتهما عند التسليم فان الدعوى ضده قائمة على شرط:
أن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء قد تم بمجرد اكتشاف الضرر وداخل الأيام السبعة الموالية للاستلام”.
يستنتج من نص هذه المادة أن المشرع يخضع مسألة التحفظات لشرطين أساسين أولهما أن تتم التحفظات بواسطة خبير والثاني أن تتم في أجل سبعة أيام من تاريخ وضع البضاعة تحت تصرفه.
غير أن اشتراط صدور التحفظ من خبير لا ينسجم تماما مع مقتضيات المادة 542 من مدونة التجارة البحرية التي تمنح الحق في إبداء التحفظات لمقاول الشحن والتفريغ او لمن ينوب عن صاحب البضاعة
وبما أن المادة 542 تعد النص الخاص المنطبق على المادة البحرية، يمكن القول إن التحفظ الصادر عن مقاول الشجن والتفريغ الذي يعمل لصالح صاحب البضاعة يعد سليما وصحيحا من الناحية القانونية و تبقى بعد ذلك مسألة الاثبات رهينة بتقرير الخبير الذي يؤكد أو ينفي موضوع التحفظ
الفقرة الثانية: استثناء من واجب التحفظ
لايمكن الحديث عن وجود تحفظات يتوجب الإخطار بها في حالة الهلاك الكلي للبضاعة، وذلك لأن الهلاك الكلي يعني عمليا انتفاء عملية التسليم من الأساس، إذ لا تسلم البضاعة أصلا حتى تُثار بشأنها أي تحفظات، ففقدان البضاعة بالكامل يعد إخلالا جوهريا بموضوع العقد، مما يجعل مسألة الإخطار بالتحفظات غير واردة[5]
وينطبق الأمر ذاته على حالة التأخير في تسليم البضاعة، حيث يتميز هذا النوع من الإخلال بسهولة التحقق والإثبات، دون حاجة إلى تقديم تحفظات خاصة، نظرا لاعتماد الموانئ على نظام توثيق دقيق يسجل تاريخ وصول السفن ومواعيد تفريغ الحمولات، وهذه الوثائق الرسمية الصادرة عن إدارة الميناء تشكل دليلا قاطعا يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع التأخير، دون حاجة إلى إثارة تحفظات من قبل المتسلم[6].
لكن تجدر الإشارة إلى ان اتفاقية روتردام و في مادتها 23 تـضـمنـت قـاعدة مـن شـأنـهـا حـث الشـاحـنيـن المـضـروريـن وأصحـاب الحـق في المـطـالبـة في اتـخـاذ إجـراءات مـعيـنة في سـبيـل الـرجـوع عـلى النـاقـل البـحـري بـالتـعـويـض مـن المـسـؤوليـة الناجمة عن التأخير وذلك بـإخـطـاره بحـصـول الـضـرر في غضون واحد وعشرين يوما متتاليا من تسليم البضاعة تحت طائلة سقوط الدعوى.
المطلب الثاني: ازدواجية النظام القانوني للتحفظات لدى المشرع المغربي
لعل ما يميز النظام القانوني المغربي بالأساس عن القانون الموريتاني هو ازدواجية القواعد القانونية التي تحكم النقل البحري بعد مصادقته على الاتفاقيات الدولية للنقل البحري وعلى رأسها اتفاقية هامبورغ وبذلك تحتل علوية على الأحكام القانونية التي تضمنتها التجارية البحرية، وفي هذ الصدد تكون معاهدة هامبورغ تنطبق على النقل البحري الدولي عندما تتوفر شروط اعمالها بينما ينحسر مجال تطبيق التقنين البحري ليظل مطبقا أساسا في نطاق العلاقات البحرية الداخلية والاحكام التي لا تسري عليها المعاهدة.[7]
الفقرة الأولى: التشريعي الداخلي
اقتضت المادة 262 من مدونة التجارة البحرية على أنه “كل دعوى أقيمت على قائد الباخرة أو على مجهزها او أرباب السلع بشأن المطالبة بتعويض عن فساد خصوصي لحق بالبضائع أو ضاع البعض منها فإنها لا تقبل ،إذا لم يوجه المدعي احتجاجا مدعما بأسباب في ظرف 8 أيام على الأكثر من تاريخ جعل السلع عمليا رهن إشارة من وجهة اليه ولا تدخل في ذلك الاجل أيام العطل والاعياد ويجب أن يوجه ذلك الاحتجاج عن طريق غير قضائية أو برسالة مضمونة الوصول وأن تتلوه دعوى يقيمها صاحب ذلك الاحتجاج امام المحاكم في ظرف اجل تسعين يوما”
مـن المنـطق إذا أن تبـدأ مطـالبـة النـاقـل بالتـعـويض، بإخـطـاره بهـلاك البضـاعـة أو تلفهـا ليـعلم بمـا حـدث ويفحـص الأمـر ثم يتـخـذ قـرارا فيه أمـا بفـض النـزاع وديـا دون الحـاجـة للـدخـول مـع المـضرور في خصـومة قضـائيـة، وإنمـا برفض طلبـات المضـرور،[8] وبالتـالي الـتأهب للـدعـوى لذلك أو جب المشرع المغربي على صـاحب البضـاعـة إخـطـار النـاقـل بالخسـائـر والأضـرار الحـاصـلة للبـضـاعـة.
ويشترط في الإخطار أن يكـون مكـتوبـا بحـيث تـوجـه تحفـظـات كتـابية إلى النـاقـل أو ممثـله في مينـاء التفـريغ قبـل أو في وقـت تسليـم البضـاعـة وإذا لم يتم الإخـطـار تعتبر البضـاعـة مستـلمـة حسبـمـا وصفـت في وثيقـة الشـحـن لغـاية ثـبـوت العـكس ويجب أن يكون واضـحـا ومحـددا بحيث يتضـمن مـا أصـاب البضـاعـة فعـلا من خسـائـرا أو إضـرار محـررة بصفـة واضحـة ودقيقـة بمعـنى أنه يشـمل في مضمـونة على ماهيـة الخسـائـر أو الأضـرار التي لم يـرتضيهـا المـرسل إليه عـند استـلامـه للبضـاعـة ويكـون مـحـددا بعيـدا عن العـموميـات التي تجـعل منه مجـرد سـرد لبيـانـات لم تـوضـح الغـرض من تـحـريرهـا[9].
الفقرة الثانية: الإخطار في الاتفاقيات الدولية
صادقت المملكة المغربية على اتفاقية هامبورغ[10] التي قررت ضمن مقتضاياتها[11] ، على أنه يتـعـين عـلى مسـتـلم البضاعة إخـطـار النـاقـل كـتـابـة في خـلال يـومـي العـمـل التـالييـن لليـوم الـذي يـصـل فيـه التـسـليـم، وإلا افـتـرض أنـه قـد حـصـل تـسليمـهـا بـالحـالـة المـثبـتـة في سـنـد الشـحـن اللهــم إلا إذا اسـتـطـاع الشـاحـن بـعـدئـذ إقـامـة الـدليـل عـلى غيـر ذلك، هـذا في حـالتـي الهـلاك الكـلي أو التـلف الـظـاهـر أمـا إذا كـان الهـلاك جـزئـيا أو التـلف غيـر ظـاهـر فـإنـه يـجـوز تـقـديـم الإخـطـار خـلال 15 يـومـا التـاليـة للتـسليـم، عـلى أنـه لا يـلـزم تـقـديـم الإخـطـار إذا تـمـت معـاينـة البـضـاعـة وتـم إثـبـات حـالتـهـا عـنـد التـسـليـم وممـا لاشـك فيـه أن إطـالـة الـمـدة في التلف الغير الظاهر إلى خمسة عشر يوما يـمـثـل حـمـايـة أوسـع للشـاحـنين او المـرسـل إليـهم، حيـث تتـاح لهـم فـرصـة أكبـر وفسـحـة مـن الـوقـت لفـحص البـضـاعـة وتـحـديد الهـالك أو التـالف منـهـا لإخـطـار النـاقـل به وبصفة خـاصـة عـند مـا تـكـون البـضـاعـة المـنقـولـة والمـسلمـة مـن كـمـيات كبيـرة ويـسـتغـرق تـحـديـد التـالف منـهـا بعـض الـوقـت،
تجدر الإشارة الى اتفاقية روتردام التي لم تدخل احكامها حيز التطبيق بعد قد قلصت اجال الأخطار الى 7 أيام فحسب إذا لم يكن التلف غير ظاهر اما إذا كان ظاهرا فيجب القيام به عند تسلم البضاعة
أمـا معـاهـدة بـروكسـل فقد حددت ميعاد الاخطار في حالة الهلاك او التلف الظاهر قبل أو وقت انتقال البضائع الى حراسة الشخص الذي له بموجب عقد النقل الحق في تسليمها أما بالنسبة لحالة الهلاك او التلف غير الظاهر فقد حددت فيه مدة الاخطار في 3 أيام من التسليم .
المبحث الثاني: الاثار القانونية للتحفظات
تحفظات صاحب البضاعة تنتج آثارا قانونية هامة إذ ترتب آثارا ملزمة تجاه جميع أطراف العقد كما تؤثر هذه التحفظات على حقوق الغير، لا سيما شركة التأمين التي تملك حق الحلول محل صاحب البضاعة لمباشرة الدعوى ضد الناقل. لذا، فإن إثبات التحفظات بشكل دقيق وموثق يعد شرطا أساسيا لحماية الحقوق وضمان التعويض[12].
المطلب الأول: أثر التحفظات على أطراف القعد
ترتب التحفظات، متى تمت وفقا للشروط القانونية السليمة، آثارا مباشرة على أطراف العقد، خصوصا فيما يتعلق بإثبات الضرر و بشروط الدعوى
الفقرة الأولى: قلب عبئ الاثبات
إذا تم تـوجيه الإخـطـار طبقـا للشـروط المـذكـورة أعـلاه فإنـه يكـون قـرينـة قـانـونية Présomption légal لصـالح المـرسل إليه تـدعمـه أمـام المحـكمـة مفـادهـا أن البضـاعـة لم تسـلم له طبقـا لمـواصفـاتهـا في سنـد الشحـن وأن النـاقـل البحـري مسـؤول عمـا لحق البضـاعـة من خسـائـر وأضـرار يتعيـن عليه تعـويضهـا.[13]
وهي قـرينـة لصـالح النـاقـل مـؤداهـا ان اسـتـلام المـرسل إليه البضـاعـة دون تحفـظـات يفـترض مـعه أنـه تسلمـهـا في الحـالة المـوصـوفـة لهـا في سـنـد الشحـن وبمفهـوم المخـالفـة فإن حـصـول إخـطـار في مـوعـده مسـتوفيـا لشـروطـه القـانـونيـة يشكـل قـرينـة على أن البضـائـع لم تسـلم على مـا نحـو هي مـوصـوفـة به في سنـد الشـحـن
الفقرة الثانية :سقوط الحق في الدعوى
يستشف من نص المادة 1200 مدونة التجارة الموريتانية أن المشرع قد نص على ضرورة تسجيل التحفظات في غضون سبعة أيام، وإذا لم يتم ذلك، يعد تنازلا عن الحق في رفع الدعوى ونتيجة لذلك فإن عدم تسجيل التحفظات في الفترة المحددة، يمكن أن يترتب عن ذلك عدم قبول الدعوى لجبر الضرر، هذا الخيار يطابق موقف المشرع المغربي في المـادة 262 من مدونة التجارة البحرية المغربية التي نصت على سقـوط كـل دعـوى ضـد النـاقـل من أجـل التـلف أو الضـياع الجـزئي إذا لم يبـادر المـرسل إليه أو المـرسل (الشـاحـن) أو أي شخـص يعـمل لحسـاب إحـداهمـا بإجـراء احتجاج معلل في ظـرف 8 أيـام من تـاريخ اليوم الذي وضعت فيه البضائع فعليا تحت تصرف المرسل اليه [14].
بـعـبـارة أخـرى، للـنـاقـل البـحـري الـدفـع بعـدم قبــول دعـوى المـرفوعة عـلـيـه إذا لم يـراع مسـتلـم البـضـاعـة الـقـواعـد الخـاصـة بـالإخـطـار عـن الأضـرار الـمـدعـى بـحـصـولهـا مما سيترتـب ع ضيـاع حـق الشـاحـنيـن أو المـرسـل إليـه في الحـصـول التـعـويـض المـنـاسـب عـلى الـرغـم مـن حـصـول الـضـرر فـعـلا، وعــدم تـقـادم دعـوى الـمسـؤوليـة ذاتـهـا.
وهو بلا شك خيار منافي للتوجهات الحمائية للموردين ويعرض مصالحهم لمهب الريح لا سيما إذا علمنا ان الشحنات البحرية عادة ما تكون معلبة و مقلفة ويستغرق إخراجها من الميناء مدة ليست بالقصيرة بسبب بطء الإجراءات الجمركية والأمنية مما يصعب معه التأكد من سلامتها فعليا داخل أجل سبعة أو ثمانية أيام .
الامر الذي يدفعنا للتساؤل حول مبررات هذ الجـزاء الشـديـد عـلى مسـتـلم البـضـائـع إذا لـم يـقـم بـإثـبـات واقـعـة الهـلاك أو التـلف في مـواجـهـة النـاقـل في الميعاد المحدد، بحـيث يتـرتـب عـلى تـخـلفـه بـإخـطـاره بـذلك عـدم قبـول دعــواه .
المطلب الثاني:اثار التحفظات بالنسبة للغير
إن النظام القانوني لعقد النقل البحري عرف تطورا لم يعرفه أغلب بقية العقود الأخرى، في مرحلة أولى كان التأمين البحري على البضائع اختيارا [15] لكن نظرا لعدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية انتهى بالتشريعات إلى إقرار وجوبية التأمين على البضائع، لمواجهة التأثيرات التي يتعرض لها الشاحنين أو المرسل إليهم في تعاملهم مع الناقلين البحريين ومصدري البلدان الأجنبية وعموما فان عقد التامين يرتبط ارتباطا وثيقا بعقد النقل و ينتج آثارا متداخلة تؤثر في التزامات وحقوق الأطراف المتعاملة ضمن عملية النقل
الفقرة الأولى: التزام صاحب البضاعة بالمحافظة على حقوق المؤمن
يجب تنفيذ عقد التأمين البحري على البضائع بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقضي به الأمانة والثقة في المعاملات.
فيلتزم المرسل اليه المؤمن له في حالة وقوع الحادث بخطأ من الغير أن يتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على حقوقه تجاه الغير المسؤول عن الحادث حتى يتسنى للمؤمن الحلول محلة[16]، وفي هذا نجد المادة 130 من مجلة التأمين الموريتانية تنص على أن المؤمن له يجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الضامنة لحقوقه ضدّ الآخرين وهو مسؤول تجاه المؤمن عن عدم القيام بهذا الواجب. كما تقرر المادة 20 من مدونة التأمينات المغربية على أنه على المؤمن له أن يتصرف تصرف الحريص على ماله وأن يحافظ على مصالح المؤمن و يتضمن ذلك الالتزام بإعلام المؤمن بزيادة الخطر وبوقوع الحادث والالتزام بالتخفيف من آثاره و بإبلاغه بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسؤولا ليقوم باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمعاينة البضاعة المؤمن عليها ومعرفة حجم الضرر الحاصل وتقدير التعويض
مما يوجب على المؤمن له الشاحن او المرسل اليه أن يتصرف تصرف الحريص على ماله وأن يحافظ على مصالح المؤمن ويتضمن الالتزام العام بالمحافظة على مصالح المؤمن الالتزام بإعلام المؤمن الخطر بزيادة الخطر وبوقوع الحادث والالتزام بالتخفيف من آثاره و أخيرا الالتزام بالمحافظة على حقوق الرجوع على الغير المسؤول
وترجع هذه الإجراءات إلى خصوصية التأمين البحري على البضائع والالتزامات المتبادلة التي تمكن المؤمن له من الحلول محل المؤمن له فيما لهذا الأخير من الحقوق والدعاوي ضدّ الغير نتيجة الخسائر والأضرار التي كانت سببا في ذلك الأداء
الفقرة الثانية: حلول المؤمن محل صاحب البضاعة
الحلول يعني إنزال شركة التأمين منزلة المؤمن له المتضرر في دعوى الحق والرجوع على المسؤول عن الضرر بالتعويض, ويقوم حلول المؤمن محل المؤمن له على أساس اتفاقي حيث تتضمن وثائق التأمين شرطا يفيد التزام المؤمن له بإحلالها محله في حقوقه ودعواه اتجاه الغير الذي تسبب في الضرر، وهو المسمى شرط الحلول لذلك تكتسب شركة التأمين حق الحلول بناء على شرط يضمنه عقد التأمين[17]
من الراجح فقها وقضاء هو تأسيس دعوى الرجوع على عقد النقل البحري لقيامها على إجراءات مستوحاة من دعوى المسؤولية التي يمارسها المرسل إليه ضد الناقل البحري وتتمثل هذه الإجراءات بالإدلاء بوثيقة الشحن الأصلية، إضافة إلى ضرورة القيام بالتحفظات القانونية.
وتحدد الخسائر بالنسبة لشركة التأمين عـن طـريق مراقب التلف أو الخبير ويشترط أن يكون مفوضي التلف وخبراء التأمين البحري حاصلين على خبرة 3 سنوات من الممارسة المهنية في الميدان.
وفي هذا الإطار يجب التمييز بين الخبير ومراقب الأضرار أو التلف ذلك أن المقتضيات القانونية للمشرعين قد تركت مجالا للخلط بين هاتين الوظيفتين، والحال أن مراقب التلف يختلف عن الخبير الأول يعتبر امتداد لشركات التأمين في الميناء ويقع عليه واجب حماية مصالح هذه الشركات عن طريق التدخل للحد من الأضرار والقيام بالشكليات الضرورية التي ستمكنها فيما بعد من ممارسة حقها في الرجوع على المتسبب بالضرر أما بالنسـبة للخبير فيتم اختياره لخبرته في مجال معين ويتم انتداب الخبير في المادة البحرية إما بصفة رضائية أو قضائية.
والملاحظ أنه وفي صورة احترام الخبير أو مراقب التلف للإجراءات المنصوص عليها كاستدعاء الطرفين لحضور معاينة الخسائر فإنه يكون لتقديره قيمة الاختبار، أما في حالة عدم قيامه بالإجراءات والشكليات كعدم استدعاء الطرفين للحضور فإنه لن يكون لهذا التقرير سوى قيمة إرشادات.
قائمة المراجع
- علي جمال الدين، “النقل البحري للبضائع”، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2003.
- يونس بنونه ،مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون المغربي دراسة مقارنة م اتفاقية هامبورغ،الدار البيضاء، المطبعة السريعة 1993
- يونس بنونه , إشكالية تطبيق اتفاقية هامبورغ امام القضاء المغربي,مجلة المحاكم المغربية عدد 6 يونيو 1992
- عادل علي المقداد ,القانون البحري ,ط 1 مكتبة الثقافة والنشر عمان 1999
- محمد كمال محمدي ,مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية,منشأة المعارف الإسكندرية 1995
- ايلي صفا ،,أحكام التجارة البحرية ,دار المنشورات الحقوقية بيروت ،2001.
- مصطفى كمال طه ، اساسيات القانون التجاري والقانون البحري، المركز القومي للإصدارات القانونية
- لطيف جبر كوماني .مسؤولية الناقل البحري ,الدار العلمية للنشر والتوزيع الأردن ط 2001.
- فرج توفيق حسن , أحكام الضمان في القانون اللبناني, بيروت 1 1977.
- عبد الودود يحي . الموجز في عقد التأمين ، دار النهضة العربية ، 2000
- R. Raudière et E. Dupontavice, «Droit maritime », précis Dalloz, ED, Dalloz, Paris, 12éme Edition.
- C.Scapel, les reformes apportées par les règles de Hambourg a la responsabilité du transporteur maritime, Revue SCAPEL, colloque du 12 novembre 1992 sur les règles de Hambourg, IMTM, 1993.
- Innocent fetez kamdem,la responsabilite du transporteur maritime de marchandises au niveau international,mémoire a i’univ Laval 1999
- Kerguelen Neyrolles ,lamy transport « commission de transport ventes internationales modes de paiement transport maritime ,,,, »paris sociétés Lamy 1999
.
-
علي جمال الدين، “النقل البحري للبضائع”، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2003، ط 2 ص 76.
-
C.Scapel, les reformes apportées par les règles de Hambourg a la responsabilité du transporteur maritime, Revue SCAPEL, colloque du 12 novembre 1992 sur les règles de Hambourg, IMTM, 1993.p 13
-
يونس بنونه , إشكالية تطبيق اتفاقية هامبورغ امام القضاء المغربي,مجلة المحاكم المغربية عدد 6 يويبيو 1992ص 131
-
يونس بنونه ،مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون المغربي دراسة مقارنة م اتفاقية هامبورغ،الدار البيضاء، المطبعة السريعة 1993 ص 216
-
عادل علي المقداد ,القانون البحري ,ط 1 مكتبة الثقافة والنشر عمان 1999 ص 156
-
محمد كمال محمدي ,مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية,منشأة المعارف الإسكندرية 1995 ط 1 ص 245
-
Innocent fetez kamdem,la responsabilite du transporteur maritime de marchandises au niveau international,mémoire a i’univ Laval 1999 P 130
-
ايلي صفا ,,أحكام التجارة البحرية ,دار المنشورات الحقوقية بيروت ط 1 2001 ص 67
-
Kerguelen Neyrolles ,lamy transport « commission de transport ventes internationales modes de paiement transport maritime ,,,, »paris sociétés Lamy 1999 P 990
-
صادقت عليها ، ودخلت حيز التنفيذ بالنسبة للمغرب في 1 نوفمبر 1992
-
المادة 19 من الاتفاقية
-
R. Raudière et E. Dupontavice, «Droit maritime », précis Dalloz, ED, Dalloz, Paris, 12éme Edition, p 214.
-
مصطفى كمال طه ’ اساسيات القانون التجاري والقانون البحري, المركز القومي للاصدارات القانونية .ط 1 ص 37
-
لطيف جبر كوماني .مسؤولية الناقل البحري ,الدار العلمية للنشر والتوزيع الأردن ط 1 2001. ص 105
-
فرج توفيق حسن , أحكام الضمان في القانون اللبناني, بيروت ط1 1977 ص 136
-
عبد الودود يحي . الموجز في عقد التأمين ، دار النهضة العربية ط 1 ص203
-
سعيد السيد قنديل ,المسؤوبية المدنية لشركات التأمين ,دار الجامعة الجديدة للنشر ط1 2005 ص32