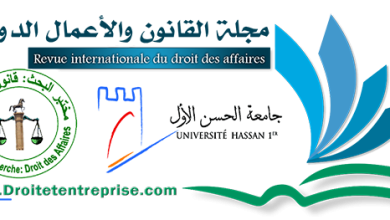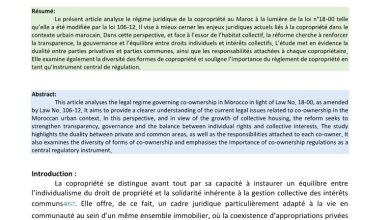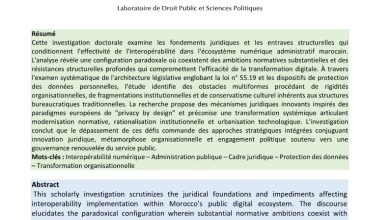نزعات إيديولوجية في التفاعل مع النصين الديني والقانوني – عبد الصمد نيت أكني

نزعات إيديولوجية في التفاعل مع النصين الديني والقانوني
إعداد: عبد الصمد نيت أكني
بسم الله الرحمان الرحيم
يتميز البحثان الديني والقانوني بكونهما مغيا بغاية معرفة حكم الدين والقانون في موضوع ما، اعتمادا على النصوص المرجعية فيهما، وتوسلا بمنهجية استنطاقها على نحو ما انتهى إليه علماء الحقلين من قواعد تخص الفهم، والاستنباط، والاجتهاد.
هذه القواعد بُنيت تراكميا على أسس معرفية لا دخل للذوات فيها؛ والمشكّكُ في معرفيتها محجوج بأدلة ليس هذا مقام بسطها، وتبدأ الإيديولوجيا في الظهور من عدمه حينما يريد الباحث استثمار هذه القواعد في الموضوع، وتنزيلها على حيثياته، فقد يكون موفقا في تنـزيه فعله التنزيلي عن الإيديولوجيا، وقد يكون غير موفق في ذلك، والقولُ الفصل هنا للقارئ الناقد لا غير.
وقبل الشروع في بسط تجليات الإيديولوجيا في التفاعل مع النصين الديني والقانوني، لابد من التأكيد على أن المقصود بالباحث هنا غير الفقيه الأصولي في الحقل الديني، وغير المشرع والفقيه والقاضي في الحقل القانوني، وإنما المقصود بالباحث في هذه المقالة غيرهم ممن يسهل تطرق الأدلوجة إلى فعلهم البحثي فيما يتصل باستكناه دلالات النصوص؛ بسبب عدم خبرة الباحث المراد هنا نظريا وعمليا بالأصول المعرفية للتفاعل مع النصين الديني والقانوني إلى حد يمكن له التحكم في فعله البحثي من أن تتسرب إليه النزعات الإيديولوجية.
وفيما يلي بسط بعض هذه النزعات الإيديولوجية في علاقتها بالنصين الديني والقانوني من باب التمثيل لا الحصر.
1- النزعة التعسفية
ومعناها هنا وقوع الباحث في وضعية يستدعي فيها نصوصا دينية أو قانونية بعيدة عن الموضوع، محاولا إظهارها كأنها مناسبة له، والحالُ أنه مزيِّف سواء أ شعر بذلك أم لم يشعر، ولا يُغني كونه حَسَنَ النية في فعله البحثي ليرفع عنه تهمة الأدلوجة؛ إذ الأخيرة تنزّل بغض النظر عن نيات الباحث، وقصوده.
ويرجع سبب هذا التعسف إما إلى ضعف المتعسِّف معرفيا ومنهجيا، وإما إلى تضخم أناه على حساب ما يفرضه وضع الموضوع من ضرورة خلوص النية من لوثة التمركز الذاتي، وإما إلى غاية ذاتية يسعى إلى التبشير بها بتوسلات معرفية، وهذا السبب الأخير في غاية الخفاء، والاندلاس.
وفي جميع الأحوال؛ فالتعسف في إسقاط النصوص على غير محالها، وإخراجها عن أسيقتها، ولَيّ أعناقها، وعدم فهم أجزائها في إطارها الكلي نوع من الأدلوجة التي تعبّر -في الأخير- عن حكم الباحث في الموضوع، لا عن حكم الدين أو القانون فيه.
2- النزعة الانتقائية
ومعناها عدم استقراء الباحث جميع النصوص الدينية أو القانونية ذات الصلة بالموضوع، مكتفيا ببعضها، ومقصيا لغيرها، فإن كان واعيا بٱفتي الاكتفاء والإقصاء فالأدلوجة في ذلك غير مبهمة، وإن كان غير واع بتنيك الٱفتين فعدم قصديته لا تشفع له لئلا يوصف فعله البحثي بالأدلوجة، وقد اتُّهم بالأدلوجة لهذه العلة الكبار ممن قطعوا من بوادي المعرفة أميالا كثيرة، فكيف بصغار الباحثين !
ومن الانتقائية كذلك بتر النص، والاكتفاء بجزء منه على منهج «لا تقربوا الصلاة» [سورة النساء، من الآية: 43]، وعلى مذهب الشاعر حين قال:
دع المساجد للعباد تسكنها ** وسر إلى حانة الخمار يسقينا
ما قال ربك ويل للألى سكروا ** وإنما قال ويل للمصلينا
ومن الانتقائية كذلك عدم رعي الهرم التشريعي في فهم النص الديني والقانوني، فيجعل مراتب النصوص مرتبة واحدة، ويسوّي بين دلالات ألفاظها.
ففي الاكتفاء إقصاء، وفي الإقصاء اكتفاء، وفي الإظهار إخفاء، وفي الإخفاء إظهار، وكل ذلك أدلوجة سافرة لا تشتبه وجوهها على من شُهِد له بالخبرة في تقويم البحوث وفق ثنائية الإيديولوجي والمعرفي.
3- النزعة التسويغية
ومعناها تبرير موضوع ما، والسعي إلى مجرد إقناع المتلقي والتأثير فيه، باستثمار النصوص الدينية أو القانونية بطريقة منظّمة، تدفع السُّذَّج من القرّاء إلى التسليم الأعمى لنتائج البحث.
وليس كل تبرير أدلوجة، فقد يسوِّغ الباحث نتائج موضوع ما اتفق علماء الحقل الذي ينتمي إليه الموضوع على معرفية نتائجه، لكن قد يحدُث أن يُشكَّك في معرفيتها لحاجة في نفس يعقوب؛ فيصير المسوِّغ مقررا لأمر مجمع عليه، دفعا لأدلوجة المشككين.
فالمقصود بالتسويغ هنا ما كان غرضه التضليل، والتوهيم، والخداع، بأسس يظنها الٱخر معرفية، والحالُ أنها غير بريئة عند النظر فيما وراء المسوِّغات من نزعات ذاتية تشم ولا تفرك، لدقتها، وتعقدها.
هذا المسوِّغ يعرف الحق في الموضوع، وإنما يحتال في تبرير تزييفه على النحو الذي قد يرضي الغَرير، بتوظيفه قدسية النص (الدين) أو إلزاميته (القانون)، وصرفهم بطريقة ما عن إعمال النظر فيما قاله الشارع أو المشرع، وفي مدى مناسبته للموضوع من عدمه، أو بتأوُّل بعض القواعد تأولا يبشر بالفهم الذي يريده الباحث، كتأوّل قاعدة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال؛ لتغييب دلالة ما قد يكون لها وجه قوي ومعتبر، وكتأوّل قاعدةِ دستوريةِ تصديرِ الدستور لجعلها دليلا على صحة الفهم، والحالُ أن صفة الدستورية للتصدير لا يلزم منها كون فهم الباحث لما تضمنه من نصوص دستوريا.
4- النزعة المصلحية
ومعناها تطويع النص الديني والقانوني ليوافق مصالح الباحث، وتطلعاته، دون الالتفات إلى مقاصد الشارع والمشرع في حالة تعارضها مع أهدافه الذاتية، وحالُ المتلبس بهذه النزعة أنه يحسم ابتداء في نتائج البحث بما يوافق مصلحته، ثم يشرع في التدليل لها باستدعاء ما يناسبها من نصوص، وفهوم، ويظهر ذلك -مثلا- في تطلع الباحث -لمصلحة ما- إلى جزاءات معينة في موضوع محدد.
وفي هذه النزعة اجتمع ما تفرق في غيرها، ففيها تعسف، وانتقاء، وتسويغ، إلا أنها تزيد على غيرها بكون الباحث يتغيا -عن قصد- من ذلك مصلحة معينة، ولهذا تفردت هذه النزعة بالتضليل الواعي والقصدي، في حين تحتمل باقي النزعات التزييف القصدي وغير القصدي.
ودركُ هذه النزعة مسلك ممتنع في حقّ من لم يستوف شرائط التأهل للنقد، والتقويم.
5- النزعة الشمولية
ومعناها هنا التشبث بضرورة إخضاع النص الديني والقانوني لمنهج تفسيري أحادي يضمن وحده خلوص الفهم والتفسير من أي ميل إيديولوجي.
ومقتضى هذه النزعة فرض منهج واحد به يفسر النصين، وتجاوز ما سواه من المناهج التفسيرية التي تكوثرت داخل الحقلين الديني والقانوني، وهي عقيدة إيديولوجية لا ترى إلا نفسها، ولا تقبل تفسيرا إلا ما أتى من باب منهجها المرتضى.
ومثال ذلك في الحقل الديني سعي المبجِّل للعلم التجريبي إلى تبيئته فيه، بدعوته إلى استثماره في تفسير النص الديني طلبا للحياد، ووصولا إلى موضوعية العلوم الطبيعية، ولا خفاء فيما في هذا السعي من تجاوز دلالات كثيرة للنصوص لعدم مناسبتها لمنهج العلم الأمپيريقي، ولهوى ذي الإيديولوجيا العلموية.
ومثال ذلك في الحقل القانوني مذهب الشرح على المتون أو الالتزام بالنص، الذي يقوم “على فكرة التوسع في تفسير القانون، وبذل الجهد في معرفة مقصوده حتى تستوعب نصوصه كافة القضايا، والوقائع، وكل عجز في بيان حكم القانون يرجع فيه اللوم إلى المفسّر لا إلى التشريع”(1)، وفي هذا المذهب شمولية تتجلى في كونه يعتقد أن “النصوص التشريعية قد احتوت كل القواعد القانونية ولم تهمل شيئا منها، ومن أجل هذا فإنه ينبغي للفقيه أن يستعرض هذه النصوص، ويفسرها نصا نصا، فإذا ما فشل في استخلاص قاعدة منها؛ فإن العيب في ذلك لا يكون مرجعه إلى التشريع الذي يتضمن كل القواعد القانونية، وإنما يكون مرجعه إلى عجز الفقيه وعدم توفيقه في استخلاص القاعدة القانونية من النصوص التشريعية”(2)، وقد عبر عن هذه العقيدة الشمولية فقيه فرنسي بقوله: ” إن الشعار الذي أرفعه، والعقيدة التي أومن بها، هي النصوص قبل كل شيء”(3).
وقد رُد على هذه العقيدة التقليدية، وبُيّن أوجه فسادها التي من بينها ٱفة التقديس(4).
إن نشدان النزاهة من مداخل الإيديولوجيا عند التفاعل مع النصين الديني والقانوني ليس بالأمر الهين كما قد يتوهم؛ وذلك لما للإيديولوجيا من دلالات موسعة تشمل كذلك ما يلقي به اللاشعور للباحث من أفكار يصنفها القارئ الناقد من قبيل النزعات الإيديولوجية التي أوحيت إلى الباحث بطريق خفي، في الوقت الذي يعتقد فيه هذا الأخير تمحض فعله البحثي لصالح المعرفي.
وحسبُ الباحث معرفة أنّ من الكبار مَن رُمي بالأدلوجة رغم ذيوع صيتهم في مجال البحث، وعلوّ مكانتهم بين الباحثين، وهذه حقيقة “بيضاء لا يُدْجِي سَناها العِظْلِمُ” كما يقال.
والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش:
1)- أحمد محفوض، بلقاسم لالا، الدلالات الأصولية وتطبيقاتها في تفسير النص القانوني دراسة مقارنة، (ص: 6)، السنة الجامعية: 2021-2022م.
2)- إبراهيم أبو الغار، علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي، (ص: 70)، مكتبة نهضة الشرق جامعة القاهرة.
3)- إبراهيم أبو الغار، علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي، (ص: 70).
4)- ينظر: إبراهيم أبو الغار، علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي، (ص: 71).