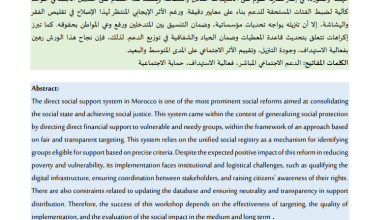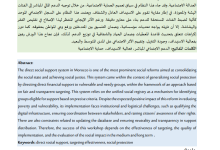التكنولوجية والدبلوماسية الحضارية رؤية لعالم بلا حواجز الباحثة : كريمة بلِّش
التكنولوجية والدبلوماسية الحضارية رؤية لعالم بلا حواجز
الباحثة : كريمة بلِّش
باحثة في سلك الدكتوراة تخصص الدراسات السياسية والعلاقات الدولية
جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – أكدال الرباط












التكنولوجية والدبلوماسية الحضارية رؤية لعالم بلا حواجز
الباحثة : كريمة بلِّش
باحثة في سلك الدكتوراة تخصص الدراسات السياسية والعلاقات الدولية
جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية – أكدال الرباط
الملخص
مع التحولات العالمية المعاصرة، أصبح التصدي للتحديات الإقليمية والدولية ضرورة ملحة، خاصة في سياق الثورة التكنولوجية الحديثة وما عقب الحرب الباردة من ظهور نظام عالمي جديد يرتكز على مبادئ العولمة. يُروج هذا النظام لمفاهيم موحدة اقتصاديًا وثقافيًا، لكنه يضع ضغطًا كبيرًا على الهوية والقيم العربية والإسلامية، مما يثير تساؤلات جوهرية بشأن حماية الهوية الثقافية في خضم هذه المتغيرات.
ولمواجهة هذه الضغوط، بادرت العديد من المجتمعات العربية والإسلامية إلى إطلاق نقاشات موسعة، تسعى إلى بلورة حلول تعالج الإشكالات القائمة دون التضحية بالموروث الثقافي والديني. هذه النقاشات تركز على مفهوم “الدبلوماسية الحضارية” كوسيلة للتفاعل والتعاون دون المساس بالقيم الجوهرية، مما يتيح الإنفتاح المتوازن والمدروس على الآخرين.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى إستراتيجيات متكاملة تُمكن الأجيال الصاعدة من الإندماج الواعي في عصر التكنولوجيا، مع الحفاظ على قيم المجتمع وهويته. فالتوفيق بين الأصالة والمعاصرة يتطلب توجيه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا بشكل يخدم الأهداف الثقافية والإجتماعية، ويُدعم البناء المعرفي للأمة.
فعلى الرغم من تزايد الدعوات لحوار الحضارات، فإن التأثير السياسي والعقائدي على مفهوم هذا الحوار يبقى حاضرًا بقوة، ما يجعل مستقبل الدبلوماسية الحضارية مرتبطًا بآليات العولمة والنظام العالمي القادم.
في هذا السياق، تقدم الدبلوماسية الحضارية رؤية استباقية تسعى إلى تعزيز التفاهم والتعايش، حيث تقوم بدور مساند للدبلوماسية التقليدية عبر معالجة التغيرات التي طرأت على النظم العالمية.
الكلمات المفتاحية: الدبلوماسية الحضارية، الثورة التكنولوجية، حوار الحضارات، العولمة، المشترك الإنساني.
Technological and civilizational diplomacy is a vision for a world without barriers.
Karima Belliche
PhD Researcher Specializing in Political Studies and International Relations
Mohammed V University Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Agdal, Rabat
Abstract
In light of contemporary global transformations, addressing regional and international challenges has become an urgent necessity, particularly in the context of the modern technological revolution and the post-Cold War emergence of a new world order centered on globalization principles. This system promotes unified economic and cultural concepts but imposes significant pressure on Arab and Islamic identity and values, raising fundamental questions about safeguarding cultural identity amidst these changes.
In response to these pressures, many Arab and Islamic societies have initiated extensive discussions aimed at formulating solutions that address existing challenges without compromising their cultural and religious heritage. These discussions focus on the concept of “civilizational diplomacy” as a means of fostering interaction and cooperation while preserving core values, thereby enabling a balanced and deliberate openness to others.
This highlights the need for comprehensive strategies that empower future generations to integrate consciously into the technological era while preserving societal values and identity. Striking a balance between authenticity and modernity requires steering modern technologies in ways that serve cultural and social objectives and support the nation’s knowledge development.
Despite the growing calls for dialogue among civilizations, political and ideological influences on this concept remain strong, making the future of civilizational diplomacy closely tied to the mechanisms of globalization and the emerging global order.
In this context, civilizational diplomacy offers a forward-looking vision that seeks to promote understanding and coexistence, complementing traditional diplomacy by addressing the changes affecting global systems.
Keywords: Civilizational Diplomacy, Technological Revolution, Dialogue of Civilizations, Globalization, The human commonality.
مقدمة
إن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية باتت ضرورة ملحة في عصر الثورة التكنولوجية الحديثة، لاسيما بعد انتهاء الحرب الباردة وظهور نظام عالمي جديد قائم على مبادئ العولمة. هذا النظام يقدم أطروحاته ضمن إطار ثقافي واقتصادي موحد، ولكنه في الوقت ذاته يفرض ضغوطاً على الأمة العربية والإسلامية فيما يتعلق بهويتها وتقاليدها وأخلاقياتها. هذه التحديات تمثل قضية بالغة الأهمية والحساسية، وتثير قلقاً واسعاً بين المفكرين والعلماء، خاصةً في ظل محاولات التأثير على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات.
من أجل التصدي لهذا الواقع، شهدت العديد من المجتمعات العربية والإسلامية نقاشات موسعة وحوارات مفتوحة تهدف إلى إيجاد حلول واقعية وفعالة[1]. تتمحور هذه الحوارات حول حماية الهوية الوطنية مع الحفاظ على خصوصيتها الثقافية والدينية، والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إنفتاح إيجابي ومدروس على الآخر. هذا الإنفتاح يسعى لتحقيق ما يعرف بـ”الإتصال الثقافي”، وهو وسيلة للتفاعل والتعاون الثقافي دون تجاوز الخط الفاصل الذي قد يؤدي إلى صدام أو تنازل عن القيم الجوهرية.
وفي ظل هذه النقاشات، تبرز أهمية صياغة إستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تمكين الأجيال الصاعدة من الإنخراط في حضارة العصر الحديث بثقة ووعي. يتطلب ذلك العمل على تحقيق توازن بين الأصالة والمعاصرة، بحيث يتم الحفاظ على قيم المجتمع وهويته بالتوازي مع التعامل البناء والإيجابي مع التقنيات الحديثة وتكنولوجية المعلومات والإتصال.
من جهة أخرى، فإن التعامل مع الثورة التكنولوجية ينبغي أن يأخذ بعين الإعتبار التحدي الأكبر الذي تمثله الفجوة المعرفية بين دول الشمال المتقدم والجنوب النامي. هذه الفجوة تضاعفت بفعل الإنفجار المعلوماتي[2]، مما جعل من الضروري وضع سياسات وطنية وإقليمية لتطوير قدرات المجتمعات على الإستفادة المثلى من هذا التدفق الهائل للمعلومات.
وفي هذا الإطار، يصبح الهدف الأساسي هو تعزيز الهوية الوطنية، مع تمكين الأجيال الجديدة من دخول عالم التكنولوجيا بثقة ووعي، وتوفير الأدوات اللازمة لبناء مستقبل أكثر أماناً وفاعلية وأصالة، مع ضمان تحقيق توازن مستدام بين الإنفتاح والحفاظ على القيم المجتمعية.
وعلى الرغم من الدعوات المتعددة إلى حوار الحضارات، ما فتئت الرؤية الفكرية الخاصة المتمثلة بالأفكار السياسية هي التي تصنع مفاهيم الحوار[3]، بغض النظر عن العقيدة الفكرية الجماعية للمجتمعات التي تمثلها هوياتها الثقافية الخاصة، علاوة عن إمكانيات القوة التي تلقي بظلالها على الحوار ومساراته. ويظل مستقبل الدبلوماسية الحضارية مرتبطا بتشكيل النظام العالمي خلال المراحل القادمة، التي سيكون لها تأثير بالغ في تحديد مسار الحوار من خلال منظومة العولمة وآلياتها.
ومن هذا المنطلق، فالدبلوماسية الحضارية[4] كمفهوم مستجد، يتميز بنزعته المستقبلية عن طريق توظيفه لبناء مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، إذ ينظر إلى أن هنالك تغيرا كبيرا في البنية الحضارية الدولية، على مستوى السياسات والعلاقات الدولية ويقول بأن حالتي السلام والصدام كلاهما حالتان حضاريتان بامتياز، ويعبران عن أبعاد حضارية وأمداد ثقافية تعتمد فيها على الباعث الديني والإقتصادي والسياسي في المدى الإستعماري سابقا، والذي كان يحرك التعاملات الحضارية.
وبالتالي فهو أكبر من كونه مشروعا مرحليا أو آنيا، بل هو رؤية لمستقبل إنساني أفضل، ومن هذا المنطلق تبلورت فلسفة الحوار الحضاري، المتمثلة في العثور على أرضية مشتركة للتفاهم والتلاقي بين الأمم ذات الهوية الثقافية المختلفة.
فالحضارة[5] الآن بكل تجلياتها وتفرداتها أضحت تقدم نفسها من مناطق مختلفة، تؤكد على أن هنالك تسابقا نحو رؤية كونية واحدة موحدة تهدف إلى تحقيق السلم والسلام العالمي، وهذا هو التغير الأساسي في البنى الحضارية الحالية.
ومما لا شك فيه، أن الدبلوماسية الحضارية كمفهوم لا يعتبر بديلا للدبلوماسية التقليدية، ولكنه انبثق ليساعد هذه الأخيرة ويعي بأن هناك تغيرا وتحولا يطال الدبلوماسية التقليدية من منطلق التحول الذي حدث في المنتظم الحضاري.
فالمتغيرات والمستجدات الدولية تحي بأن العالم أصبح يتأثر بنفس القضايا على سبيل المثال (فيروس كورونا، قضايا المناخ، الحروب…) وعليه فكلنا نتأثر بذات المؤثرات، ومن هذا المنطلق يجب على الحضارة أن تكتشف ذاتها في هذا المنتظم الكبير، لأن الحضارة الإنسانية هي حضارة شريفة في أصلها لا تلغي الخصوصيات ولا تلغي الثقافات ولا المعتقدات.Haut du formulaire
وبالتالي، إن أي فكر أو فلسفة مهما كانت لا يمكن أن تنبع من فراغ، بل هي تعبر بالضرورة عن أيديولوجية جماعة أو طبقة أو شعب معين، ولذلك فإن الدبلوماسية الحضارية كانت معبرة تماما عن التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وذلك للعودة بالممارسة الدبلوماسية إلى مداخل جديدة تساهم في الغاية الفضلى للعيش المشترك، وتكريس مبادئ السلم والتعايش والحوار وتثمين قيم التعاون والتبادل والتفاهم، لتجعل من الإجتهاد في بلورة مفاهيم علمية جديدة وآليات عملية ناجزة، أمرا ملهما في مواكبة التطورات الدولية، وتحقيق الإنتقال بها نحو الأفضل.
Bas du formulaire
ومن خلال هذه الورقة سنركز على دور الدبلوماسية الحضارية في تحقيق السلام العالمي، وتدبير الأزمات، وجلب الإستثمارات، وتقديم صورة مشرقة للحضارات والثقافات لمختلف الدول من خلال إظهار الجوانب الإيجابية من الإختلاف وقبوله، حيث أن الحضارات وجدت للتكامل والحوار لا للتنافر والصراع، كل هذا في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة.
لا شك أن محاولة دراسة مثل هذا الموضوع ليس بالأمر اليسير، أولا: نظرا لجدة المفهوم، ثانيا: لحيوية جهازه المفاهيمي، وبالتالي أين يمكن تصنيفه؟ هل في حقل العلاقات الدولية، أو العلوم الإنسانية، أو الدراسات الإسلامية؟
لكن دوافع اختيارنا لهذا الموضوع أقوى من هذه العقبات ويمكن حصرها في نقطتين رئيسيتين:
السبب الأول: هو محاولة تبيان أن الدبلوماسية الحضارية لا تقدم نفسها وصيفا لمفهوم الدبلوماسية الثقافية، أو الرقمية أو الروحية، وإنما هناك مكمن عملي تحاول هذه الرؤية أن تقدمه عبر مفهومها، وتسعى من خلال هذا المستوى العملي إلى التقارب مع الدبلوماسية العامة، لتأسيس شبكة عالمية للدبلوماسية الحضارية؛ وهذا هو مناط الإطار العملي، الذي يتمثل في الإجابة عن أسئلة من قبيل: كيف يمكن التأسيس؟ وما هي الفلسفة؟ وما هي القضايا؟ ومن هم الفاعلون الرئيسيون؟.
السبب الثاني: هو أن طرح هذا المفهوم يأتي كمساهمة في توظيف المشترك الحضاري الإنساني لإرساء سلوك دولي يدعم تحقيق التنمية الإنسانية، وينبذ الحروب[6]، ويتيح تعزيز التضامن الدولي، والتنسيق الجماعي لمواجهة الكثير من الإشكالات التي تُهدّد البشرية جمعاء.
هذه الرؤية أثارت نقاشات مكثفة حول مفهوم الدبلوماسية الحضارية كبديل أكثر إستدامة للتعامل مع التحديات الناشئة عن إختلافات الهويات الثقافية. فقد جادل منتقدوا هنتغتون بأن الثورة التكنولوجية ليست فقط محركاً للصراع، بل يمكن أن تُستخدم كأداة فعالة لتعزيز الحوار والتفاهم الثقافي العالمي، من خلال تسهيل التفاعل بين الثقافات وتشجيع التعاون الإنساني المشترك.
واستنادا إلى ما سبق نطرح الإشكالية التالية:
كيف تسهم الثورة التكنولوجية في توظيف المشترك الحضاري الإنساني لتعزيز الحوار والتفاعل بين الثقافات في إطار ما يعرف بالدبلوماسية الحضارية؟
تنبثق من هذه الإشكالية الرئيسية أسئلة فرعية من قبيل:
- ما هي منطلقات الصراع الحضاري؟
- وما هي العلاقة بين الثورة التكنولوجية وصراع الحضارات؟
وعلى هذا الأساس نضع الفرضيات التالية:
- نفترض أن توظيف الثورة التكنولوجية في الدبلوماسية الحضارية يحتاج إلى إستراتيجية شاملة تُركز على تبني ثقافة التفاعل الإيجابي بين الشعوب، وإبراز القيم المشتركة مع احترام التنوع.
- يمكن للثورة التكنولوجية أن تسهم في تقديم نموذج عالمي يوازن بين احترام الهويات الثقافية المحلية والإنفتاح على الحوار الثقافي عبر المنصات الرقمية.
ولا يفوتنا أن ننوه أن موضوعا مثل هذا واسع جدا، ولا يمكن تناوله من مختلف الجوانب، خاصة أنه يتعرض لمفهوم الحضارات الكبرى التي تقوم أساسا على الديانات السماوية الثلاث (الإسلام، المسيحية، اليهودية) وخصوصية كل واحدة منها، علاوة إلى ذلك فإن تاريخ الحضارات بين الشعوب طويل جدا ومليء بالأحداث، لذلك سيقتصر مجهودنا المتواضع على تناول الموضوع من ناحية العلاقات الدولية[7].
ولذلك يجب الأخذ بالحسبان أن ما سنحاول توضيحه من خلال هذه الورقة، هو أهمية الدبلوماسية الحضارية بالنسبة لحوار الحضارات[8] ودور الثورة التكنولوجية في تقريب وجهات النظر ونبذ كل أشكال العنف والصراع، حيث أن عدم تقبل الخلافات هو الباعث الأول لزرع الخلافات وتفاقمها، كما أن مشاكل الصراع بين الحضارات لا يقف عند تناطح وتصادم الأفكار، بل ينعكس على قضايا وطنية وإقليمية ودولية مختلفة، مثال على ذلك (الحرب الروسية الأوكرانية، قضايا البيئة والإقتصاد، وهيمنة صناعات الدول الكبرى وتأثيرها على الدول النامية وحضارات أخرى..).
ولإثبات صحة الفرضيات المذكورة أعلاه سنستعين بالمنهج التحليلي والمنهج الوصفي، أما المنهج التحليلي سيساعدنا في تحليل المحتوى والمقاربات لفهم التغيرات[9] الحالية التي تشهدها الساحة الدولية والتي تسعى الورقة لتحليلها.
أما المنهج الوصفي سنوظفه لتوصيف المفهوم محل الدراسة، وهذا يستوجب جمع المعلومات حول المفهوم المراد دراسته والإهتمام بصقله ووصفه وصفا دقيقا، وقد تم توظيف هذا المنهج في هذه الدراسة من خلال وصف المتغيرات، خاصة متغيرين أساسيين (المشترك الحضاري والسلوك الدولي).
من أجل وضع هذا العمل بين يدي القارئ، قمنا بتقسيم الورقة إلى ثلاث محاور:
أولا: توظيف المشترك الحضاري: من إدارة الصراعات إلى تعزيز الدبلوماسية الحضارية
ثانيا: الثورة التكنولوجية: أداة لتعزيز الحوار الحضاري والعلاقات الدولية
ثالثا: من الفضاء الرقمي إلى الحوار الحضاري: آفاق جديدة للعلاقات الدولية.
المحور الأول: توظيف المشترك الحضاري: من إدارة الصراعات إلى تعزيز الدبلوماسية الحضارية
أدى إنهيار الإتحاد السوفييتي وسقوط المعسكر الشيوعي إلى إنتشار فكرة مفادها أن النموذج الليبرالي الديمقراطي قد إنتصر، وأن إنتصاره ليس ظرفيا بل نهائيا، وهذا التوجه عبرت عنه أطروحة الأمريكي ذو الأصل الياباني فرنسيس فوكوياما في كتابه “نهاية التاريخ وخاتم البشر”[10].
وبرزت في نفس الفترة فكرة “النظام العالمي الجديد”[11]، الذي سيكون فيه للولايات المتحدة الأمريكية دور في قيادة العالم إلى مستقبل أفضل، وقد ربط هذا المفهوم بجملة من القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية العليا، مثل الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنمية، والإستقرار، واحترام القانون الدولي[12].
وقد صرح في هذا الإتجاه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران في ندوة عقدتها اليونسكو سنة 1994 قال فيها: “إن ما نحتاج إليه هو عقد إنمائي بين الشمال والجنوب، ورؤية عالمية واحدة للتنمية على غرار الرؤية العالمية للبيئة التي أفرزتها قمة ريو دي جانيرو”[13].
كما دعت بعض المؤسسات الخاصة على هامش إجتماع البلدان الأكثر تصنيعا في العالم بمدينة نابولي بإيطاليا في يوليو 1994، إلى بلورة تصور “من أجل عقد إجتماعي” وقد جاء في هذا التصور “أن العالم الذي نعيش فيه اليوم في حاجة لمؤسسات جديدة تعنى بالتنمية الإجتماعية والعالمية وهي تتكون من دمج المنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة العمل الدولية”[14].
من جانب آخر تمت الدعوة إلى ضرورة مشاركة المواطنين في التنمية البشرية الذي أعلن عنه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية لعام 1993، مما يؤكد ضرورة بناء مفاهيم جديدة لتنمية بشرية دائمة تنسج التنمية حول الناس لا الناس حول التنمية[15].
فالتعايش بين الثقافات المتنوعة في العالم يعد إحدى القضايا المحورية التي ينبغي أن تكون مصدر إلهام لبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب، بدلاً من أن تتحول إلى مصدر لصراع بين الحضارات. فالتنوع الثقافي ليس مبرراً للخلاف، بل فرصة لتعزيز التفاهم المشترك واحترام التعددية.
ومع ذلك، شهدت الساحة الدولية تبني بعض الأفراد أو الأطراف لخطابات تحريضية تعزز النعرات العنصرية بهدف تحقيق مكاسب آنية، سواء كانت سياسية أو انتخابية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الخطاب الذي إستخدمه دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، خلال حملته الإنتخابية السابقة. فقد عمد ترامب إلى إطلاق تصريحات إستفزازية ضد المسلمين في بعض الأحيان، وضد المكسيكيين في أحيان أخرى، مستهدفاً إستقطاب شريحة معينة من الناخبين على حساب مبادئ التعايش وقيم العدالة الإجتماعية[16].
إن مثل هذه الخطابات لا تخدم إلا تأجيج الفجوات الثقافية وتعميق الخلافات بين المجتمعات المختلفة، في حين أن التحديات العالمية الراهنة تستدعي التكاثف والعمل المشترك لتعزيز الإنسجام بين الثقافات، ونبذ كل أشكال العنصرية والتمييز، بما يُسهم في تحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا لجميع الشعوب.
فرغم تعدد الثقافات واختلافاتها، إلا أننا جميعًا ننتمي إلى حضارة واحدة، وهي حضارتنا التي نعيشها في العصر الحالي، على غرار ما عاشته البشرية في فترات تاريخية سابقة من حضارات مختلفة. وبالرغم من أن الحضارة قد تُعتبر موحدة تحت مفهوم شامل، فإنها تحمل في طياتها تباينًا واختلافًا بين فروعها المتعددة، حيث تمثل هذه الفروع الهويات المتنوعة التي تنتمي إليها شعوب وأمم متعددة، تتفاوت ثقافاتها ولغاتها وأديانها، وهذه الإختلافات تشكل أحد أبرز سمات الحضارة البشرية.[17]
وبالحديث عن هذه الإختلافات، يُبرز مفهوم “حوار الأديان”، وأحيانًا “حوار المذاهب”، الذي قد يُظهر تقاربًا أو صراعًا بين الأديان والمذاهب، وبالطبع، يبقى الفارق المشترك بينها هو التنوع والإختلاف. فهذه الإختلافات تظهر نتيجة لاجتهادات بشرية في معالجة قضايا دينية وفقهية متعددة، على مر الزمن.
ومع مرور الزمن وتراكم الفكر، نشأت رؤى وأفكار متنوعة حول هذه القضايا، فبعضها كان يسعى لتقريب المفاهيم الدينية، بينما كان البعض الآخر بعيدًا عنها، حيث دخلت عليها عادات وتقاليد، أو حتى بعض المثيولوجيات، بالإضافة إلى تأثيرات الحكام أو الفقهاء أو آخرين. وهكذا، قد يكون هناك تباين واسع بين الأهداف والمقاصد الأصلية التي كانت قائمة في بداية الأمور، وبين التشوهات التي وصلنا إليها في العصر الحديث.
هذا الموضوع يمتد في مسار طويل، سواء في الماضي البعيد أو في الحاضر، بل وحتى في المستقبل. ويتجلى هذا التأثير بوضوح في ظل العولمة وثورة العلوم والتكنولوجيا الحديثة، ولا سيما ما يرتبط منها بثورة الإتصالات ووسائل المواصلات، إضافة إلى التطور الكبير في تقنيات الإعلام والمعلومات وظهور عصر الطفرة الرقمية. وقد كانت الأفكار والمعتقدات على مر العصور تجد طريقها للتلاقح والإنتقال بين الشعوب. ويمكن إيضاح ذلك من خلال الحديث عن “طريق الحرير”، الذي لا يعد مجرد ذكرى تاريخية، بل هو إشارة لحركة مستمرة للثقافات عبر الزمان والمكان، التي تدفع عجلة التبادل الثقافي والتأثير الحضاري بين مختلف الأمم[18].
وكان لكل من الإسلام والمسيحية، بشكل خاص، دور أساسي ومؤثر في تشكيل هذا التفاعل الثقافي بين الشعوب، حيث ساهمت هاتان الديانتان بشكل كبير في التأثير على الحضارة الإنسانية الكونية، بحيث يمكن وصفها بأنها حضارة واحدة توحد بين التنوع والتعددية، فكل واحدة من هذه الأديان قد لعبت دورًا محوريًا في امتزاج الثقافات والتبادل الفكري بين شعوب الأرض، وتشكيل أسس التفاهم المتبادل والنمو الثقافي على الصعيدين المحلي والعالمي.
فالعالم اليوم يمر بمرحلة حرجة، إذ يعيش متغيّرات ومستجدات كثيرة، أنتجت تحديات وصراعات عديدة، وامتدت تلك الصراعات في جميع أنشطة الحياة، الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وأخطرها التحديات الفكرية والثقافية، حيث إكتسب مجال العلاقة بين الحضارات زخما كبيرا خاصة مـع طـرح صموئيل هانتنجتون الشهير المعروف “بصدام الحضارات” لتعيد النقاش مرة أخرى حول مستقبل العلاقات بين الدول وطبيعتها.
فحسب هذه الأطروحة فإن “عالم ما بعد الحرب الباردة لن تكون فيه أكثر الصراعات إنتشارا أو أهمية وخطورة بين طبقات إجتماعية غنية وفقيرة أو جماعات أخرى على أسس إقتصادية ولكن بين شعوب تنتمي إلى هويات ثقافية مختلفة”[19].
في هذا السياق، وفي خضم النقاش الدولي الذي بات يعرف مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، ولما كانت السياسة الخارجية للدول مجالا لتفاعل البحث العلمي دوليا، سواء من قبل الفلاسفة أو فقهاء علم السياسة أو العلاقات الدولية، أو من قبل مراكز الأبحاث ذات الإهتمام بهذا المجال، بادرت منظمة الإيسيسكو إلى جانب أساتذة جامعيين وأكاديميين ومثقفين، بخلق مفهوم علمي قيد التشكل، فاليوم نحن أمام مسألة لم نتعود عليها هي أننا نساهم في صناعة المعرفة ولا نستوردها[20].
فمنظمة الإيسيسكو تلتزم دائما بمبادئ القانون الدولي، وبأعراف دبلوماسية وضعها الآخرون، ولكن اليوم على الأقل نستطيع أن نقول بأن المنظمة ساهمت في صناعة مفهوم ينطلق من العالم الإسلامي ولكن بمجرد تأصيله نظريا يصبح ملكا للجميع[21].
وبطبيعة الحال، أن الدبلوماسية الحضارية ليس مفهوما بحثا في تنظيره، إنما هو مفهوم عملي تطبيقي يتضمن فاعلين رئيسيين، وينتقل من المفهوم الفلسفي إلى قضايا محددة (قضايا التطرف، والحرب، والمناخ..) إلى فاعلين يؤدون الدور إزاء هذه القضايا (الدول، والمنظمات الدولية، ومراكز الأبحاث، والمؤسسات العلمية، والسفارات..)، فمن خلال هذه المنطلقات، فإن دور المملكة المغربية إلى جانب دول أخرى مقدر في المشاركة في خلق هذا المفهوم، وأنه خرج من النسق الإسلامي إلى النسق العالمي.
وفي هذا الإطار، فالمملكة المغربية هي مقر منظمة العالم الإسلامي، وهذا معطى مهم، ونشأة المنظمة في المغرب جاءت من بعد حضاري ووعيا بقيمة العلوم والثقافة والتربية في إغناء الحضارات، وكذلك تيار الحضارة قديم جدا منذ مدة، فعلاقات المغرب العربية – الشرق أوسطية، وعلاقات المغرب مع مختلف الدول العربية والإسلامية، والأوربية والأفريقية والأمريكية والأسيوية، وعلاقات المغرب بالمنظمات الدولية والجهوية، تعتبر مصدرا من مصادر الإشعاع والتأثير والتأثر الكبير والبين، لذلك فتيار الفكر الإنساني مراقب ومنظور إليه بكثير من الإعتداد في المملكة المغربية.
وعلى هذا الأساس، يأتي طرح هذا المفهوم كمساهمة في توظيف المشترك الحضاري الإنساني لإرساء سلوك دولي يدعم تحقيق التنمية الإنسانية، يتعلق بقيم ومبادئ عابرة للثقافات تلبي الحاجات الأساس للإنسانية، ويجتمع في اعتبارها والأخذ بها الناس جميعا أو غالبيتهم على الأقل، بالرغم من الإختلافات الأخرى بينهم. ولعل هذا يقودنا إلى القول إن عالمنا اليوم في حاجة إلى خطاب جامع يراعي الوحدة في المشترك، والتنوع في المختلف.
المحور الثاني: الثورة التكنولوجية: أداة لتعزيز الحوار الحضاري والعلاقات الدولية
يشهد عالمنا المعاصر تحولات جذرية مستمرة نتجت عن الثورة التكنولوجية التي أحدثت نقلة نوعية وغير مسبوقة في أنماط الإتصال والتواصل الإنساني. فقد أدى إنتشار شبكة الإنترنت والإعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة إلى جعل المعلومات في متناول الأفراد بسرعة فائقة، وامتدت تأثيرات هذه الثورة إلى مختلف المجالات الحياتية، مما أدى إلى إعادة تشكيل طبيعة المعرفة وآليات الوصول إليها بشكل عميق ومؤثر.
حيث أن أبرز ملامح هذا العصر الرقمي هو التزايد الهائل في حجم المعلومات المتاحة، والمعروف بإسم “الإنفجار المعلوماتي”، هذا التدفق اللامتناهي من البيانات والمعرفة أصبح يشكل تحدياً كبيراً للأفراد، حيث أصبح من شبه المستحيل الإلمام الشامل بكل ما يتم إنتاجه يومياً، لكن هذا الفيض المعرفي لا يتوقف تأثيره عند الأفراد فقط؛ بل يطال النظم الإجتماعية والثقافية والسياسية بشكل أوسع.
وبطبيعة الحال ساهمت هذه التحولات التقنية في إزالة العديد من الحواجز التقليدية التي كانت تفصل بين المجتمعات البشرية. فلم تعد الإنقسامات الدينية أو القومية أو اللغوية أو حتى الجغرافية تشكل عقبات كبرى أمام التفاعل والتواصل. هذا التداخل الثقافي والإنساني الذي عززته التكنولوجيا، خلق عالماً أكثر ترابطاً، لكنه في الوقت نفسه، فرض تحديات جديدة تتطلب من الأفراد والمجتمعات القدرة على التكيف مع وتيرة التطور السريعة وما يرافقها من تغييرات في أساليب التفكير والحياة.
وفي هذا الإطار، أصبحنا نشهد عصراً حضارياً جديداً يُعيد تعريف معاني التواصل والمعرفة والعولمة في ظل التغيرات الكبرى التي أطلقتها الثورة التكنولوجية، مما يفتح الأبواب أمام آفاق لا حدود لها، لكن ذلك يتطلب وعياً وإدارة رشيدة للتحديات التي قد تترتب على هذا التحول العميق.
ومما لا شك فيه، أدى الإنفتاح المعلوماتي إلى نشوء فضاء عالمي مشترك، حيث أصبحت الحدود التقليدية بين الثقافات والحضارات أقل وضوحاً، مما ساعد على تعزيز التفاعل بينها بطريقة أكثر سهولة وفاعلية. هذا الإنفتاح أسهم بشكل كبير في إعادة تشكيل الهويات على المستويين الفردي والجماعي، مما أتاح فرصاً واسعة للتفاهم العميق والتداخل الثقافي بين الشعوب. ومن خلال هذا الفضاء الجديد، بدأ العالم يشهد تجارب إنسانية مشتركة تُبنى على قيم التعاون والتواصل بعيداً عن الحواجز الجغرافية واللغوية.
في هذا السياق، يمكن القول إن الثورة التكنولوجية لم تكتفِ بإعادة تشكيل أساليب الوصول إلى المعرفة وحسب، بل إمتدت تأثيراتها العميقة إلى طبيعة العلاقات الإنسانية ذاتها. فقد أسست هذه الثورة لعصر جديد يقوم على التداخل المتزايد والترابط المعقد بين المجتمعات، على نطاق عالمي لم يكن له مثيل في أي حقبة زمنية سابقة. هذا العصر، الذي يتميز بترابط غير مسبوق، يفتح الأبواب لفرص لا حدود لها، لكنه في الوقت ذاته يتطلب وعياً جماعياً لضمان أن يكون هذا التقدم محفزاً للتطور الإيجابي وليس مصدر تهديد لسلامة المجتمعات واستقرارها.
وفي سياق تناول موضوع الدبلوماسية الحضارية، يظهر بوضوح الدور الأساسي الذي تؤديه الثورة التكنولوجية بوصفها أداة متعددة الأبعاد قادرة على تعزيز التواصل العالمي، وتهيئة فضاء مفتوح للحوار بين الأمم. فقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية، وبالأخص شبكة الإنترنت، وسيلة فعّالة لإزالة الحواجز الجغرافية والثقافية التي لطالما أعاقت التفاعل الحضاري المباشر، مما أدى إلى تمكين الشعوب من مشاركة أفكارها وقيمها على نطاق عالمي.
فالتحدي الرئيسي في هذا الإطار يكمن في كيفية تسخير الإمكانيات اللامحدودة التي توفرها التقنيات الحديثة لتكريس ثقافة الحوار الحضاري. فالإنترنت لم يقتصر دوره على توفير منصات تواصل فحسب، بل خلق بيئة ديناميكية تجمع بين مختلف الخلفيات الثقافية، مما يُعزّز فرص التفاهم المشترك وبناء جسور التعاون بين الحضارات.
كما يتطلب تعميق ثقافة الحوار الحضاري في العصر الرقمي جهداً واعياً ومشتركاً لتوجيه هذه التقنيات نحو أهداف بنّاءة تخدم السلم العالمي، وتحقيق ذلك يستلزم تطوير سياسات ومنصات تشجع النقاش المتبادل، وتحترم التنوع الثقافي، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة من خلال تعزيز إستخدام التكنولوجيا كوسيلة للتمكين الثقافي والمعرفي، وليس كأداة للهيمنة أو الإقصاء.
وبالتالي، فإن الثورة التكنولوجية تُمثل فرصة فريدة لإعادة تعريف العلاقات بين الحضارات والشعوب والدول، شريطة أن تُستخدم بحكمة ورؤية إستراتيجية تستهدف تحقيق التنمية البشرية وتعزيز التعايش السلمي.
المحور الثالث: من الفضاء الرقمي إلى الحوار الحضاري: آفاق جديدة للعلاقات الدولية
أصبح حقل العلاقات الدولية مسرحا للعديد من التفاعلات فيما بين الدول، هذه التفاعلات تجسدها الممارسات الدولية من خلال السياسة الخارجية للدول والتي تتمثل في العمل الحكومي من أجل تحقيق المصالح الوطنية (القومية) للدول، مستعملة في ذلك مجموعة من الأدوات والآليات لصنع ثم تنفيذ هذه السياسة وتجسيد كيانها خارج الإطار المكاني لهذه الدول. ولبلوغ ذلك تعتبر الدبلوماسية من بين الأدوات التي تستعملها مختلف الدول من أجل تسيير سياساتها الخارجية[22].
فبتطور العلاقات الدولية تطورت وظائف الدولة وتدخلاتها في عدة مجالات، وتطور وسائل الإتصال جعل الميدان الدبلوماسي يتسع إلى العديد من المجالات الإقتصادية والتكنولوجية والإجتماعية، والحضارية، ولم يعد التمثيل السياسي البروتوكولي هو الوظيفة الرسمية للدبلوماسية، بل أضحت الوظيفة الدبلوماسية متداخلة في عدة مجالات أوسع من السابق كالدبلوماسية الحضارية ، وبالتالي أصبحت هذه الوظيفة بحاجة إلى العديد من المتدخلين والأطراف الأخرى من أجل تعزيز نشاطها[23].
وبالتالي إن الدعوة إلى الدبلوماسية الحضارية يتصادم مع عدة عقبات تاريخية وثقافية ودينية، كما خلصنا سابقا، فالتحديات التي تواجه المنتظم الدولي تحول دون تكريس مبادئ السلم والتعايش والحوار وتثمين قيم التعاون المتبادل.
ووعيا بأهمية النقاش الفكري والأكاديمي في بلورة مفاهيم علمية جديدة وآليات عملية ناجزة، تم طرح الدبلوماسية الحضارية، كما ذكرنا سالفا، كمساهمة في توظيف المشترك الحضاري الإنساني لإرساء سلوك دولي يدعم تحقيق التنمية الإنسانية وعليه أصبح الحوار الحضاري ضرورة قصوى، وهو لا يشمل فقط مسألة الديانات والثقافات كما هو متداول عند البعض، وإنما يجب أن يتناول ميادين سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وفكرية؛ ولا يمكنه إلا أن يكون عالمياً وشاملاً لينتظم به ومعه التنوع البشري بكل أشكاله ومصالحه.
وقد أظهرت المبادرات المقدمة بهذا الصدد (أشغال الندوة العلمية الدولية الدبلوماسية الحضارية “قراءات متقاطعة”)، مدى أهمية تمحيص وصقل هذا المفهوم المستجد داخل المؤسسات الجامعية باعتبارها فضاء لإنتاج الفكر والمعرفة، وسط عالم يشهد مجموعة من التحديات والإرهاصات التي لا تستثني أحداً، حتى يمسي أحد فروع الدبلوماسية الدولية، اعتباراً إلى اجتهادات فكرية أكاديمية، واستنادا لمبدأ المشترك الحضاري الذي يطبع المجتمعات الإنسانية.
وبحديثنا عن آفاق الدبلوماسية الحضارية وسبل تحقيقها ونحن نقارب الموضوع، هو التأكيد على الأدوار التواصلية المختلفة ذات الأوجه المتعددة التي تقوم بها شبكة الإنترنت، فالتحدي والرهان اليوم يعول فيه على إستثمار شبكة الإنترنت في تعزيز ثقافة الحوار الحضاري والثقافي بين مختلف الشعوب والحضارات والدول، ورغبة في ترسيخ علاقات دولية بحس إنساني، وإرساء سلوك دولي يدعم تحقيق التنمية الإنسانية، وينبذ الحروب، ويتيح تعزيز التضامن الدولي.
ولا شك أن البحث العلمي كذلك، قد أدى دورًا بارزًا وحيويًا في العقود الأخيرة، تمثل في تضييق الهوة بين الإرث الحضاري العميق من جهة، والتقدم التكنولوجي المتسارع من جهة أخرى، حيث ساهم في تحقيق نوع من التوفيق والمصالحة بين هذين المجالين اللذين لطالما بدا وكأنهما يسيران في مسارات متوازية أو حتى متباعدة. ومن الأمثلة الأكثر إيضاحًا لهذا النهج التناغمي، يُمكن أن نستعرض النموذج الهندي الذي يُجسد حالة فريدة واستثنائية[24].
فالهند أشبه بمتحف مفتوح يجمع بين الزمان والمكان في مشهد واحد: تنوع يدهشك من حيث المظاهر الثقافية، الإجتماعية، والإقتصادية، فهي بلاد تجمع بين الغنى الفاحش والفقر المدقع، وبين التقدم المذهل والتخلف الكامن في بعض الجوانب، إلى جانب تعدد دياناتها، لغاتها، وفلسفاتها التي تتجاوز الحصر.
ومع ذلك، فإن الهند ليست مجرد متحف للتنوع، بل دولة تمتلك قدرات مبهرة على الصعيد العلمي والتكنولوجي. فهي من الدول التي وصلت إلى القدرة على إنتاج السلاح النووي، وأصبحت فاعلة في مجال إستكشاف الفضاء الخارجي، ناهيك عن تحقيقها الإكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب الغذائية. وهذا يؤكد أن العمق الحضاري إذا ما جرى إستثماره بشكل ذكي، يمكن أن يكون ركيزة أساسية لتحقيق التقدم التكنولوجي. أما السير في الإتجاه المعاكس – أي تحويل التقدم التكنولوجي إلى عمق حضاري – فيبدو أمرًا أكثر تعقيدًا وأقل شيوعًا على مر التاريخ[25].
في المقابل، تقدم الحضارة الصينية مثالاً على الذاتية في مفهوم الحضارة، رغم إختلاف أسسها العقائدية والإجتماعية ونظامها السياسي. ومع هذا، تميزت الحضارة الصينية بتحقيق إنجازات حضارية كبيرة على مدى تاريخها الطويل، حيث كان للعائلات الحاكمة دور أساسي في تطويرها. فقد بنيت الصين حضارتها من الداخل، وحققت تقدماً ملحوظاً في مجالات متعددة مثل الصناعات والفنون والعلوم. ورغم هذا التقدم، لم تكن الصين تسعى أبداً للإنتشار العالمي أو السيادة أو الهيمنة.
وجدير بالذكر أن تاريخ الصين، سواء في فترات العصور القديمة أو الوسطى أو الحديثة، لا يقدم أي دليل على سياسة إمبراطورية تتسم بالأطماع الخارجية أو تسعى لتوسيع نفوذها خارج حدودها[26].
إن العالم بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بات مختلفا عما كان عليه، حيث جاءت هذه الأحداث وغيرت كل القناعات وأعطت تحديات لم يعد بالإمكان التنبؤ بها، حيث كان لها الأثر العميق على الفكر الأمريكي وعلى رؤية الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لنفسها ولباقي العالم، حيث قامت بتشكيل وصياغة طرح جديد في طبيعة المعايير التي سوف تحكم وتحدد العلاقات بين الدول، وذلك عن طريق دبلوماسية نشطة قائمة على التواصل بين الشعوب والحوار الدولي[27].
وتبقى المقولة التي مفادها حوار الحضارات، هي المعول عليها في التطلع إلى مستقبل العالم، وهي مقولة قديمة بقدم الإنسان والحضارة، وقد ذكّر بها المفكر الفرنسي روجيه جارودي من خلال مؤلفه “حوار الحضارات”، حيث عبر: “… ان غير الغربيين بإمكانهم أن يساعدونا على الأساس بحدود رؤيتنا الكونية، إنني أتمنى أن يأتي من أفريقيا وآسيا لإتمام تربيتنا، فنحن متخلفون في عدة نقاط حياتية أساسية”*[28]. وكذلك الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997م، حيث يرى أنّ فكرة حوار الثقافات محاولة من أجل التفاهم بغية دحض التصادم، فالمؤتمرات السياسية والإقتصادية عبر العالم تعقد من أجل تقوية دعامة الحوار المتواصل بين الشعوب والأمم[29].
خلاصة عامة
يعد حوار الحضارات من أكثر المفاهيم والمصطلحات انتشارا خلال العقد الأخير من القرن العشرين سواء أكان ذلك على مستوى الترويج له عبر المجلات وأجهزة الإعلام والمحطات الإذاعية ومواقع متعددة على شبكة الأنترنيت، أو عن طريق البحث والدراسة والمناقشة في دوائر البحوث والدراسات، أو في الكليات والجامعات والمنتديات الفكرية، فالحوار الحضاري بوصفه قضية عالمية وإنسانية يعد في نظر الكثير من المفكرين وعلى رأسهم (روجيه غارودي) مطلبا جوهريا في عصرنا الراهن، لا بل ضرورة ملحة.
إن أساس الحوار بين الحضارات ينطلق عبر العلاقة المتبادلة بين الجماعات البشرية المختلفة، وهذا ما تسعى إليه الدبلوماسية الحضارية من خلال التقارب الحضاري، استنادا إلى حقيقة أن الحضارات الإنسانية تتجلى بكونها نتاج تعاون الشعوب كافة، فعملية التفاعل والإقتباس في ما بين الحضارات ما زال مستمرا وحاضرا، فالحضارات على اختلافها لها سجل واضح في الإقتباس من حضارات أخرى بشكل يعزز ويثمن من فرص نموها وتطورها.
ولكي يكون الحوار حوارا إنسانيا بعيدا عن خلفيات الهيمنة والإحتواء ويحقق الغايات المرجوة منه، ينبغي أن يؤسس على منظومة مفاهمية حضارية إنسانية تدار من خلالها منهجيته، ولهذا تم التأسيس لمفهوم الدبلوماسية الحضارية التي تسعى من خلاله إلى التقارب الحضاري.
وأخيرا لا يمكن القول بأن الثورة التكنولوجية تقدم إجابات نهائية أو تحد أو تحسم في الخلافات، بل على الأقل تسعى إلى التقارب الحضاري. فالحوار ثقافة لا تعطي إجابات نهائية، بل أن الإجابات كثيرا ما تبقى متعددة، فبيئات الحوار بيئات منافسة جدلية قائمة على التعلم والتجدد، وبالتالي كان من الضرورة البحث عن سبل للمواءمة والحيلولة دون أن تكون نقاط الخلاف عقبة في سبيل التفاهم المشترك، بحيث لا يمكن أن يتحقق إلا إذا انطلق من فكرة استعداد كل حضارة لفهم الأخرى.
وبالتالي يجب الخروج من “النظرة الإغترابية” للآخر الحضاري والبدء بحوار يرتكز على نظرة استيعابية لمكوناته وقيمه الحضارية، ويتم ذلك بتبني نظام مستقر، ولمراكز الأبحاث والجامعات ووسائل الاعلام دور جوهري لتحقيق المشترك الحضاري.
قائمة المراجع
مراجع بالعربية
- محمد سيف الإسلام بوفلاقة، حوار الحضارات في منظور الثقافة الإسلامية – الأسس والقواعد-، مجلة مقاربات فلسفية، المجلد 8 العدد: 01/2021.
- جاب الله زهية، الممارسة البحثية في ظل الإنفجار التكنولوجي والمعلوماتي، مجلة دفاتر علم الإجتماع، المجلد 10 العدد 2 السنة/2023.
- خالد الكركري، “حوار الحضارات. تحرير المصطلح والمنهج”، حوار الحضارات والمشهد الثقافي العربي. الأردن دار الفارس للنشر والتوزيع، 2004.
- فوكوياما فرنسيس، نهاية التاريخ وخاتم البشر.. (ترجمة: حسين أحمد أحمين)، ط1، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1993.
- حسنين توفيق إبراهيم، “العلاقة بين أطروحتي نظام عالمي جديد وعولمة”، الحوار العدد 37.
- زكي الميلاد، المسألة الحضارية وكيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير، المغرب: المركز الثقافي العربي، 1999.
- زكي الميلاد، تركي الربيعي، الإسلام والغرب: الحاضر والمستقبل، بيروت دار الفكر المعاصر، 1998.
- صموئيل هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي. (ترجمة: د. مالك عبيد أبو شهيوة، محمد محمود خلف)، الجماهيرية الليبية: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، 1999.
- بودردبن منيرة، دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية دراسة حالة الولايات المتحدة الامريكية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسة والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قسنطينة منتوري، السنة الجامعية 2008-2009.
- غاستون بوتول، الحروب والحضارات، (ترجمة: أحمد عبد الكريم)، دمشق: طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 1989.
- لبرت شفايتسر، فلسفة الحضارة، (ترجمة عبد الرحمان البدوي)، بيروت : دار الأندلس، 1983.
- علي الشامي، الحضارة والنظام العالمي: أصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب، بيروت، دار النهضة، 1995.
صابر مولاي أحمد، السياسة الدولية ومطلب الدبلوماسية الحضارية، نشر على موقع الاستراتيجية، بتاريخ 2022/08/30، تاريخ الزيارة 22/09/2023 https://cutt.us/UsoZP
مصطفى الفقي، التكنولوجيا والحضارة، مجلة الخليج، نشر بتاريخ: 20 ديسمبر 2016، تاريخ الزيارة: 2025/01/08،
كلمة سعادة السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز حوار الحضارات بمنظمة الإيسيسكو خلال مقابلة تلفزيونية، في برنامج ملف خاص.. رهانات الدبلوماسية الحضارية الكبرى في ظل السياسة الدولية، على قناة ميدي 1 بتاريخ 8 يونيو 2023، تاريخ الدخول 28/9/2023 https://cutt.us/lMtIW
- حوار الحضارات الطريق الأمثل للتعايش السلمي بين الشعوب، صحيفة الشرق الأوسط، نُشر بتاريخ، 11 مايو 2016، تاريخ الزيارة: 2025/01/08.
عبد الحسين شعبان، في استشكال “حوار الحضارات”، موقع هيسبريس، نشر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، تاريخ الزيارة: 2025/01/08
مراجع أجنبية
- Robert Gilpin, War and change in world politics, Cambridge university press, United Kingdom, 1981.
- La Rousse, Dictionnaire Encyclopédique, Paris, Tome 1, 1999.
Michel le long, « L’Islam et l’Occident », Revue Tiers Monde, N92, Octobre Novembre 1982
- – للإستزادة أنظر:
– محمد سيف الإسلام بوفلاقة، حوار الحضارات في منظور الثقافة الإسلامية – الأسس والقواعد-، مجلة مقاربات فلسفية، المجلد 8 العدد: 01/2021، ص 95-116. ↑
- – يُعرف مصطلح “انفجار المعلومات” بالزيادة المتسارعة والهائلة في كمية المعلومات المنتجة والمنشورة عبر جميع المجالات والتخصصات. ووفقاً للدكتور فضيل دليو، فإن كمية المعلومات المتاحة تشهد تضاعفاً تقريباً كل سبع إلى ثماني سنوات. ويُظهر ذلك بوضوح في حقيقة أن حجم المعلومات المُنتَجة خلال العقود الثلاثة الماضية تجاوز إجمالي ما أُنتِج من معلومات عبر القرون السابقة بأكملها، مما يُبرز الدور المحوري لانفجار المعلومات في تشكيل حياة البشر اليومية. يُشير الدكتور دليو أيضاً إلى أن تدفق المعلومات في الوقت الراهن قد بلغ مستوى يكاد لا يُتصور، نظراً لسرعته وحجمه.
من أبرز مظاهر هذا الانفجار المعلوماتي، كما أوضح الدكتور دليو، هو النمو الهائل في حجم الإنتاج الفكري، حيث تُنتج كميات غير مسبوقة من الكتب، الدراسات، والأبحاث في فترات زمنية قصيرة. إلا أن هذا النمو يصاحبه تشتت واضح في الإنتاج الفكري، مما يجعل عملية الوصول إلى المعلومات المفيدة أو ذات الصلة تحدياً في ظل الفيض الهائل من البيانات. أنظر:
-جاب الله زهية، الممارسة البحثية في ظل الإنفجار التكنولوجي والمعلوماتي، مجلة دفاتر علم الإجتماع، المجلد 10 العدد 2 السنة/2023، ص 12 ↑
- – الحوار “لفظة مشتقة من الكلمة اللاتينية Dialogues والتي تعني محادثة، والحوار يعني مداولة كلامية، نقاش، تبادل لوجهات النظر بين شخصين أو أكثر، بهدف إيجاد أرضية للوفاق والتفاهم”.
– La Rousse, Dictionnaire Encyclopédique, Paris, Tome 1, 1999, Page 338. ↑
- – جاء المفهوم من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومن مركزها حوار الحضارات وبالتعاون مع مركز الاستشراف الاستراتيجي بنفس المنظمة. هذا مفهوم جديد وقد تبثت جدته في الندوة التي أقيمت يوم 2-3 يونيو 2023 بمدرج الندوات المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش الندوة العلمية الدولية، الدبلوماسية الحضارية “قراءات متقاطعة”.
وخرجت ببيان وإعلان مراكش يبين عن جدت هذا المفهوم وسبقه وهو مفهوم بسيط في حدوده وعميق في مكنوناته يستقرأ التطورات الحالية في المنتظم الدولي من منطلق الرؤية الحضارية ويستشف هذه التحولات ويطرح سؤال أين مكمن الحلول لهذه التداولات الداخلية في تضاعيف البعد الحضاري، سواء على مستوى سلام الحضارات أو صدام الحضارات. ↑
- – الحضارة تمثل التقدم الشامل، سواء على المستوى الروحي أو المادي، للأفراد والمجتمعات. ولضمان استمرارية هذا التقدم الحضاري، يصبح من الضروري وجود رؤية شاملة للكون، تُحدد من خلالها مسارات وأهداف التطور الحضاري الذي يسعى الإنسان لتحقيقه. أنظر:
– ألبرت شفايتسر، فلسفة الحضارة، (ترجمة عبد الرحمان البدوي)، بيروت : دار الأندلس، 1983، ص 37. ↑
- – تُظهر الحروب وخاصة الحروب المقدسة مدى قوة الشعور الديني الكامن في ضمير الإنسان. فقد عانت البشرية على مر تاريخها من وطأة الحروب، ورغم أن بعضها قد يكون صراعات دنيوية، إلا أنه تم إضفاء طابع القداسة عليها في العديد من الأحيان. أنظر:
– غاستون بوتول، الحروب والحضارات، (ترجمة: أحمد عبد الكريم)، دمشق: طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 1989، ص 36. ↑
- – بعد الحرب العالمية الثانية، شهد مجال العلاقات الدولية أزمة هوية عميقة تمثلت في غموض حول الحدود المعرفية والمنهجية لهذا الحقل من الدراسة. وقد دفع هذا الأمر العديد من العلماء إلى الاعتقاد بأن معالجة هذه الأزمة لا يمكن أن تتم إلا من خلال وضع نظرية شاملة للسياسة الدولية. إذ أن جوهر أي مجال أكاديمي يُعتبر علمياً يعتمد على قدرته على إنتاج نظريات تُحدد إطار عمله ومنهجيته، وبالتالي فوجود هذه النظريات سيعزز من وضوح الحدود المعرفية لذلك المجال. أنظر: ↑
- – يعتبر حوار الحضارات مصطلحا حديثا دعت إلى استعماله وشيوعه العلاقات الدولية وتشابك المصالح بين الأمم، فحوار الحضارات لا يتطرق إلى موضوعات العقيدة ولا العبادات، بل بخلاف ذلك يبحث في منظومات القيم والتقاليد الاجتماعية، وفي حقوق الإنسان وحقوق الطفل وموقف الديانات ومن شؤون البيئة، وما شابه ذلك من قضايا. خالد الكركري، “حوار الحضارات. تحرير المصطلح والمنهج”، حوار الحضارات والمشهد الثقافي العربي. الأردن دار الفارس للنشر والتوزيع، 2004، ص 20-23. ↑
- – Robert Gilpin, War and change in world politics, Cambridge university press, United Kingdom, 1981, P3. ↑
- – فوكوياما فرنسيس، نهاية التاريخ وخاتم البشر.. (ترجمة: حسين أحمد أحمين)، ط1، القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، 1993. ↑
- – ظهر هذا المفهوم أثناء حرب الخليج الثانية، وذلك على إثر تبني إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لهذا المفهوم وقيام الدوائر الإعلامية والسياسية والأكاديمية الأمريكية بالترويج له. ↑
- – حسنين توفيق إبراهيم، “العلاقة بين أطروحتي نظام عالمي جديد وعولمة”، الحوار العدد 37، ص 70. ↑
- – زكي الميلاد، المسألة الحضارية وكيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير، المغرب: المركز الثقافي العربي، 1999، ص 16-17. ↑
- – نفس المرجع الآنف الذكر، ص 17. ↑
- – زكي الميلاد، تركي الربيعي، الإسلام والغرب: الحاضر والمستقبل، بيروت دار الفكر المعاصر، 1998، ص 21. ↑
- – حوار الحضارات الطريق الأمثل للتعايش السلمي بين الشعوب، صحيفة الشرق الأوسط، نُشر بتاريخ، 11 مايو 2016، تاريخ الزيارة: 2025/01/08. ↑
- – عبد الحسين شعبان، في استشكال “حوار الحضارات”، موقع هيسبريس، نشر بتاريخ 9 أكتوبر 2018، تاريخ الزيارة: 2025/01/08
- – عبد الحسين شعبان، في استشكال “حوار الحضارات”، مرجع سابق. ↑
- – صموئيل هنتنجتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي. (ترجمة: د. مالك عبيد أبو شهيوة، محمد محمود خلف)، الجماهيرية الليبية: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، 1999، ص 14. ↑
- – أشغال الندوة العلمية الدولية، الدبلوماسية الحضارية “قراءات متقاطعة”، يومي 2-3 يونيو 2023، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مدرج الندوات (المختار السوسي)- مراكش. ↑
- – كلمة سعادة السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز حوار الحضارات بمنظمة الإيسيسكو خلال مقابلة تلفزيونية، في برنامج ملف خاص.. رهانات الدبلوماسية الحضارية الكبرى في ظل السياسة الدولية، على قناة ميدي 1 بتاريخ 8 يونيو 2023، تاريخ الدخول 28/9/2023 https://cutt.us/lMtIW ↑
- – بودردبن منيرة، دور الدبلوماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية دراسة حالة الولايات المتحدة الامريكية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسة والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة قسنطينة منتوري، السنة الجامعية 2008-2009، ص 6. ↑
- – بودردبن، ص 6 مرجع سابق. ↑
- د – مصطفى الفقي، التكنولوجيا والحضارة، مجلة الخليج، نشر بتاريخ: 20 ديسمبر 2016، تاريخ الزيارة: 2025/01/08، ↑
- – مصطفى الفقي، مرجع سابق. ↑
- – يقول علي الشامي : “ان ذاتية الحضارة الصينية وتماسكها الداخلي تختلف عن ذاتية الهند في نقطة واحدة جوهرية، ذلك أن الصين عكس الهند لم تواجه أي تهديد أو غزو فكري أو ديني كما لم تعرف انقسامات ثقافية – مجتمعية بفضل المؤثرات الخارجية”. للإستزادة أنظر:
– علي الشامي، الحضارة والنظام العالمي: أصول العالمية في حضارتي الإسلام والغرب، بيروت، دار النهضة، 1995، ص 78. ↑
- – بودرنين، ص 7 مرجع سابق. ↑
- *- صرح الرئيس الفرنسي السابق دوغول: “إن في الضفة الجنوبية من البحر المتوسط دول في طريق النمو، وهذه الدول لها حضارة وثقافة إنسانية، ومعنى للعلاقات الإنسانية فقدناها، في مجتمعاتنا المصنعة، والتي سنكون فرحين يوما ما إذا وجدناها عندهم…”.
– Michel le long, « L’Islam et l’Occident », Revue Tiers Monde, N92, Octobre Novembre 1982, Page 753. ↑
- – أنظر، صابر مولاي أحمد، السياسة الدولية ومطلب الدبلوماسية الحضارية، نشر على موقع الاستراتيجية، بتاريخ 2022/08/30، تاريخ الزيارة 22/09/2023 https://cutt.us/UsoZP ↑