القيود على مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري للبضائع مقاربة قانونية بين النص و التطبيق – الدكتورة : حفيظة العدراري
Restrictions on the principle of limitation of liability of the maritime carrier: A legal approach between text and application
القيود على مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري للبضائع مقاربة قانونية بين النص و التطبيق
Restrictions on the principle of limitation of liability of the maritime carrier: A legal approach between text and application
الدكتورة : حفيظة العدراري
دكتورة في القانون الخاص
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/EJTM3163
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

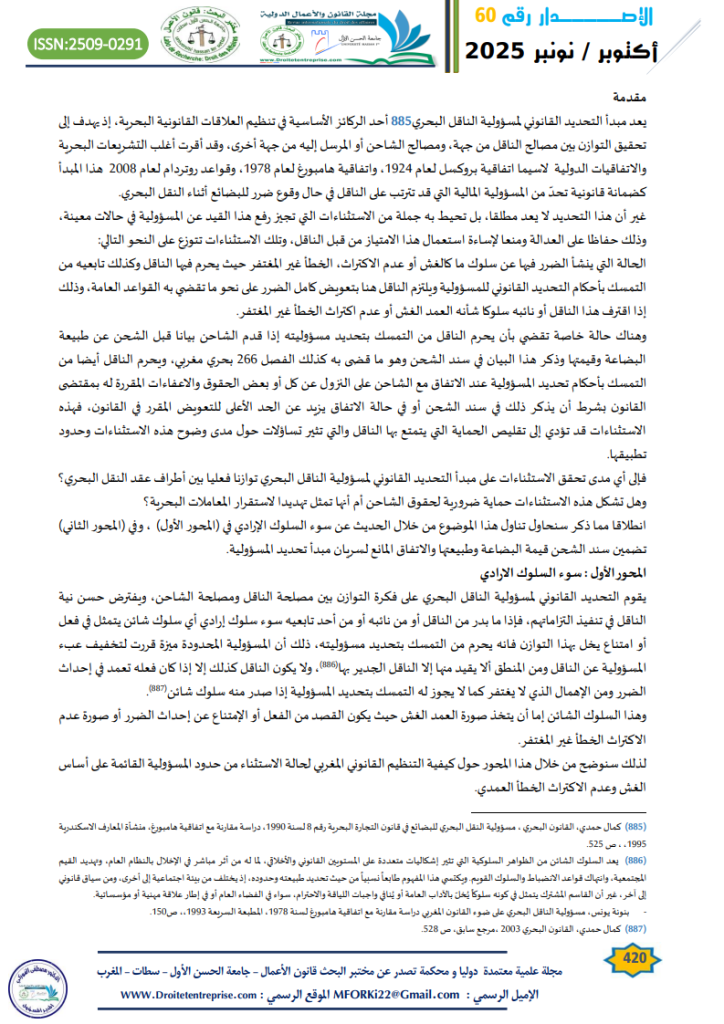
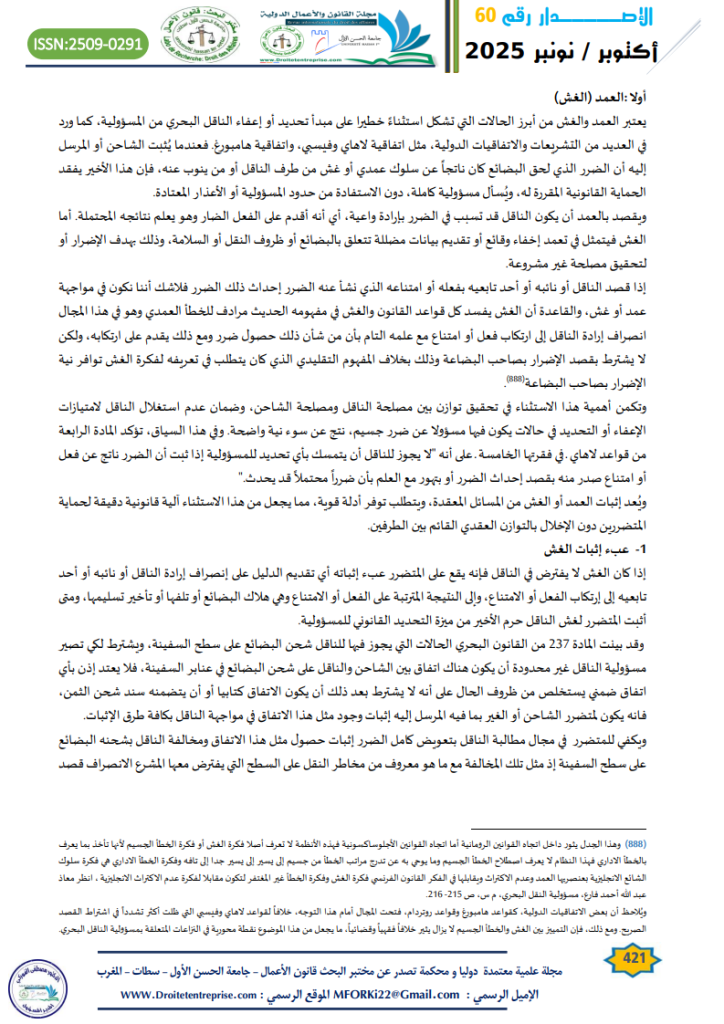
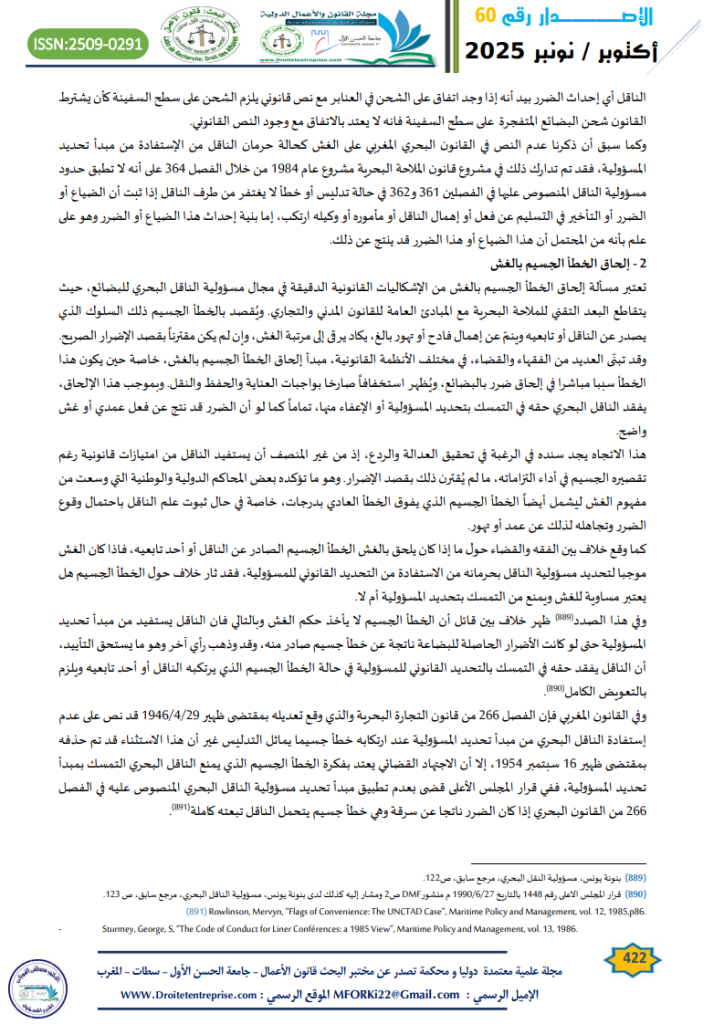
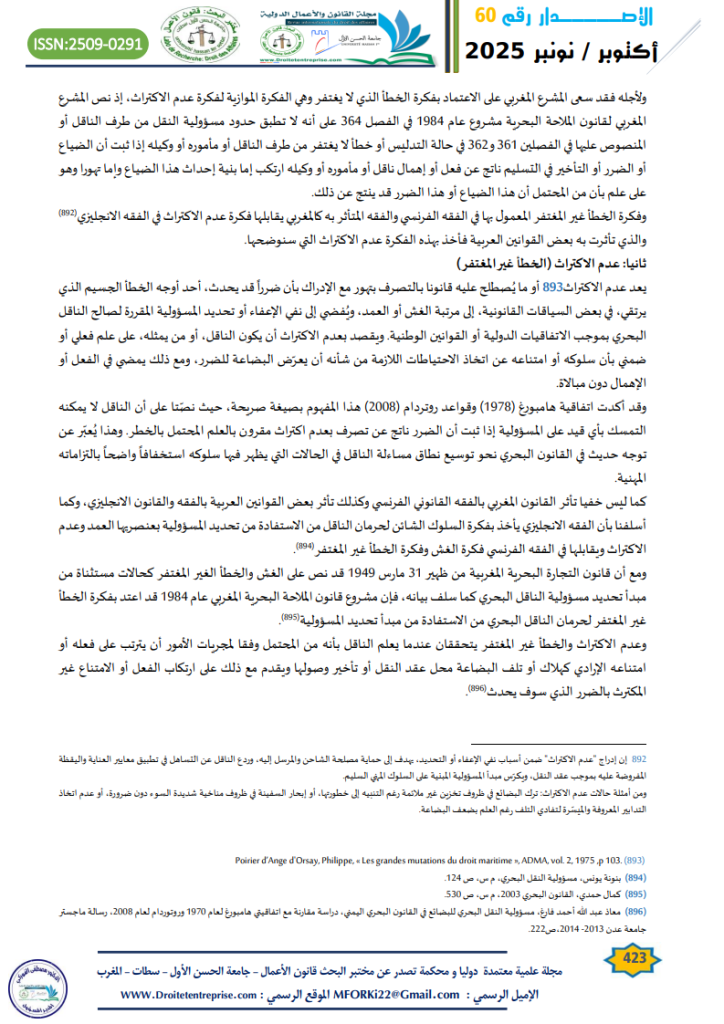
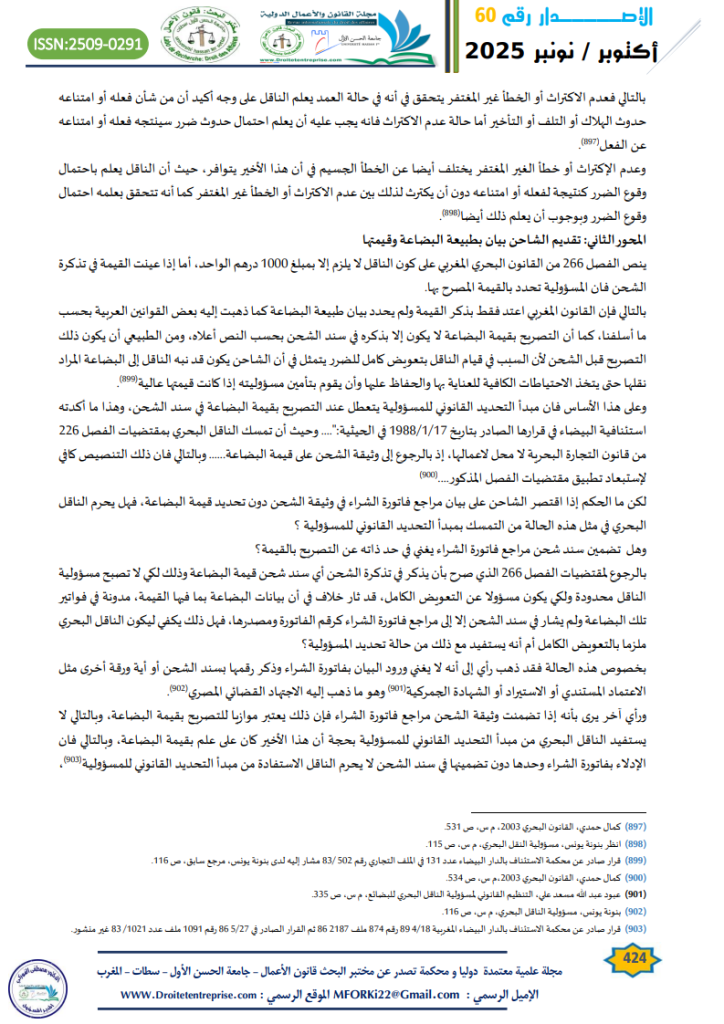
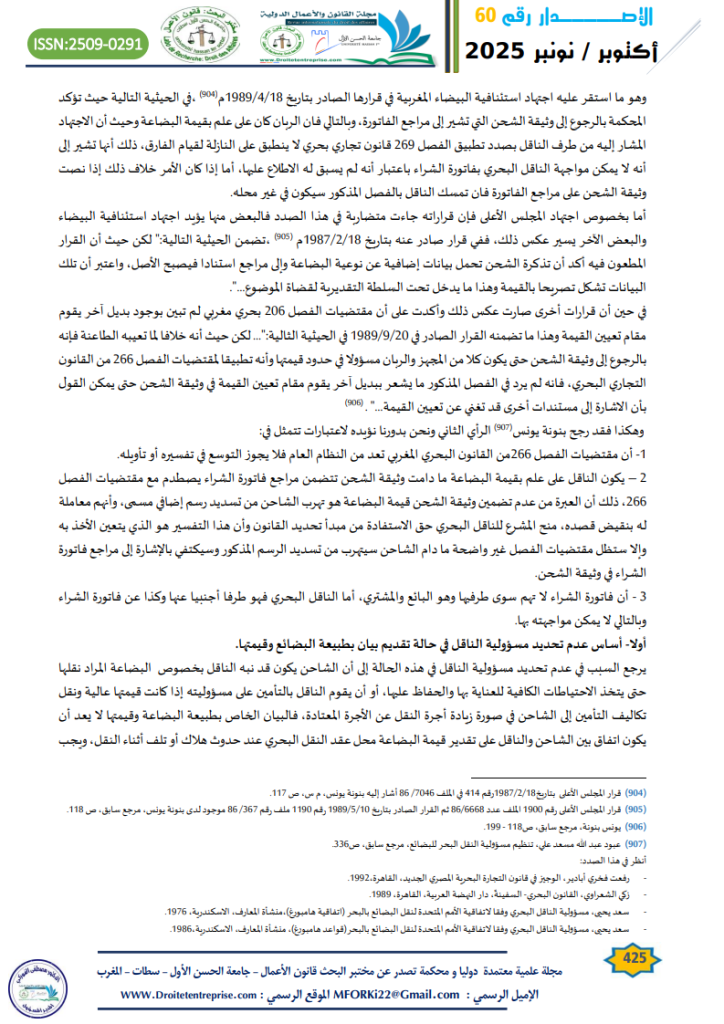
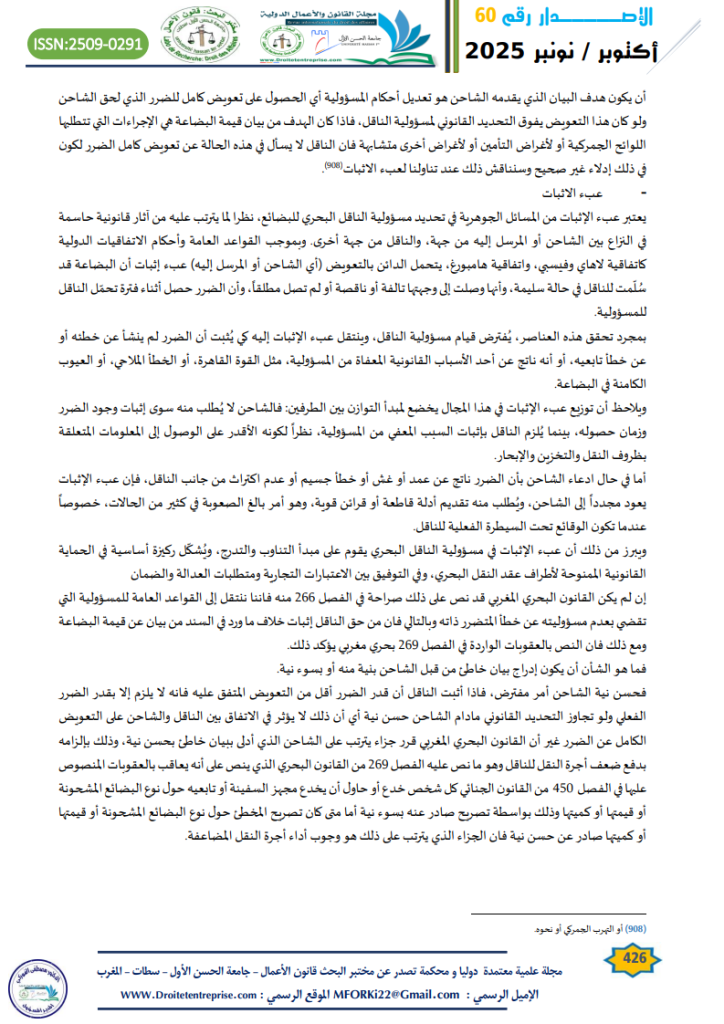
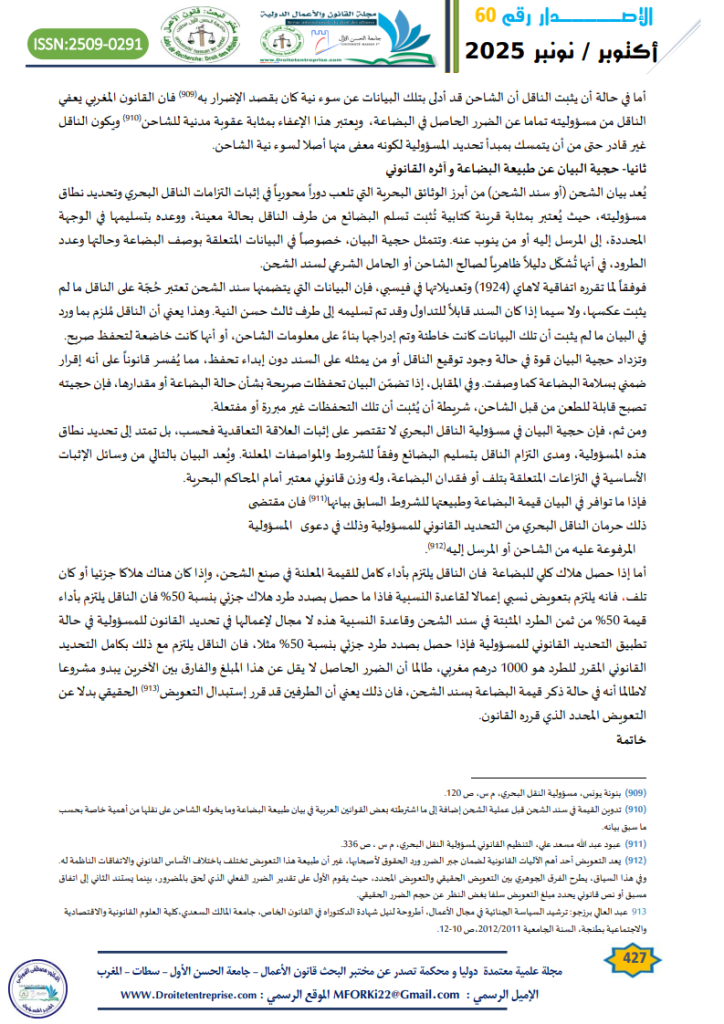
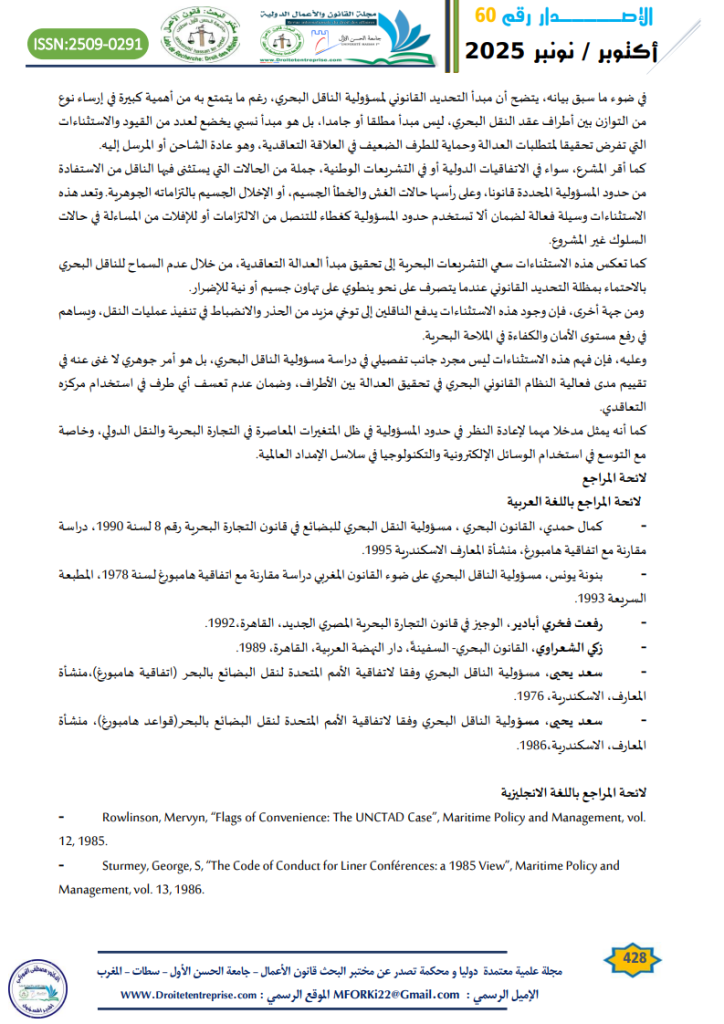
القيود على مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري للبضائع مقاربة قانونية بين النص و التطبيق
Restrictions on the principle of limitation of liability of the maritime carrier: A legal approach between text and application
الدكتورة : حفيظة العدراري
دكتورة في القانون الخاص
ملخص
يعتبر مبدأ التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الناقل من جهة، وحماية البضاعة ومصالح الشاحنين من جهة أخرى. ويكرَّس هذا المبدأ في معظم الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري، كاتفاقية هامبورغ (1978) وقبلها قواعد لاهاي (1924) ولاهاي-فيسبي (1968)، وأيضا في اتفاقية روتردام (2008)، وهو يحدد سقفا للتعويض الذي يمكن أن يطالب به الناقل في حال تلف أو ضياع البضاعة، بما يعكس طبيعة النقل البحري كمجال محفوف بالمخاطر.
غير أن هذا التحديد ليس مطلقا، بل ترد عليه استثناءات قانونية تتيح رفع المسؤولية عن الحد المقرر قانونا، أو حتى إلغاء الاستفادة من التحديد كليا، في حالات معينة. وأهم هذه الاستثناءات ،الخطأ العمدي أو الغش من طرف الناقل أو تابعيه، سوء النية أو الإهمال الجسيم،
مخالفة الالتزامات التعاقدية الأساسية، الاتفاق الصريح، عدم الإدلاء بالبيانات الجوهرية.
وتبرز أهمية هذه الاستثناءات في ضمان عدم تحصين الناقل من المسؤولية في الحالات التي يثبت فيها سوء النية أو الإهمال الجسيم، مما يعكس التوجه نحو حماية مصلحة الشاحن وتشجيع الناقلين على الالتزام الدقيق بواجباتهم التعاقدية والقانونية.
Abstract
The principle of legal limitation of the liability of the maritime carrier is a fundamental principle aimed at achieving a balance between the interests of the carrier on the one hand, and the protection of the goods and the interests of shippers on the other. This principle is enshrined in most international agreements regulating maritime transport, such as the Hamburg Convention (1978). Before it, the Hague Rules (1924) and the Hague-Visby Rules (1968), as well as the Rotterdam Convention (2008), set a ceiling for the compensation that the carrier can claim in the event of damage or loss of goods, reflecting the nature of maritime transport as a risky field.
However, this limitation is not absolute. Legal exceptions exist that allow liability to be waived below the legally prescribed limit, or even waived entirely, in certain cases. The most important of these exceptions are intentional error or fraud on the part of the carrier or its agents, bad faith or gross negligence, breach of basic contractual obligations, express agreement, and failure to provide essential information.
The importance of these exceptions lies in ensuring that the carrier is not immune from liability in cases where bad faith or gross negligence is proven, reflecting the trend towards protecting the shipper’s interests and encouraging carriers to strictly adhere to their contractual and legal obligations.
مقدمة
يعد مبدأ التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري[1] أحد الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات القانونية البحرية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الناقل من جهة، ومصالح الشاحن أو المرسل إليه من جهة أخرى، وقد أقرت أغلب التشريعات البحرية والاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية بروكسل لعام 1924، واتفاقية هامبورغ لعام 1978، وقواعد روتردام لعام 2008 هذا المبدأ كضمانة قانونية تحدّ من المسؤولية المالية التي قد تترتب على الناقل في حال وقوع ضرر للبضائع أثناء النقل البحري.
غير أن هذا التحديد لا يعد مطلقا، بل تحيط به جملة من الاستثناءات التي تجيز رفع هذا القيد عن المسؤولية في حالات معينة، وذلك حفاظا على العدالة ومنعا لإساءة استعمال هذا الامتياز من قبل الناقل، وتلك الاستثناءات تتوزع على النحو التالي:
الحالة التي ينشأ الضرر فيها عن سلوك ما كالغش أو عدم الاكتراث، الخطأ غير المغتفر حيث يحرم فيها الناقل وكذلك تابعيه من التمسك بأحكام التحديد القانوني للمسؤولية ويلتزم الناقل هنا بتعويض كامل الضرر على نحو ما تقضي به القواعد العامة، وذلك إذا اقترف هذا الناقل أو نائبه سلوكا شأنه العمد الغش أو عدم اكتراث الخطأ غير المغتفر.
وهناك حالة خاصة تقضي بأن يحرم الناقل من التمسك بتحديد مسؤوليته إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وذكر هذا البيان في سند الشحن وهو ما قضى به كذلك الفصل 266 بحري مغربي، ويحرم الناقل أيضا من التمسك بأحكام تحديد المسؤولية عند الاتفاق مع الشاحن على النزول عن كل أو بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له بمقتضى القانون بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن أو في حالة الاتفاق يزيد عن الحد الأعلى للتعويض المقرر في القانون، فهذه الاستثناءات قد تؤدي إلى تقليص الحماية التي يتمتع بها الناقل والتي تثير تساؤلات حول مدى وضوح هذه الاستثناءات وحدود تطبيقها.
فإلى أي مدى تحقق الاستثناءات على مبدأ التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري توازنا فعليا بين أطراف عقد النقل البحري؟ وهل تشكل هذه الاستثناءات حماية ضرورية لحقوق الشاحن أم أنها تمثل تهديدا لاستقرار المعاملات البحرية؟
انطلاقا مما ذكر سنحاول تناول هذا الموضوع من خلال الحديث عن سوء السلوك الإرادي في (المحور الأول) ، وفي (المحور الثاني) تضمين سند الشحن قيمة البضاعة وطبيعتها والاتفاق المانع لسريان مبدأ تحديد المسؤولية.
المحور الأول : سوء السلوك الارادي
يقوم التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري على فكرة التوازن بين مصلحة الناقل ومصلحة الشاحن، ويفترض حسن نية الناقل في تنفيذ التزاماتهم، فإذا ما بدر من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه سوء سلوك إرادي أي سلوك شائن يتمثل في فعل أو امتناع يخل بهذا التوازن فانه يحرم من التمسك بتحديد مسؤوليته، ذلك أن المسؤولية المحدودة ميزة قررت لتخفيف عبء المسؤولية عن الناقل ومن المنطق ألا يقيد منها إلا الناقل الجدير بها([2])، ولا يكون الناقل كذلك إلا إذا كان فعله تعمد في إحداث الضرر ومن الإهمال الذي لا يغتفر كما لا يجوز له التمسك بتحديد المسؤولية إذا صدر منه سلوك شائن([3]).
وهذا السلوك الشائن إما أن يتخذ صورة العمد الغش حيث يكون القصد من الفعل أو الإمتناع عن إحداث الضرر أو صورة عدم الاكتراث الخطأ غير المغتفر.
لذلك سنوضح من خلال هذا المحور حول كيفية التنظيم القانوني المغربي لحالة الاستثناء من حدود المسؤولية القائمة على أساس الغش وعدم الاكتراث الخطأ العمدي.
يعتبر العمد والغش من أبرز الحالات التي تشكل استثناءً خطيرا على مبدأ تحديد أو إعفاء الناقل البحري من المسؤولية، كما ورد في العديد من التشريعات والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لاهاي وفيسبي، واتفاقية هامبورغ. فعندما يُثبت الشاحن أو المرسل إليه أن الضرر الذي لحق البضائع كان ناتجاً عن سلوك عمدي أو غش من طرف الناقل أو من ينوب عنه، فإن هذا الأخير يفقد الحماية القانونية المقررة له، ويُسأل مسؤولية كاملة، دون الاستفادة من حدود المسؤولية أو الأعذار المعتادة.
ويقصد بـالعمد أن يكون الناقل قد تسبب في الضرر بإرادة واعية، أي أنه أقدم على الفعل الضار وهو يعلم نتائجه المحتملة. أما الغش فيتمثل في تعمد إخفاء وقائع أو تقديم بيانات مضللة تتعلق بالبضائع أو ظروف النقل أو السلامة، وذلك بهدف الإضرار أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة.
إذا قصد الناقل أو نائبه أو أحد تابعيه بفعله أو امتناعه الذي نشأ عنه الضرر إحداث ذلك الضرر فلاشك أننا نكون في مواجهة عمد أو غش، والقاعدة أن الغش يفسد كل قواعد القانون والغش في مفهومه الحديث مرادف للخطأ العمدي وهو في هذا المجال انصراف إرادة الناقل إلى ارتكاب فعل أو امتناع مع علمه التام بأن من شأن ذلك حصول ضرر ومع ذلك يقدم على ارتكابه، ولكن لا يشترط بقصد الإضرار بصاحب البضاعة وذلك بخلاف المفهوم التقليدي الذي كان يتطلب في تعريفه لفكرة الغش توافر نية الإضرار بصاحب البضاعة([4]).
وتكمن أهمية هذا الاستثناء في تحقيق توازن بين مصلحة الناقل ومصلحة الشاحن، وضمان عدم استغلال الناقل لامتيازات الإعفاء أو التحديد في حالات يكون فيها مسؤولا عن ضرر جسيم، نتج عن سوء نية واضحة. وفي هذا السياق، تؤكد المادة الرابعة من قواعد لاهاي ـ في فقرتها الخامسة ـ على أنه “لا يجوز للناقل أن يتمسك بأي تحديد للمسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناتج عن فعل أو امتناع صدر منه بقصد إحداث الضرر أو بتهور مع العلم بأن ضرراً محتملاً قد يحدث”.
ويُعد إثبات العمد أو الغش من المسائل المعقدة، ويتطلب توفر أدلة قوية، مما يجعل من هذا الاستثناء آلية قانونية دقيقة لحماية المتضررين دون الإخلال بالتوازن العقدي القائم بين الطرفين.
- عبء إثبات الغش
إذا كان الغش لا يفترض في الناقل فإنه يقع على المتضرر عبء إثباته أي تقديم الدليل على إنصراف إرادة الناقل أو نائبه أو أحد تابعيه إلى إرتكاب الفعل أو الامتناع، وإلى النتيجة المترتبة على الفعل أو الامتناع وهي هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها، ومتى أثبت المتضرر لغش الناقل حرم الأخير من ميزة التحديد القانوني للمسؤولية.
وقد بينت المادة 237 من القانون البحري الحالات التي يجوز فيها للناقل شحن البضائع على سطح السفينة، ويشترط لكي تصير مسؤولية الناقل غير محدودة أن يكون هناك اتفاق بين الشاحن والناقل على شحن البضائع في عنابر السفينة، فلا يعتد إذن بأي اتفاق ضمني يستخلص من ظروف الحال على أنه لا يشترط بعد ذلك أن يكون الاتفاق كتابيا أو أن يتضمنه سند شحن الثمن، فانه يكون لمتضرر الشاحن أو الغير بما فيه المرسل إليه إثبات وجود مثل هذا الاتفاق في مواجهة الناقل بكافة طرق الإثبات.
ويكفي للمتضرر في مجال مطالبة الناقل بتعويض كامل الضرر إثبات حصول مثل هذا الاتفاق ومخالفة الناقل بشحنه البضائع على سطح السفينة إذ مثل تلك المخالفة مع ما هو معروف من مخاطر النقل على السطح التي يفترض معها المشرع الانصراف قصد الناقل أي إحداث الضرر بيد أنه إذا وجد اتفاق على الشحن في العنابر مع نص قانوني يلزم الشحن على سطح السفينة كأن يشترط القانون شحن البضائع المتفجرة على سطح السفينة فانه لا يعتد بالاتفاق مع وجود النص القانوني.
وكما سبق أن ذكرنا عدم النص في القانون البحري المغربي على الغش كحالة حرمان الناقل من الإستفادة من مبدأ تحديد المسؤولية، فقد تم تدارك ذلك في مشروع قانون الملاحة البحرية مشروع عام 1984 من خلال الفصل 364 على أنه لا تطبق حدود مسؤولية الناقل المنصوص عليها في الفصلين 361 و362 في حالة تدليس أو خطأ لا يغتفر من طرف الناقل إذا ثبت أن الضياع أو الضرر أو التأخير في التسليم عن فعل أو إهمال الناقل أو مأموره أو وكيله ارتكب، إما بنية إحداث هذا الضياع أو الضرر وهو على علم بأنه من المحتمل أن هذا الضياع أو هذا الضرر قد ينتج عن ذلك.
2 – إلحاق الخطأ الجسيم بالغش
تعتبر مسألة إلحاق الخطأ الجسيم بالغش من الإشكاليات القانونية الدقيقة في مجال مسؤولية الناقل البحري للبضائع، حيث يتقاطع البعد التقني للملاحة البحرية مع المبادئ العامة للقانون المدني والتجاري. ويُقصد بالخطأ الجسيم ذلك السلوك الذي يصدر عن الناقل أو تابعيه وينمّ عن إهمال فادح أو تهور بالغ، يكاد يرقى إلى مرتبة الغش، وإن لم يكن مقترناً بقصد الإضرار الصريح.
وقد تبنّى العديد من الفقهاء والقضاء، في مختلف الأنظمة القانونية، مبدأ إلحاق الخطأ الجسيم بالغش، خاصة حين يكون هذا الخطأ سببا مباشرا في إلحاق ضرر بالبضائع، ويُظهر استخفافاً صارخا بواجبات العناية والحفظ والنقل. وبموجب هذا الإلحاق، يفقد الناقل البحري حقه في التمسك بتحديد المسؤولية أو الإعفاء منها، تماماً كما لو أن الضرر قد نتج عن فعل عمدي أو غش واضح.
هذا الاتجاه يجد سنده في الرغبة في تحقيق العدالة والردع، إذ من غير المنصف أن يستفيد الناقل من امتيازات قانونية رغم تقصيره الجسيم في أداء التزاماته، ما لم يُقترن ذلك بقصد الإضرار. وهو ما تؤكده بعض المحاكم الدولية والوطنية التي وسعت من مفهوم الغش ليشمل أيضاً الخطأ الجسيم الذي يفوق الخطأ العادي بدرجات، خاصة في حال ثبوت علم الناقل باحتمال وقوع الضرر وتجاهله لذلك عن عمد أو تهور.
كما وقع خلاف بين الفقه والقضاء حول ما إذا كان يلحق بالغش الخطأ الجسيم الصادر عن الناقل أو أحد تابعيه، فاذا كان الغش موجبا لتحديد مسؤولية الناقل بحرمانه من الاستفادة من التحديد القانوني للمسؤولية، فقد ثار خلاف حول الخطأ الجسيم هل يعتبر مساوية للغش ويمنع من التمسك بتحديد المسؤولية أم لا.
وفي هذا الصدد([5]) ظهر خلاف بين قائل أن الخطأ الجسيم لا يأخذ حكم الغش وبالتالي فان الناقل يستفيد من مبدأ تحديد المسؤولية حتى لو كانت الأضرار الحاصلة للبضاعة ناتجة عن خطأ جسيم صادر منه، وقد وذهب رأي آخر وهو ما يستحق التأييد، أن الناقل يفقد حقه في التمسك بالتحديد القانوني للمسؤولية في حالة الخطأ الجسيم الذي يرتكبه الناقل أو أحد تابعيه ويلزم بالتعويض الكامل([6]).
وفي القانون المغربي فإن الفصل 266 من قانون التجارة البحرية والذي وقع تعديله بمقتضى ظهير 29/4/1946 قد نص على عدم إستفادة الناقل البحري من مبدأ تحديد المسؤولية عند ارتكابه خطأ جسيما يماثل التدليس غير أن هذا الاستثناء قد تم حذفه بمقتضى ظهير 16 سبتمبر 1954، إلا أن الاجتهاد القضائي يعتد بفكرة الخطأ الجسيم الذي يمنع الناقل البحري التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية، ففي قرار المجلس الأعلى قضى بعدم تطبيق مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري المنصوص عليه في الفصل 266 من القانون البحري إذا كان الضرر ناتجا عن سرقة وهي خطأ جسيم يتحمل الناقل تبعته كاملة([7]).
ولأجله فقد سعى المشرع المغربي على الاعتماد بفكرة الخطأ الذي لا يغتفر وهي الفكرة الموازية لفكرة عدم الاكتراث، إذ نص المشرع المغربي لقانون الملاحة البحرية مشروع عام 1984 في الفصل 364 على أنه لا تطبق حدود مسؤولية النقل من طرف الناقل أو المنصوص عليها في الفصلين 361 و362 في حالة التدليس أو خطأ لا يغتفر من طرف الناقل أو مأموره أو وكيله إذا ثبت أن الضياع أو الضرر أو التأخير في التسليم ناتج عن فعل أو إهمال ناقل أو مأموره أو وكيله ارتكب إما بنية إحداث هذا الضياع وإما تهورا وهو على علم بأن من المحتمل أن هذا الضياع أو هذا الضرر قد ينتج عن ذلك.
وفكرة الخطأ غير المغتفر المعمول بها في الفقه الفرنسي والفقه المتأثر به كالمغربي يقابلها فكرة عدم الاكتراث في الفقه الانجليزي([8]) والذي تأثرت به بعض القوانين العربية فأخذ بهذه الفكرة عدم الاكتراث التي سنوضحها.
ثانيا: عدم الاكتراث (الخطأ غير المغتفر)
يعد عدم الاكتراث[9] أو ما يُصطلح عليه قانونا بـالتصرف بتهور مع الإدراك بأن ضرراً قد يحدث، أحد أوجه الخطأ الجسيم الذي يرتقي، في بعض السياقات القانونية، إلى مرتبة الغش أو العمد، ويُفضي إلى نفي الإعفاء أو تحديد المسؤولية المقررة لصالح الناقل البحري بموجب الاتفاقيات الدولية أو القوانين الوطنية. ويقصد بعدم الاكتراث أن يكون الناقل، أو من يمثله، على علم فعلي أو ضمني بأن سلوكه أو امتناعه عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة من شأنه أن يعرّض البضاعة للضرر، ومع ذلك يمضي في الفعل أو الإهمال دون مبالاة.
وقد أكدت اتفاقية هامبورغ (1978) وقواعد روتردام (2008) هذا المفهوم بصيغة صريحة، حيث نصّتا على أن الناقل لا يمكنه التمسك بأي قيد على المسؤولية إذا ثبت أن الضرر ناتج عن تصرف بعدم اكتراث مقرون بالعلم المحتمل بالخطر. وهذا يُعبّر عن توجه حديث في القانون البحري نحو توسيع نطاق مساءلة الناقل في الحالات التي يظهر فيها سلوكه استخفافاً واضحاً بالتزاماته المهنية.
كما ليس خفيا تأثر القانون المغربي بالفقه القانوني الفرنسي وكذلك تأثر بعض القوانين العربية بالفقه والقانون الانجليزي، وكما أسلفنا بأن الفقه الانجليزي يأخذ بفكرة السلوك الشائن لحرمان الناقل من الاستفادة من تحديد المسؤولية بعنصريها العمد وعدم الاكتراث ويقابلها في الفقه الفرنسي فكرة الغش وفكرة الخطأ غير المغتفر([10]).
ومع أن قانون التجارة البحرية المغربية من ظهير 31 مارس 1949 قد نص على الغش والخطأ الغير المغتفر كحالات مستثناة من مبدأ تحديد مسؤولية الناقل البحري كما سلف بيانه، فإن مشروع قانون الملاحة البحرية المغربي عام 1984 قد اعتد بفكرة الخطأ غير المغتفر لحرمان الناقل البحري من الاستفادة من مبدأ تحديد المسؤولية([11]).
وعدم الاكتراث والخطأ غير المغتفر يتحققان عندما يعلم الناقل بأنه من المحتمل وفقا لمجريات الأمور أن يترتب على فعله أو امتناعه الإرادي كهلاك أو تلف البضاعة محل عقد النقل أو تأخير وصولها ويقدم مع ذلك على ارتكاب الفعل أو الامتناع غير المكترث بالضرر الذي سوف يحدث([12]).
بالتالي فعدم الاكتراث أو الخطأ غير المغتفر يتحقق في أنه في حالة العمد يعلم الناقل على وجه أكيد أن من شأن فعله أو امتناعه حدوث الهلاك أو التلف أو التأخير أما حالة عدم الاكتراث فانه يجب عليه أن يعلم احتمال حدوث ضرر سينتجه فعله أو امتناعه عن الفعل([13]).
وعدم الإكتراث أو خطأ الغير المغتفر يختلف أيضا عن الخطأ الجسيم في أن هذا الأخير يتوافر، حيث أن الناقل يعلم باحتمال وقوع الضرر كنتيجة لفعله أو امتناعه دون أن يكترث لذلك بين عدم الاكتراث أو الخطأ غير المغتفر كما أنه تتحقق بعلمه احتمال وقوع الضرر وبوجوب أن يعلم ذلك أيضا([14]).
المحور الثاني: تقديم الشاحن بيان بطبيعة البضاعة وقيمتها
ينص الفصل 266 من القانون البحري المغربي على كون الناقل لا يلزم إلا بمبلغ 1000 درهم الواحد، أما إذا عينت القيمة في تذكرة الشحن فان المسؤولية تحدد بالقيمة المصرح بها.
بالتالي فإن القانون المغربي اعتد فقط بذكر القيمة ولم يحدد بيان طبيعة البضاعة كما ذهبت إليه بعض القوانين العربية بحسب ما أسلفنا، كما أن التصريح بقيمة البضاعة لا يكون إلا بذكره في سند الشحن بحسب النص أعلاه، ومن الطبيعي أن يكون ذلك التصريح قبل الشحن لأن السبب في قيام الناقل بتعويض كامل للضرر يتمثل في أن الشاحن يكون قد نبه الناقل إلى البضاعة المراد نقلها حتى يتخذ الاحتياطات الكافية للعناية بها والحفاظ عليها وأن يقوم بتأمين مسؤوليته إذا كانت قيمتها عالية([15]).
وعلى هذا الأساس فان مبدأ التحديد القانوني للمسؤولية يتعطل عند التصريح بقيمة البضاعة في سند الشحن، وهذا ما أكدته استئنافية البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 17/1/1988 في الحيثية:”…. وحيث أن تمسك الناقل البحري بمقتضيات الفصل 226 من قانون التجارة البحرية لا محل لاعمالها، إذ بالرجوع إلى وثيقة الشحن على قيمة البضاعة…… وبالتالي فان ذلك التنصيص كافي لإستبعاد تطبيق مقتضيات الفصل المذكور….([16])
لكن ما الحكم إذا اقتصر الشاحن على بيان مراجع فاتورة الشراء في وثيقة الشحن دون تحديد قيمة البضاعة، فهل يحرم الناقل البحري في مثل هذه الحالة من التمسك بمبدأ التحديد القانوني للمسؤولية ؟
وهل تضمين سند شحن مراجع فاتورة الشراء يغني في حد ذاته عن التصريح بالقيمة؟
بالرجوع لمقتضيات الفصل 266 الذي صرح بأن يذكر في تذكرة الشحن أي سند شحن قيمة البضاعة وذلك لكي لا تصبح مسؤولية الناقل محدودة ولكي يكون مسؤولا عن التعويض الكامل، قد ثار خلاف في أن بيانات البضاعة بما فيها القيمة، مدونة في فواتير تلك البضاعة ولم يشار في سند الشحن إلا إلى مراجع فاتورة الشراء كرقم الفاتورة ومصدرها، فهل ذلك يكفي ليكون الناقل البحري ملزما بالتعويض الكامل أم أنه يستفيد مع ذلك من حالة تحديد المسؤولية؟
بخصوص هذه الحالة فقد ذهب رأي إلى أنه لا يغني ورود البيان بفاتورة الشراء وذكر رقمها بسند الشحن أو أية ورقة أخرى مثل الاعتماد المستندي أو الاستيراد أو الشهادة الجمركية([17]) وهو ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي المصري([18]).
ورأي آخر يرى بأنه إذا تضمنت وثيقة الشحن مراجع فاتورة الشراء فإن ذلك يعتبر موازيا للتصريح بقيمة البضاعة، وبالتالي لا يستفيد الناقل البحري من مبدأ التحديد القانوني للمسؤولية بحجة أن هذا الأخير كان على علم بقيمة البضاعة، وبالتالي فان الإدلاء بفاتورة الشراء وحدها دون تضمينها في سند الشحن لا يحرم الناقل الاستفادة من مبدأ التحديد القانوني للمسؤولية([19])، وهو ما استقر عليه اجتهاد استئنافية البيضاء المغربية في قرارها الصادر بتاريخ 18/4/1989م([20]) ،في الحيثية التالية حيث تؤكد المحكمة بالرجوع إلى وثيقة الشحن التي تشير إلى مراجع الفاتورة، وبالتالي فان الربان كان على علم بقيمة البضاعة وحيث أن الاجتهاد المشار إليه من طرف الناقل بصدد تطبيق الفصل 269 قانون تجاري بحري لا ينطبق على النازلة لقيام الفارق، ذلك أنها تشير إلى أنه لا يمكن مواجهة الناقل البحري بفاتورة الشراء باعتبار أنه لم يسبق له الاطلاع عليها، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك إذا نصت وثيقة الشحن على مراجع الفاتورة فان تمسك الناقل بالفصل المذكور سيكون في غير محله.
أما بخصوص اجتهاد المجلس الأعلى فإن قراراته جاءت متضاربة في هذا الصدد فالبعض منها يؤيد اجتهاد استئنافية البيضاء والبعض الآخر يسير عكس ذلك، ففي قرار صادر عنه بتاريخ 18/2/1987م ([21]) ،تضمن الحيثية التالية:” لكن حيث أن القرار المطعون فيه أكد أن تذكرة الشحن تحمل بيانات إضافية عن نوعية البضاعة وإلى مراجع استنادا فيصبح الأصل، واعتبر أن تلك البيانات تشكل تصريحا بالقيمة وهذا ما يدخل تحت السلطة التقديرية لقضاة الموضوع…”.
في حين أن قرارات أخرى صارت عكس ذلك وأكدت على أن مقتضيات الفصل 206 بحري مغربي لم تبين بوجود بديل آخر يقوم مقام تعيين القيمة وهذا ما تضمنه القرار الصادر في 20/9/1989 في الحيثية الثالية:”… لكن حيث أنه خلافا لما تعيبه الطاعنة فإنه بالرجوع إلى وثيقة الشحن حتى يكون كلا من المجهز والربان مسؤولا في حدود قيمتها وأنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 266 من القانون التجاري البحري، فانه لم يرد في الفصل المذكور ما يشعر ببديل آخر يقوم مقام تعيين القيمة في وثيقة الشحن حتى يمكن القول بأن الاشارة إلى مستندات أخرى قد تغني عن تعيين القيمة…” . ([22])
وهكذا فقد رجح بنونة يونس([23]) الرأي الثاني ونحن بدورنا نؤيده لاعتبارات تتمثل في:
1- أن مقتضيات الفصل 266من القانون البحري المغربي تعد من النظام العام فلا يجوز التوسع في تفسيره أو تأويله.
2 – يكون الناقل على علم بقيمة البضاعة ما دامت وثيقة الشحن تتضمن مراجع فاتورة الشراء يصطدم مع مقتضيات الفصل 266، ذلك أن العبرة من عدم تضمين وثيقة الشحن قيمة البضاعة هو تهرب الشاحن من تسديد رسم إضافي مسمى، وأنهم معاملة له بنقيض قصده، منح المشرع للناقل البحري حق الاستفادة من مبدأ تحديد القانون وأن هذا التفسير هو الذي يتعين الأخذ به وإلا ستظل مقتضيات الفصل غير واضحة ما دام الشاحن سيتهرب من تسديد الرسم المذكور وسيكتفي بالإشارة إلى مراجع فاتورة الشراء في وثيقة الشحن.
3 – أن فاتورة الشراء لا تهم سوى طرفيها وهو البائع والمشتري، أما الناقل البحري فهو طرفا أجنبيا عنها وكذا عن فاتورة الشراء وبالتالي لا يمكن مواجهته بها.
أولا- أساس عدم تحديد مسؤولية الناقل في حالة تقديم بيان بطبيعة البضائع وقيمتها.
يرجع السبب في عدم تحديد مسؤولية الناقل في هذه الحالة إلى أن الشاحن يكون قد نبه الناقل بخصوص البضاعة المراد نقلها حتى يتخذ الاحتياطات الكافية للعناية بها والحفاظ عليها، أو أن يقوم الناقل بالتأمين على مسؤوليته إذا كانت قيمتها عالية ونقل تكاليف التأمين إلى الشاحن في صورة زيادة أجرة النقل عن الأجرة المعتادة، فالبيان الخاص بطبيعة البضاعة وقيمتها لا يعد أن يكون اتفاق بين الشاحن والناقل على تقدير قيمة البضاعة محل عقد النقل البحري عند حدوث هلاك أو تلف أثناء النقل، ويجب أن يكون هدف البيان الذي يقدمه الشاحن هو تعديل أحكام المسؤولية أي الحصول على تعويض كامل للضرر الذي لحق الشاحن ولو كان هذا التعويض يفوق التحديد القانوني لمسؤولية الناقل، فاذا كان الهدف من بيان قيمة البضاعة هي الإجراءات التي تتطلبها اللوائح الجمركية أو لأغراض التأمين أو لأغراض أخرى متشابهة فان الناقل لا يسأل في هذه الحالة عن تعويض كامل الضرر لكون في ذلك إدلاء غير صحيح وسنناقش ذلك عند تناولنا لعبء الاثبات([24]).
- عبء الاثبات
يعتبر عبء الإثبات من المسائل الجوهرية في تحديد مسؤولية الناقل البحري للبضائع، نظرا لما يترتب عليه من آثار قانونية حاسمة في النزاع بين الشاحن أو المرسل إليه من جهة، والناقل من جهة أخرى. وبموجب القواعد العامة وأحكام الاتفاقيات الدولية كاتفاقية لاهاي وفيسبي، واتفاقية هامبورغ، يتحمل الدائن بالتعويض (أي الشاحن أو المرسل إليه) عبء إثبات أن البضاعة قد سُلّمت للناقل في حالة سليمة، وأنها وصلت إلى وجهتها تالفة أو ناقصة أو لم تصل مطلقاً، وأن الضرر حصل أثناء فترة تحمّل الناقل للمسؤولية.
بمجرد تحقق هذه العناصر، يُفترض قيام مسؤولية الناقل، وينتقل عبء الإثبات إليه كي يُثبت أن الضرر لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه، أو أنه ناتج عن أحد الأسباب القانونية المعفاة من المسؤولية، مثل القوة القاهرة، أو الخطأ الملاحي، أو العيوب الكامنة في البضاعة.
ويلاحظ أن توزيع عبء الإثبات في هذا المجال يخضع لمبدأ التوازن بين الطرفين: فالشاحن لا يُطلب منه سوى إثبات وجود الضرر وزمان حصوله، بينما يُلزم الناقل بإثبات السبب المعفي من المسؤولية، نظراً لكونه الأقدر على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بظروف النقل والتخزين والإبحار.
أما في حال ادعاء الشاحن بأن الضرر ناتج عن عمد أو غش أو خطأ جسيم أو عدم اكتراث من جانب الناقل، فإن عبء الإثبات يعود مجدداً إلى الشاحن، ويُطلب منه تقديم أدلة قاطعة أو قرائن قوية، وهو أمر بالغ الصعوبة في كثير من الحالات، خصوصاً عندما تكون الوقائع تحت السيطرة الفعلية للناقل.
ويبرز من ذلك أن عبء الإثبات في مسؤولية الناقل البحري يقوم على مبدأ التناوب والتدرج، ويُشكّل ركيزة أساسية في الحماية القانونية الممنوحة لأطراف عقد النقل البحري، وفي التوفيق بين الاعتبارات التجارية ومتطلبات العدالة والضمان
إن لم يكن القانون البحري المغربي قد نص على ذلك صراحة في الفصل 266 منه فاننا ننتقل إلى القواعد العامة للمسؤولية التي تقضي بعدم مسؤوليته عن خطأ المتضرر ذاته وبالتالي فان من حق الناقل إثبات خلاف ما ورد في السند من بيان عن قيمة البضاعة ومع ذلك فان النص بالعقوبات الواردة في الفصل 269 بحري مغربي يؤكد ذلك.
فما هو الشأن أن يكون إدراج بيان خاطئ من قبل الشاحن بنية منه أو بسوء نية.
فحسن نية الشاحن أمر مفترض، فاذا أثبت الناقل أن قدر الضرر أقل من التعويض المتفق عليه فانه لا يلزم إلا بقدر الضرر الفعلي ولو تجاوز التحديد القانوني مادام الشاحن حسن نية أي أن ذلك لا يؤثر في الاتفاق بين الناقل والشاحن على التعويض الكامل عن الضرر غير أن القانون البحري المغربي قرر جزاء يترتب على الشاحن الذي أدلى ببيان خاطئ بحسن نية، وذلك بإلزامه بدفع ضعف أجرة النقل للناقل وهو ما نص عليه الفصل 269 من القانون البحري الذي ينص على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 450 من القانون الجنائي كل شخص خدع أو حاول أن يخدع مجهز السفينة أو تابعيه حول نوع البضائع المشحونة أو قيمتها أو كميتها وذلك بواسطة تصريح صادر عنه بسوء نية أما متى كان تصريح المخطئ حول نوع البضائع المشحونة أو قيمتها أو كميتها صادر عن حسن نية فان الجزاء الذي يترتب على ذلك هو وجوب أداء أجرة النقل المضاعفة.
أما في حالة أن يثبت الناقل أن الشاحن قد أدلى بتلك البيانات عن سوء نية كان بقصد الإضرار به([25]) فان القانون المغربي يعفي الناقل من مسؤوليته تماما عن الضرر الحاصل في البضاعة، ويعتبر هذا الإعفاء بمثابة عقوبة مدنية للشاحن([26]) ويكون الناقل غير قادر حتى من أن يتمسك بمبدأ تحديد المسؤولية لكونه معفى منها أصلا لسوء نية الشاحن.
ثانيا- حجية البيان عن طبيعة البضاعة وآثره القانوني
يُعد بيان الشحن (أو سند الشحن) من أبرز الوثائق البحرية التي تلعب دوراً محورياً في إثبات التزامات الناقل البحري وتحديد نطاق مسؤوليته، حيث يُعتبر بمثابة قرينة كتابية تُثبت تسلم البضائع من طرف الناقل بحالة معينة، ووعده بتسليمها في الوجهة المحددة، إلى المرسل إليه أو من ينوب عنه. وتتمثل حجية البيان، خصوصاً في البيانات المتعلقة بوصف البضاعة وحالتها وعدد الطرود، في أنها تُشكّل دليلاً ظاهرياً لصالح الشاحن أو الحامل الشرعي لسند الشحن.
فوفقاً لما تقرره اتفاقية لاهاي (1924) وتعديلاتها في فيسبي، فإن البيانات التي يتضمنها سند الشحن تعتبر حُجّة على الناقل ما لم يثبت عكسها، ولا سيما إذا كان السند قابلاً للتداول وقد تم تسليمه إلى طرف ثالث حسن النية. وهذا يعني أن الناقل مُلزم بما ورد في البيان ما لم يثبت أن تلك البيانات كانت خاطئة وتم إدراجها بناءً على معلومات الشاحن، أو أنها كانت خاضعة لتحفظ صريح.
وتزداد حجية البيان قوة في حالة وجود توقيع الناقل أو من يمثله على السند دون إبداء تحفظ، مما يُفسر قانوناً على أنه إقرار ضمني بسلامة البضاعة كما وصفت. وفي المقابل، إذا تضمّن البيان تحفظات صريحة بشأن حالة البضاعة أو مقدارها، فإن حجيته تصبح قابلة للطعن من قبل الشاحن، شريطة أن يُثبت أن تلك التحفظات غير مبررة أو مفتعلة.
ومن ثم، فإن حجية البيان في مسؤولية الناقل البحري لا تقتصر على إثبات العلاقة التعاقدية فحسب، بل تمتد إلى تحديد نطاق هذه المسؤولية، ومدى التزام الناقل بتسليم البضائع وفقاً للشروط والمواصفات المعلنة. ويُعد البيان بالتالي من وسائل الإثبات الأساسية في النزاعات المتعلقة بتلف أو فقدان البضاعة، وله وزن قانوني معتبر أمام المحاكم البحرية.
فإذا ما توافر في البيان قيمة البضاعة وطبيعتها للشروط السابق بيانها([27]) فان مقتضى
ذلك حرمان الناقل البحري من التحديد القانوني للمسؤولية وذلك في دعوى المسؤولية
المرفوعة عليه من الشاحن أو المرسل إليه([28]).
أما إذا حصل هلاك كلي للبضاعة فان الناقل يلتزم بأداء كامل للقيمة المعلنة في صنع الشحن، وإذا كان هناك هلاكا جزئيا أو كان تلف، فانه يلتزم بتعويض نسبي إعمالا لقاعدة النسبية فاذا ما حصل بصدد طرد هلاك جزئي بنسبة 50% فان الناقل يلتزم بأداء قيمة 50% من ثمن الطرد المثبتة في سند الشحن وقاعدة النسبية هذه لا مجال لإعمالها في تحديد القانون للمسؤولية في حالة تطبيق التحديد القانوني للمسؤولية فإذا حصل بصدد طرد جزئي بنسبة 50% مثلا، فان الناقل يلتزم مع ذلك بكامل التحديد القانوني المقرر للطرد هو 1000 درهم مغربي، طالما أن الضرر الحاصل لا يقل عن هذا المبلغ والفارق بين الآخرين يبدو مشروعا لاطالما أنه في حالة ذكر قيمة البضاعة بسند الشحن، فان ذلك يعني أن الطرفين قد قرر إستبدال التعويض([29]) الحقيقي بدلا عن التعويض المحدد الذي قرره القانون.
خاتمة
في ضوء ما سبق بيانه، يتضح أن مبدأ التحديد القانوني لمسؤولية الناقل البحري، رغم ما يتمتع به من أهمية كبيرة في إرساء نوع من التوازن بين أطراف عقد النقل البحري، ليس مبدأ مطلقا أو جامدا، بل هو مبدأ نسبي يخضع لعدد من القيود والاستثناءات التي تفرض تحقيقا لمتطلبات العدالة وحماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وهو عادة الشاحن أو المرسل إليه.
كما أقر المشرع، سواء في الاتفاقيات الدولية أو في التشريعات الوطنية، جملة من الحالات التي يستثنى فيها الناقل من الاستفادة من حدود المسؤولية المحددة قانونا، وعلى رأسها حالات الغش والخطأ الجسيم، أو الإخلال الجسيم بالتزاماته الجوهرية. وتعد هذه الاستثناءات وسيلة فعالة لضمان ألا تستخدم حدود المسؤولية كغطاء للتنصل من الالتزامات أو للإفلات من المساءلة في حالات السلوك غير المشروع.
كما تعكس هذه الاستثناءات سعي التشريعات البحرية إلى تحقيق مبدأ العدالة التعاقدية، من خلال عدم السماح للناقل البحري بالاحتماء بمظلة التحديد القانوني عندما يتصرف على نحو ينطوي على تهاون جسيم أو نية للإضرار.
ومن جهة أخرى، فإن وجود هذه الاستثناءات يدفع الناقلين إلى توخي مزيد من الحذر والانضباط في تنفيذ عمليات النقل، ويساهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة في الملاحة البحرية.
وعليه، فإن فهم هذه الاستثناءات ليس مجرد جانب تفصيلي في دراسة مسؤولية الناقل البحري، بل هو أمر جوهري لا غنى عنه في تقييم مدى فعالية النظام القانوني البحري في تحقيق العدالة بين الأطراف، وضمان عدم تعسف أي طرف في استخدام مركزه التعاقدي.
كما أنه يمثل مدخلا مهما لإعادة النظر في حدود المسؤولية في ظل المتغيرات المعاصرة في التجارة البحرية والنقل الدولي، وخاصة مع التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجيا في سلاسل الإمداد العالمية.
لائحة المراجع
لائحة المراجع باللغة العربية
- كمال حمدي، القانون البحري ، مسؤولية النقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ، منشأة المعارف الاسكندرية 1995.
- بنونة يونس، مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون المغربي دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، المطبعة السريعة 1993.
- رفعت فخري أبادير، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، القاهرة،1992.
- زكي الشعراوي، القانون البحري- السفينةّ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.
- سعد يحيى، مسؤولية الناقل البحري وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر (اتفاقية هامبورغ)،منشأة المعارف، الاسكندرية، 1976.
- سعد يحيى، مسؤولية الناقل البحري وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر(قواعد هامبورغ)، منشأة المعارف، الاسكندرية،1986.
لائحة المراجع باللغة الانجليزية
- Rowlinson, Mervyn, “Flags of Convenience: The UNCTAD Case”, Maritime Policy and Management, vol. 12, 1985.
- Sturmey, George, S, “The Code of Conduct for Liner Conférences: a 1985 View”, Maritime Policy and Management, vol. 13, 1986.
- () كمال حمدي، القانون البحري ، مسؤولية النقل البحري للبضائع في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ، منشأة المعارف الاسكندرية 1995، ، ص 525. ↑
- () يعد السلوك الشائن من الظواهر السلوكية التي تثير إشكاليات متعددة على المستويين القانوني والأخلاقي، لما له من أثر مباشر في الإخلال بالنظام العام، وتهديد القيم المجتمعية، وانتهاك قواعد الانضباط والسلوك القويم. ويكتسي هذا المفهوم طابعاً نسبياً من حيث تحديد طبيعته وحدوده، إذ يختلف من بيئة اجتماعية إلى أخرى، ومن سياق قانوني إلى آخر، غير أن القاسم المشترك يتمثل في كونه سلوكاً يُخلّ بالآداب العامة أو يُنافي واجبات اللياقة والاحترام، سواء في الفضاء العام أو في إطار علاقة مهنية أو مؤسساتية.
بنونة يونس، مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون المغربي دراسة مقارنة مع اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، المطبعة السريعة 1993،، ص150. ↑
- () كمال حمدي، القانون البحري 2003 ،مرجع سابق، ص 528. ↑
- () وهذا الجدل يثور داخل اتجاه القوانين الرومانية أما اتجاه القوانين الأجلوساكسونية فهذه الأنظمة لا تعرف أصلا فكرة الغش أو فكرة الخطأ الجسيم لأنها تأخذ بما يعرف بالخطأ الاداري فهذا النظام لا يعرف اصطلاح الخطأ الجسيم وما يوحي به عن تدرج مراتب الخطأ من جسيم إلى يسير إلى يسير جدا إلى تافه وفكرة الخطأ الاداري هي فكرة سلوك الشائع الانجليزية بعنصريها العمد وعدم الاكتراث ويقابلها في الفكر القانون الفرنسي فكرة الغش وفكرة الخطأ غير المغتفر لتكون مقابلا لفكرة عدم الاكتراث الانجليزية ، انظر معاذ عبد الله أحمد فارع، مسؤولية النقل البحري، م س، ص 215- 216.
ويُلاحظ أن بعض الاتفاقيات الدولية، كقواعد هامبورغ وقواعد روتردام، فتحت المجال أمام هذا التوجه، خلافاً لقواعد لاهاي وفيسبي التي ظلت أكثر تشدداً في اشتراط القصد الصريح. ومع ذلك، فإن التمييز بين الغش والخطأ الجسيم لا يزال يثير خلافاً فقهياً وقضائياً، ما يجعل من هذا الموضوع نقطة محورية في النزاعات المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري. ↑
- () بنونة يونس، مسؤولية النقل البحري، مرجع سابق، ص122. ↑
- () قرار المجلس الاعلى رقم 1448 بالتاريخ 27/6/1990 م منشورDMF ص2 ومشار إليه كذلك لدى بنونة يونس، مسؤولية الناقل البحري، مرجع سابق، ص 123. ↑
- () Rowlinson, Mervyn, “Flags of Convenience: The UNCTAD Case”, Maritime Policy and Management, vol. 12, 1985,p86.
- Sturmey, George, S, “The Code of Conduct for Liner Conférences: a 1985 View”, Maritime Policy and Management, vol. 13, 1986.
- إن إدراج “عدم الاكتراث” ضمن أسباب نفي الإعفاء أو التحديد، يهدف إلى حماية مصلحة الشاحن والمرسل إليه، وردع الناقل عن التساهل في تطبيق معايير العناية واليقظة المفروضة عليه بموجب عقد النقل، ويكرّس مبدأ المسؤولية المبنية على السلوك المهني السليم.
ومن أمثلة حالات عدم الاكتراث: ترك البضائع في ظروف تخزين غير ملائمة رغم التنبيه إلى خطورتها، أو إبحار السفينة في ظروف مناخية شديدة السوء دون ضرورة، أو عدم اتخاذ التدابير المعروفة والميسّرة لتفادي التلف رغم العلم بضعف البضاعة. ↑
- () Poirier d’Ange d’Orsay, Philippe, « Les grandes mutations du droit maritime », ADMA, vol. 2, 1975 ,p 103. ↑
- () بنونة يونس، مسؤولية النقل البحري، م س، ص 124. ↑
- () كمال حمدي، القانون البحري 2003، م س، ص 530. ↑
- () معاذ عبد الله أحمد فارغ، مسؤولية النقل البحري للبضائع في القانون البحري اليمني، دراسة مقارنة مع اتفاقيتي هامبورغ لعام 1970 وروتوردام لعام 2008، رسالة ماجستر جامعة عدن 2013- 2014،ص222. ↑
- () كمال حمدي، القانون البحري 2003، م س، ص 531. ↑
- () انظر بنونة يونس، مسؤولية النقل البحري، م س، ص 115. ↑
- () قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 131 في الملف التجاري رقم 502 /83 مشار إليه لدى بنونة يونس، مرجع سابق، ص 116. ↑
- () كمال حمدي، القانون البحري 2003،م س، ص 534. ↑
- () عبود عبد الله مسعد علي، التنظيم القانوني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع، م س، ص 335. ↑
- () بنونة يونس، مسؤولية الناقل البحري، م س، ص 116. ↑
- () قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية 18/4 89 رقم 874 ملف 2187 86 ثم القرار الصادر في 27/5 86 رقم 1091 ملف عدد 1021/ 83 غير منشور. ↑
- () قرار المجلس الأعلى بتاريخ18/2/1987رقم 414 في الملف 7046/ 86 أشار إليه بنونة يونس، م س، ص 117. ↑
- () قرار المجلس الأعلى رقم 1900 الملف عدد 6668/86 ثم القرار الصادر بتاريخ 10/5/1989 رقم 1190 ملف رقم 367/ 86 موجود لدى بنونة يونس، مرجع سابق، ص 118. ↑
- () يونس بنونة، مرجع سابق، ص118 – 199. ↑
- () عبود عبد الله مسعد علي، تنظيم مسؤولية النقل البحر للبضائع، مرجع سابق، ص336.
أنظر في هذا الصدد:
رفعت فخري أبادير، الوجيز في قانون التجارة البحرية المصري الجديد، القاهرة،1992.
زكي الشعراوي، القانون البحري- السفينةّ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.
سعد يحيى، مسؤولية الناقل البحري وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر (اتفاقية هامبورغ)،منشأة المعارف، الاسكندرية، 1976.
سعد يحيى، مسؤولية الناقل البحري وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بالبحر(قواعد هامبورغ)، منشأة المعارف، الاسكندرية،1986. ↑
- () أو التهرب الجمركي أو نحوه. ↑
- () بنونة يونس، مسؤولية النقل البحري، م س، ص 120. ↑
- () تدوين القيمة في سند الشحن قبل عملية الشحن إضافة إلى ما اشترطته بعض القوانين العربية في بيان طبيعة البضاعة وما يخوله الشاحن على نقلها من أهمية خاصة بحسب ما سبق بيانه. ↑
- () عبود عبد الله مسعد علي، التنظيم القانوني لمسؤولية النقل البحري، م س ، ص 336. ↑
- () يعد التعويض أحد أهم الآليات القانونية لضمان جبر الضرر ورد الحقوق لأصحابها، غير أن طبيعة هذا التعويض تختلف باختلاف الأساس القانوني والاتفاقات الناظمة له. وفي هذا السياق، يطرح الفرق الجوهري بين التعويض الحقيقي والتعويض المحدد، حيث يقوم الأول على تقدير الضرر الفعلي الذي لحق بالمضرور، بينما يستند الثاني إلى اتفاق مسبق أو نص قانوني يحدد مبلغ التعويض سلفا بغض النظر عن حجم الضرر الحقيقي. ↑
- عبد العالي برزجو: ترشيد السياسة الجنائية في مجال الأعمال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة المالك السعدي،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2011/2012،ص 10-12. ↑






