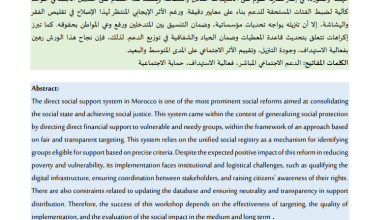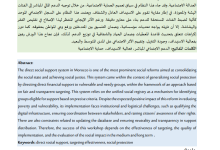دور الإبتكارات في الحد من الأزمات والكوارث – دراسة تطبيقية على دولة الامارات العربية – الأستاذ : راشد سبيت سالمين البدواوي – الأستاذ : سلطان محمد الشحي

دور الإبتكارات في الحد من الأزمات والكوارث )دراسة تطبيقية على دولة الامارات العربية (
The role of innovations in reducing crises and disasters ) An applied study on the United Arab Emirates(
الأستاذ : راشد سبيت سالمين البدواوي
عضو هيئة تدريس – كلية الشرطة أبوظبي
الأستاذ : سلطان محمد الشحي
عضو هيئة تدريس – كلية الشرطة أبوظبي
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 الخاص بشهري أكتوبر نونبر 2024
لتحميل الإصدار المتضمن للبحث :
اضغط هنا
مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 54 أكتوبر – نونبر 2024
رابط Google Scholar
الملخص
تواجه المؤسسات الأمنية في العصر الحديث تحديات متزايدة تتمثل في الأزمات والكوارث المتنوعة، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان. في ظل التغيرات المناخية، تزايد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، وزيادة الأنشطة الإرهابية، أصبحت المؤسسات الأمنية بحاجة إلى تطوير أدواتها واستراتيجياتها للتعامل مع هذه الأزمات بفاعلية. كما تتزايد الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول، مما يشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن الوطني والعالمي.
التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الأمني اليوم هو ضرورة الاستجابة السريعة والدقيقة للأزمات، مع توفير الحماية الفورية للمجتمع وضمان استمرارية الخدمات الحيوية. الهجمات الإرهابية المعقدة والجرائم المنظمة تشكل تهديدات جديدة تتطلب استجابات مبتكرة، في حين أن الكوارث الطبيعية قد تؤدي إلى أضرار واسعة النطاق تتطلب تنسيقًا سريعًا بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية. هذه التحديات دفعت الدول والمؤسسات الأمنية إلى إعادة التفكير في الأساليب التقليدية لتطوير حلول مبتكرة تعزز من قدرتها على التنبؤ والاستجابة للأزمات.
Abstract
Security institutions in the modern era face increasing challenges represented by various crises and disasters, whether natural or man-made. In light of climate change, the increase in natural disasters such as earthquakes and floods, and the increase in terrorist activities, Security institutions need to develop their tools and strategies to deal with these crises effectively. Cybercrime and cyberattacks targeting countries’ critical infrastructure are also increasing, posing a major threat to national and global security.
The greatest challenge facing security work today is the necessity of rapid and accurate response to crises, while providing immediate protection to society and ensuring the continuity of vital services. Complex terrorist attacks and organized crime pose new threats that require innovative responses, while natural disasters may result in widespread damage that requires rapid coordination between various government agencies and institutions.
These challenges have prompted countries and security institutions to rethink traditional methods to develop innovative solutions that enhance their ability to anticipate and respond to crises.
المقدمة
أصبح من الضروري الاعتماد على الابتكارات التكنولوجية والإدارية للتغلب على هذه الأزمات والكوارث. والتحول الرقمي والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أصبحا عاملين أساسيين في تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة للتحديات الأمنية. ومن خلال استخدام تقنيات متقدمة مثل الطائرات بدون طيار (Drones) لمراقبة المناطق الواسعة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الكبيرة في الوقت الحقيقي، باتت المؤسسات الأمنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ التدابير الوقائية قبل حدوث الأزمات.
والتقدم التكنولوجي لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل أيضًا تطوير أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الموارد بكفاءة خلال الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل. هذه الأنظمة تتيح للمؤسسات الأمنية التحرك بسرعة وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لضمان الحد من الخسائر البشرية والمادية. وفي هذا السياق، تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد من خلال تبني وزارة الداخلية سلسلة من الابتكارات التي تسهم في مواجهة الكوارث بكفاءة عالية، مثل استخدام أنظمة الإنذار الذكية وتقنيات إدارة الأزمات المتكاملة.
وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور الابتكار في تحسين العمل الأمني، مع التركيز بشكل خاص على النماذج المبتكرة التي تم تبنيها في العمل الأمني عالميًا. كما تستعرض الدراسة ممارسات وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف ساهمت هذه الابتكارات في تعزيز الاستجابة للكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها. ومن خلال دراسة هذه النماذج والممارسات، سيتم تقديم تحليل عميق لدور الابتكار في مواجهة الأزمات والكوارث وتقديم توصيات من شأنها تعزيز الفاعلية الأمنية في المستقبل.
ثانياً: مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في التحديات المعقدة والمتزايدة التي تواجه المؤسسات الأمنية في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية والبشرية في العصر الحديث. ومع تزايد التهديدات الأمنية، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية مثل الإرهاب، الجرائم الإلكترونية، أو الكوارث الطبيعية، يبرز السؤال حول مدى فعالية الأساليب التقليدية في التصدي لهذه الأزمات. وفي هذا السياق، أصبح الابتكار عنصرًا أساسيًا لتعزيز فعالية العمل الأمني والقدرة على التنبؤ والاستجابة للأزمات بشكل أسرع وأكثر فعالية. ولكن على الرغم من التقدم التكنولوجي، فإن هناك تحديات تتمثل في عدم كفاية الابتكارات المستخدمة أو محدودية تطبيقها بشكل صحيح في بعض المؤسسات الأمنية. وتركز هذه الدراسة على كيفية توظيف الابتكار في العمل الأمني، ودور وزارة الداخلية الإماراتية في تبني الابتكارات لمواجهة الكوارث. والمشكلة الرئيسية للبحث تكمن في تحديد كيف يمكن لهذه الابتكارات أن تساعد في الحد من تأثير الأزمات والكوارث، وما إذا كانت الحلول الحالية كافية لتغطية الاحتياجات المستقبلية، أم أن هناك حاجة لمزيد من الابتكار والتطوير.
ثالثاً: تساؤلات الدراسة
- كيف ساهمت الابتكارات في تحسين فعالية مؤسسات الأمن في مواجهة الكوارث؟
- ما هي ممارسات وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الابتكارات للحد من تأثير الكوارث؟
- ما هي أنواع الابتكار الأكثر فعالية في العمل الأمني؟
- كيف يمكن تعزيز الابتكار في المؤسسات الأمنية للتصدي للتحديات المستقبلية؟
رابعاً: أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتعلق بالابتكار ودوره في العمل الأمني، ومنها:
- استعراض الابتكارات التكنولوجية والإدارية المستخدمة في المؤسسات الأمنية، وتحديد مدى تأثيرها في تحسين الأداء الأمني.
- تحليل نماذج الابتكار في العمل الأمني محليًا وعالميًا، مع التركيز على تطبيقاتها في مواجهة الأزمات والكوارث.
- تقييم ممارسات وزارة الداخلية الإماراتية في تبني الابتكارات للحد من تأثير الأزمات والكوارث وتعزيز الأمن.
- تقديم توصيات لتطوير الابتكارات في العمل الأمني، بهدف تعزيز فعالية المؤسسات الأمنية في التصدي للتحديات المستقبلية.
خامساً: أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من الحاجة الملحة لتحسين العمل الأمني في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الابتكار. وتشمل أهمية الدراسة ما يلي:
- إسهامها في تحسين القدرة الأمنية: من خلال تحليل الابتكارات المستخدمة وتقديم اقتراحات لتطويرها، يمكن أن تساعد الدراسة في تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية في التنبؤ والاستجابة الفعالة للأزمات.
- تسليط الضوء على التجربة الإماراتية: تُبرز الدراسة ممارسات وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة في استخدام الابتكارات للحد من الكوارث، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في مجال الأمن.
- تعزيز الفهم الأكاديمي والعملي: تقدم الدراسة فهمًا أعمق لكيفية تأثير الابتكارات التكنولوجية والإدارية على الأمن، مما يساعد الباحثين وصناع القرار على اتخاذ إجراءات مدروسة لتحسين العمل الأمني.
- أهمية الابتكار في الأمن الوطني: تهدف الدراسة إلى التأكيد على أن الابتكار هو عنصر محوري في تحسين الأمان والاستقرار، وهو ما يمكن أن يفيد الدول الأخرى في تبني ممارسات مماثلة.
سادساً: منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم وصف الابتكارات وتحليل تأثيرها على العمل الأمني. والمنهج المستخدم سيتضمن:
- جمع البيانات والمعلومات من مصادر متنوعة، مثل المراجع العربية أو الأجنبية، والدراسات السابقة، التي تتناول موضوع الابتكار في العمل الأمني.
- دراسة حالة وزارة الداخلية الإماراتية كمثال تطبيقي لتوضيح كيفية تبني الابتكارات في مواجهة الأزمات والكوارث.
- تقديم توصيات بناءً على التحليل لتطوير الابتكارات في المؤسسات الأمنية.
سابعاً: الدراسات السابقة
دراسة (اللينجاوي، 2023)، وهدفت الدراسة إلى تحليل وفهم قدرات وسلوكيات الذكاء الاصطناعي في قطاع صناعة الأمن والتكنولوجيا. وتتناول الدراسة المعنى الأساسي للذكاء والذكاء الاصطناعي، وتاريخ بدء الاهتمام بهذه التكنولوجيا وأهميتها في تطوير قدرات عمليات الشرطة في مختلف الإدارات. كما تتعمق الدراسة في تحليل التقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه النظام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربة وزارة الداخلية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبالنظر إلى إشكالية الدراسة وتساؤلاتها، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي، لملائمتهما لهذا النوع من الدراسات، بهدف تحليل التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وأوصت الدراسة بضرورة تحليل التحديات التقنية والتكنولوجية التي تواجه صُنّاع الذكاء الاصطناعي في القطاع الأمني والشرطي، وذلك للتغلب على المعوقات التي تواجه الشرطة والأمن في ظل الوضع الراهن، وزيادة الاختراقات الأمنية وتطور وسائل الجريمة التكنولوجية.
وجاءت دراسة (عبد المجيد، علاي، 2023) متفقه مع دراسة (اللينجاوي، 2023)، حيث هدفت الدراسة إلى فهم وتحليل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الجرائم، واستكشاف كيفية الاستفادة القصوى من هذه التقنيات لتحقيق الأمن ومنع وقوع الجريمة. بشكل عام، تسعى الدراسة إلى تحديد أنواع تطبيقات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في عمليات التحري والاستدلال، وكذلك في حل ألغاز القضايا الكبيرة والغامضة المتعلقة بجرائم المخدرات. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي. وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها: استخدام قدرات أنظمة التعرف على الوجه والهوية الرقمية، بما يساعد الأجهزة الأمنية في التعرف على الأشخاص المطلوبين وجمع المعلومات عنهم لحفظ الأمن العام ومنع وقوع الجرائم. كما توصلت الدراسة إلى أن استخدام الروبوتات الشرطية والسيارات ذاتي القيادة والطائرات المسيرة تساعد في سرعة القبض على الجناة ومنع حدوث الجريمة، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. وقد أوصت الدراسة بضرورة ربط تقنيات الذكاء الاصطناعي بقواعد وأنظمة البيانات في أجهزة الشرطة والمعلومات لتسريع تحقيق النتائج الأمنية وحفظ الأمن داخل المجتمعات، وذلك من خلال إنتاج تحليلات حقيقية قائمة على الأدلة والبيانات الموثوقة.
ودراسة (J. Glantz, and others,2020 ) بعنوان ” استخدام الطائرات بدون طيار في إدارة الكوارث”. حيث تستعرض الدراسة استخدام الطائرات بدون طيار “الدرونز” في إدارة الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ وإعادة الإعمار. وتهدف الدراسة إلى استعراض كيفية استخدام تقنية الدرونز لتحسين القدرة على الاستجابة للكوارث وتوفير صورة شاملة ودقيقة للمناطق المتضررة وتعزيز عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: يمكن استخدام “الدرونز” للبحث عن الناجين والمفقودين في مناطق الكوارث. يتم تجهيز “الدرونز” بأجهزة استشعار مثل الكاميرات الحرارية والكاميرات عالية الدقة لتحديد المواقع الحيوية وتوفير صور ومقاطع فيديو في الوقت الحقيقي للفرق الإغاثية. كما يمكن استخدام الدرونز للمسح الجوي وتقييم الأضرار في المناطق المتضررة. يمكن للكاميرات عالية الدقة المثبتة على الدرونز تحديد الأضرار بشكل دقيق وتسهيل عمليات التخطيط والتنسيق للإعمار وإعادة البناء. كما يمكن استخدام “الدرونز” لرصد وتسجيل تقدم عمليات إعادة الإعمار. يمكن استخدام صور الدرونز والمقاطع المصورة لتقييم التقدم وتوثيق التغييرات ومراقبة التطورات المستمرة في المناطق المتضررة. وأوصت الدراسة بتوسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الكاميرات الحرارية والكاميرات عالية الدقة في معدات الطائرات بدون طيار، وتحسين الأجهزة الاستشعارية لزيادة دقة تحديد المواقع وتقديم صور ومقاطع فيديو في الوقت الحقيقي للفرق الإغاثية.
بينما دراسة (الفقي، 2023) جاءت بعنوان “توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الجنائية بين الفرص والتحديات”. وهدفت الدراسة إلى بيان أبرز التحديات القانونية التي تثار عند استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي من قبل جهات الاستدلال والتحقيق والحكم، حتى يتسنى تحليل هذه التحديات ومن ثم النظر في مدى فعالية البنية القانونية الحالية في مواجهتها. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليل. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة عمليات الاستدلال والتحقيق الجنائي. كما أن تحليلات البيانات الضخمة من خلال الذكاء الاصطناعي تقدم معلومات قيمة للمحققين والقضاة لاتخاذ القرارات بشأن الجرائم والعقوبات. وقد أوصت الدراسة بتطوير القوانين واللوائح لضمان حماية الخصوصية ومكافحة التمييز في استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية. ووضع إطار قانوني لمراقبة وتقييم استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية وتطبيق عقوبات على الانتهاكات.
ودراسة ( (Michael D. Carley, 2017 تناولت هذه الدراسة التحولات التي شهدها قطاع الأمن والدفاع مع مرور الزمن، حيث تم الانتقال من الاعتماد على الأساليب التقليدية إلى استخدام الابتكارات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. هدف الباحث إلى فهم كيف تساعد هذه التقنيات غير التقليدية في تحسين عمليات الأمن. وخلصت النتائج إلى أن الابتكار في المجال الأمني يساهم بشكل فعال في الكشف المبكر عن التهديدات وتعزيز المراقبة الأمنية. وقد أوصى الباحث بالاستثمار المستمر في هذه الابتكارات ودمجها مع الاستراتيجيات الأمنية التقليدية.
كما تناولت دراسة (Sarah M. Hayden ,2019 ) على كيفية تأثير الابتكارات في مجال الأمن السيبراني على الأمن القومي، خاصةً في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية. تمحورت أهداف الدراسة حول تقييم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين في الكشف عن التهديدات وحماية البنية التحتية الوطنية. ووجدت النتائج أن هذه الابتكارات عززت بشكل كبير قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة الجرائم الإلكترونية. وكانت التوصيات بضرورة تبني استراتيجيات أمنية وطنية متكاملة تعتمد على الابتكار المتواصل وتطوير القدرات التكنولوجية.
كما استهدفت دراسة (John P. Vincent,2021 ) الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين عمليات الأمن الداخلي. هدفت الدراسة إلى توضيح كيف يمكن لهذه التقنيات تحسين قدرات الأجهزة الأمنية على اكتشاف الأنماط المشبوهة والاستجابة بشكل أسرع للأزمات. وقد أظهرت النتائج أن استخدام هذه الأدوات أدى إلى تحسين سرعة ودقة العمليات الأمنية، وتحديد التهديدات في مراحل مبكرة. وأوصى الباحث بتبني هذه التقنيات على نطاق أوسع في العمل الأمني وتدريب الكوادر على استخدامها بفعالية.
المبحث الأول
مـــاهية الإبتكار
تمهيد:
يُعتبر الابتكار من المفاهيم الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقني. فهو ليس مجرد وسيلة لتطوير المنتجات أو الخدمات فحسب، بل يمثل آلية لتحقيق التفوق التنافسي، وتجاوز الأزمات، وتعزيز القدرات المؤسسية والشخصية. ومع تسارع التغيرات التي يشهدها العالم اليوم، أصبحت القدرة على الابتكار مفتاحًا لتحقيق التميز والاستدامة. ويهدف هذا المبحث إلى استكشاف ماهية الابتكار، من خلال تعريفه واستعراض أنواعه، والنظريات المفسرة له، بما يسهم في تقديم فهم متكامل لدوره وأهميته في تطوير العمليات والأنظمة. وذلك بتقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية:
- المطلب الأول: تعريف الإبتكار.
- المطلب الثاني: أنواع الإبتكار.
- المطلب الثالث: النظريات المفسرة للإبتكار.
المطلب الأول
تعريف الإبتكار
يُعد الابتكار أحد المفاهيم الأساسية التي تشكل الأساس للتقدم والتطور في مختلف المجالات، سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو حتى على المستوى الفردي. في عالم اليوم، حيث تتسارع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، يصبح الابتكار ليس مجرد خيار بل ضرورة استراتيجية تُمكّن المؤسسات من مواكبة التحديات الجديدة وتعزيز تنافسيتها. لذلك، فإن فهم مفهوم الابتكار من جوانبه المختلفة يسهم في توضيح الدور الحيوي الذي يلعبه في تحسين الأداء وتطوير الحلول الإبداعية. وفي هذا المطلب، سيتم تناول تعريف الابتكار من خلال استعراض مجموعة من التعريفات التي قدّمها الباحثون والمفكرون في هذا المجال، مع تقديم تعريف إجرائي واضح يتناسب مع سياق الدراسة.
عرف الإبتكار بأنه “تطبيق خلاق للأفكار بما يزيد من الفعالية والكفاءة والجودة والقدرات لدى وزارة الداخلية على تحقيق رؤيتها ورسالتها والالتزام بقيمها المؤسسية وهي الترجمة الفعلية للأفكار الابتكارية الى خدمات وعمليات” (الطحان، 2024).
ونحن نرى، أن هذا التعريف يركز على تطبيق الأفكار الابتكارية في تحسين الأداء المؤسسي في وزارة الداخلية. إنه تعريف وظيفي وعملي للابتكار، حيث يربطه مباشرة بتحقيق الأهداف المؤسسية مثل الفعالية والكفاءة والجودة. الابتكار هنا ليس مجرد فكرة، بل عملية تحول هذه الأفكار إلى خدمات وعمليات فعالة.
كما عرف بأنه “تجسيد أو تجميع أو تركيب للمعارف ضمن منتجات أو خدمات أو عمليات، تتسم في أنها جديدة وقيمة وأصيلة وتتسم بالقيمة والإبهار” (عابدين، 2024).
ونحن نرى، أن هذا التعريف الابتكار كتجميع وتركيب للمعارف في منتجات أو خدمات جديدة، مع التركيز على الأصالة والقيمة المضافة. إنه تعريف أكثر عمومية ويبرز الابتكار كعملية إبداعية تنطوي على إنتاج شيء مميز وجديد يثير الإعجاب ويضيف قيمة.
كما عرف “الابتكار هو تنفيذ لمنتج (سلعة أو خدمة) أو عملية جديد (جديدة) أو محسن (محسنة) بشكل معتبر، أو أسلوب تسويق جديد، أو أسلوب تنظيمي جديد في ممارسات أعمال أو في تنظيم مكان العمل أو في العلاقات الخارجية “ (أحمد، 2023).
ونحن نرى، أن هذا التعريف يركز على الابتكار في المنتجات والخدمات والعمليات، ويشمل أيضًا الابتكارات في التسويق والتنظيم. يعكس هذا التعريف نطاقًا أوسع للابتكار، حيث يتجاوز المنتجات والخدمات ليشمل العمليات التنظيمية والهيكلية. الابتكار هنا يُعتبر تحسينًا شاملاً في مختلف جوانب الأعمال.
كما عرف بأنه ” قدرة الفرد على تقديم استجابات تتميز بأكبر قدر من الطلاقة الفكرية والمرونة التلقائية والأصالة وذلك كاستجابة لمشكلة أو موقف مثير” (دراكر، 2022).
ونحن نرى، أن هذا التعريف يركز على الجانب الشخصي والفردي للابتكار، حيث يتحدث عن القدرات الفكرية للفرد مثل الطلاقة والمرونة والأصالة. هذا التعريف يُبرز الابتكار كاستجابة ذهنية وحل إبداعي لمشاكل أو مواقف مثيرة، مما يسلط الضوء على الابتكار كقدرة شخصية.
وعرف أيضاً بأنه “الأسلوب الذي يستخدمه الفرد في إنتاج أكبر عدد من الأفكار حول المشكلة التي يتعرض لها الطلاقة الفكرية، وتتصف هذه الأفكار بالتنوع والاختلاف (المرونة) وعد التكرار أو الشيوع (الأصالة)” (جندل، 2022).
ومن خلال تحليل التعريفات المختلفة للابتكار، يبدو أن الابتكار هو عملية متعددة الأبعاد تتجاوز مجرد التفكير الإبداعي إلى تطبيق الأفكار بشكل يحقق قيمة مضافة وفعالية في السياقات العملية المختلفة. هناك جانب تنظيمي يركز على تطوير المؤسسات وتحسين الأداء (كما في تعريف الطحان وأحمد)، وهناك جانب فردي يعنى بقدرة الأفراد على التفكير الإبداعي (كما في تعريف دراكر وجندل). الابتكار ليس فقط إنتاج شيء جديد بل هو عملية تطوير وتحسين مستمر تستجيب لاحتياجات المجتمع أو المؤسسة بطرق أصيلة ومرنة.
وعليه نرى أنه يمكن تعريف الابتكار بأنه “العملية التي يتم فيها تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ملموسة وقابلة للتطبيق تسهم في تحسين الأداء المؤسسي أو حل المشاكل بطرق جديدة ومبتكرة، وتتسم بالأصالة والمرونة والقيمة المضافة سواء على مستوى المنتجات أو العمليات أو التنظيم”. وهذا التعريف الإجرائي يركز على أهمية الابتكار كعملية تفاعلية تجمع بين التفكير الإبداعي والتطبيق العملي من أجل تحقيق نتائج ملموسة قابلة للقياس.
المطلب الثاني
أنواع الإبتكار
يُعد الابتكار ظاهرة متعددة الأبعاد تتخذ أشكالًا وأنواعًا مختلفة بناءً على المجالات التي يُطبق فيها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. يمكن تقسيم الابتكار إلى أنواع رئيسية، منها الابتكار الإداري، الابتكار التقني، والابتكار الإضافي. نستعرض فيما يلي كل نوع بشيء من التفصيل:
يصنف الابتكار إلى ثلاثة أنواع، وفقاً للتقسيم التالي:
أولاً- الابتكار الإداري:
يُعتبر الابتكار الإداري أحد المجالات الحيوية التي يغطيها مفهوم الابتكار بشكل عام، وهو يتعلق بإيجاد حلول إبداعية وفريدة لمشاكل جديدة أو حتى ابتكار طرق جديدة لحل المشاكل القديمة بفعالية. يتميز الابتكار الإداري بقدرته على التوصل إلى علاقات وأنماط تنظيمية جديدة، تُفضي في نهاية المطاف إلى سياسات وأسس تنظيمية مبتكرة، تساعد على تحسين وتطوير الأداء داخل المنظمة (دراكر، 2022).
وفي جوهره، يعكس الابتكار الإداري التفاعل الإبداعي مع البيئة المحيطة بالمؤسسة، سواء من خلال تحسين الطرق الإدارية أو تعزيز الكفاءات داخل المؤسسة نفسها. ومن أهم سمات الابتكار الإداري هو القدرة على نقل الأفكار الجديدة من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنفيذ العملي، حيث تتحول هذه الأفكار إلى خدمات ومنتجات مبتكرة تعزز من كفاءة وفعالية المؤسسة في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها (جندل، 2022).
وهناك عدة عوامل تدفع الأفراد العاملين في المؤسسات نحو الابتكار. هذه الدوافع تكون محفزة إما على المستوى الشخصي أو المؤسسي، وتشمل: (الطحان، 2024)
- تحقيق مراتب علمية مرموقة: السعي نحو اكتساب معرفة جديدة وتطوير الذات يعزز من قدرة الأفراد على الابتكار.
- الشعور بالرضا الشخصي: الرغبة في تحقيق الرضا النفسي والاعتزاز بالذات تمثل دافعًا قويًا للموظفين لتقديم مساهمات مبتكرة.
- الرغبة في تقديم مساهمة قيمة: يسعى الأفراد المبتكرون دائمًا لتقديم حلول ومساهمات جديدة تضيف قيمة إلى المؤسسة.
- معالجة المشاكل المعقدة والغموض: يعزز الابتكار من قدرة الأفراد على فهم المشاكل المعقدة والتعامل مع الغموض بطرق إبداعية.
- خدمة المجتمع: الابتكار الإداري لا ينحصر داخل المؤسسة فقط، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع من خلال تحسين الكوادر الفنية وتقديم حلول مبتكرة للمشاكل الاجتماعية.
ثانياً- الإبتكار التقني:
الابتكار التقني، الذي يُعرف أحيانًا بالابتكار التكنولوجي، يمثل القوة الدافعة وراء تحسين العمليات والخدمات داخل المنظمات والمؤسسات. يتمثل الابتكار التقني في تقديم تقنيات جديدة أو تطوير الأساليب الحالية بهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. هذا النوع من الابتكار يركز على تبني الحلول التقنية التي تمكن المؤسسات من الاستجابة للتغيرات السريعة في السوق وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، مما يضمن لها ميزة تنافسية تفوق غيرها من المؤسسات (السيد، 2019).
والابتكار التقني يُعرف بأنه كل تحسين أو تجديد يحدث داخل المنظمة في الخدمات أو في طرق وأساليب العمل. الهدف الرئيسي للابتكار التقني هو تحسين الأداء العام للمؤسسة، سواء من خلال تحسين كفاءة العمليات أو تقديم منتجات وخدمات جديدة تعزز من تجربة العملاء وتلبي احتياجاتهم بطرق مبتكرة. الابتكار التقني ليس مجرد عملية تطوير داخلية، بل هو أداة لتطوير الميزة التنافسية للمؤسسة، حيث يُمكّنها من البقاء في الطليعة في السوق المتغيرة باستمرار. (الطحان، 2024)
ويعتبر (Daft) أن الابتكار التقني هو عملية فعالة تبدأ من القاعدة وتتحرك نحو الأعلى. ويُفسر هذا المفهوم بأن الموظفين في المستويات الدنيا، الذين يتمتعون بالخبرة الفنية والعملية المباشرة، هم من يولدون الأفكار الإبداعية، ويتم دعم هذه الأفكار من قِبَل الإدارة العليا لتنفيذها. بمعنى آخر، الابتكار التقني ليس عملية تُفرض من أعلى إلى أسفل، بل هو عملية تفاعلية يشارك فيها كل الموظفين، خصوصًا من لديهم الخبرة العملية في المجال التقني. هذه الديناميكية تجعل الابتكار التقني في المؤسسات أكثر فعالية لأنه ينبع من خبرات وتجارب العاملين في الميدان، الذين يفهمون التحديات اليومية ويبحثون عن حلول تقنية لمعالجتها. (الطحان، 2024)
ومن جانبه، يرى (Narquis) أن الابتكار التقني يتمثل في قدرة المنظمة على تبني تقنية جديدة تجعلها تبتعد عن الأنماط التقليدية في العمل. عندما تتبنى المنظمة تقنية جديدة قبل غيرها، فإنها تعد مبتكرة. ومع ذلك، إذا بدأت المنظمات الأخرى بتبني نفس التقنية أو التغيير، فإن هذا يُعتبر “ابتكارًا بالتبني” أو نوعًا من “التقليد”. بمعنى آخر، الابتكار التقني يرتبط بالقدرة على الريادة في اعتماد التقنيات الحديثة، في حين أن المؤسسات التي تأتي بعد ذلك وتقلد هذا الابتكار تستفيد من التغيير دون أن تُعتبر مبتكرة بشكل أصلي (المصري، عامر، 2018)
والابتكار التقني أصبح عنصرًا أساسيًا في عالم الأعمال اليوم. فالتكنولوجيا الحديثة تغيّر باستمرار طريقة عمل المؤسسات وتؤثر بشكل كبير على الكفاءة والإنتاجية. الشركات التي تتبنى الابتكار التقني تستطيع تحسين عملياتها، زيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الشركات أن تُقدم خدمات ومنتجات جديدة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء بطريقة أفضل من منافسيها، مما يعزز مكانتها التنافسية في السوق (السيد، 2019).
ومن الأمثلة على أهمية الابتكار التقني: (الطحان، 2024)
- رفع كفاءة العمل: من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات، يمكن للمؤسسات تحسين سرعة وكفاءة العمل وتقليل الأخطاء البشرية.
- تحسين جودة الخدمات: تقنيات مثل تحليل البيانات الكبيرة (Big Data) تمكن الشركات من تقديم خدمات أكثر تخصيصًا ودقة للعملاء بناءً على بيانات تفصيلية.
- التكيف مع السوق المتغيرة: يساعد الابتكار التقني المؤسسات على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق، سواء كانت هذه التغيرات في احتياجات العملاء أو في المنافسة.
- الاستدامة: الابتكار التقني يمكن أن يسهم في تحسين استدامة العمليات من خلال تقنيات صديقة للبيئة وتوفير الموارد، مما يعزز من مكانة المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولهذا عندما تكون المنظمة رائدة في تبني تقنية جديدة، فإنها تضع نفسها في مقدمة المنافسين. ومع ذلك، فإن مجرد تبني التقنيات الحديثة ليس كافيًا لجعل المؤسسة مبتكرة؛ الابتكار الحقيقي يحدث عندما يتم دمج هذه التقنيات بطرق جديدة وغير تقليدية لتطوير العمليات وتقديم خدمات جديدة. في بعض الأحيان، قد تجد المؤسسات الأخرى هذه الابتكارات فعالة وتبدأ في تقليدها، وهو ما يُعرف بـ “الابتكار بالتبني. (المصري، عامر، 2018)
وعلى سبيل المثال، عندما قامت إحدى الشركات الكبرى بتقديم نموذج لتطبيق تقنية الحوسبة السحابية لتحسين إدارة الموارد، بدأت الشركات الأخرى في تقليد هذا النموذج والاستفادة منه. ورغم أن هذه الشركات التي تبنت التكنولوجيا قد تحسنت بفضل ذلك، إلا أنها ليست مبتكرة بمعنى الريادة، بل تستفيد من الابتكار الذي تم من قبل. (جندل، 2022)
أمثلة على الابتكار التقني في العمل الأمني:
- الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: تستخدم الأجهزة الأمنية اليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات وتحديد الأنماط المشبوهة أو الأنشطة الإجرامية المحتملة. على سبيل المثال، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات كاميرات المراقبة في الوقت الفعلي للكشف عن سلوكيات غير طبيعية أو مشبوهة. كما يمكن تحليل البيانات الرقمية مثل المكالمات الهاتفية أو المحادثات الإلكترونية للكشف عن تهديدات أمنية قبل وقوعها (Kas, M., Khadka, A. G., Frankenstein, W., Abdulla, A. Y., & Kunkel, L. F. (2012). ).
- تقنيات التعرف على الوجوه: تعد أنظمة التعرف على الوجوه واحدة من أبرز الابتكارات التقنية في مجال الأمن. يمكن للأجهزة الأمنية استخدامها في المطارات، الحدود، والأماكن العامة لتحديد الأشخاص المطلوبين أو المشتبه بهم من خلال مقارنة صورهم بقاعدة بيانات المجرمين. هذه التكنولوجيا تعزز من قدرة المؤسسات الأمنية على كشف الأنشطة الإجرامية بشكل سريع ودقيق. (Da Veiga, A. 2019.).
- الطائرات بدون طيار : (Drones) تُستخدم الطائرات بدون طيار في العديد من الأنشطة الأمنية، مثل مراقبة الحدود، الاستجابة لحالات الطوارئ، ومراقبة الأماكن العامة. هذه الطائرات مزودة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة استشعار تمكنها من تقديم رؤى دقيقة وفورية عن المناطق التي يصعب الوصول إليها. كما أنها تستخدم في العمليات الأمنية الحساسة مثل مراقبة التجمعات الكبرى أو البحث عن المفقودين في المناطق الوعرة.
- تقنيات الأمن السيبراني: مع ازدياد التهديدات السيبرانية، أصبحت حماية البيانات والمعلومات الأمنية ضرورة قصوى. الابتكار التقني في الأمن السيبراني يشمل استخدام أنظمة متقدمة للكشف عن الهجمات الإلكترونية والتصدي لها، بما في ذلك الجدران النارية (firewalls)، التشفير، وتكنولوجيا الكشف عن الفيروسات. تعتمد الأجهزة الأمنية أيضًا على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالهجمات الإلكترونية ومنعها قبل حدوثها.
- نظام الإنذار المبكر: تعتمد العديد من الأجهزة الأمنية على أنظمة الإنذار المبكر التي تستخدم أجهزة استشعار وتحليلات البيانات للتنبؤ بالكوارث الطبيعية أو الهجمات الإرهابية. هذه الأنظمة تساهم في توفير وقت كافٍ للاستجابة والتعامل مع التهديدات قبل أن تتفاقم، مما يقلل من الخسائر البشرية والمادية.
- إنترنت الأشياء (IoT) في الأمن: تستخدم الأجهزة الأمنية الآن تقنيات إنترنت الأشياء لربط مجموعة من الأجهزة مثل الكاميرات، المستشعرات، والسيارات، بهدف إنشاء شبكة متكاملة توفر معلومات في الوقت الفعلي حول الأنشطة الأمنية. على سبيل المثال، يمكن لكاميرات المراقبة المثبتة في المدن الذكية الاتصال بشكل تلقائي مع الشرطة أو فرق الاستجابة للطوارئ عند حدوث حادث ما، مما يعزز من سرعة الاستجابة.
- الروبوتات الأمنية: تُستخدم الروبوتات في العمل الأمني للقيام بمهام خطيرة قد تعرض حياة البشر للخطر، مثل تفكيك المتفجرات أو الدخول إلى الأماكن المغلقة والمراقبة. يمكن لهذه الروبوتات أن تعمل في البيئات التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها أو التي تشكل خطرًا على السلامة. (Tolah, A., Furnell, S. M., & Papadaki, M. 2021 ).
ونحن نرى، أن الابتكار التقني في العمل الأمني يُعد ضرورة لا غنى عنها في العصر الحديث لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. ومن خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، وإنترنت الأشياء، تستطيع الأجهزة الأمنية تعزيز كفاءتها، وزيادة قدرتها على الوقاية من الجريمة، وحماية الأفراد بشكل أكثر فعالية. ومع ذلك، فإن الاستخدام المسؤول والمتوازن لهذه التقنيات يظل ضروريًا لضمان الحفاظ على خصوصية المواطنين وتحقيق الفعالية في العمل الأمني.
ثالثاً- الابتكار الإضافي:
الابتكار الإضافي هو نوع من الابتكار الذي يركز على تلبية احتياجات المتعاملين من خلال تقديم خدمات إضافية تجعلهم أكثر رضا وتفاعلاً مع المنظمة. الهدف الأساسي من هذا النوع من الابتكار هو تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الولاء لهم من خلال تقديم تحسينات على الخدمات الحالية أو تقديم خدمات جديدة تتماشى مع توقعاتهم. هذا الابتكار يختلف عن الابتكار الإداري الذي يركز على تحسين العمليات الداخلية، والابتكار التقني الذي يركز على تقديم تقنيات جديدة، حيث أن الابتكار الإضافي يتعامل مباشرة مع المتعاملين ويعتمد على تلبية احتياجاتهم الخاصة. (المصري، عامر، 2018)
وفقًا لما قدمه (Damanpour)، يُعرف الابتكار الإضافي أو المساعد بأنه تلك الابتكارات التي توسع حدود البيئة التنظيمية للمنظمة وتذهب إلى ما هو أبعد من الوظائف الأساسية التي تقوم بها المنظمة. بمعنى آخر، الابتكار الإضافي لا يقتصر على تحسين الأداء الداخلي، بل يسعى إلى توسيع نطاق الخدمات والعمليات بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين واحتياجاتهم المتغيرة. (السيد، 2019).
ما يميز الابتكار الإضافي هو دوره الكبير في تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة. عندما تقوم المنظمة بتقديم خدمات إضافية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المتعاملين، فإن ذلك يخلق تجربة متفردة يصعب تقليدها من قبل المنافسين. على سبيل المثال، المؤسسات التي تقدم خدمات دعم مخصصة لما بعد البيع أو التي توفر خيارات تخصيص المنتج بناءً على تفضيلات المتعاملين، تكون قادرة على تعزيز ولاء العملاء وتحقيق ميزة تنافسية طويلة الأمد. (البارودي، 2021)
ما يجعل الابتكار الإضافي فعّالًا هو اعتماده على رأي المتعاملين بشكل كبير. من خلال جمع التغذية الراجعة من المتعاملين، تستطيع المنظمة تحديد التغييرات والتحسينات التي يحتاجها العملاء، وبالتالي يتم تعديل أو تطوير الخدمات بناءً على هذه الملاحظات. هذا التفاعل المستمر بين المنظمة والمتعاملين يساهم في تحسين الخدمة بشكل مستمر، ويخلق ولاءً طويل الأمد للعلامة التجارية. (جندل، 2022)
من الأمثلة على الابتكار الإضافي ما تقوم به بعض المؤسسات من تقديم خدمات ما بعد البيع، مثل الصيانة المجانية أو الاستشارات، وكذلك توفير قنوات تواصل سريعة وفعّالة تتيح للعملاء الحصول على الدعم في أي وقت. وهذه الابتكارات الإضافية تُعزز من تجربة المتعاملين وتجعلهم يشعرون بأنهم محور اهتمام المؤسسة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة في السوق. (المصري، عامر، 2018)
في مجال العمل الأمني، يُعد الابتكار الإضافي أمرًا حيويًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزيادة رضاهم عن الأجهزة الأمنية. يعتمد الابتكار الإضافي هنا على تقديم خدمات أمنية إضافية أو تحسينات على الخدمات الحالية بما يعزز شعور المجتمع بالأمان ويزيد من الثقة في المؤسسات الأمنية.
أمثلة على الابتكار الإضافي في العمل الأمني:
- الخدمات الاستباقية للأمن المجتمعي: تقوم الأجهزة الأمنية بتقديم خدمات إضافية تهدف إلى تحسين الأمان المجتمعي من خلال تطوير نظم الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحديد المناطق الأكثر عرضة للجريمة. هذه الخدمات الاستباقية تُظهر الابتكار الإضافي في توفير الأمان بشكل مبكر قبل وقوع الحوادث (Gluckman, P. 2020.).
- تحسين قنوات الاتصال مع الجمهور: يمكن للأجهزة الأمنية تبني تقنيات مبتكرة لتحسين قنوات التواصل مع المواطنين والمقيمين، مثل تطبيقات الهواتف الذكية التي تتيح للأفراد الإبلاغ عن الحوادث بسرعة وبسهولة، أو الحصول على خدمات أمنية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة. هذه الابتكارات الإضافية توفر خدمة مريحة وسريعة للمواطنين، مما يزيد من رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة (Vinci, A. 2020.).
- خدمات ما بعد التحقيق: عادةً ما تنتهي العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن بعد إنهاء التحقيق أو الخدمة الأمنية المطلوبة. ومع ذلك، يمكن أن تقدم الأجهزة الأمنية خدمات ما بعد التحقيق، مثل تقديم تقارير دورية عن حالة التحقيق أو متابعة الحالة لضمان عدم تكرار المشكلة. هذه الخدمة الإضافية تساعد على تعزيز الثقة بين المواطنين والجهاز الأمني (Auernhammer, J., & Hall, H. 2014).
- التدريب والتوعية المجتمعية: بالإضافة إلى الخدمات الأمنية التقليدية، يمكن للأجهزة الأمنية أن تقدم برامج تدريب وتوعية للمواطنين حول كيفية حماية أنفسهم وممتلكاتهم. مثلًا، تقديم ورش عمل في المدارس أو المجتمعات حول الأمن الإلكتروني أو طرق الحماية من الاحتيال. هذا النوع من الابتكار الإضافي يخلق مجتمعًا أكثر وعيًا ويدفع الناس للشعور بأن الأجهزة الأمنية ليست فقط للحماية، بل للتعاون معهم لرفع مستوى الأمان الشخصي (Da Veiga, A. 2019.).
- تخصيص الخدمات الأمنية: يمكن للأجهزة الأمنية أن تتبنى مبدأ تخصيص الخدمات لتلبية احتياجات فئات معينة من المجتمع. على سبيل المثال، تقديم خدمات أمنية خاصة لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة عبر إنشاء خطوط هاتف مخصصة أو وحدات متنقلة لتلبية احتياجاتهم. هذه الابتكارات الإضافية تظهر اهتمام الأجهزة الأمنية بتلبية احتياجات جميع الفئات في المجتمع. ومن خلال تقديم خدمات إضافية تُلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين وتزيد من رضاهم، تُحقق الأجهزة الأمنية ميزة تنافسية مستدامة تتمثل في زيادة الثقة العامة وتعزيز الصورة الإيجابية للأجهزة الأمنية. فالمواطنون الذين يحصلون على خدمات إضافية ويشعرون بأن احتياجاتهم مأخوذة في الاعتبار سيكونون أكثر تعاونًا مع هذه الأجهزة، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأمان بشكل عام (Tolah, A., Furnell, S. M., & Papadaki, M. 2021 ).
إن الابتكار الإضافي في العمل الأمني يُعد أداة فعّالة لتعزيز كفاءة الخدمات الأمنية وزيادة رضا المجتمع. من خلال تقديم خدمات إضافية مبتكرة، تتمكن الأجهزة الأمنية من تحسين تجربتها مع الجمهور وتعزيز الميزة التنافسية، مما يجعلها أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة بشكل فعال ومستدام.
المطلب الثاني
النظريات المفسرة للإبتكار
يُعد الابتكار ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها عوامل نفسية، سلوكية، وتنظيمية، مما دفع الباحثين إلى تطوير نظريات متعددة لتفسير هذه الظاهرة. تسعى النظريات المفسرة للابتكار إلى فهم الدوافع الكامنة وراء الابتكار وكيفية نشوء الأفكار الجديدة، بالإضافة إلى تحديد العوامل التي تؤثر على قدرة الأفراد والمؤسسات على الابتكار. في هذا المطلب، سيتم استعراض عدد من النظريات التي تفسر الابتكار من وجهات نظر مختلفة، ومنها نظرية التحليل النفسي، النظرية السلوكية، والنظرية الجشطالتية. وكل نظرية تقدم تفسيرًا فريدًا لكيفية ظهور الابتكار والظروف التي تحفزه، مما يعزز الفهم الشامل لدور الابتكار في تحقيق التطور والتغيير في المجتمعات والمؤسسات. (المصري، عامر، 2018)
أولاً- نظرية التحليل النفسي:
ترى نظرية التحليل النفسي، كما قدمها فرويد، أن الابتكار ينبع من الصراعات النفسية الداخلية التي يعيشها الفرد، وتحديداً من الصراع بين الغرائز الداخلية مثل العدوانية والجنسية وبين ضوابط المجتمع ومطالبه. وفقاً لفرويد، يعد الابتكار شكلاً من أشكال التعبير عن هذه الصراعات، حيث يلجأ الفرد إلى ما يُسمى بـ”الإعلاء” كآلية دفاعية لتحويل دوافعه الغريزية إلى نشاطات إبداعية مقبولة اجتماعيًا. بمعنى آخر، يستخدم الشخص الابتكار كوسيلة للتعبير عن صراعاته النفسية بطرق مقبولة، مثل الإبداع في الفن أو الموسيقى أو الأدب أو العلم (غلوكمان،2019).
يرى فرويد أن الابتكار هو نتيجة للتوفيق بين مبدأ اللذة، الذي يسعى لإشباع الدوافع الغريزية، ومبدأ الواقع، الذي يفرض قيودًا اجتماعية وأخلاقية. وبالتالي، الابتكار يمثل نوعًا من المصالحة بين هذين المبدأين، حيث يتم تحويل الرغبات الغريزية إلى أهداف مقبولة من قبل المجتمع (البارودي، 2021).
ومن جهة أخرى، يعبر كوبية (Kubie) عن رأي مشابه حيث يرى أن منطقة ما قبل الشعور – التي تقع بين الشعور واللاشعور – هي المصدر الأساسي للإبداع. هذه المنطقة تمتلك القدرة على إعادة تنظيم الأفكار وتحويلها إلى أشكال جديدة ومبتكرة. ومن هنا، يُنظر إلى الابتكار على أنه عملية تتوسط بين الوعي واللاوعي، حيث يمكن للأفكار القديمة أن تتشكل بطرق جديدة عبر إعادة تنظيمها في هذه المنطقة الذهنية.
أما يونغ (Jung)، فيضيف بُعدًا آخر للنظرية من خلال تمييزه بين نوعين من اللاشعور: اللاشعور الشخصي، الذي يتفق فيه مع فرويد ويعبر عن التجارب الشخصية للفرد، واللاشعور الجمعي، الذي يحمل تراث الأجيال السابقة وينتقل عبر الوراثة. يعتقد يونغ أن هذا اللاشعور الجمعي هو مصدر الإبداع والابتكار، حيث يحمل الفرد داخليًا تراثًا غنيًا يمكنه استخدامه لإنتاج أفكار جديدة. (المصري، عامر، 2018)
في الوقت الذي تختلف فيه وجهات النظر داخل مدرسة التحليل النفسي حول المصدر الأساسي للإبداع، فإن هناك إجماعًا على الدور الهام الذي تلعبه المحتويات اللاشعورية وما قبل الشعورية في هذه العملية. ومع ذلك، يواجه هذا التفسير بعض الانتقادات، حيث يعتبر البعض أنه يفتقر إلى المنطقية، نظرًا لاعتماده على عناصر غير واعية يصعب قياسها أو التحقق منها علميًا (السيد، 2019).
وفي الختام، تقدم نظرية التحليل النفسي تفسيرًا مثيرًا للاهتمام حول الابتكار، حيث تربطه بالصراعات النفسية الداخلية وآليات الدفاع مثل الإعلاء، مما يفتح المجال لفهم أعمق للدوافع التي قد تحفز الأفراد على الإبداع والابتكار.
ثانياً- النظرية السلوكية:
فسر رواد النظرية السلوكية الابتكار على أنه في جوهره علاقة تشريطية بين مثيرات واستجابات، حيث يعتمد النشاط الابتكاري على تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به. وبالرغم من اتفاقهم على الأسس العامة لهذه الفكرة، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول كيفية تكوين هذه الروابط أو التشريطات. (المصري، عامر، 2018)
يرى ثورنديك أن الثواب الذي يعقب الاستجابة هو العامل الأساسي في تقوية العلاقة بين المثير والاستجابة. وفقًا لثورنديك، إذا تبعت الاستجابة ثواب، فإن الشخص يكون أكثر ميلًا لتكرار تلك الاستجابة في المستقبل عند تعرضه لنفس المثير. من هنا، يمكن تفسير الابتكار على أنه نتاج لتكرار مواقف يتلقى فيها الفرد مكافآت على أفكاره أو تصرفاته المبتكرة، مما يشجعه على تطوير سلوكيات إبداعية جديدة (السيد، 2019).
و”هل وسكينر” كلاهما يؤكد على أهمية الثواب أو التعزيز في تقوية الاستجابة، ولكن مع تركيز على مفهوم اختزال الحاجة. بمعنى أن التعزيز لا يقوي فقط الاستجابة، بل يلبي حاجة أو رغبة معينة لدى الفرد. الابتكار، في هذا السياق، يتم رؤيته كنتيجة لتلبية حاجة داخلية للفرد، سواء كانت الحاجة إلى النجاح، أو التقدير، أو تحقيق الذات. وبالتالي، عندما يحقق الفرد ابتكارًا ويلقى تعزيزًا أو ثوابًا (مثل النجاح أو الاعتراف)، فإنه يصبح محفزًا لتكرار هذا السلوك الابتكاري. ويركز “جاثري” على مفهوم الاقتران الزمني بين المثير والاستجابة. وفقًا له، فإن مجرد حدوث المثير والاستجابة في نفس الوقت أو في تتابع زمني مباشر يؤدي إلى ارتباط بينهما. في سياق الابتكار، هذا يعني أن الفرد قد يطور سلوكيات ابتكارية من خلال التعرض المستمر لمثيرات معينة (مثل التحديات أو المشاكل)، ما يجعله يولد استجابات إبداعية نتيجة لهذا التفاعل المستمر (المصري، عامر، 2018).
ونحن نرى، أنه يُنظر إلى الابتكار من خلال النظرية السلوكية على أنه عملية تشريطية تحدث نتيجة للارتباط بين مثيرات معينة واستجابات الفرد. يختلف الباحثون حول كيفية تشكيل هذا الارتباط، إلا أنهم يتفقون على دور الثواب أو التعزيز في تقوية هذه الروابط. الابتكار هنا ليس مجرد عملية ذهنية أو نفسية داخلية، بل نتيجة للتفاعل المستمر بين الفرد وبيئته، حيث يلعب التعزيز دورًا كبيرًا في دفع الفرد لتكرار السلوكيات الابتكارية وتنميتها.
ثالثاً- النظرية الجشطالية:
ظهرت النظرية الجشطالية في ألمانيا، وتركز على مفهوم الكل والشكل العام بدلاً من الأجزاء الفردية. يُشير اسم “جشطالت” إلى “الصيغة” أو “الشكل”، وتعكس هذه النظرية الاعتقاد بأن الفهم والإدراك الإنساني يتعامل مع البناء الكلي للأشياء بدلاً من تحليلها إلى عناصر وأجزاء صغيرة. وفقًا لهذه المدرسة، فإن الخبرة الإنسانية تأتي ككل واحد، ويجب أن تُفهم ككل، وليس من خلال تفكيكها إلى ارتباطات بين مثيرات واستجابات كما كانت تفعل المدرسة الارتباطية. وأصحاب هذه النظرية رفضوا فكرة أن السلوك يمكن تفسيره فقط بمبدأ المثير والاستجابة، واعتبروا أن السلوك الإنساني سلوك هادف نابع من تفاعل الفرد مع بيئته الكلية. من هنا، تفسر النظرية الابتكار من خلال المجال الإدراكي للفرد المبتكر. حيث تُعتبر عملية الابتكار استجابة للتوترات أو القوى المختلفة التي تتألف منها بيئة الفرد أو مجاله السلوكي. هذه التوترات تستمر إلى أن يتم حلها أو الوصول إلى حالة إشباع من خلال عملية ابتكارية.
وتُعتبر النظرية الجشطالية أن الابتكار يأتي من خلال عملية الاستبصار، وهو الفهم العميق الذي يصل إليه الفرد بعد تفكير في المشكلة وتقييم العناصر المتضمنة فيها. وفقًا لمؤسس النظرية، ماكس فرتايمر، يحدث الابتكار عندما يتم إدراك المشكلة بشكل شامل، ثم يبدأ الفرد في تنظيم العناصر وفهم العلاقات بينها. هذه العملية قد تشمل الابتعاد عن المشكلة لبعض الوقت قبل الوصول إلى ومضة الاستبصار، وهي اللحظة التي يجد فيها الفرد الحل للمشكلة من خلال عملية ذهنية فعالة، مما يؤدي إلى إنتاج ابتكاري.
عوامل تؤثر على الاستبصار (المصري، عامر، 2018):
- مستوى النضج الجسمي: النضج الجسمي يحدد قدرة الفرد على القيام بأنشطة معينة قد تسهم في تحقيق الابتكارات. الأشخاص الذين يمتلكون نضجًا جسميًا مناسبًا يكونون أكثر قدرة على تنفيذ الأفكار الابتكارية.
- مستوى النضج العقلي: الإدراك والقدرة على الاستبصار تختلف باختلاف مستوى النمو المعرفي للفرد. الشخص الذي يمتلك خبرة عالية ونموًا عقليًا متقدمًا يكون أكثر قدرة على تنظيم علاقات مجاله الإدراكي وإدراكها بوضوح.
- تنظيم المجال: يعني تنظيم المجال وجود جميع العناصر اللازمة لحل المشكلة، مثل الهدف، الوسيلة، والدافع. إذا كان أحد هذه العناصر مفقودًا، قد يصعب على الفرد الوصول إلى حل مبتكر.
- الخبرة: تشير إلى الألفة بعناصر الموقف أو المشكلة بناءً على الخبرات السابقة للفرد. عندما يكون المبتكر ملمًا بعناصر المشكلة، يصبح قادرًا على تنظيم وربط الأجزاء المختلفة بطرق أكثر سهولة وفعالية.
ووفقًا لهذه النظرية، الابتكار هو قدرة الفرد على النظر إلى مكونات المجال الإدراكي الخاص به بطريقة مختلفة عن النظرة التقليدية. ويتمثل الابتكار في القدرة على إدراك العلاقات الخفية بين العناصر المتاحة، ومن ثم تأتي لحظة الاستبصار كحل للمشكلة بشكل فجائي، حيث يتم إنتاج الحل الابتكاري. يختلف الابتكار هنا عن الأفكار الاعتيادية بأنه يتطلب إعادة تنظيم شاملة للمجال الإدراكي بطريقة جديدة تؤدي إلى حل المشكلة بصورة غير متوقعة (السيد، 2019).
والنظرية الجشطالية تفسر الابتكار باعتباره عملية استبصارية تنشأ من تفاعل الفرد مع مجاله الإدراكي الكلي. الشخص المبتكر قادر على إدراك العلاقات الخفية بين عناصر المشكلة، وتنظيم هذه العناصر بطريقة جديدة تؤدي إلى حلول مبتكرة. الابتكار وفقًا لهذه النظرية يعتمد على مستوى النضج العقلي والجسمي للفرد، بالإضافة إلى خبرته وتنظيمه للعناصر المحيطة بالمشكلة.
المبحث الثاني
دور الابتكار في تعزيز العمل الأمني في مواجهة الأزمات والكوارث
تمهيد:
أصبح الابتكار عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الأمني وتحسين قدرته على التصدي للأزمات بفعالية، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة والكوارث الطبيعية والطارئة التي تواجه المجتمعات الحديثة. وتعتمد المؤسسات الأمنية اليوم على مجموعة من الابتكارات التكنولوجية والإدارية لتعزيز قدراتها في التنبؤ بالأزمات والتعامل معها بشكل سريع وحاسم. يُظهر الابتكار في العمل الأمني كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أن تحدث تحولًا جذريًا في استراتيجيات الأمن والاستجابة للطوارئ.
وفي هذا المبحث، يتناول المطلب الأول نماذج الابتكارات المستخدمة في العمل الأمني. بينما يُركز المطلب الثاني على ممارسات وزارة الداخلية، التي تبنت مجموعة من الابتكارات التقنية والإدارية للحد من تأثير الكوارث وتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات. وذلك بتقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية:
- المطلب الأول: نماذج الابتكارات في العمل الأمني
- المطلب الثاني: ممارسات وزارة الداخلية في استخدام الابتكارات لمواجهة الأزمات والكوارث.
المطلب الأول
نماذج الابتكارات في العمل الأمني
شهد العالم في السنوات الأخيرة تطبيق العديد من الابتكارات الأمنية التي ساهمت بشكل مباشر في تحسين مستوى الأمان وتقليل تأثير الكوارث. ومن هذه الابتكارات، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة والكشف المبكر عن التهديدات، وتوظيف الطائرات بدون طيار لمراقبة المناطق الحساسة والاستجابة السريعة للحوادث، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة الذكية التي تعتمد على إنترنت الأشياء لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية. كما أن التطور في مجال الأمن السيبراني أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية البنى التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية. وسوف نوضح ذلك فيما يلي:
- كاميرات المراقبة الذكية:
كاميرات الذكاء الاصطناعي هي أنظمة كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق للتعرف على الصور ومعالجة البيانات المرئية بطريقة ذكية. تعتمد هذه الكاميرات على خوارزميات تحليل الصور والتعرف على الأنماط لتمييز الكائنات والأشكال والحركات والسلوكيات المختلفة (علاي، عبد المجيد،2023).
وتعمل كاميرات الذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات المراقبة والأمان من خلال توفير ميزات متقدمة مثل التعرف على الوجوه والتعرف على الأشخاص والكائنات والكشف عن الحركة غير المعتادة والتنبيهات الفورية. يتم تحليل الصور الملتقطة بواسطة الكاميرات باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن أنماط مشبوهة أو أحداث غير عادية، مما يساعد على تحسين أمن البيئة المراقبة والتصدي للمخاطر ( اللينجاوي، 2023).
وتستخدم كاميرات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الأمن العام، والمراقبة السكنية، والأمن التجاري، والمراقبة الحضرية. يتم استخدامها للكشف عن الجرائم، وتحسين إجراءات الأمان والتأمين، وتسهيل إدارة الحركة والتنقل، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع والأفراد. وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في كاميرات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحسين قدرات المراقبة والتحليل والاستجابة الفعالة في العديد من السيناريوهات، مما يساهم في تعزيز الأمن والسلامة بشكل عام (هديب، 2024).
- الربوتات:
الروبوتات هي أجهزة آلية مصممة لتنفيذ مهام محددة بشكل ذاتي، وتعتمد على التقنيات الروبوتية والذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك. ويتم تصميم الروبوتات لتشبه بعض الجوانب البشرية، سواء في الشكل أو الحركة أو القدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة بها (السيسي، 2022) وتتنوع أشكال وأحجام الروبوتات، وتتراوح بين الروبوتات الصغيرة التي تستخدم في المهام الدقيقة والتجارب العلمية، وحتى الروبوتات الكبيرة التي تستخدم في الصناعة والخدمات والعمليات الشرطية. وتتميز الروبوتات بقدرتها على استيعاب ومعالجة المعلومات والتعلم من البيانات التي تجمعها من البيئة المحيطة بها. وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين الروبوتات من اتخاذ قرارات ذاتية وتكييف سلوكها بناءً على المواقف والتحديات التي تواجهها (فورد، 2022) وتستخدم الروبوتات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الصناعة، والطب، والعلوم، والخدمات، والعمليات الشرطية. تعزز الروبوتات الكفاءة والدقة في تنفيذ المهام، وتساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل المخاطر والتكاليف في العديد من الصناعات والقطاعات (هديب، 2023).
وتطبيق الروبوتات في العمل الشرطي والأمني يمكن أن يكون له عدة فوائد وتأثيرات، منها:
- تنفيذ المهام الخطرة: يمكن للروبوتات تنفيذ المهام الخطرة والمحفوفة بالمخاطر التي قد تشكل تهديدًا على حياة البشر، مثل التعامل مع متفجرات أو مواد سامة، والتحرك في مناطق خطرة أو معادية. ويساهم ذلك في حماية حياة رجال الأمن وتقليل المخاطر المرتبطة بتلك المهام (مهدي، 2024)؛ (العلي، 2024).
- مراقبة ومسح المناطق: يمكن للروبوتات استخدام أنظمة الكاميرات وأجهزة الاستشعار المتقدمة لمراقبة ومسح المناطق بشكل مستمر ودقيق. ويمكنها تحديد النشاطات المشبوهة والتعرف على الأشخاص أو الأشياء غير المرغوب فيها، والتنبيه بشكل فوري للفرق الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة (هديب، 2024).
- دعم التواصل والتفاعل: يمكن للروبوتات توفير وسيلة للتواصل والتفاعل مع الجمهور والمواطنين في العمليات الشرطية. ويمكنها تقديم المعلومات والإرشادات، والاستجابة للاستفسارات والشكاوى(علاي، عبد المجيد، 2023).
- تعزيز الكفاءة والدقة: يمكن للروبوتات أن تكون قادرة على تنفيذ المهام بشكل أكثر كفاءة ودقة من الإنسان. فهي لا تتأثر بالعوامل البشرية مثل التعب أو التشتت، ويمكن برمجتها بطرق تضمن تنفيذ المهام بشكل متسق وبدقة عالية (هديب، 2023).
- توفير الوقت والجهد: باستخدام الروبوتات في العمل الشرطي والأمني، يمكن توفير الوقت والجهد المستخدمين في تنفيذ بعض المهام الأمنية وتتمتع الروبوتات بقدرة على العمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى استراحة، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات (عبد الله،2021).
- مساعدة في جمع البيانات وتحليلها: يمكن للروبوتات أن تساهم في جمع البيانات الأمنية وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يمكنها تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، مما يمكن رجال الأمن من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على المعلومات الدقيقة (مهدي، 2024)؛ (العلي، 2024).
- السوار الالكتروني:
يعمل السوار الإلكتروني كجهاز لتتبع حركة وموقع الفرد الذي يرتديه بدقة عالية. ويُستخدم السوار الإلكتروني في مراقبة السجناء المشروطين أو المتهمين بجرائم معينة، مما يساهم في مراقبة احترامهم للشروط المفروضة عليهم. ويُمكن للسوار الإلكتروني فرض قيود محددة على الفرد مثل منعه من دخول مناطق معينة أو الابتعاد عن مكان معين دون إذن مسبق، مما يعزز التحكم في تحركاتهم. ويتيح استخدام السوار الإلكتروني للجهات الأمنية مراقبة فعّالة ومتابعة مستمرة للأفراد الذين يخضعون للإشراف القضائي، مما يساعد في تحقيق الأمن والسلامة العامة (علاي، عبد المجيد، 2023).
وترى هذه الدراسة، إنه يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء السوار الإلكتروني، مثل تحسين دقة تتبع الحركة وتحديد الموقع. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تطوير نماذج تنبؤية لسلوك المشتبه بهم أو المسجونين، مما يساعد في تحديد المخاطر المحتملة وتخطيط استراتيجيات الرقابة بشكل أفضل. بالتالي، ويتضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزز من قدرة الأجهزة الأمنية على مراقبة الأفراد وإدارة السلوكيات الضارة بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق الأمن والسلامة العامة في المجتمع.
- التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية:
التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية يُعتبر أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الهامة في مجال الأمن، ويتضمن العديد من النقاط المهمة:
- تحليل البيانات الكبيرة وتوليد التوقعات المستقبلية، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات الكبيرة المتاحة من مصادر مختلفة مثل سجلات الجرائم والأنماط السلوكية والتحليلات الاجتماعية لتوليد توقعات مستقبلية دقيقة (الشامسي، 2022).
- تحليل البيانات الجماعية لتحديد الأنماط والاتجاهات المحتملة للجريمة والتهديدات الأمنية، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في استخدام تقنيات التحليل الإحصائي لتحديد الأنماط المختلفة للجريمة والتهديدات الأمنية وتوقع احتمالية حدوثها في المستقبل (هديب، 2024).
- تحليل تاريخ الجرائم والبيانات الجغرافية وعوامل أخرى، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل تاريخ الجرائم والبيانات الجغرافية وعوامل أخرى مثل الأحوال الجوية والأحداث الاجتماعية لتحديد المناطق المعرضة للمخاطر وتوقع أنواع الجرائم المحتملة في كل منطقة (علاي، عبد المجيد،2023).
- مساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتخطيطية، حيث يُمكن استخدام التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لتوجيه السياسات والاستراتيجيات الأمنية والتخطيط لتحسين استجابة الجهات الأمنية وتعزيز الأمن العام.
إن استخدام هذه التقنيات، يمكن للجهات الأمنية تحسين قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والتهديدات المحتملة، وبالتالي تعزيز الأمن والسلامة العامة في المجتمع.
ومـن أحـدث التقنيـات العالميـة للتنبـؤ بالجريمـة هـي خاصيـة التعـرف التلقائـي إلـى الوجـه، المعــروف باســم AFR )) Recognition Face Automaticيعمــل هــذا النظــام مــن خلال تحليــل ميــزات الوجــه الرئيســة، وإنشــاء تمثيــل رياضــي لهــا، ثــم مقارنتهــا مــع الوجــوه المعروفـة فـي قاعـدة البيانـات داخـل الأنظمة الأمنية، لتحديـد التطابقـات المحتملـة، وأصبحـت AFR مألوفـة بشـكل متزايـد للجمهـور مـن خلال اسـتخدامه فـي المطـارات للمسـاعدة فـي إدارة عمليـات فحـص جـوازات السـفر (علاي، عبد المجيد،2023).
- التطبيقات الذكية:
التطبيقات الذكية هي برامج أو أنظمة تقنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعلم الآلة وغيرها من التقنيات الحديثة. تهدف هذه التطبيقات إلى تحسين وتسهيل العديد من العمليات والمهام في مجالات مختلفة، مثل الأمن، الصحة، التعليم، النقل، التجارة الإلكترونية، وغيرها. بفضل الابتكارات المستمرة، توفر التطبيقات الذكية حلولاً فعّالة ومبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات (فاروق، 2024)؛ (محمد، 2022).
وتتميز التطبيقات الذكية بقدرتها على جمع وتحليل البيانات الكبيرة بسرعة وفعالية، وتقديم نتائج دقيقة ومخصصة بناءً على تحليلات تفصيلية. تستخدم التطبيقات الذكية تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعلم وتحسين أداءها مع مرور الوقت، مما يساعد على تحسين جودة الخدمات والتجارب التي يقدمها التطبيق للمستخدمين. وتشمل التطبيقات الذكية مجموعة متنوعة من التقنيات والأدوات، مثل التطبيقات الجوالة، والمساعدات الصوتية، والأجهزة القابلة للارتداء، والروبوتات الذكية، وأنظمة التحكم الصوتية، وغيرها. تتراوح تلك التطبيقات من تقديم المعلومات الفورية والترفيه والتواصل الاجتماعي إلى إدارة المهام والملاحة وتحليل البيانات واتخاذ القرارات الذكية (حنا، 2024)؛ (الزغبي، 2023).
وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً مهماً في مجال مكافحة المخدرات عبر توفير أدوات وتقنيات تساعد في تحليل البيانات وتوجيه الجهود نحو مناطق الخطر وتنبؤ انتشار المخدرات. من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للجهات المختصة في مكافحة المخدرات تحليل الأنماط السلوكية وتحديد الاتجاهات المحتملة لتداول المخدرات واستخدامها (هديب، 2024). وباستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات، يمكن للتطبيقات الذكية في مجال مكافحة المخدرات تحديد المناطق التي تشهد نشاطاً مشبوهاً، وتوجيه الجهود والموارد نحو تلك المناطق لتعزيز الرقابة والرصد. كما يمكن لهذه التطبيقات توفير تقارير تحليلية تساعد في فهم أسباب انتشار المخدرات والتوجه نحو الحلول الفعالة (فاروق، 2024)، (مهدي، 2024).
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام التطبيقات الذكية لتبسيط عمليات الإبلاغ والتواصل بين الجهات المختصة في مكافحة المخدرات، مما يسهل تبادل المعلومات وتنسيق الجهود لتعزيز العمليات الرصدية والتدخل السريع (هديب، 2024).
- تحليل البيانات الضخمة:
تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يشير إلى استخدام الخوارزميات والنماذج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لاستكشاف وتحليل البيانات بشكل فعال. ويعتمد تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على قدرة الأنظمة الذكاء الاصطناعي على تعلم واكتساب المعرفة من البيانات المتاحة واستخلاص الأنماط والمعلومات القيمة (هديب، 2024).
وتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تحليل البيانات تشمل مجموعة متنوعة من الأساليب والأدوات. على سبيل المثال يمكن استخدام تقنيات التعلم الآلي مثل التعلم العميق والتعلم الآلي الإشرافي وغير الإشرافي لاكتشاف الأنماط والتصنيف والتجميع في البيانات. كما يمكن استخدام تقنيات التعلم التعزيزي لاتخاذ القرارات الذكية بناءً على تحليل البيانات(مهدي،2024). وتحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يسمح بمعالجة كميات كبيرة من البيانات واستخلاص الأنماط المعقدة والتوصل إلى رؤى قيمة. يمكن أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات في تحقيق توقعات دقيقة، وتحديد العوامل المؤثرة، واكتشاف الصلات النمطية غير المرئية بين المتغيرات (مهدي، 2024).
واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات يمكن أن يكون ذو تأثير كبير على العمل الشرطي والأمني، وذلك على النحو التالي:
- تحليل أنماط الجريمة: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المتعلقة بالجرائم واكتشاف الأنماط والتوجهات الجنائية. يمكن أن يساعد هذا في تحديد المناطق التي تشهد نشاطًا جنائيًا مرتفعًا وتوجيه الموارد بشكل فعال للحد من الجريمة (عبد التواب، 2022).
- توقع الجرائم: باستخدام تقنيات التعلم الآلي والتحليل الاحصائي، يمكن للذكاء الاصطناعي توقع حدوث الجرائم في مناطق محددة وفي فترات زمنية معينة. يمكن أن يساعد هذا التوقع في اتخاذ إجراءات وقائية وتعزيز تواجد الشرطة في الأماكن المحتملة لتفادي حدوث الجرائم (هديب، 2024).
- تحليل البيانات الأمنية: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الأمنية واستخلاص المعلومات القيمة لمكافحة التهديدات الأمنية. ويمكن تحليل مجموعة متنوعة من المصادر مثل وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد البيانات الجرمية لاكتشاف الأنماط والتوجهات وتحديد الأشخاص المشتبه بهم (فاروق، 2024).
- تحليل الصور والفيديو: تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل تعرف الصورة وتعرف الوجه يمكن أن تستخدم لتحليل الصور والفيديو وتحديد تفاصيل محددة مثل التعرف على الأشخاص المشتبه بهم أو تحليل التصرفات المشبوهة. ويمكن استخدام هذه التقنيات في مراقبة الأماكن العامة، مثل المطارات أو المحطات أو الحدود، للكشف عن الأنشطة المشبوهة وتحديد الأفراد الذين قد يكونون يشكلون تهديدًا للأمن (هديب، 2024).
- دعم اتخاذ القرارات: تحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر أدوات قوية لدعم اتخاذ القرارات في المجال الأمني. يمكن تحليل البيانات وتوليدها في تقارير وتوصيات قائمة على الأدلة للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتكتيكية (مهدي، 2024).
ويُعتبر استخدام البيانات الضخمة في قواعد البيانات الكيميائية مصدرًا رئيسيًا في عملية البحث عن تركيبات المواد المخدرة. يُستخدم هذا المصدر على نطاق واسع لربط ملايين المركبات وتمكين العثور على العقاقير المسببة للإدمان والمركبات الأخرى المهمة في العينات الجنائية. تُمكّن تقنيات التحليل الكيميائي الآلية من التعرف الكمي والنوعي للمواد ومكوناتها في مجالات متنوعة مثل البيئة والطب والطب الشرعي وغيرها. (Gasteiger, 2020)
ولقد تزايدت حجم البيانات الكيميائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد المواد المسجلة في قاعدة بيانات CAS إلى أكثر من 160 مليون مادة عضوية وغير عضوية في عام 2020. ومن الواضح أن إدارة وتحليل هذه البيانات بطريقة فعالة تتطلب استخدام تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي. ومع التقدم المستمر في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة الرقمية، تطورت التخصصات العلمية الحديثة مثل معلوماتية الكيمياء لتسهيل العمليات الحسابية وتحليل المعادلات والنظريات الكيميائية. وتسهم هذه التطورات في تطوير الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات الكيميائية والمساعدة في تحديد وتحليل المركبات والأطياف الكيميائية. وباستخدام أساليب الإحصائيات، يُمكن تحديد أنواع متعددة من المركبات وتعرفيها من خلال المقارنة الطيفية مع قاعدة بيانات كبيرة. تُعد هذه التطورات مهمة جدًا في فهم الكيمياء وتطبيقاتها العملية في مجالات متنوعة ( اللينجاوي، 2023).
المطلب الثاني
ممارسات وزارة الداخلية في استخدام الابتكارات لمواجهة الأزمات والكوارث.
تتبنى وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عدد من الابتكارات بشكل فعّال في مجال مكافحة الجرائم. وترتكز هذه الممارسات على عدة جوانب منها:
- تحليل البيانات الضخمة: تستخدم وزارة الداخلية تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الكبيرة المتعلقة بالجرائم والأنشطة الإجرامية. ويتم استخدام هذا التحليل لاكتشاف الأنماط الجديدة للجريمة وتحديد العوامل التي تؤثر في انتشارها، بما في ذلك جرائم المخدرات (اللينجاوي، 2023).
- المراقبة والتحليل الذكي للصور ومقاطع الفيديو: يتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأماكن العامة وتحليل صور ومقاطع فيديو للكشف عن الأنشطة المشبوهة، بما في ذلك تجارة وتهريب المخدرات (اللينجاوي، 2023).
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأمن الحدودي: تستخدم وزارة الداخلية أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحسين أمن الحدود ومراقبة التجارة الدولية، وهو مجال يمكن أن يشمل مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.
- التنبؤ بالجرائم: تستخدم وزارة الداخلية تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتوقع الجرائم المحتملة، بما في ذلك جرائم المخدرات، وبالتالي تمكين السلطات من اتخاذ إجراءات استباقية لمنعها.
- التعاون مع القطاع الخاص والجهات الدولية: تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع الشركات التقنية الرائدة والجهات الدولية ذات الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي لتبادل المعرفة وتطوير الحلول الفعّالة في مجال مكافحة الجريمة (الشامسي، 2022).
- التحليلات التنبؤية: يمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات لتحديد الأنماط والتنبؤ بالأنشطة المستقبلية لتجار المخدرات، مما يساعد وكالات إنفاذ القانون على اتخاذ تدابير وقائية وتعطيل عمليات الاتجار بالمخدرات (اللينجاوي، 2023).
- المراقبة والرصد: يُمكن استخدام التكنولوجيا الذكية لرصد وتتبع حركة تجار المخدرات وأنشطتهم وشبكاتهم، مما يُسهل على وكالات إنفاذ القانون جمع الأدلة وتعقب تجار المخدرات.
- كشف الوصفات الطبية المزورة: بفضل التحليلات الذكية، يمكن كشف الوصفات الطبية المزورة التي غالبًا ما يستخدمها تجار المخدرات لتوزيع المواد المخدرة، مما يُسهم في منع توزيعها والحد من الاتجار بالمخدرات (الشامسي، 2022).
- تحديد المناطق عالية الخطورة: يمكن استخدام التكنولوجيا الذكية لتحديد المناطق عالية الخطورة ومراقبتها لأنشطة الاتجار بالمخدرات، مما يُسهل على وكالات إنفاذ القانون اتخاذ تدابير وقائية وتعطيل عمليات الاتجار بالمخدرات (الشامسي، 2022).
- تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز: تُستخدم تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز في مواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك تدريب أفراد الشرطة على التعامل مع الهجمات الإرهابية والحوادث الطارئة. وتتيح هذه التقنية للمستخدم تجربة بيئات افتراضية تمثل مواقف حرجة، مما يساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة وتطبيق استراتيجيات الاستجابة الفعالة. يتم تنفيذ هذه الخبرات باستخدام أجهزة الحاسوب والنظارات الخاصة بالواقع الافتراضي، وتقنيات الواقع المعزز التي تجمع بين المناظر الحقيقية والعناصر الافتراضية.
- الدوريات الذكية للشرطة: تعتمد الشرطة على دوريات ذكية مجهزة بأنظمة التحكم عن بعد والكاميرات الرادارية لتعزيز الرصد والمراقبة في المناطق المحددة. وتساهم هذه الدوريات في التعامل مع الزحام المروري وإدارة الأحداث الكبيرة بفعالية أكبر، مما يعزز من قدرة الشرطة على فرض القانون وضمان الأمن العام.
- كاميرات الجسد لضباط الشرطة: جهزت شرطة أبوظبي أفرادها العاملين في الميدان بكاميرات رقمية عالية الجودة، يتم حملها على الصدر بجانب بطاقات التعريف الشخصية. وتم تجهيز هذه الكاميرات بتقنيات متطورة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز مسار التطوير والتحسين في شرطة أبو ظبي، وتبني أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الممتازة للجمهور.
الخاتمة
تعد وزارة الداخلية في الإمارات نموذجًا رائدًا في توظيف الابتكارات التكنولوجية المتقدمة، سواء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الأمنية أو تقنيات المراقبة الذكية للتنبؤ بالتهديدات الأمنية قبل وقوعها. كما ساهمت الوزارة في تطوير نظم الإنذار المبكر، وتحسين كفاءة الاستجابة للأزمات من خلال تبني تقنيات مثل الطائرات بدون طيار (Drones) وأنظمة المراقبة المتقدمة التي تضمن سرعة التدخل في حالات الطوارئ.
ولقد أظهرت الدراسة أن وزارة الداخلية نجحت في تحويل الابتكار إلى ثقافة مؤسسية، حيث لا يقتصر الابتكار على الجانب التقني فحسب، بل يمتد ليشمل التطوير المستمر للعمليات الإدارية وتنمية مهارات الكوادر البشرية لضمان استمرارية التحسن في مواجهة الأزمات والكوارث. من خلال الابتكار، وتمكنت الوزارة من تعزيز قدرتها على التنسيق بين الجهات المختلفة وتفعيل آليات التعاون المشترك التي ساعدت في تحسين إدارة الأزمات.
أولاً- النتائج:
- تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة: استطاعت وزارة الداخلية بفضل الابتكارات التكنولوجية رفع كفاءة وفعالية الاستجابة للأزمات والكوارث، مما قلل من آثارها السلبية على المجتمع.
- تحسين جاهزية البنية التحتية الأمنية: الابتكارات التي اعتمدتها الوزارة ساهمت في تحسين منظومة الأمن الوطني من خلال أنظمة ذكية ومتكاملة تمكنها من رصد التهديدات الأمنية والتعامل معها بفعالية.
- تنمية الكوادر البشرية: من خلال توفير برامج تدريبية تعتمد على الابتكار التكنولوجي، تمكنت الوزارة من تطوير مهارات كوادرها وزيادة جاهزيتهم للتعامل مع التحديات الأمنية.
- التكامل بين التكنولوجيا والإدارة: ساهم الابتكار الإداري والتكنولوجي في تحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة، مما أدى إلى رفع كفاءة العمل الأمني.
ثانياً- التوصيات:
- الاستمرار في تبني الابتكارات التكنولوجية الحديثة: يجب على وزارة الداخلية مواصلة الاستثمار في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات بشكل استباقي.
- على وزارة الداخلية النظر في تعزيز وتوسيع استخدام تقنيات النانو في عملياتها الأمنية وإدارة الأزمات. تقنيات النانو توفر إمكانيات كبيرة لتحسين الأمن الوطني من خلال تطوير مواد وأجهزة مبتكرة ذات خصائص فريدة. يمكن استخدام تقنيات النانو في المجالات التالية:
- تحسين معدات الحماية الشخصية: تطوير ملابس وأدوات حماية شخصية مقاومة للمواد الكيميائية والبيولوجية والحرارية، مما يزيد من أمان الأفراد العاملين في الخطوط الأمامية أثناء الاستجابة للأزمات والكوارث.
- رصد التهديدات البيئية والكيميائية: استخدام أجهزة استشعار نانوية للكشف المبكر عن التلوث الكيميائي أو البيولوجي، مما يتيح استجابة أسرع وأكثر دقة للتهديدات المحتملة.
- تعزيز الاتصالات وتقنيات الاستشعار: تطوير شبكات استشعار نانوية قادرة على جمع المعلومات الحيوية في الوقت الفعلي، مما يسهم في تحسين جودة البيانات وزيادة دقة التنبؤ بالأزمات والتعامل معها.
- تحسين المواد والمعدات الأمنية: تصميم مواد نانوية قوية وخفيفة الوزن يمكن استخدامها في تطوير معدات أمنية متقدمة، مثل دروع الحماية وأدوات التفتيش الأمني.
- تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية: ينبغي على الوزارة توسيع شبكة التعاون مع المنظمات الدولية والدول المتقدمة في مجال الأمن والتكنولوجيا لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
- تطوير برامج تدريبية مبتكرة: يوصى بتقديم المزيد من البرامج التدريبية التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتحسين جاهزية الكوادر الأمنية لمواجهة التحديات المتزايدة.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي: يمكن أن تلعب وزارة الداخلية دورًا أكبر في نشر الوعي لدى المواطنين حول كيفية التصرف في حالات الأزمات والكوارث، من خلال مبادرات مجتمعية توعوية تعتمد على تقنيات تفاعلية.
- تشجيع الابتكار المؤسسي: يجب تعزيز ثقافة الابتكار داخل وزارة الداخلية، من خلال توفير بيئة مشجعة على الابتكار والتطوير المستمر، مع التركيز على أهمية مشاركة الموظفين في تقديم أفكار وحلول إبداعية.
قائمة المراجع
أولاً- المراجع العربية:
- أحمد، صبيحي. (2023). الابتكار والإبداع ومستقبل الإنسانية. معهد الشارقة للتراث.
- المصري، إيهاب عيسى عبد الرحمن. (2023). الابتكار في المؤسسات الرقمية. الدولية للكتب العلمية.
- عابدين، ندى محمد مأمون. (2024). الابتكار وريادة الأعمال. المتحدة للنشر والتوزيع.
- الطحان، جاسم محمد علي. (2024). الابتكار ورياد الأعمال؛ آفاق معاصرة لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية. دار الكتاب الجامعي.
- الطحان، جاسم محمد علي. (2024). الابتكار؛ مؤشر النهوض التنموي. دار الكتاب الجامعي.
- بسنت، جون. (2012). الابتكار. مكتبة لبنان ناشرون.
- جندل، جاسم محمد. (2022). الابتكار. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
- كافي، مصطفى يوسف. (2022). الابتكار وريادة الأعمال. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.
- سيد أحمد، سنوسي. (2023). الابتكار التكنولوجي: أداة لرفع تنافسية المؤسسة. دار الفجر للنشر والتوزيع.
- دراكر، بيتر إف. (2022). الابتكار وريادة الأعمال. رف للنشر والتوزيع.
- صالح، ماجدة محمود. (2019). الابتكار والإبداع. دار المعرفة الجامعية.
- البارودي، منال أحمد. (2019). علم استشراف المستقبل. المجموعة العربية للتدريب والنشر.
- السيد، إبراهيم جابر. (2019). إدارة الابتكار والتطوير للمنظمات الحديثة. العلم والإيمان للنشر والتوزيع.
- السواح، أسامة منصور. (2007). المنهج التطبيقي لإدارة الأزمات الأمنية والكوارث. مطبعة بن دسمال، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الغرابلي، زينب. (2018). إدارة الأزمات. دار الحافظ للنشر والتوزيع، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- المصري، إيهاب عيسى، & عامر، طارق عبد الرؤوف. (2018). الإبداع والتفكير الابتكاري. المؤسسة العربية للعلوم والثقافة.
- الحبسي، سالم عبد الله علوان. (2022). إدارة الأزمات الأمنية. مركز الإمارات للدراسات والبحوث، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- حنا، مهدي (2024)، الذكاء الاصطناعي؛ واقع وتحديات، آلان للنشر والتوزيع، عمان.
- غلوكمان، بيتر. (2019). الابتكار والعواقب غير المقصودة للتطوير. الدار العربية للعلوم الناشرون.
- فاروق، عبد الرحمن (2024)، الذكاء الاصطناعي، دار كتبنا، القاهرة.
- مهدي، طارق جمعة (2024)، الذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب، دار الفكر الجامعي، القاهرة
- .هديب، إسلام (2024)، الجوانب الموضوعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة.
- هديب، إسلام (2023)، الذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإلكتروني، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.
- الزغبي، أشرف (2023)، الذكاء الاصطناعي الافتراضي، البديل للنشر والتوزيع، القاهرة.
- محمد، أسماء السيد (2022)، الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المعاصرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة.
- السيسي، صلاح الدين حسن محمد (2022)، الذكاء الاصطناعي وعالم التقنيات التكنولوجية المتطورة، دار السحاب للنشر والتوزيع، عمان.
- فورد، مارتن (2022)، الذكاء الاصطناعي والروبوتات وكيف ستغير كل شئ، الدار العربية للعلوم، القاهرة، 2022.
- العلي، بلال موسى (2024)، الذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون وآفاقه المستقبلية، دار إبهار للنشر والتوزيع، عمان.
ثانياً- الدراسات والبحوث:
- البرق، خليفة بشير علي. (2011). مراكز إدارة الأزمات والكوارث بين الواقع والمأمول. رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة المصرية، القاهرة.
- اللينجاوي، خلود (2023)، تقنية الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث منشور، مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار 47، المغرب.
- عبد المجيد، محمد نور الدين، علاي، عمار راشد (2023)، استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ بالجريمة والوقاية منها، بحث منشور، مجلة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد20، العدد4، الشارقة.
- الشامسي، جمعه سلطان سيف (2022)، التقنيات الحديثة والبرامج الذكية ودورها في مكافحة الجريمة والمخدرات، بحث منشور، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية، مصر.
- البابلي، عمار ياسر زهير (2021)، دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالجريمة، شرطة دبي، دبي.
ثالثاً- المراجع الأجنبية:
- Gluckman, P. (2020). US Intelligence Community, Global Security, and AI: From Secret Intelligence to Smart Spying. Journal of Global Security Studies, Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa023
- Tolah, A., Furnell, S. M., & Papadaki, M. (2021). An Empirical Analysis of the Information Security Culture Key Factors Framework. Computers & Security, 108. https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102354
- Vinci, A. (2020). Artificial Intelligence for Cybersecurity: Literature Review and Future Research Directions. ScienceDirect. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120199
- Kas, M., Khadka, A. G., Frankenstein, W., Abdulla, A. Y., & Kunkel, L. F. (2012). Analyzing Scientific Networks for Nuclear Capabilities Assessment. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(7), 1294–1312. https://doi.org/10.1002/asi.22678
- Da Veiga, A. (2019). Achieving a Security Culture. In: Cybersecurity Education for Awareness and Compliance, IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7847-5.ch005
- Auernhammer, J., & Hall, H. (2014). Organizational Culture in Knowledge Creation, Creativity and Innovation: Towards the Freiraum Model. Journal of Information Science, 40, 154–166. https://doi.org/10.1177/0165551513508356
- (Wrzalik, Jereb, 2019), USE OF EXPERT SYSTEMS IN CRISIS MANAGEMENT, Czestochowa University of Technology, Poland.pl 2University of Maribor, Slovenija.
- (VLADU,Oana-Mihaela,2023), DIGITAL TRANSFORMATION IN CRISIS MANAGEMENT: THE KEY ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, “Carol I” National Defence University, Bucharest, Romania.
- Glantz, Sarah and others, 2020 , UAV Use in Disaster Management, Proceedings of the 17th ISCRAM Conference – Blacksburg, VA, USA May 2020 ,Amanda Lee Hughes, Fiona McNeill and Christopher Zobel, eds.
- Kavitha ,Saraswathi,2021, Smart Technologies for Emergency Response and Disaster Management: New Sensing Technologies or/and Devices for Emergency Response and Disaster Management, Institute of Technology, India.
- Wong, Yew Kee,2021, DEALING CRISIS MANAGEMENT USING AI, Jaishree Ranganathan and Tsega Tsahai, Middle Tennessee State University, USA.
- Alruqi, Asma Salman& Aksoy, Mehmet Sabih,2023, The Use of Artificial Intelligence for Disasters,Aksoy, M.S. The Use of Artificial Intelligence for Disasters. Open Journal of Applied Sciences, 13, 731-738.
- Samarakkody, N., Amaratunga, D., Haigh, R. (2022). “Technological Innovations for Enhancing Disaster Resilience in Smart Cities: A Comprehensive Urban Scholar’s Analysis.” Sustainability. Retrieved from MDPI.
- Wenjuan S., Paolo, Brian. (2021). “Application of Artificial Intelligence in Disaster Management.” Journal of Disaster Research.
- Glantz, Sarah and others, 2020 , UAV Use in Disaster Management, Proceedings of the 17th ISCRAM Conference – Blacksburg, VA, USA May 2020 ,Amanda Lee Hughes, Fiona McNeill and Christopher Zobel, eds.
- Carley, M. D. (2017). Innovation in security and defence: From traditional to non-conventional approaches. Journal of Defence Studies, 14(2), 120-134.
- Hayden, S. M. (2019). Cybersecurity innovations and their impact on national security. International Journal of Cyber Security and Digital Forensics, 8(4), 215-230.
- Vincent, J. P. (2021). The role of AI and big data in enhancing security operations. Journal of Information Security, 13(3), 189-204.