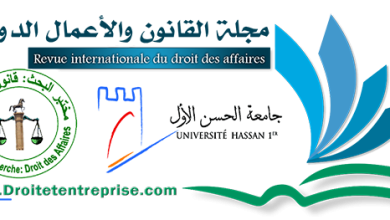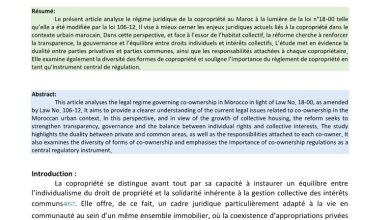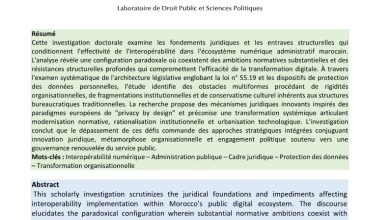أبرز السيكولوجيات المرضية في البحث العلمي – عبد الصمد نيت أكني

أبرز السيكولوجيات المرضية في البحث العلمي
عبد الصمد نيت أكني
للبحث العلمي شروط بتحققها يوصف البحث بالعلمية، ويكون قابلا لقراءته قراءة نقدية تتغيا إظهار مزاياه، ونقائصه، وبنيته المعرفية.
ومن شروط البحث العلمي ضرورة تنزيه الفعل البحثي من المؤثرات النفسية التي تحول دون الوصول إلى النتائج التي يفرضها واقع الموضوع، وإنما هي نتائج تعبر عن سيكولوجيات مرضية، وتشوهات معرفية يعاني منها الباحث، ويعبر عنها باللغة المستعملة، وبالمناهج المتوسل بها في البحث.
هذه النفسيات والتشوهات إنما يتفطن إليها القارئ الحصيف، ويستخرجها -أحيانا- بالمناقيش، على نحو ما صنعه البلقيني مع اعتزاليات الزمخشري في كشافه، والاهتمامُ باستخراج المؤثرات النفسية من أوائل ما ينبغي للقارئ الناقد السعي إليه؛ إذ البحث ترجمان الباحث ولسان حاله.
وقصدي من هذا الكلام عدم الاستهانة بالمدخل النفسي عند نقد البحث على حساب مداخل أخرى صارت قبلة ارتضاها بعض النقدة من ذوي العقيدة الشمولية، والأحادية المنهجية، فكل مدخل له فوائده وعوائده لا تظهر إلا عند استثمار أغلب المناهج النقدية أو كلها.
وفيما يلي أمثلة عن أبرز السيكولوجيات المرضية يمكن للناقد ملاحظتها في بعض البحوث.
1)- الطاووسية:
وتظهر فيما يلي:
– حينما يُكثر الباحث من تضخيم أناه، لإثبات كونه من النخبة المثقفة، أو للإحساس بالنجاح الذاتي، أو لاستجلاب المديح من غيره.
– حينما يستثمر معجما لغويا حافلا بمفردات التعالي، والغرور.
– حينما يعد الباحث نفسه مرجعا في الترجيح، والتخطئة، والتصويب.
– حينما تكون ثقته الزائدة بنفسه دافعا للخوض في موضوعات لا تناسب مستواه المعرفي.
– حينما ينتقي من المناهج ما توصله إلى النتائج التي يصبو إليها ابتداء.
– حينما يتجاهل فكر الٱخر، ولا يقدر على استثماره رغم نفعيته، وأهميته، ومرجعيته عند عموم الباحثين.
2)- السيكوباتيا:
وتظهر فيما يلي:
– حينما لا يعترف الباحث بمناهج البحث العلمي جملة وتفصيلا.
– حينما يستعمل لغة اندفاعية، وعدوانية.
– حينما يزدري بعض العلوم، والمعارف.
– حينما ينتهك حق الملكية الفكرية.
– حينما يخوض معركة دونكيشوتية لإعلاء رأيه، وتثبيته.
3)- الزورانية:
وتظهر فيما يلي:
– حينما يكون الباحث بيرونيا بحيث يشك في كل شيء، ولا يؤمن بوجود حقيقة أو حقائق.
– حينما يتعسف دائما في تفسير ٱراء غيره من الباحثين، وذلك بتأزيمها، أو تسييسها، أو تهويلها، أو التحذير منها.
– حينما ينشغل بما وراء السطور على نحو مبالغ فيه لا يقبله عقل، ولا يقر به واقع.
4)- الحدية:
وتظهر فيما يلي:
– حينما ينظر الباحث إلى الموضوع من زاويتين فقط، فإما الزاوية الأولى أو الثانية، والثالثة مرفوعة.
– حينما يضطرب رأيه في موضوع ما، بحيث لا يستقر على قول واحد.
5)- المازوخية:
وتظهر فيما يلي:
– حينما يبدي الباحث رأيا بغرض تعريض ذاته للعنف الرمزي، وصولا إلى المتعة، واللذة، والإشباع العاطفي.
– حينما يقارب الموضوع بطريقة بكائية.
– حينما يَخضع للٱخرين، بأن يبدي ٱراء غيره في الموضوع دون طرح رأيه أو دون مناقشة ما يستحق التقويم.
6)- الهوس:
ويظهر فيما يلي:
– حينما لا يعطي الباحث الموضوع حقه من التفكير، وإنما يتسرع في بناء رأيه؛ بسبب فرط نشاطه، وارتفاع مزاجه.
– حينما يشعر بتدفق الأفكار.
7)- الفصام:
ويظهر فيما يلي:
– حينما ينسب الباحث بعض الأفكار إلى علم ما مع البناء عليها، مُعِدّا ذلك حقيقة لا خلاف فيها، والحالُ أن الأمر -عند التحقيق- مجرد هلوسة، واضطراب إدراكي.
– حينما يتشبث بيقينيات وإن كانت خاطئة أو غير واقعية، كوهم التسييس، والتأزيم، والمؤامرة، والشك، وغيرها من الأوهام التي تدل على وجود ما يسمي باضطراب الأفكار.
وغيرها من النفسيات المرضية التي يمكن الوقوف عندها في بعض البحوث، وإنما أوردت ما تقدم على سبيل التمثيل لا الاستيعاب، فهي قليل من كثير، وبَرْضٌ مِن عِدٍّ كما يقال.
والحمد لله رب العالمين.