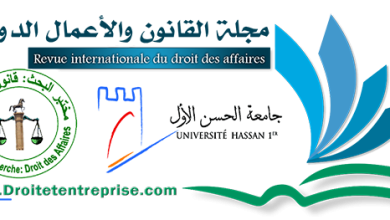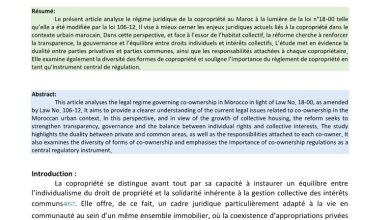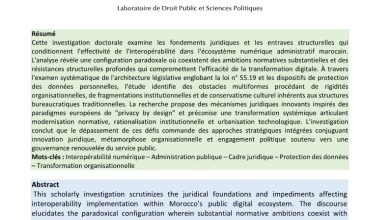في الواجهةمقالات قانونية
التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها الباحثة: ثرياء بنت أحمد بن علي الكلبانية
15 فبراير, 2025

التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها
The Security and Social Challenges of Social Media in the Sultanate of Oman and Ways to Address Them
الباحثة: ثرياء بنت أحمد بن علي الكلبانية
سلطنة عمان
ملخص
هدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب المكتبي في جمع البيانات.
من أهم نتائج البحث: أن أبرز التحديات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان تتمثل ي كل من التوظيف الأيديولوجي والسياسي لوسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر زعزعة الهوية والوحدة الوطنية، وانتشار الجرائم الالكترونية وجرائم المعلوماتية. وأن أبرز التحديات الاجتماعية تتمثل بكل من خلخلة وتفكيك الكيان الأسري والعلاقات الاجتماعية، ومخاطر الهدم التربوي ونشر الانحلال القيمي والأخلاقي، ونشر ثقافة التطرف والتحريض على العنف والإرهاب.
الكلمات المفتاحية:
الأمن الوطني، الأمن الاجتماعي، التحديات الأمنية والاجتماعية، وسائل التواصل الاجتماعي.
Abstract
The main objective of this research is to shed light on the security and social challenges of social media in the Sultanate of Oman and ways to confront them, by following the descriptive analytical approach and the library method in collecting data.
Among the most important findings of the research: The most prominent security challenges for social media in the Sultanate of Oman are represented by the ideological and political employment of social media, the risks of destabilizing identity and national unity, and the spread of electronic and information crimes. And that the most prominent social challenges are represented by the disruption and dismantling of the family entity and social relations, the dangers of educational demolition, the spread of moral and value decay, the spread of a culture of extremism and incitement to violence and terrorism.
keywords:
National Security, Social Security, Security and Social Challenges, Social Media.
مقدمة:
كان للتطور النوعي وغير المسبوق الذي شهده العالم في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات تأثيراً كبيراً على أنماط الحياة الإنسانية بأسرها؛ فإذا كانت شبكة الانترنت تمثل أبرز ملامح هذا التغير والتطور، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل ذروة هذه الطفرة في الوقت الراهن( ).
إزاء ذلك، ظهر اتجاهان متصادمان في تقييم وتفسير الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي والأثر المترتب عن استخداماتها المختلفة: الاتجاه الأول: يرى فيها ميزة وفرص كثيرة لتبادل الاتصال والمعرفة والقضاء على عوائق الزمان والمكان، بما يسهم في تقارب الأفراد وزيادة مستويات تفاعلهم وإنشاء علاقات اجتماعية جديدة، فضلاً عن المزايا التي توفرها وتفيد في تيسير الكثير من الإجراءات والتعاملات التجارية والاقتصادية. أما الاتجاه الثاني: فيرى فيها الكثير من المخاطر والتهديدات الأمنية والاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية، وأنها تشكل مصدراً لخطر حقيقي يهدد العلاقات الاجتماعية من جهة، والأمن الوطني من جهة أخرى( ) وخاصة في مجتمع محافظ كمجتمعنا في سلطنة عمان.
ومع ذلك، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر اتساعاً وتأثيراً على الواقع من كافة نواحيه، نظراً للنمو المطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في أعداد مستخدميها، وتعدد وتنوع خصائصهم وسماتهم النوعية والعمرية، وتباين مستوياتهم التعليمية وأوضاعهم المهنية، فضلاً عن الاختلافات والتباينات المتعلقة بالانتماءات الفكرية والسياسية، وغير ذلك من السمات والخصائص، ومع ذلك، تظل القواسم المشتركة بينهم محددة بالاتجاهات والحاجات والميول التي تجمعهم، بالإضافة إلى القضايا والاهتمامات المشتركة التي يلتقون عندها، سواءً أكان ذلك بالوفاق والاتفاق أو بالخلاف والاختلاف، وهذا كله جعل من وسائل التواصل الاجتماعي تشكل جانباً مهماً وفاعلاً في حياة الملايين من الأفراد، الأمر الذي أكسبها ميزات إعلامية بالغة الأهمية بالنسبة لكل الاتجاهات والقوى الفاعلة، من حيث ساهمت في فتح آفاق واسعة للإعلام وعلى نحو غير مسبوق، ناهيك عن الدور الذي أصبحت تمارسه هذه المواقع والشبكات في مجال صناعة الرأي العام والتأثير عليه بلا قيود رقابية مهنية أو تشريعية( ).
تتبين المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان في ضوء العديد من المصطلحات والمفاهيم الأمنية الحديثة، كمفهوم التهديدات السيبرانية (Cyber Threats) والذي يعكس العلاقة الوطيدة بين الأمن والتكنولوجيا، ولأن أغلب البنى التحتية للدول صارت مرتبطة بشبكة الانترنت( )، ومنها كذلك مفهوم الحروب السيبرانية (Cyber Wars) التي تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسة، هي: المعلومات، الفضاء الالكتروني، الطابع الرقمي( ).
يدخل ضمن ذلك، ما يعرف اليوم بـ حروب الجيل الخامس (Fifth Generation Warfare)، والتي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في (احتلال العقول)، وإثارة الفتن والصراعات الفكرية والعقائدية والمذهبية لتهديد الأمن والاستقرار القومي( )؛ خاصة وأن هذه التقنيات قد فتحت المجال للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود لممارسة أدوار بالغة الخطورة والتهديد على الأمن الوطني والاجتماعي، وهو ما يعد تطوراً غير مسبوقاً( ).
لقد أصبح من المسلم به اليوم، أن المخاطر والتحديات الأمنية الناتجة عن استخدام مختلف تقنيات وتطبيقات الاتصال والمعلومات الحديثة، تزداد بالتوازي مع زيادة مستويات نضج تلك التقنيات والتطبيقات، والانتقال بها على مستوى الجمهور من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة الاستخدام الكثيف( )، ولهذا أصبحت هذه التحديات تحتل حيزاً مهماً ضمن استراتيجيات الأمن السيبراني للدول ومن بينها سلطنة عمان، في الوقت نفسه الذي باتت تحظى فيه أيضاً باهتمام متصاعد ضمن أولويات الأمن الدولي( ).
وهكذا، فإنه وبالرغم من الميزات الكثيرة والمتنوعة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي، إلا إن الكثير من الدول المتقدمة والنامية تفطنت للمخاطر والتهديدات التي يمكن أن تنجم عن تعدد وتنوع طرق استخدامها وتوظيفها، والتي يمكن أن تهدد أمن واستقرار الدول والمجتمعات( )، حتى أن بعض الدول بما فيها دول لها تاريخ طويل في مجال تطبيق مبادئ الحكم الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات، اضطرت إلى اتخاذ قرارات بحجب بعض مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن تسببت لها بمخاطر وتهديدات حقيقية تمس أمنها الوطني والمجتمعي( ) كما فعلت سلطنة عمان بحجب بعض المواقع ومنها التليجرام وغيره. وعلى هذا الأساس، يأتي هذا البحث للوقوف على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها.
مشكلة البحث وتساؤلاته:
تعد وسائل شبكات التواصل الاجتماعي جزء من الإعلام الإلكتروني الحديث المرتبط بتقنية الانترنت، تساهم بنقل المعلومة والحقيقة والحدث صوتاً وصورة، وهذا بحد ذاته ما يجعل منها تحدياً له الكثير من الأبعاد الفكرية والثقافية والسياسية والقانونية والأمنية، طالما وأن النشر فيها واستخدامها متاح للجميع بدون ضوابط أو رقابة فعلية( ). ونظراً لتعدد وتنوع معطيات هذه الشبكات، فقد تمكنت من تغيير العديد من مظاهر التفكير والسلوك الفردي حول استخدامها، الأمر الذي بات يتطلب قدراً كبيراً من الحيطة والحذر( )؛ خاصة وأن الاستخدام الواسع لهذه الشبكات قد أدى إلى ظهور العديد من التحديات والأخطار التي يجب دراستها والتعامل معها بعناية فائقة.
في هذا الاتجاه، تؤكد التطورات التقنية المتسارعة على أنه لا يمكن في الوقت الراهن لأي بلد مهما كان حجمه العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أن يغفل الدور المحوري الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي سواء في تفاعل الأفراد داخل المجتمع الواحد، أو في تفاعل أفراد هذا المجتمع مع مختلف المجتمعات والثقافات الأخرى( ).
تتمثل مشكلة البحث في الحاجة إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها، بحيث يمكن صياغتها على النحو الآتي:
ما التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها؟
تنبثق عن هذا السؤال مجموعة من التساؤلات الفرعية التي يمكن صياغتها على النحو الآتي:
1. ما العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأمن الوطني والاجتماعي؟
2. ما تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي؟
3. ما التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان؟
4. ما السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان؟
أهداف البحث:
يسعى البحث بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1. توضيح العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأمن الوطني والاجتماعي.
2. الكشف عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي.
3. إبراز التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان.
4. بيان السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع العماني، والحاجة إلى تسليط الضوء على ما يترتب عن استخدام تلك الشبكات والوسائل من المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية إبراز العلاقة بين هذه الوسائل والأمن الوطني والمجتمعي، لاسيما في ظل انفتاحها على الحدود السياسية والثقافية والفكرية للدول والمجتمعات، وضعف مستوى سيطرة الدولة عليها، وضرورة البحث في السبل الناجعة لمواجهة تلك التحديات الأمنية والاجتماعية في سلطنة عمان. كما تأتي أهمية البحث من حيث يسعى إلى تقديم إضافة علمية جديدة، وتوجيه دعوة جادة ومحفزة لكافة الجهات الأكاديمية والبحثية، والدارسين والباحثين للقيام بالمزيد من الدراسات المتصلة بهذا الشأن.
حدود البحث:
الحدود الموضوعية: يقتصر البحث على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها.
الحدود المكانية: سلطنة عمان.
الحدود الزمانية: العام 2022م.
الدراسات السابقة:
يمكن الإشارة إلى أهم وأبرز ما اطلعت عليه الباحثة في هذا الشأن على النحو الآتي:
1. دراسة (حميد، 2021)( )؛ هدف هذا البحث إلى التعرف على أهم التحديات القانونية أمام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرف على القواعد القانونية المتعلقة بها في المجتمع العربي عموماً وسلطنة عمان خصوصاً، ومدى إسهامها في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، من الممارسات والمخالفات القانونية الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، التوتير، انستجرام، يوتيوب…) وغيرها.
2. دراسة (عبد الحكيم، 2021)( )؛ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المخاطر الأمنية والاجتماعية لمواقع التواصل الاجتماعي على الطلاب بجامعة جنوب الوادي بقنا، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المخاطر الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي نشر الأخبار والأحداث دون التأكد من صحتها، وأن أكثر المخاطر الاجتماعية لمواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في سيطرة الأوهام على الحقيقة.
3. دراسة (الحازمي، 2021)( )؛ هدفت هذه الدراسة إلى توضيح وإظهار التحديات الأمنية المتعلقة بوسائل الإعلام عامة والالكتروني الجديد، وتطرق البحث أيضاً إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي، والرأي العام، وتوضيح أهمية وعي القائمين على الإعلام بالأمن القومي، وتأثير هذه المواقع على البيئة الإعلامية والجمهور العربي، وقدم البحث رؤية استشرافية لواقع العلاقة بين الأمن القومي والإعلام العربي.
4. دراسة (بني صالح، 2021)( )؛ هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن، باتباع المنهج الوصفي ومراجعة الأدبيات السابقة، وتوصلت الدراسة إلى طبيعة التأثير الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والمجتمعي، كما حددت الدراسة المخاطر الناجمة عنها.
5. دراسة (قاسمي وجداي، 2019)( )؛ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي للدول الخليجية، باتباع منهج دراسة الحالة، وخلصت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد أثرت في شتى المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية، وأصبحت تشكل سلطة لفرض قوانينها في الوسط الاجتماعي الخليجي مما استوجب وضع استراتيجيات شاملة لمواجهة هذه الظاهرة المعلوماتية التي تعد الفريدة من نوعها.
6. دراسة (أمين، 2019)( )؛ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز التحديات الأمنية والإشكاليات التي تنطوي عليها مواقع التواصل الاجتماعي، وسبل مواجهتها، باتباع منهج المسح الاجتماعي على عينة من النخبة الإعلامية بلغت (250) مفردة. من أهم نتائج الدراسة: أن غالبية المبحوثين من النخبة الإعلامية في مملكة البحرين (81%) ترى أن بعض المحتوى المقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضر بالحالة الأمنية في البلاد.
7. دراسة (يوسفي، 2017)( )؛ هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي للدول، وقد بينت الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي هي نتيجة للتزاوج بين التقنية ووسائل الاتصال والإعلام، الأمر الذي أكسبها مكانة اجتماعية دولية مهمة، وأدى إلى سعي الدول القوية لتوظيف هذه المواقع الاجتماعية لتهديد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي للدول.
منهج البحث
يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب المكتبي في جمع البيانات، وذلك من خلال الاستفادة من المؤلفات والكتب والدوريات والأبحاث العلمية التي عنت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي.
هيكل البحث
يتألف البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، وذلك وفق التقسيم الآتي:
مقدمة، وتشتمل على مشكلة البحث وتساؤلاته، أهميته وأهدافه… الخ.
المبحث الأول: وسائل التواصل الاجتماعي والأمن الوطني والاجتماعي
المطلب الأول: تعريف وسائل التواصل الاجتماعي
المطلب الثاني: مفهوم الأمن الوطني والاجتماعي
المطلب الثالث: أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي
المبحث الثاني: وسائل التواصل الاجتماعي وتحدياتها الأمنية والاجتماعية في سلطنة عمان وسبل مواجهتها:
المطلب الأول: التحديات الأمنية
المطلب الثاني: التحديات الاجتماعية
المطلب الثالث: سبل المواجهة
خاتمة، تشتمل على أهم النتائج والتوصيات
المبحث الأول
وسائل التواصل الاجتماعي والأمن الوطني والاجتماعي
تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أهم وأبرز منتجات الطفرة التقنية لشبكة الانترنت، والتي أصبح لها تأثيراً واضحاً وجلياً في كافة جوانب الحياة الإنسانية على كافة المستويات الفردية والجمعية، إذ أتاحت لجميع الأفراد التحول إلى دائرة المساهمة بدرجات متعددة ومتفاوتة في الشكل والمضمون والتأثير من الممارسة الإعلامية خارج نطاق القواعد المهنية التقليدية، الأمر الذي أسفر عن حدوث تحولات كبيرة في المفاهيم والنظريات والتطبيقات الإعلامية المعاصرة، والتي صارت تدخل جميعاً في إطار ما يعرف بـ الإعلام الجديد.
تعزز هذا التحول بصورة كبيرة بفضل التطور المتسارع في تقنيات الاتصال ابتداء بالحاسوب وشبكة الانترنت وانتهاءً بالأجهزة الذكية، وهذا بالتحديد ما يقع عليه مناط التأكيد عند البحث في أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي، وهو الأثر الذي يتطلب إدراكه في المقام الأول تحديد وبيان المفاهيم الرئيسية المتصلة به، وذلك على نحو ما هو آتي:
المطلب الأول: وسائل التواصل الاجتماعي
يعد مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي (Social Network Sites) أو شبكات الإعلام الاجتماعي (Social Media) من أهم المفاهيم المرتبطة بالإنترنت والإعلام الإلكتروني والمجتمع الرقمي الافتراضي، بحيث يمكن التعريف بها في عدة محاور على النحو الآتي:
1. تعريف وسائل التواصل الاجتماعي:
تباينت تعريفات وسائل التواصل الاجتماعي والمفاهيم التي وضعت لها تبعاً لتباين وتعدد وجهات نظر الباحثين، والحقول والغايات المرتبطة بدراسة هذه الشبكات منذ بداية نشأتها وعلى طول مسار تطورها، حتى وصلت الى ما هي عليه في الوقت الراهن.
تُعرف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها: “خدمات توجد على شبكة الويب تتيح للأفراد بيانات شخصية (Profile) عامة أو شبه عامة خلال نظام محدد يمكنهم من وضع قائمة لمن يرغبون في مشاركتهم الاتصال ورؤية قوائمهم أيضا وللذين يتصلون بهم وبتلك القوائم التي يصنعها الآخرون خلال النظام”( ).
وفي تعريف آخر، هي: “مواقع تتشكل على شبكة الويب، تتيح للأفراد بناء بيانات شخصية عن حياتهم العامة أو شبه العامة، وإتاحة الفرصة للاتصال بقائمة المسجلين، والتعبير عن وجهات نظر الأفراد أو المجموعات من خلال عملية الاتصال، وتختلف طبيعة التواصل من موقع لآخر”( ).
كما عرفها البعض بأنها: “مجموعة من مواقع التواصل الفعالة على شبكة الانترنت في ظل عالم افتراضي يتخطى فيه الفاعلون حدود الزمان والمكان، ويسمح فيها ببناء علاقات وتقاسم التجارب وتبادل الأخبار والمعارف وتشارك المعلومات والأنشطة التي تستخدم لأغراض عديدة ذات تأثيرات مختلفة إيجابية وسلبية تتوقف على طبيعة الاستخدام”( ).
ومن الباحثين من عرَّفها بأنها: “منظومة من الشبكات الرقمية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والهويات نفسها”( ).
علاوة على ذلك، فقد عرفت مواقع التواصل الاجتماعي بأنها: “تلك العمليات التي يتم التواصل من خلالها بين مجموعة من الناس عن طريق مواقع وخدمات إلكترونية، توفر سرعة توصيل المعلومات على نطاق واسع، فهي مواقع لا تعطي المستخدم لها معلومات فقط، بل تتزامن وتتفاعل معه أثناء إمداده بتلك المعلومات، وبذلك تكون أسلوبا لتبادل المعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة الانترنت”( ).
يتبين في ضوء ما تقدم، أن الأصل في وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي أنها مواقع رقمية تقدم خدماتها عبر شبكة الويب (الانترنت)، وتنطلق فاعليتها من حيث تسمح بإنشاء ملفات شخصية لكل مستخدم لها، يتضمن هذا الملف (بروفايل) بيانات تعريفية به، ومن ثم فإن الموقع يتيح لجميع المستخدمين والمسجلين فيه إمكانية النشر والمشاركة والتواصل مع بعضهم البعض، والتعبير عن وجهة نظرهم وتبادلها مع الآخرين ضمن هذا النظام، ومن الممكن أن تختلف طبيعة وخصائص الاتصالات من موقع لآخر( ).
كما تتسم مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من السمات الوظيفية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التواصلية، تتمثل بمجموعة من الخدمات التي يتيحها كل موقع منها للمشتركين فيه، كالمحادثة الفورية، والرسائل الخاصة، ورسائل البريد الإلكتروني، والتدوين، وخدمات الفيديو، ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات، ولعل هذه الخصائص هي التي مكنت تلك المواقع من أن يصبح لها دور فاعل في التجييش الاجتماعي والتفاعل والتأثير بقيادات غير منظمة، من حيث استطاعت تحويل الأقوال إلى أفعال والتوجهات إلى مشاريع عمل جاهزة للتنفيذ، وهي قد نجحت في التأثير على ملايين المتفاعلين مع أحداث كثيرة ليحصد المؤثرون ما يريدون من تغيير( ).
في ضوء ما تقدم، يمكن تعريف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها: “شـبكة من المواقـع الفعالـة جـداً في تسـهيل عمليات التواصل والتفاعل الإجتماعيـ بـين مجموعـة مـن المعـارف والأصدقاء، كما تمكن الأصدقاء القدامى من الاتصال بعضهم البعض وبعد طول سنوات، وتمكنهم أيضاً مـن التواصـل المرئـي والصـوتي وتبـادل الصـور وغيرهـا مـن الإمكانـات الـتي توطـد العلاقـة الاجتماعية بيـنهم، وهي كذلك علاقات تنشأ لسبب ما أحدثها التطور التقني، وسواء نشأت بواسطة المراسلة متعددة الأوجه أو بواسطة المحادثة صوتاً أو صورة أو كليهما، فإنها تتخذ طابعاً تفاعلياً اجتماعياً قابل للتوسع والانتشار في الفضاء الرقمي( ).
3. تصنيف وسائل التواصل الاجتماعي:
منذ بداية ظهورها وحتى اليوم، أصبحت هناك أعداداً كبيرة من مواقع وشبكات وبرامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي، على نحو يصعب معه حصرها أو ضبطها بتصنيف محدد وموحد، نظراً لتباين واختلاف وتعدد الأشكال والأغراض والخدمات والمحتويات فيما بينها، ومع ذلك يمكن تصنيف وسائل التواصل الاجتماعي حسب طبيعة المحتوى الذي يوفره كل منها، على النحو الآتي( ):
1. مواقع للمحادثات غير المتزامنة؛ وهي تلك المواقع التي لا تتيح للمستخدمين إمكانية التواصل المتزامن المباشر، وتعمل بالتواصل بشكل غير متزامن: (Email, Yahoo, Google).
2. مواقع للمحادثات المتزامنة؛ وهي التي تتيح للمستخدمين إمكانية التواصل المتزامن سواء كان هذا التواصل كتابة أو استماعاً أو مشاهد: (Chat, Skype, Yahoo Messenger).
3. مواقع النشر والتدوين والمشاركة الاجتماعية؛ وهي تلك المواقع التي تمكن للأفراد المشتركين من إقامة علاقات صداقه وتواصل وتبادل الملفات المكتوبة والمسموعة والمرئية سوياً ومنها: (Facebook, Instagram, Twitter, WordPress Blogger, What’s App, Myspace, Ning)، وعن طريق مواقع المشاركة الاجتماعية يمكن للمشتركين في هذا المواقع مشاركة ملفاتهم بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن، مثل: (You Tube, Tuktuk, Bookmarks Labrary).
3. خصائص وسمات وسائل التواصل الاجتماعي:
كان الهدف الأساسي من شبكة الانترنت هو تسهيل مشاركة المعلومات وتبادلها ونقلها وإرسالها وتلقيها، بما يخدم مجموعات العمل المتجانسة، ولم يكن بوسع أحد أن يتنبأ حينها بأن الانترنت ستكون بيئة تواصلية وتفاعلية اجتماعية وإعلامية عالمية شاملة على نحو ما هو عليه واقع الحال في العصر الراهن( )، فقد أدى تطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إلى تحول صناعة الإعلام من البيئة التماثلية (Analog) الى صناعته في البيئة الرقمية (Digital)؛ وهذا بدوره ما أدى إلى تطوير استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية، ومن ثم، فقد كانت الخصائص والسمات المرتبطة بهذا التحول كفيلة بجعل وسائل التواصل الاجتماعي تحولاً مرغوباً بل وجعلت الإقبال عليها شديداً للغاية( ).
وبمجرد ما إن بدأ التحول الذي قادته الشبكات الاجتماعية يفتح آفاقاً واسعة، بدأ جدل شديد يثار أيضاً بشأن ما إذا كانت هذه الشبكات ستتجاوز بشكلها وأدواتها الأشكال والأدوات التقليدية للإعلام، لاسيما فيما يتعلق بقدرتها على التأثير في سلوك الأفراد والجماهير( ).
نظراً لذلك، اتجهت أنظار الباحثين إلى دراسة الخصائص والسمات الجوهرية التي تتسم بها وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكن التمييز بين نوعين من تلك السمات، وبيانها على النحو الآتي:
(أ). السمات الشكلية لوسائل التواصل الاجتماعي:
وهي مجموعة من السمات التي جعلت وسائل التواصل الاجتماعي متاحة وفي محل إقبال الكثير من الأفراد على نحو مستمر، وتتمثل بكل مما يلي:
1. سهولة الاستخدام (Accessiblity)؛ تعد خاصية سهولة الاستخدام من أهم عوامل تفضيل المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة إقبال الجماهير، إذ لا يتطلب الأمر بذل جهد كبير لفهم أو استيعاب كيفية التسجيل فيها والتعامل معها والاستفادة من ميزاتها، خاصة مع استخدام بعض البرمجيات التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الموضوعات المعقدة مثل الوسائط المتعددة وغيرها( )، إذ تشير الدراسات إلى أن خاصية سهولة الاستخدام تعد أحد أهم عوامل تفضيل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بل أن تزايد إقبال الجماهير عليها يرتبط بشكل رئيسي بسهولة الاستخدام( ).
2. التفاعلية (Interactivity)؛ تشير هذه الخاصية إلى أن المستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي لم يعد سلبياً كما كان بل أصبح مشاركاً إيجابياً؛ فالتفاعلية في وسائل التواصل الاجتماعي تمنح المستخدم تأثيراً يمتد إلى السيطرة على المخرجات، ما دامت تتوفر في البرامج الطرق المتعددة للاقتراب من المعلومات أو المحتوى والتي أصبحت مطلباً في كل برامج ووسائل التواصل الاجتماعي أو معظمها( ).
لقد مكنت هذه السمة المستخدمين من كسر حاجز السلبية والخوف، والانتقال إلى حالة الفاعلية والمشاركة والقدرة على التعبير عن الرأي، وممارسة النقد والتعليق، والمشاركة في صنع القرار( ).
3. الوسائط المتعددة (Multimedia)؛ تعرف الوسائط المتعددة بأنها عبارة عن برامج تمزج بين الكتابة، والصور الثابتة والمتحركة، والتسجيلات الصوتية، والرسوم الخطية لعرض الرسالة؛ كما تساهم بفضل ما تتوافر عليه من سمات في تحسين الاتصال، وإثراء المواد المقدمة عبرها؛ ومن ثم فهي تستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إنتاج وتوصيل ونقل الرسائل عن طريق دمج النصوص، والرسوم، والصور الثابتة والمتحركة، بالأصوات، والتأثيرات المختلفة( )، ولأن عمل الوسائط المتعددة يقوم على مبدأ التكامل بين أكثر من عنصر لتوصيل الأفكار والمعاني، فإنها تعد من أهم سمات تحقيق التفاعلية في عمليات التواصل الاجتماعي( ).
4. سرعة الحصول على المعلومات (Quick Access to Information)؛ توصف شبكات التواصل الاجتماعي بأنها الطريق السريع للوصول للأخبار والمعلومات نتيجة توفر التقنيات المساعدة على ذلك فيها، وقدرتها على التحديث المستمر للمعلومات والأخبار( ).
5. الروابط والنصوص التشعبية (Hyperlinks)؛ الرابط أو النص التشعبي هو عبارة عن مسار غير خطي يمنح المستخدم مساحة للتنقل بين مواقع وصفحات متعددة، والقدرة على الاتصال والوصول إلى الموضوعات ذات الصلة داخل وخارج موقع التواصل الاجتماعي( ).
ساهمت النصوص التشعبية (Hyperlinks) والهاشتاغات في زيادة سرعة الوصول إلى الجديد من الأخبار والمعلومات، ومتابعة القضايا والأحداث على نحو شديد القرب في كل وسائل التواصل الاجتماعي( )؛ إذ تتوفر ضمن هذه السمة خاصيتان: تتمثل الخاصية الأولى في إمكانية الإشارة إلى الموضوعات ذات الصلة بالموضوع، وذلك بتوفير وصلات إلى نصوص متصلة بالموضوع في الموقع نفسه أو في مواقع أخرى بها يضيف المزيد من المعلومات إلى الموضوع الأصلي؛ أما الخاصية الثانية فتتمثل في إمكانية الإشارة إلى المواقع ذات الصلة بالموضوع، من خلال توفير وصلات إلى المواقع ذات الصلة بالموضوع المطروح؛ كما أنها توفر أيضاً أداة البحث في الموقع لتخدم الباحثين عن المعلومات والموضوعات التي سبق وأن نشرها من قبل( ).
(ب). السمات التقنية وسائل التواصل الاجتماعي:
وهي مجموعة من السمات المتعلقة بفاعلية وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها الانتشارية والتأثيرية في البيئة الرقمية، ويمكن إجمالها بكل مما يلي( ):
1. تفتيت الاتصال (Demassification)؛ تشير هذه الخاصية إلى أن الرسالة الاتصالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن توجيهها إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي، وتعني أيضاً درجة تحكم في نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها.
2. اللاتزامن (A Synchronization)؛ تفيد هذه الخاصية في إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد المستخدم، ولا تتطلب من المشاركين كلهم أن يستخدموا النظام في الوقت نفسه.
3. الحركية أو قابلية التحرك (Mobility)؛ تتميز وسائل التواصل الاجتماعي بصغر حجمها، مما يكسبها خاصية مميزة وهي إمكانية الاستفادة منها في الاتصال من أي مكان إلى آخر في أثناء تحرك مستخدمها، على غرار الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة وغيرها.
4. قابلية التحويل (Convertibility)؛ تشير هذه الخاصية إلى قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على نقل المعلومات من وسيط إلى آخر، كالتقنيات التي يمكنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس.
5. قابلية التوصيل (Connectivity)؛ توفر هذه الخاصية إمكانية توصيل الأجهزة الاتصالية بأنواع كثيرة من أجهزة أخرى وبغض النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد الذي تم فيه الصنع،
6. الشيوع والانتشار (Ubiquity)؛ وهي خاصية الانتشار المنهجي لنظام وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم وفي داخل كل طبقة من طبقات المجتمع.
7. الكونية (Globalization)؛ أتاحت وسائل الاتصال الاجتماعي إمكانية أن تجري كافة عملياتها التواصلية في بيئة عالمية دولية، تستطيع فيها المعلومات أن تتبع المسارات المعقدة تعقد المسالك التي يتدفق عليها رأس المال إلكترونياً عبر الحدود الدولية جيئة وذهاباً من أقصى مكان في الأرض إلى أدناه في أجزاء على الألف من الثانية، إلى جانب تتبعها مسار الأحداث الدولية في أي مكان في العالم.
علاوة على ذلك، يمكن رصد مجموعة أخرى من السمات التي تتسم بها وسائل التواصل الاجتماعي، كالآتي( ):
1. اللامركزية الاجتماعية؛ إذ تتسم شبكات التواصل الاجتماعي بدرجه عالية من اللامركزية، التي تنتهي بالتدريج إلى تفكيك مفهوم الهوية التقليدية.
2. المرونة الفردية وانهيار فكرة الجماعة المرجعية، بمعناها التقليدي في المجتمع الرقمي الذي تدور فيه عمليات التواصل الاجتماعي باستخدام هذه الشبكات.
3. التواصل العابر للحدود والمستمر عبر الزمن؛ حيث لم تعد تلعب حدود الجغرافياً دوراً في تشكيل التجمعات الافتراضية، كما أنها مجتمعات لا تنام حيث يستطيع الفرد أن يجد من يتواصل معه على مدار الساعة.
4. إمكانية الاختفاء والاختباء؛ تطبق وسائل التواصل الاجتماعي قواعد لضمان الخصوصية والسرية، ويمكن العمل فيها بهويات وأسماء وشخصيات مستعارة.
5. الخروج عن السيطرة القانونية والأمنية؛ مازالت شبكات التواصل الاجتماعي تشكل فضاءات رحبة ومفتوحة للتمرد على القوانين والأنظمة السياسية.
المطلب الثاني: مفهوم الأمن الوطني والاجتماعي
الأمن في اللغة؛ هو نقيض الخوف، والفعل الثلاثي أمِن أي حقق الأمان. قال ابن منظور: “أمنت فأنا آمن، وأمنت غيري أي ضد أخفته، فالأمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الكفر، والإيمان بمعنى التصديق، وضده التكذيب، فيقال آمن به قوم وكذب به قوم”( ).
قال تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾( ).
أما من الناحية الاصطلاحية، فلكي يتبين مفهوم الأمن الوطني والاجتماعي، لابد من التأكيد على أنهما بعدان من أبعاد الأمن الإنساني، والذي عرفته لجنة الأمن الإنساني التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003، بأنه: “الحماية الحيوية الأساسية لحياة جميع البشرـ بطرائق تعزز الحقوق والحريات والوفاء بها”؛ ويشمل كل صور الأمن التي تتحقق بها سلامة الإنسان، كالأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي، الأمن الاجتماعي، الأمن السياسي.. وغيرها( ).
يستند مفهوم الأمن الوطني الى كلمة (وطني) كصفة له. والوطن لغة هو مكان الإنسان ومقره “ويصبح البقاء في المكان هو استيطان له، واتخاذه موطناً، وبذلك، يكون مفهوم الأمن الوطني لغوياً: سلامة المكان، أي أنه المكان الذي يستقر فيه جمع من الناس، في سلام من دون خوف، وبهذا يصبح مفهوم الأمن الوطني معناه هو كل ما يبعد الأخطار عن مكان وسبل العيش” ( ).
كما يعرف الأمن الوطني، بأنه: “بعد من أبعاد الأمن الإنساني الذي يقصد به التحرر من الخوف والحاجة الى ضمان الحماية والتمكين من حقوق الإنسان، لجميع المواطنين في ذات الوقت دون استثناء أو تمييز على اعتبارها منظومة حقوقية متكاملة غير قابلة للتجزئة”( ).
وفي تعريف آخر، الأمن الوطني هو “أن يكون البلد ضمن حدوده بعيداً عن أي تهديد يعرض وجوده للخطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتحقق الأمن الوطني في الحالات التالية:
أولاً: غياب التهديد.
ثانياً: امتلاك القوة الكفيلة لمواجهه التهديد.
ثالثاً: الابتعاد بالبلاد عن آثار الخطر حال وقوعه”( ).
كذلك يعرف الأمن الوطني في بعده القومي، بأنه: “ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يستهدف خلق الظروف المواتية لحماية القيم الحيوية”( )؛ ومن ثم، فهو كل ما تقوم به الدولة من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية( ).
ويعرفه هنري كيسنجر بأنه: “أية تصرفات يسعى المجتمع– عن طريقها– إلى حفظ حقه في البقاء( ).
يحيل التعريف السابق الى مفهوم الأمن الاجتماعي، والذي يعرف بأنه: “تلك الحالة التي تتوافر فيها الحماية والأمان والطمأنينة للفرد والجماعة معاً”( ).
كما يعرف الأمن الاجتماعي بأنه: “قدرة المجتمع على الاستمرار في طابعه الأساسي في ظل الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة أو الفعلية، فهو يتعامل مع الاستدامة في ظل ظروف مقبولة للتطور للأطر التقليدية للغة، الثقافة، الجمعيات، الدين، الهوية والأعراف الوطنية… وغيرها، وينشغل بالحالات التي ترى فيها المجتمعات أنها مهددة من حيث الهوية”( ).
وعليه، يمكن تعريف الأمن الوطني بصيغة إجرائية، على أنه: “ذلك الأمن الذي يتمتع به الفرد في نطاق الدولة، والقائم على ضمان حقوقه وحرياته العادلة في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والعيش الكريم والمستدام بدون تمييز، بما يساهم في الحفاظ على استقرار وأمن المجتمع والدولة، والأمن والاستقرار الإنساني بين الدول والشعوب، على أسس من الحرية، العدالة، النزاهة، الشفافية، والشرعية.
كما يمكن تعريف الأمن الاجتماعي إجرائياً، بأنه: تلك الحالة التي يكون فيها المجتمع آمناً وموحداً في نطاق هويته وثوابته الوطنية، وقادراً على الحفاظ على أمنه ومواجهة كل التحديات التي تهدده وتهدد أمنه الوطني من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.
بصيغة شاملة، يمكن تعريف الأمن الوطني والاجتماعي بأنه كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الكيان السياسي للدولة، وتوفير الأمن للمجتمع والمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء الوطني لديهم، وحماية الهوية الوطنية والثقافة الاجتماعية، وكافة المبادئ والمعتقدات الدينية واللغوية، والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية.
المطلب الثالث: أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي:
ساهمت التحديات الناشئة عن التطور في تقنيات الاتصال والمعلومات، في ظهور العديد من المصطلحات والمفاهيم الأمنية، وفي مقدمتها مصطلح الأمننة (Securitization)، والذي يشير في أبسط معانيه الى إضفاء الطابع الأمني، أو الى تشكيل الفعل الأمني متى ما تطلب ذلك؛ فالأمننة بتعبير آخر هي ذلك المسار الذي يمكن من خلاله للدولة أن تعلن عن مسألة أو فعل ما بأنه يشكل تهديداً أمنياً، يتطلب استخدام وسائل وأدوات استثنائية لمواجهته( )، وقد صار لهذا المفهوم صدى كبيراً إزاء القضايا والمشكلات الأمنية الناتجة عن وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن كشفت موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية في مطلع عام 2011 عن حجم المخاطر والتهديدات التي صارت تحدثها هذه الوسائل، وانعكاساتها على كافة الجوانب الأمنية للدول.
لقد نجم عن الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي أن تمكنت هذه الشبكات من فرض سيطرتها على المجتمعات، ما جعلها سلاحاً ذو حدين ولها تأثير خطير جداً وكبير على الدول والمجتمعات، وحينما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والاجتماعي، فإن مناط التأكيد يقع بلا شك على خطورة العديد من صور الاستخدام الخاطئ لتلك الوسائل من قبل الأفراد والجماعات( ).
وفي ظل غياب المعايير الواضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه الوسائل تشكل مصدراً للعديد من التهديدات الأمنية التي تمس بدرجات متفاوتة كل جوانب الأمن الوطني والاجتماعي، من خلال استخداماتها لأغراض الحشد والتعبئة السياسية للجماهير، نشر الشائعات، التحريض على العنف والإرهاب، التجييش الطائفي والمذهبي، الجرائم الالكترونية( )، الهدم الثقافي، تفكيك الهويات الاجتماعية والوطنية، الجريمة المنظمة، الابتزاز، التهديدات الأخلاقية والقيمية( )، وغير ذلك من العناوين العريضة التي أصبحت تدخل في إطار التهديدات الأمنية، وهذا بدوره ما جعل من ضبط تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة ملحة لتحقيق الأمن المجتمعي( ).
انعكس تعدد وتنوع وتداخل وتشابك تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على مفهوم الأمن نفسه، من حيث ساهمت تلك التأثيرات في توسيع نطاق المفهوم التقليدي، فلم يعد يقتصر على النواحي العسكرية والأمنية التقليدية، بل صار يشمل كافة جوانب حياة الأفراد والمجتمع بكل مجالاته، بما في ذلك الأمن السياسي، والأمن الاجتماعي، الأمن الثقافي، الأمن الفكري، الأمن القيمي والأخلاقي، وهذا بدوره ما ساهم في بلورة الاتجاه نحو أمننة وسائل التواصل الاجتماعي( ).
يرتبط أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي بالمخاطر والتحديات الأمنية الناتجة عن استخدام مختلف تقنيات وتطبيقات الاتصال والمعلومات الحديثة، خاصة وأن أغلب البنى التحتية للدول صارت مرتبطة بشبكة الانترنت( )، في الوقت الذي ازدادت فيه تلك المخاطر نتيجة للتطور المتسارع والمستمر في التقنيات والتطبيقات الذكية، والتي نقلت مستوى التعامل مع وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي إلى مستويات متقدمة من الاقبال الشديد والاستخدام الكثيف( )، بحيث أصبحت مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي تحتل حيزاً مهماً في الاستراتيجيات الأمنية لكافة الدول، فضلاً عن دخولها ضمن أولويات الأمن الدولي( ).
ساهمت العديد من المصطلحات والمفاهيم الأمنية الجديدة، في الكشف عن أثر المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث صار يجري الحديث بكثرة عن التهديدات السيبرانية (Cyber Threats) كمصطلح يكشف عن العلاقة الوثيقة بين الأمن وتقنيات الاتصال والمعلومات، متصلاً ذلك بمفهوم الحرب السيبرانية (Cyber War)، كنشاط تستخدم فيه وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض لوجيستية وتنفيذية تسهم في زيادة المخاطر والتهديدات الأمنية المرتبطة بشبكة الانترنت( ).
علاوة على ذلك، يبرز أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي من خلال ما يعبر عنه مفهوم حروب الجيل الخامس (Fifth Generation Warfare)، وهو نوع من الحروب الفكرية والثقافية تعتمد بدرجة رئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مستويات معينة من (احتلال العقول)، على نحو ما يمكن من إثارة الفتن والصراعات الفكرية والعقائدية والمذهبية وغيرها من المظاهر التي تضاعف من المخاطر المترتبة عن استخدام تلك الشبكات وتهدد بشكل مباشر كل جوانب الأمن والاستقرار الوطني والاجتماعي( ).
كما تبرز تلك المخاطر بوجه خاص، من حيث أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود لممارسة أدوار بالغة الخطورة والتهديد على الأمن الوطني والاجتماعي( )، على نحو ما تكشف بعد موجة الربيع العربي التي ثبت لاحقاً لأنها كانت لعبة قذرة لعبها الكثير من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين والهيئات الدولية، تحت شعارات الحرية والتغيير والديمقراطية, وهي الشعارات التي استخدمت في وسائل التواصل الاجتماعي لتجييش الجماهير وتوظيفها بطرق وأشكال مغرضة، انتهت إلى حالة من الفوضى والحروب والصراعات الأهلية المدمرة( ).
يزيد من حدة تلك المخاطر والتأثيرات، أن الواقع الاجتماعي في معظم المجتمعات العربية يشهد بشكل عام بما فها المجتمع العماني صوراً متعددة من الإنحراف الفكري لدى الشباب، خاصة اهتزاز القيم واضطراب المعايير الاجتماعية والأخلاقية، الأمر الذي يتمثل بوضوح في تزايد ألوان الانحراف، وانتشار صور من السلوك لم تكن مألوفة من قبل مما يهدد الأمن والاستقرار الوطني والمجتمعي( ).
يتبين من ذلك، أن أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي أصبح يتخذ طابعاً واسعاً ومستمراً في التنامي والاتساع من حيث طبيعته وأشكاله وصوره وأنواع المخاطر والتهديدات الأمنية المترتبة عن تلك الوسائل، ودرجة خطورتها وحدة انعكاساتها على الأمن الوطني بأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وعلى الأمن الاجتماعي بأبعاده الثقافية والقيمية والأخلاقية والفكرية والتربوية.
كما يتبين مما تقدم، الى أي مدى ساهم ذلك الأثر في توسيع نطاق مفهوم الأمن الوطني والاجتماعي، وعن مدى الترابط الوثيق بين الأمن السياسي والأمن المجتمعي، باعتبار أن افتقاد أياً منهما يؤدي الى افتقاد الآخر، إذ لا يمكن تصور دولة آمنة ومستقرة بمجتمع مهدد ومنقسم ومتشرذم ومتطاحن، كما لا يمكن تصور مجتمع آمن ومستقر بدون دولة ثابتة ونظام حكم قوي ومتماسك، وقانون مطبق، ومؤسسات تعمل بانتظام وما الى ذلك، وهذا كله ما يفرض أمننة وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى رصدها والتعامل معها من منظور أمني واستراتيجي شامل وفاعل.
المبحث الثاني
وسائل التواصل الاجتماعي وتحدياتها الأمنية والاجتماعية
في سلطنة عمان وسبل مواجهتها
أشارت نتائج دراسة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2019 إلى أن (94%) من العمانيين يستخدمون وسيلة واحدة على الأقل من وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها انتشاراً الواتساب بنسبة (93%) يليها اليوتيوب بمعدل بلغ (71%)، ثم الانستجرام وصل إليه (50%)، كما يقضي العمانيون ملا لا يقل عن (6) ساعات يوميا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والأكثر استخداماً منها في المجتمع العُماني يوضحها الشكل البياني التالي( ):
شكل (1): وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في المجتمع العُماني
على هذا الأساس، يعنى هذا المبحث باستعراض التحديات الأمنية والاجتماعية الناشئة عن وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بالاستناد الى ما خلصت إليه جهود الباحثين والدارسين، وذلك في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:
المطلب الأول: التحديات الأمنية
يمكن إبراز التحديات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان في ثلاثة محاور المتشابكة في بعض جوانبها، وتأثيراتها الأمنية، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: التوظيف الأيديولوجي والسياسي لوسائل التواصل الاجتماعي:
لا تعمل وسائل التواصل الاجتماعي بمعزل عن سياقاتها السياسية والاجتماعية، بل هي في الأساس ترتكز على طبيعة الاهتمامات الأيديولوجية التي يلتقي عندها أفرادها، والتي تعد محركاً رئيسياً يستمد منه المستخدمين مرجعياتهم الحاكمة، ومن ثم، فإن التحديات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي تكمن في التغيرات التي تطرأ على أفكار ومعتقدات المستخدمين وتوجهاتهم( ).
لقد بدا واضحاً منذ بداية عام 2011 كيف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات لتعبئة الرأي العام، وإثارة الخلافات والصراعات والانقسامات السياسية التي تستهدف بشكل مباشر العلاقة بين النظم السياسية والمجتمعات، وتعمل على خلق شروخ شديدة فيها، بحيث توظف تلك الشبكات للتحشيد للاحتجاجات السياسية، والتحريض على التظاهرات والاضرابات تحت شعارات المعارضة السياسية وحرية التعبير، والمطالبات المشروعة بالتغيير السياسي والاقتصادي إلا أن الشواهد الواقعية تثبت أن الأمور غالباً ما تكون موظفة لأغراض غير معلنة، قد تصل إلى حد التخريب وإشاعة الفوضى السياسية في الدول( ).
تعمل شبكات التواصل الاجتماعي على إعادة تكوين مجتمعي للمستخدمين ذي طابع ايديولوجي، يؤدى غالباً إلى خلق تكتلات وجماعات تعمل على نقل فعالياتها من الواقع الافتراضي إلى الواقع الفعلي، وهذا بدوره ما يتجلى في الممارسات السياسية في الفضاء الرقمي، والتي ثبت فعلياً أن مواقع التواصل الاجتماعي تسهم كثيراً في تحويلها إلى نماذج صراعية، من شأنها أن تهدد الأمن الوطني( ) وهذا ما لمسناه ف بلادنا في عام 2011.
ثانياً: زعزعة الهوية والوحدة الوطنية:
لكل مجتمع هوية تميزه عن غيره من المجتمعات( )؛ وهوية كل مجتمع تمتد على مساحة كاملة من الجغرافيا والثقافة واللغة والتاريخ، وما يتشكل عنها من مظاهر وخصائص وسمات، كالأعياد، والممارسات الدينية، والأزياء والملابس، والعادات والطبائع، والنظم السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية وغير ذلك؛ “وغالباً ما يكون التعليم بمثابة الأداة الأولى والأهم لغرس الهوية وترسيخ الشعور بالانتماء إلى الوطن في ضمائر الصغار والناشئة”( ).
والهوية لمجتمع ما لابد وأن تستند إلى أصول تستمد منها قوتها، وإلى معايير قيمية ومبادئ أخلاقية وضوابط اجتماعية وغايات سامية تجعلها مركزا للاستقطاب العالمي والإنساني( )، لاسيما وأن واقع التعدد والتنوع والتباين بين الهويات الثقافية يفرض دائماً بروز مسألة الهوَّية، باعتبارها من أكثر المسائل حساسية وتعقيداً بالنسبة لأي بلد ومجتمع، كونها بالأساس تُحدد وجهات النظر المتبادلة بين الثقافات المختلفة، حيث ينصرف الشعور بالانتماء إلى أبعاد معنوية أكثر منها مادية، وهي أبعاد وجدانية وشعورية وتاريخية، لا تنفصل عن أبعادها الوطنية الاجتماعية الثقافية والفكرية والأمنية( ).
على هذا الأساس، تعد الهوية الوطنية عاملاً رئيسياً من عوامل تحقيق الأمن والاستقرار الوطني والاجتماعي، في الوقت الذي يعنى فيه البعد المجتمعي للأمن الإنساني بخلق توازن فعلي بين الخصوصيات اللغوية أو العرقية أو الدينية وبين الحاجة إلى بناء منطق الاندماج الوطني للمواطنين في مجتمع تعددي وعادل، تصورا بديلاً وإطاراً جديدا لفهم ودراسة الهوية الوطنية وأدوارها في تحقيق الأمن الوطني والاجتماعي( )، ذلك أنها تختزل في طياتها وتوحد كافة الهويات الفرعية داخل المجتمع الواحد، وتحد من كافة أشكال الصراعات والانقسامات الداخلية؛ وفي المقابل، فإن واقع الأمن الوطني والاجتماعي يعكس مدى تماسك المجتمع والتفاف أفراده حول هويتهم الوطنية، تتآزر معهم في سبيل ذلك مختلف مؤسسات التعليم والإعلام والعقل الجمعي للشعب وإرادته للانطلاق نحو آفاق المستقبل( ).
لقد اصبح سؤال الهوية الوطنية من أكثر الأسئلة التي تطرح بكثافة في مقابل تحديات العولمة والمعلوماتية( )، التي اقتحمت كافة المجتمعات بشكل كبير، حتى ظهرت العديد من التحديات التي تمس الهويات الوطنية وتهددها( ).
وفي ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي تضاعفت خطورة هذه المسألة، من حيث أصبحت تلك الوسائل عاملاً من عوامل تهديد الهوية الوطنية، وأدوات فاعلة تستخدم وتوظف لأغراض زعزعة الهويات وتفتيت المجتمعات إلى هويات وثقافات فرعية مذهبية وطائفية وعرقية وقبلية وعشائرية وسياسية وايديولوجية، جعلت الإنسان يعيش صراعاً مزدوجاً، يتمثل في جانب منه في محاولة الحفاظ على هويته الوطنية وتأكيدها وترسيخها, وإعادة ربط حاضره ومستقبله بماضيه وثوابته وسعيه للتوفيق بينهما, ومن جانب آخر يتمثل بصراعه مع الآخَر على كافَّة المستويات( )؛ الأمر الذي يتجلى أثره بشكل أو بآخر في الأوضاع المأساوية التي أدت إليها الانقسامات والصراعات الداخلية التي شهدتها وتشهدها بعض دول المنطقة العربية، في ظل ما آلت إليه تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2011، والتي مازالت آثارها الكارثية وعواقبها الوخيمة قائمة حتى الوقت الراهن.
والمجتمع العماني كغيره من المجتمعات الخليجية والعربية أو العالمية ليس في منأى عن تلك التأثيرات؛ فأفراد المجتمع بكافة فئاتهم العمرية والثقافية يتعرضون لتأثير الإعلام، وشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من العوامل التي باتت تفرض الكثير من التحديات على محك الهوية الوطنية( ).
ثالثاً: انتشار الجرائم الالكترونية وجرائم المعلوماتية:
تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي على المحتوى الذي ينشر فيها، ونظراً لعدم وجود معايير ووسائل رقابية تحد من النشر غير المشروع للمحتوى الخادع والمضلل، والمحتوى الذي ينطوي على معلومات وخطابات مغرضة، فقد ظهرت طائفة من الجرائم التي اصبحت ترتكب وتمارس بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن تصنيفها على نحو ما هو آتي( ):
(أ)- جرائم الاعتداء على الخصوصيات والسرية؛ وتهدف هذه الجرائم إلى نشر المعلومات بطرق غير مشروعة، عن طريق الاختراقات والقرصنة، وغالباً ما يؤدي نشر هذا النوع من المعلومات إلى تهديد حقوق ومصالح أفراد، وشخصيات عامة مؤثرة وفاعلة، وقد يصل الأمر إلى نشر معلومات الدولة ذات الطابع السري والاستخباراتي.
(ب)- جرائم نشر الأخبار الكاذبة والاشاعات؛ وهي جرائم اثبتت في السنوات الأخيرة إلى أي مدى يمكن أن تصل درجة خطورتها الأمنية، إذ يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، والتي قد تتعلق بأشخاص وجماعات/مجتمعات ومعتقدات وأفكار، والهدف منها غالباً تكدير السلم العام، وإثارة النعرات والصراعات والتصادمات الفكرية والمجتمعية والأسرية والقبلية والعشائرية، وإحداث البلابل والفتن العامة في الدول المستقرة.
(جـ)- جرائم التزييف والتزوير الالكتروني؛ وفيها تستخدم التقنية في عمليات تزوير وتزييف للوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية، لأغراض إجرامية متعددة، أهمها الأغراض المالية، والأغراض الانتحالية كتغيير الهويات والشخصيات، ليسهل لها التحرك والسفر إلى مناطق مختلفة حول العالم، وقد استفادت التنظيمات الإرهابية ومنظمات الجريمة العابرة للحدود من هذه الجرائم، في تمرير وتنفيذ عملياتها الخطيرة والتي تحتمل مخاطر أمنية مضاعفة.
(د)- جرائم القرصنة؛ وتهدف إلى الاعتداء على الأصول وحقوق الملكية الفكرية، وسرقة الأعمال والابداعات والاختراعات والبيانات والمعلومات المختلفة، والاتجار بها بطرق غير مشروعة.
(هـ)- جرائم الإرهاب الالكتروني؛ وهي من الجرائم التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المطلب الثاني: التحديات الاجتماعية:
برغم كل إيجابياتها، مازالت وسائل التواصل الاجتماعي تثير الكثير من المخاوف التي تتعلق بدورها السلبي على أمن واستقرار المجتمعات( )، ذلك أن إيجابياتها مشروطة بالاستخدام الإيجابي والصحيح لها، في حين لا تتوفر بالفعل أي قيود تضمن ذلك، بل أن هذه الوسائل مفتوحة دائماً لكل أشكال وصور الاستخدام السلبي، الأمر الذي أفرز العديد من التحديات الاجتماعية التي لا تنفصل في طابعها ومضمونها عن التحديات الأمنية المباشرة، بحيث يمكن التطرق إليها في عدة محاور على النحو الآتي:
أولاً: خلخلة وتفكيك الكيان الأسري والعلاقات الاجتماعية:
لقد ألقت وسائل التواصل الاجتماعي بظلال تأثيرها السلبي والجارف على الفرد والمنزل، والعائلة، والحياة نفسها، على نحو ما جعل من هذه الوسائل على رأس أخطر القضايا الأمنية وأهم الإشكاليات الاجتماعية والسياسية في القرن الحالي( )، ولا شك في أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي قد جعل الأسرة تواجه عبئاً جديداً، حيث فرضت عليها أن تتعرف إلى طبيعة هذه الوسائل وكل السمات المتصلة بها من حيث التقنيات الحديثة: وظائفها وخدماتها ومميزاتها ومخاطرها وآثارها المختلفة على أبنائها وعلاقاتهم مع أسرهم، وهذا يُضيف مهمة جديدة إلى مهامِها( ).
تؤكد العديد من الدراسات أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي يؤثر على الفرد من مختلف النواحي التربوية والتعليمية والاجتماعية والنفسية والصحية، خاصة مع صعوبة التحكم المباشر في استخدام الأفراد لهذه الشبكات والمواقع، الأمر الذي اعتبرته منظمة اليونسكو أحد تحديات القرن الحادي والعشرين، التي تتطلب من المجتمعات بالضرورة العمل على تبني التربية الإعلامية على اعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي أحد أشكال الإعلام الجديد( ).
كما تؤكد العديد من الدراسات، أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم بدور فاعل في نشر أنماط حياتية تؤدي إلى تفكيك الأسرة وخلخلة بنائها وعلاقاتها، وخاصة تلك الأنماط التي تعزز النزعات الفردية لدى الأبناء، وتدفعهم الى التقوقع والانفراد، والتمركز حول الذات( )، مما يؤدي إلى سيطرة اللامبالاة عليهم، وزيادة إهمالهم لعلاقاتهم الاجتماعية مع بقية أفراد الأسرة، كما تدفعهم الى الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية، والانعزال عن المجتمع وكل الأحداث الجارية، ذلك أنهم يجدون البدائل في إقامة علاقات مع الآخرين عبر الشبكة، والتي تُعتبر أكثر تحرراً من المعايير الاجتماعية وأكثر إثارةً وأقل خطورة، فيضعُف ارتباطهم بالأسرة التي كان لها دور الرقابة، فتنحرف أخلاقهم وينجرفون وراء القيم والأفكار الغربية، ويقعون في مستنقعات الإباحية والرذيلة( ).
كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تفكيك الترابط والتلاحم الأسري، نتيجة دفعها الأبناء إلى الانطواء والعزلة، الأمر الذي يتطور مع الوقت إلى تدني مستوى المهارات الاجتماعية لديهم، وضعف مستوى القدرة على التواصل مع الآخرين أو إقامة الصداقات، فضلاً عن تراجع مستوياتهم الدراسية، وانخفاض القدرة على التركيز والانتباه، إضافةً إلى بعض الآثار النفسية، مثل فقدان القدرة في التعبير عن الذات، وضعف مستوى الثقة بها( ).
تتعرض الأسرة اليوم لِعملية هدم وتفكيك جارفة لنسيجها الاجتماعي، وذلك نتيجة انخراط معظم أبنائها في دائرة التغير السلبي الناجم عن الاستخدام الخاطئ وغير المنضبط والمتكرر لمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يخلق فجوات في التعامل والتواصل الإيجابي بين الآباء والأبناء، ويؤدي إلى ضعف العلاقات المُتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة، وعدم وجود مساحة كافية من الحوار وتبادل الآراء والخبرات فيما بينهم، وهذا كله يعني أن الأسرة قد فقدت تلاحمها ووحدتها وبنيتها المتماسكة التي كانت تتمتع بها قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي( ).
تشير الدراسات إلى أن الأسرة تتأثر بالأثر الذي تتركهُ مواقع التواصل الاجتماعي على أفرادها، وإلى أن أغلب الأٌسر التي يستخدم أفرادها مواقع التواصل الاجتماعي، يعانون ويتأثرون بأضرارها التي تنعكس على الأبناء من مختلف النواحي الدينية والأخلاقية القيمية، والاجتماعية، والنفسية، والصحية، وأنّ من أبرز أضرارها أنها تبني السلوكيات السلبية، والأخلاق المنحرفة، والعلاقات التي تتعارض مع قيم المجتمع الدينية والتقاليد والعادات الاجتماعية( ).
يتضح من ذلك، أن أكثر من يتعرض اليوم لمخاطر وتهديدات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجتمعات العربية عموماً، والمجتمع العماني على وجه الخصوص هي الأسرة، لاسيما في ظل اتساع مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل بين الأفراد من مجتمعات مختلفة، وهذا بدوره ما فرض على الأسرة تحدياً جديداً يظهر من خلال دورها في التربية والتوجيه والإرشاد إلى قيم المجتمع والالتزام بقواعده ومعاييره الأخلاقية والثقافية، واحترام الثوابت الدينية والاجتماعية( ).
كما تمتد المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الأفراد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من محيط الأسرة إلى المحيط الاجتماعي ككل، متدرجة من ضعف الترابط الأسري وعدم وجود تواصل مباشر بين الفرد وأفراد أسرته، إلى مشكلات في العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، كضعف العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء والزملاء، وتفضيل العلاقات الافتراضية عن العلاقات الواقعية والتأثر بالعادات والتقاليد الغربية( )، علاوة على ذلك غدت وسائل التواصل الاجتماعي أحد أسباب انتشار الطلاق بين الأزواج، وسبباً رئيساً في انخفاض التفاعل الأسري، فقد أسهمت في تكوين علاقات اجتماعية غير صحيحة بنيت على الكذب والمبالغة غير الحقيقية بين المتحدثين عبر شبكات التواصل، فضلاً عن انتشار ثقافة السحر والشعوذة، ونشر الفاحشة، لاسيما في ظل انتشار الحسابات المشبوهة التي تدار من جهات خارجية وداخلية موجهة للإفساد المجتمعي( ).
ثانياً: الهدم التربوي ونشر الانحلال القيمي والأخلاقي:
إن عالم وسائل التواصل الاجتماعي ما هو إلّا ساحة مفتوحة لمن شاء عرض أفكاره، وجذب المهتمين بها، أو محاولة إغوائهم بشتى الطرق والوسائل، إذ تنتشر اليوم عبر هذه الوسائل كل الأفكار والتوجهات والمضامين السلبية والمخلة بالقيم والأخلاق، والجميع عرضة لتلقيها والانجذاب إليها( ).
يتضاعف هذا الخطر حينما يتبين أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يحرصون على اتباع قواعد الاستخدام الصحيح لها، وربما يجهلونها بشكل فعلي، ويجهلون بالتالي كيف يتعاملون مع المحتوى الذي يتعرضون له، وخصوصاً الأطفال والمراهقين، كالتعامل مع نشر الأكاذيب والإشاعات، وآلية الإبلاغ عن الضرر، واحترام خصوصية الآخرين، وغيرها من الجوانب التي بات من الضروري جداً تطوير آليات تعزيزها على كافة المستويات( ).
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وفق نظرة ما الى ما يمكن أن يترتب عنها، تشكل مصدراً من مصادر الهدم التربوي، خاصة في ظل توافرها لجميع الفئات والشرائح بصفات جودة متفاوتة تناسب كل طبقات المجتمع، ومن حيث سمحت التكنولوجيا المتطورة اليوم بالجمع بين الأكفأ والأعلى قدرة، وبين الأرخص والأكثر سهولة في الاستخدام( )، في الوقت نفسه الذي تستخدم فيه هذه الوسائل لنشر وترويج مختلف الأفكار والقيم والعادات والممارسات الفاسدة، لاسيما تلك المتعلقة بالجنس، الإباحية، الشذوذ الجنسي (المثلية)، وغيرها من أشكال وصور الانفلات القيمي والأخلاقي الوافدة من المجتمعات الغربية( ).
هناك انتشار لما يسمّى بـ (الإباحية الالكترونية) عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل تبادل الوسائط المتعددة التي تتضمن محتوى مخلاً بحرية تامة( ) وأصبح هناك مجموعات خاصة بكل توجّه جنسي، لا بل هناك أيضاً ما يسمّى بـ (دعارة الأطفال) التي دفعت اليونسكو في عام 1999 لتنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة دعارة الأطفال عبر الانترنت( ).
تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصفحات التابعة للمواقع الإباحية والجنسية الخارجة عن حدود الأدب والأخلاق، والتي تؤثر سلباً على الأفراد من خلال نشر الرذيلة وممارسة الفاحشة ومشاهدة المواد والأفلام الإباحية، كما تساعد على انتشار الكذب، والعلاقات المزيفة والسرقة والنصب والاحتيال على الفتيات السذج( ).
فقد انتشر الجنس كالوباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح هناك ما يُعرف بالجنس الجوال (Phonesex) والدردشة الصوتية نتيجة للكبت العاطفي( )، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الشبكات من أفضل الأدوات التسويقية للجنس والترويج للمواقع الإباحية المنتشرة على شبكة الانترنت، والأفكار المسمومة( ).
هذا يشكّل خطورة على كافة الفئات العمرية، فهي تستغل في الأفراد وخاصة من الأطفال والمراهقين والشباب الغريزة والدوافع والحاجات الجنسية لديهم، خاصة ولأن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على نشر المعلومات الجنسية الفاضحة على شبكة الانترنت، بل أن الجنس والإباحية اتخذت شكل التجارة الالكترونية، التي تغطي طيف الميول الجنسية على اتساعه من الجنس الطبيعي إلى أقصى درجات شذوذه المتمثل في (المثلية)؛ وعليه، فإنّ الجنس يأتي على رأس قائمة الموضوعات الأكثر شيوعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت بدورها في ظهور الجنس الالكتروني كبديل للجنس الحقيقي، كما تحرض على الانغماس فيه وفي وهم ممارسته عن بعد، وبكافة أشكاله وأساليبه، مما يؤثر على علاقة الإنسان بذاته أولاً، وبالآخرين ثانياً( ).
ثالثاً: نشر ثقافة التطرف والتحريض على العنف والإرهاب:
تعد ظاهرة التطرف (Extremism) من الظواهر التي ارتبطت بشكل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يُنظر إليها من مختلف العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع، وعلم النفس، والأنثروبولوجيا، حتى اختلفت اتجاهات الباحثين في وضع معايير محددة لماهيتها( ).
وبالنظر إلى ما يشير إليه المعنى اللغوي للتطرف من تجاوز لحد الاعتدال، فإن تأثير العوامل النسبية بين المجتمعات ظل حائلاً دون الاتفاق على تعريف محدد له؛ فما قد يعتبر تطرفاً في مجتمع ما، قد لا يعد كذلك في مجتمع آخر، تبعاً لتأثير المتغيرات البيئية والحضارية والثقافية والدينية والسياسية التي يمر بها كل مجتمع( )؛ إذ يُعرف التطرف من وجهة نظر سوسيولوجية بأنه: “المغالاة السياسية أو الدينية ويعنى بالحدة الشديدة التي تتصف بها سلوكيات الفرد اتجاه موضوع أو فكر يعتنقه”( ).
بيد أن الوقائع المعاصرة المتصلة بظاهرة التطرف، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشرها كثقافة وسلوك، وجَّهَت بعض الباحثين إلى تعريفه بأنه: “كل ما يؤدي إلى خروج الفرد عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير والأساليب السلوكية الشائعة في المجتمع، معبراً عنها بالعزلة أو بالسلبية والانسحاب، أو تبني قيم ومعايير مختلفة، قد يصل الدفاع عنها إلى الاتجاه نحو العنف في شكل فردي أو سلوك جماعي منظم، بهدف إحداث التغيير في المجتمع، وفرض الرأس بقوة على الآخرين”( ).
غالباً ما يشيع التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي كموقف فكري يرفض معتنقوه أي فرصة للحوار، كما يرفضون أي تلميح حول وجود قصور أو خطأ في فهمهم، ويذهبون في جدلهم إلى أبعد مدى ممكن؛ وفي كل مجتمع توجد دائماً شريحة أو فئة متطرف، والقاسم المشترك بين المتطرفين من جميع الأطياف في نهاية الأمر هو أنهم يرفضون أي تسوية أو حل وسط مع الآخرين الذين لا يشاركونهم آراءهم”( ).
تستند ثقافة التطرف المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى قدر كبير من المبالغة في التمسك فكراً وسلوكاً بجملة من الأفكار التي يشعر معتنقها من خلالها بامتلاك الحقيقة المطلقة، على نحو ما يؤدي إلى خلق فجوة بينه وبين النسيج الاجتماعي الذي يعيش فيه وينتمي إليه، الأمر الذي يؤدي إلى غربته عن ذاته، وعن الجماعة ويعوقه عن ممارسة التفاعلات المجتمعية التي تجعله فرداً منتجاً( ).
اتخذ التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً متباينة، منها التطرف السياسي، والتطرف الاجتماعي، والتطرف الفكري، والفني، والتطرف الديني( )، وجميع هذه الصور يمكن أن تؤول في ذروتها رلى حالات خطيرة من العنف والإرهاب؛ إذ تؤدي ثقافة التطرف والممارسات المتصلة بها إلى تعطيل قوى الإنتاج الاقتصادي، وتهديد أمن واستقرار وسكينة المجتمع من كافة النواحي، الأمر الذي يزيد من حدة تفاقم المشكلات الأساسية التي يعاني منها الفرد والمجتمع، كالفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الصحية، وشحة المياه، وغيرها؛ فالتطرف يتحول إلى ظاهرة عندما تتحول المعتقدات بجميع أنواعها إلى سلوك يمارس على الواقع، بما يهدد السلم الاجتماعي داخل المجتمع، من خلال تنازع جماعات متطرفة تزرع بفكرها وثقافاتها الفتنة والانقسام الداخلي، وفتح أبواب للمزيد من الصراعات والمواجهات اللانهائية، الأمر الذي ينتهي بتدمير وطن بأسره( ).
يمكن القول، بأن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في نشر ثقافة التطرف وتحويلها إلى ثقافة فرعية ضمن الثقافة الاجتماعية العامة، انطلاقاً من فهم قاصر للدين أو من تبني موقف فكري سياسي متشدد أو نظرة اجتماعية وثقافية متعالية تجاه الآخرين، تدفع الفرد إلى العزلة والانسحاب عن ممارسة الفعاليات الاجتماعية الشائعة، والخروج عليها باعتبارها خاطئة وينبغي تغييرها بمختلف الطرق، ولو كان ذلك باستخدام القوة، وهي ثقافة قائمة على اعتقاد معتنقيها امتلاكهم للحقيقة المطلقة، ورفضهم القاطع والبات لأي طعن في قناعاتهم أو تشكيك بمعتقداتهم، باعتبارها النموذج الصحيح الذي ينبغي أن يتحول إليه جميع أفراد المجتمع، الأمر الذي يفتح الباب للكثير من التحديات الأمنية الخطيرة( )، وهذا ما تؤكده كل الشواهد والوقائع الفعلية التي شهدتها المنطقة العربية خصوصاً، والعالم بأسره عموماً على مدى العقدين الماضيين، ورصدته الكثير من البحوث والدراسات الأمنية والاجتماعية.
المطلب الثالث: سبل المواجهة:
من البديهي، أن الأشياء بذاتها لا تنطوي على الخير أو الشر، وإنما يكون ذلك نتيجة للطرق التي تستخدم بها، والأهداف من استخداماتها بطريقة دون أخرى، فالبشر هم من يكسبون الأشياء قيمتها باستخدامهم إياها، ويضفون عليها خصائص معنوية وأخلاقية، والتكنولوجيا ما هي إلا أداة يمكن استخدامها لأغراض متعددة، ومن ثم، فإن سبل المواجهة لكل التحديات الأمنية والاجتماعية التي نجمت عن وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تنطلق من التركيز على المشكلة لأن المشكلة ناتجة في الأساس عن كيفية استخدام تلك الأدوات والوسائل، وتركيز الاهتمام على جميع القضايا الوطنية والاجتماعية المتعلقة بهذا التغيير، والتي يتعين على المجتمع العماني أن يتوافق معها( ).
بشكل عام، لابد أن ترتكز المواجهة على عدة منطلقات جوهرية، تتمثل بكل مما يلي:
1. الاعتراف بحقيقة الأثر الشديد الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، وبقدرتها الهائلة على إحداث التغيير والتحول في المجتمع العماني.
2. التأكيد على العائد الإيجابي الذي يمكن تحقيقه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إامكانية الاستفادة من خصائصها ومميزاتها في معالجة سلبياتها ومخاطرها.
3. التخطيط الاستراتيجي الشامل والدائم للمواجهة المستمرة لكل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تثيرها وسائل التواصل الاجتماعي.
4. تكاتف الجهود على كافة المستويات (الفرد، الأسرة، المؤسسة، المجتمع، الدولة) في مواجهة كل المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي.
5. الاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات الرائدة والناجحة في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، ونقل الخبرات منها وتبادلها معها.
انطلاقاً من ذلك، يمكن تحديد مجموعة من السبل الكفيلة بمواجهة كافة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: المواجهة التشريعية والقانونية:
يتطلب هذا السبيل القيام بحزمة من الإجراءات الهادفة التي يمكن بلورتها على النحو الآتي:
1. تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الوطنية في سلطنة عمان، والتي تتعلق بكل جوانب استخدام الانترنت، من خلال تحديث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، بحيث يشمل كافة الجرائم والمخالفات والممارسات الخاطئة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي.
2. تطوير وتفعيل الأدوات اللائحية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة، مثل مسودة السياسة الحكومية للمشاركة الالكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في القطاع الحكومي سلطنة عمان.
3. العمل على إصدار ميثاق شرف إعلامي ذي طابع مجتمعي شامل لتنظيم ومراقبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يكون ذلك بتوافق جميع القوى الفاعلة الرسمية والإعلامية والمجتمعية، ويتضمن كافة المواد والنصوص التي تعالج أسباب الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية لدى كافة الأفراد في هذا الخصوص.
ثانياً: المواجهة التربوية والتعليمية:
لقد تبين أن جانباً كبيراً من التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، يعزى إلى أسباب تربوية وتعليمية، بل أن هذا السبيل يعد جوهرياً لأي مواجهة حاسمة لهذه التحديات.
يمكن أن يتضمن هذا الاتجاه حزمة من الإجراءات المتمثلة بصورة عامة بكل مما يلي:
1. تطوير مناهج التعليم العام، وتضمينها مقررات ومضامين تتعلق بمهارات القرن الحادي والعشرين، وعلى رأسها المهارات التقنية.
2. إدماج شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي ضمن العملية التعليمية كنطاق ومصادر ووسائل وآليات تعليمية وتربوية، مع كل ما يتعلق بطرق استخدامها من قواعد وقوانين، وما إلى ذلك، على أن يكون ذلك بشكل متدرج منذ بداية مراحل التعليم وعلى مداها بشكل مستمر، وبما يتناسب مع المتطلبات الأمنية والاجتماعية لمواجهة تحديات وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية ككل.
3. تعزيز دور مراكز الخدمة الاجتماعية لتقوم بدور مباشر في تطوير وتعزيز قدرات وخبرات أولياء الأمور والأسرة عموماً في مواجهة مخاطر وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي.
ثالثاً: المواجهة الإعلامية (التوعوية والتثقفية):
يمكن أن تتحقق المواجهة الناجعة في هذا المسار، من خلال الآتي:
1. تضافر جهود جميع المؤسسات الإعلامية وفق سياسة وطنية موحدة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والوطنية في ترشيد استخدام هذه الوسائل، من خلال توعية الأفراد بأخلاقيات وقواعد الاستخدام الصحيح.
2. توجيه برامج التوعية والتثقيف عبر كل المؤسسات والكيانات الاجتماعية المؤثرة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والدينية، والثقافية وغيرها، نحو تعريف المجتمع بالإيجابيات المثمرة لوسائل التواصل الاجتماعي والتشجيع على الاستفادة منها، وفق قاعدة أن تعزيز نقاط القوة هو أفضل طريق لتحجيم وتقليل أثر نقاط الضعف.
3. ربط كل فعاليات التنمية والتدريب وتطوير الموارد البشرية بأخلاقيات وقواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبكل الفعاليات الاستراتيجية والإجرائية المتعلقة بالاستدامة والتنمية الشاملة.
رابعاً: المواجهة الأمنية والقضائية:
وذلك من خلال تطوير الخبرات والقدرات في المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون (أجهزة الشرطة، النيابة، المحاكم)، على مستوى المتابعة والرقابة والتحري والتفتيش واجراءات السير القضائي، مع التركيز على الجوانب العلمية والتقنية، إذ ينبغي أن تتسلح هذه الهيئات بالمعرفة الدقيقة والمواكبة لكل أبعاد استخدامات الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد في هذا الجانب على ضرورة الحرص على تحقيق التوازان الخلاق بين ضمان الحقوق والحريات العامة، وتعزز فاعلية القانون وإنفاذه في مواجهة كل أشكال الانحراف والاستخدام السلبي والخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وضمان تحقيق العدالة.
الخاتمة:
في ضوء ما تقدم، يمكن إجمال أهم وأبرز نتائج البحث وتوصياته على النحو الآتي:
أولاً: النتائج:
1. وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي هي مواقع رقمية تقدم خدماتها عبر شبكة الويب (الانترنت)، تتيح لجميع المستخدمين والمسجلين فيها إمكانية النشر والمشاركة والتواصل مع بعضهم البعض، والتعبير عن وجهة نظرهم وتبادلها مع الآخرين ضمن هذا النظام، ومن الممكن أن تختلف طبيعة وخصائص الاتصالات من موقع لآخر.
2. الأمن الوطني والاجتماعي هو كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الكيان السياسي للدولة، وتوفير الأمن للمجتمع والمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء الوطني لديهم، وحماية الهوية الوطنية والثقافة الاجتماعية، وكافة المبادئ والمعتقدات الدينية واللغوية، والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية.
3. تتبين المخاطر والتحديات الأمنية الناتجة عن استخدام وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال مصطلحات متعددة كالتهديدات السيبرانية، الأمن السيبراني، حروب الجيل الخامس، الأمن الالكتروني، الأمن الرقمي، الأمن المعلوماتي، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي ترتبط في جانب منها بسلوك وممارسات الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإجرامية الدولية العابرة للحدود، وممارستها لأدوار بالغة الخطورة والتهديد على الأمن الوطني والاجتماعي
4. تتكشف التحديات الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي من حيث يشهد المجتمع العماني صوراً متعددة من الإنحراف الفكري، واهتزاز القيم واضطراب المعايير الاجتماعية والأخلاقية، الأمر الذي يتمثل بوضوح في تزايد ألوان الانحراف، وانتشار صور من السلوك لم تكن مألوفة من قبل مما يهدد الأمن والاستقرار الوطني والمجتمعي.
5. أن أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي صار يتخذ طابعاً واسعاً ومستمراً في التنامي والاتساع من حيث طبيعته وأشكاله وصوره وأنواع المخاطر والتهديدات الأمنية المترتبة عن تلك الوسائل، ودرجة خطورتها وحدة انعكاساتها على الأمن الوطني بأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وعلى الأمن الاجتماعي بأبعاده الثقافية والقيمية والأخلاقية والفكرية والتربوية.
6. تؤكد التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان ذلك الترابط الوثيق بين الأمن السياسي والأمن المجتمعي، على نحو ما يعزز الضرورات القائمة والتي تستدعي أمننة وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال رصدها والتعامل معها من منظور أمني واستراتيجي شامل وفاعل.
7. تتمثل أبرز التحديات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان في كل من التوظيف الأيديولوجي والسياسي لوسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر زعزعة الهوية والوحدة الوطنية، وانتشار الجرائم الالكترونية وجرائم المعلوماتية.
8. تتمثل أبرز التحديات الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بكل من خلخلة وتفكيك الكيان الأسري والعلاقات الاجتماعية، ومخاطر الهدم التربوي ونشر الانحلال القيمي والأخلاقي، ونشر ثقافة التطرف والتحريض على العنف والإرهاب.
ثانياً: التوصيات:
1. التخطيط الاستراتيجي الشامل والدائم للمواجهة المستمرة لكل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تثيرها وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على توحيد الجهود الوطنية على كافة المستويات (الفرد، الأسرة، المؤسسة، المجتمع، الدولة) في مواجهة كل المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي.
2. تحديث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، بحيث يشمل كافة الجرائم والمخالفات والممارسات الخاطئة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي.
3. إصدار ميثاق شرف إعلامي ذو طابع مجتمعي شامل لتنظيم ومراقبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بتوافق جميع القوى الفاعلة الرسمية والإعلامية والمجتمعية، للحد من أسباب الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية لدى كافة الأفراد.
4. إدماج شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي ضمن العملية التعليمية كنطاق ومصادر ووسائل وآليات تعليمية وتربوية، وذلك بشكل متدرج منذ بداية مراحل التعليم وعلى مداها بشكل مستمر، وبما يتناسب مع المتطلبات الأمنية والاجتماعية لمواجهة تحديات وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية ككل.
5. تطوير الخبرات والقدرات في المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون (جهاز الشرطة، الادعاء العام، المحاكم)، على مستوى المتابعة والرقابة والتحري والتفتيش واجراءات السير القضائي، مع التركيز على الجوانب العلمية والتقنية، وضمان تطبيق القانون بشكل متوازن يكفل الحقوق والحريات العامة، ويعزز فرص تحقيق العدالة.
6. الاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات الرائدة والناجحة في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، ونقل الخبرات منها وتبادلها معها.
المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم
ثانياً: المصادر والمراجع العربية:
1. أحمد، ست البنات حسن (2015). اتجاهات التحول نحو الصحافة الالكترونية في العالم العربي- دراسة وصفية تحليلية على عينة من الصحف العربية في الفترة من (2012-2013). رسالة ماجستير. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. السودان.
2. أحمد، عبير محمد عبد الصمد (2020). العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمشكلات الاجتماعية لدى الشباب الجامعي. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية. المجلد (3). العدد (52). اكتوبر. ص ص657-696.
3. أمين، رضا عبد الواحد (2007). الصحافة الكترونية. ط1. دار الفجر للنشر والتوزيع. القاهرة- مصر.
4. أمين، عبد الواحد رضا (2019). شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالحفاظ على أمن المجتمع: دراسة ميدانية على النخبة الإعلامية بمملكة البحرين. المجلة العربية للدراسات الأمنية. المجلد (35). العدد (2). ص ص186-202.
5. بني صالح، أروى سعيد (2021). أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن. المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات. العدد (36). مايو. ص ص1-16.
6. الجابري، محمد عابد (2006). مسألة الهوية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت- لبنان.
7. الحازمي، مبارك بن واصل (2021). الإعلام العربي والأمن القومي: الرؤى والتحديات.. نحو أجندة إعلامية مستقبلية. المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري كلية الإعلام جامعة بني سويف. المجلد (2). العدد (1). مايو. ص ص9-46.
8. الحسين، أسعد بن ناصر بن سعيد (2016). أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية الإسلامية. مجلة كلية التربية. جامعة الأزهر. العدد (169). الجزء (3). يوليو. ص ص325-359.
9. حسين، هالة حجاجي (2016). التنشئة الأسرية للمراهقين في ضوء تأثير مواقع التواصل الاجتماعي. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. المجلد (75). العدد (75). ص ص515-538.
10. حمدي، محمد الفاتح (2010). استخدامات النخبة للصحافة الإلكترونية وانعكاساتها على مقروئية الصحف الورقية: أستاذة جامعة -باتنة أنموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الحاج لخضر– باتنة. الجزائر.
11. حميد، عبد الوهاب كريم (2021). التحديات القانونية أمام وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي سلطنة عمان أنموذجاً- دراسة قانونية مقارنة. مجلة القانون والأعمال الدولية. العدد (32). فبراير. ص ص320-339.
12. الخزرجي، سرمد جاسم محمد (2018). الأبعاد الاجتماعية والثقافية لظاهرة التطرف الديني في المجتمع العراق- دراسة انثروبولوجية. مجلة العلوم الاجتماعية. المركز الديمقراطي العربي. ألمانيا- برلين. العدد (6)، أكتوبر. ص ص11-28.
13. خضر، باسل خليل (2014). أثر التحول في مفهوم القوة على العلاقات الدولية- الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر- غزة، فلسطين.
14. خليل, عماد الدين (1999). نظرة الغرب الى حاضر الاسلام ومستقبله. دار النفائس. بيروت- لبنان.
15. الخواجة، محمد ياسر (2018). التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. الرباط- المملكة المغربية.
16. الخولي، سناء (2004). الأسرة في عالم متغير. دار المعرفة الجامعية. القاهرة- مصر.
17. أبو دوابة، محمد محمود محمد (2012). الاتجاه نحو التطرف وعلاقته بالحاجات النفسية لدى طلبة جامعة الأزهر بغزة. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر بغزة.
18. الربعاني، أحمد (2017). اتجاهات طلبة التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان نحو الهوية الوطنية. مجلة الدراسات التربوية والنفسية. جامعة السلطان قابوس-عمان. المجلد (11). العدد (1). يناير. ص ص1-16.
19. الرعود، عبد الله ممدوح مبارك (2011). دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياسي في مصر وتونس. رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط. عمان- الأردن.
20. زاهر، ضياء الدين (2017). اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجاً. سلسلة أوراق. العدد (24). وحدة الدراسات المستقبلية- مكتبة الاسكندرية. الاسكندرية- مصر.
21. زايد، غادة عبد الفتاح عبد العزيز (2019): برنامج في التاريخ قائم على أدوات حروب الجيل الخامس لتنمية مهارات موثوقية المعلومات والاتصالات الرقمية لدى طلبة كلية التربية ومدى تأثيره على اتجاهاتهم. جامعة عين شمس، القاهرة- مصر.
22. زهرة، عطا محمد صالح (1991). في الأمن القومي. ط1. منشورات جامعة قاريونس. بنغازي- ليبيا.
23. السبعاوي، هناء جاسم (2006). الآثار الاجتماعية للهاتف النقال. مجلة دراسات موصلية. جامعة الموصل مركز دراسات الموصل- العراق. العدد (14). السنة (5). ص ص77-105.
24. سراج الدين، إسماعيل (2005). التحدي- رؤية ثقافية لمجابهة التطرف والعنف. بدون بيانات الناشر ومكان النشر. مارس.
25. السعبري، بهاء عدنان والزرفي، عماد عبد خضير (2019). انتقال التهديدات من الواقع الى العالم الافتراضي. مجلة بابل للعلوم الإنسانية. المجلد (27). العدد (4). ص ص472-487.
26. سلمان، محمود محمد (2006). الطفل العراقي بين إشكالية التنشئة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي. بحث مقدم ضمن محاضرات الموسم الثقافي الأول لمركز أبحاث الطفولة والأمومة. مطبعة القيس. بغداد- العراق.
27. سلوم، لؤي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسرية للمراهقين- دراسة ميدانية لأسر في مدينة طرطوس أنموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة تشرين. سوريا.
28. سليمان، محمد أحمد علي (2013). الأمن التربوي ودوره في الحفاظ على الهوية وتحقيق الأمن الشامل. مركز الدراسات والبحوث. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض.
29. السنجري، بشرى داود وعز الدين، سينهات محمد (2019). دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل المشاركة الانتخابية للشباب العراقي. المجلة المصرية لبحوث الإعلام. العدد (66). ص ص707-741.
30. سنو، غسان منير حمزة والطراح، علي أحمد (2002). العولمة والدولة والمجتمع العالمي دراسات في التنمية والاجتماع المدني في ظل الهيمنة الاقتصادية العالمية. دار النهضة العربية، القاهرة- مصر.
31. السويدي، جمال سند (2013). وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة الى الفايسبوك. ط2. مركز الإمارات للدراسات والبحوث. أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة.
32. السيد، معزة مصطفى فضل (2017). الإعلام الرقمي وانعكاساته على التعارف بين الحضارات- دراسة وصفية تحليلية على عينة من الخبراء والمختصين في الإعلام. رسالة دكتوراه. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. السودان.
33. الشربيني، سامي محمد الديداموني (2020). العلاقة بين الشائعات الالكترونية واستقرار الأمن الفكري للشباب من منظور العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في خدمة الفرد. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية. المجلد (2). العدد (50). ابريل. ص ص355-396.
34. الشرفات، أيمن شافي سمير (2017). أثــر مــواقع التواصــل الاجتماعي على الاحتجاجات العـربية 2010- 2014: مدخـــل نظــري. مجلة المــنــــارة. المجـلـــد (23). الـعـــــدد (1/ب). ص ص9-43.
35. الشهري، حنان بنت شعشوع (2013). أثر استخدام شبكات التواصل الإلكترونية على العلاقات الاجتماعية: الفيس بوك وتويتر نموذجاً- دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة. رسالة ماجستير. جامعة الملك عبد العزيز. الرياض- المملكة العربية السعودية.
36. الشهري، فايز عبد الله (2017). ثقافة التطرف والعنف على شبكة الانترنت: الملامح والاتجاهات. أعمال الندوة العلمية “استعمال الانترنت في تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين”. القاهرة- مصر، 25-27 اكتوبر.
37. شلوش، نورة (2018). القرصنة الالكترونية في الفضاء السيبراني: التهديد المتصاعد لأمن الدول. مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية. المجلد (8). العدد (2). ص ص185-206.
38. شيخاني، سميرة (2010). الإعلام الجديد في عصر المعلومات. مجلة جامعة دمشق. المجلد(26). العدد (1- 2). ص ص435-480.
39. شيخاني، سميرة (2010). الإعلام الجديد في عصر المعلومات. مرجع سابق. ص ص446-448؛ عطية، جميلة سالم (2014). الثورة المعلوماتية وإشكالية بناء وتداول الخطاب اللغوي والبصري- دراسة تحليلية سيميولوجية على عينة من الخطابات اللغوية والبصرية في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي- الفيسبوك نموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الجزائر (3). الجزائر.
40. صادق، عباس مصطفى (2008). الإعلام الجديد، المفاهيم والوسائل والتطبيقات. ط1. دار الشروق للنشر. عمان- الأردن.
41. الصوافي، عبد الحكيم بن عبدالله بن راشد (2015). استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلبة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان وعلاقته ببعض المتغيرات. رسالة ماجستير. جامعة نزوى. نزوى- سلطنة عمان.
42. طشطوش، هايل عبد المولى (2012). الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد. ط1. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان- الأردن.
43. عبد الحكيم، إيمان سيد (2021). المخاطر الاجتماعية والأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي على عينة من الطلاب بجامعة جنوب الوادي بقنا. مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات. جامعة القاهرة- مصر. المجلد (26). العدد (26). مارس. ص ص248-286.
44. عبد الرحمن، محمد أحمد عبد الله (2015). دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر. غزة- فلسطين.
45. عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح (2016). شبكات التواصل والانترنت والتأثير على الأمن القومي والاجتماعي. ط1. المكتب العربي للمعارف. القاهرة- مصر.
46. عبد المعطي، محمد عبد اللطيف (2020). دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو مجلس الشيوخ والمرشحين لعضويته. مجلة البحوث الإعلامية. جامعة الأزهر. العدد (55). الجزء (6). اكتوبر. ص ص3639-3702.
47. عدوان, نار يمين (2008). ملامح الانفتاح الثقافي في الفكر التربوي الاسلامي. رسالة ماجستير. الجامعة الاسلامية-غزة. فلسطين.
48. عزازي، فاتن محمد عبد المنعم (2014). تأثير لغة التعليم على الهوية لدى الطلاب- دراسة ميدانية. المجلة الدولية التربوية المتخصصة. المجلد (3). العدد (10). ص ص 164-191.
49. عزي، عبد الرحمن (2001). الانترنت والشباب بعض الافتراضات القيمية. مؤتمر الاتصال والمجتمع الخليجي: الواقع والطموح. كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. جامعة قابوس. مسقط- سلطنة عمان. 22-24 ابريل.
50. العساسفة، رامي عودة الله (2018). الأمن الاجتماعي في فكر ابن خلدون رؤية لحفظ تماسك المجتمعات العربية في الوقت الحاضر. مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر. العدد (180)، الجزء (1). اكتوبر. ص ص383-411.
51. العسكر، فهد (1998). التقنيات الصحفية الحديثة وأثرها على الأداء المهني للصحف المعاصرة. دار عالم الكتب. الرياض- المملكة العربية السعودية.
52. العمري، عبد الرحمن بن عبد الله عبدالرحمن (2018). الأبعاد الاجتماعية لاستخدامات المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي- دراسة وصفية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة جدة. مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنسانية. المجلد (26). العدد (3). ص ص139-171.
53. العنزي، صالح بن زيد بن صالح (2007). إخراج الصحف السعودية الإلكترونية في ضوء السمات الاتصالية لشبكة الإنترنت- دراسة وصفية تحليلية. رسالة ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض.
54. الفقهاء، قيس أمين (2016). دور شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للفكر المتطرف من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية. رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط. عمان- الأردن.
55. قاسمي، أحمد وجداي، سليم (2019). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي للدول الخليجية. ط1. المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية. برلين- المانيا.
56. كنعان، علي عبد الفتاح (2014). الصحافة الالكترونية في ظل الثورة التكنولوجية. ط1. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. عمان- الأردن.
57. لعزازي، فتيحة (2021). أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري لدى الشباب الجامعي دراسة وصفية مسحية لعينة من طلبة السنة الأولى علوم اجتماعية البليدة 2 المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي. مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ. المجلد (17). العدد (1). ص ص14-38.
58. مجموعة من الباحثين (2020). أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على تنشئة الطفل في المجتمع العماني (التعليمية، الاجتماعية والنفسية، الصحية). جمعية الاجتماعيين العُمانية- وزارة التنمية الاجتماعية. مسقط- سلطنة عمان.
59. المحارب، سعد بن محارب (2011). الإعلام الجديد في السعودية. ط1. دار جداول للنشر. الرياض- المملكة العربية السعودية.
60. محمد، رشدي محمد (2003). تقويم فاعلية المؤسسات الاجتماعية في مواجهة مشكلات شبكة الانترنت. الحلقة السادسة للدراسات الاجتماعية للدول العربية: طرابلس. منشورات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. القاهرة- مصر.
61. مشري، سلمى (2010). الحق في الأمن السياسي. رسالة ماجستير. جامعة فرحات عباس- سطيف-الجزائر.
62. مشطري، سهام وسرار، أمينة (2020). التنشئة الأسرية للمراهقين في ظل هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي: الفايسبوك نموذجاً- دراسة ميدانية في ثانوية الكندي جيجل. رسالة ماجستير. جامعة محمد الصديق بن يحيى. جيجل- الجزائر.
63. مصطفى، نادية (2015). الدائرة الإسلامية بين انتماء الفرد والدولة. في كتاب: دوائر الانتماء وتأصيل الهوية. مركز الحضارة للدراسات والبحوث. القاهرة- مصر.
64. المطيري، سلطان خلف (2015). شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بتحقيق الأمن المجتمعي. رسالة ماجستير. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض- المملكة العربية السعودية.
65. مطالقة، أحلام والعمري، رائقة علي (2018). أثر مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات. مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون. الجامعة الأردنية. المجلد (45). العدد (4). الملحق (2). ص ص263-283.
66. المقدادي، خالد غسان يوسف (2013). ثورة الشبكات الاجتماعية. ط1. دار النفائس للنشر. عمان- الأردن.
67. ملك، بدر محمد والكندري، لطيفة حسين (2009). دور المعلم في وقاية الناشئة من التطرف الفكري. مجلة كلية التربية. جامعة الأزهر. القاهرة. العدد (142). الجزء (1)، 2009.
68. المنصور، محمد (2012). تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية. رسالة ماجستير. الأكاديمية العربية المفتوحة. الدنمارك.
69. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (1997). لسان العرب. ط1. دار صادر. بيروت- لبنان.
70. منيغر، سناء (2014). التنوع الثقافي من منظور الأمن المجتمعي. رسالة ماجستير. جامعة سطيف 2. الجزائر.
71. هتيمي، حسين محمود (2015). العلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي. ط1. دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن.
72. يوسفي، أعمر (2017). التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي للدول. مجلة العلوم الإنسانية. العدد (7). الجزء (2). يونيو. ص ص789-802. ص790.
ثالثاً: المراجع الأجنبية:
1. Beyers, H. (2005). Tomorrow’s newspapers: online or still made out of paper? A study on perceptions. opinions and attitudes towards online newspapers. IN PERE, M. & JOSEP, R. (Eds.) Digital Utopia in the Media: from Discourses to Facts Barcelona.
2. Boyd, Danah M. and Ellison, Nicole B. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholar ship. Journal of Computer-Mediated Communication. 13 (1). pp210–230.
3. Campbell, Vincent (2004). Information Age Journalism: Journalism In An International, Arnold. London.
4. Dashti, Ali Abdulsamad (2008). The Effect of Online Journalism on The Freedom of The Press: The Case of Kuwait. A PhD Thesis. University of Stirling.
5. Domingo, D. (2006). Inventing Online Journalism: Development of the Internet as a news medium in four Catalan online newsrooms, Department de Periodisme i Ciencies de la Comunicacio. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. p74- 75.
6. Kissinger, Henry (1969). Nuclear Weapons and Foreign Policy. Wild Field and Nicholson. London.
7. Trager, Frank and Kronenberg, Philip (eds.) (1973). National Security and American Society. Kansas University Press. Kansas- USA. p35-36.