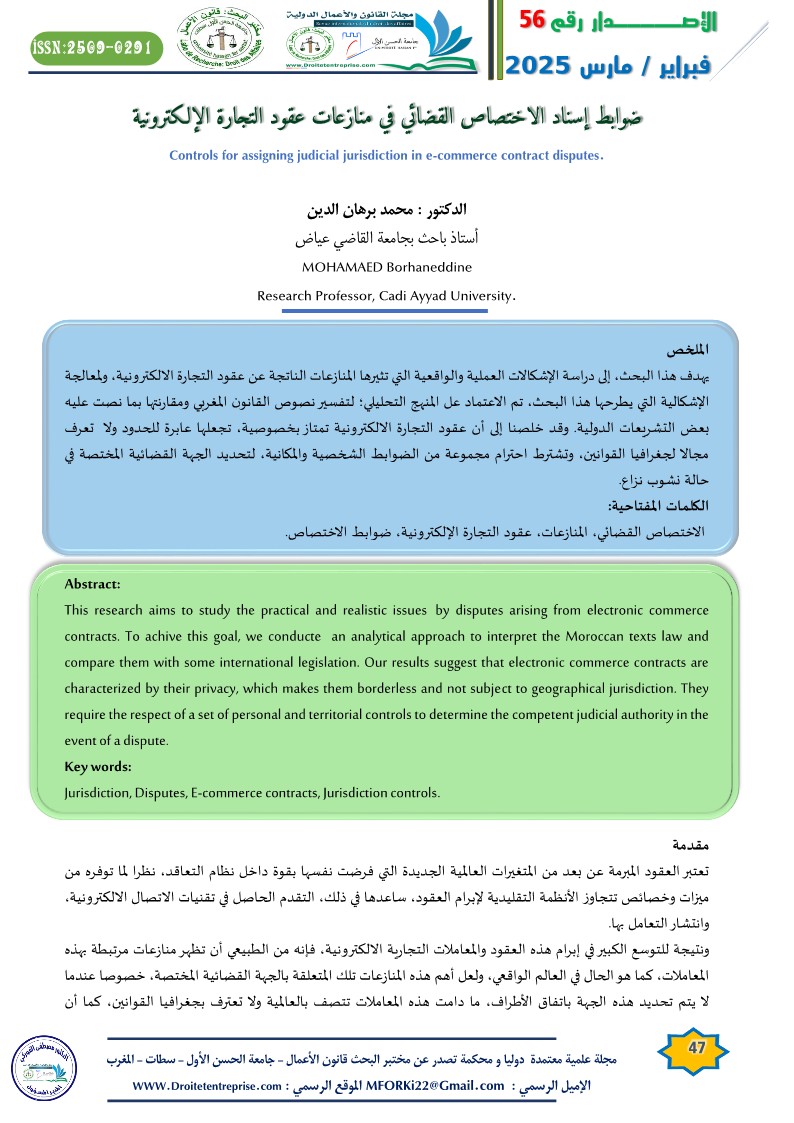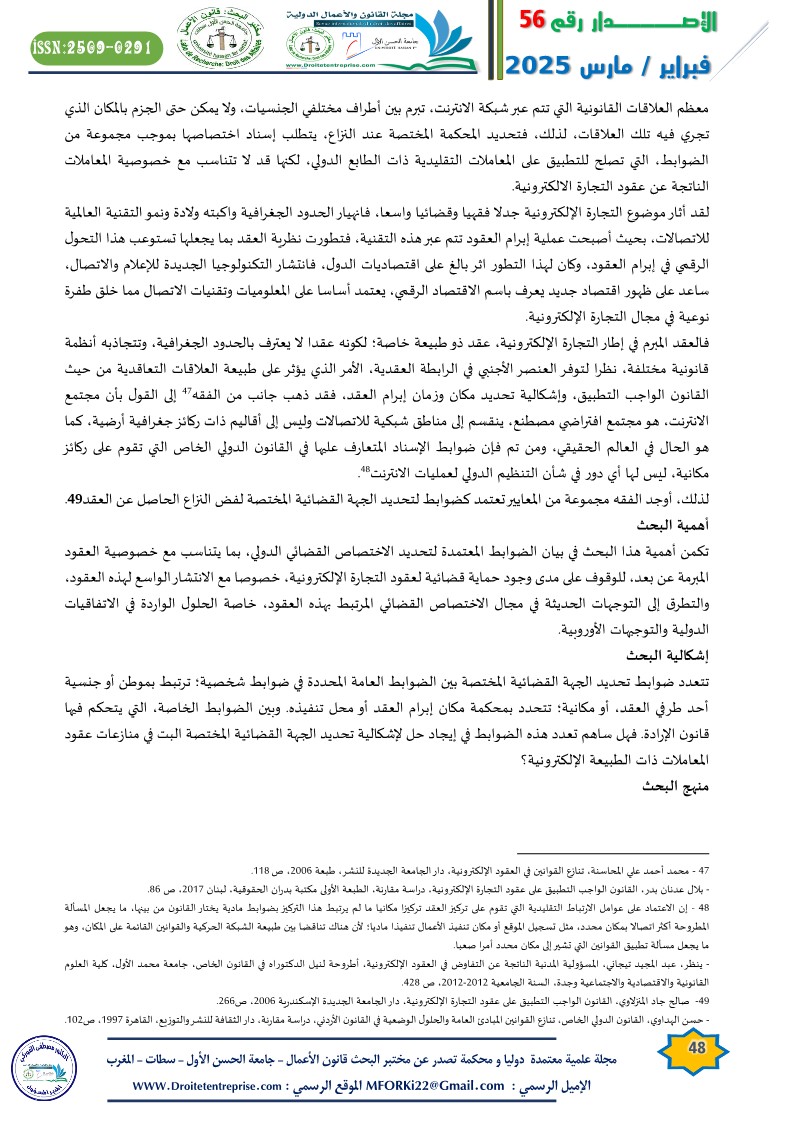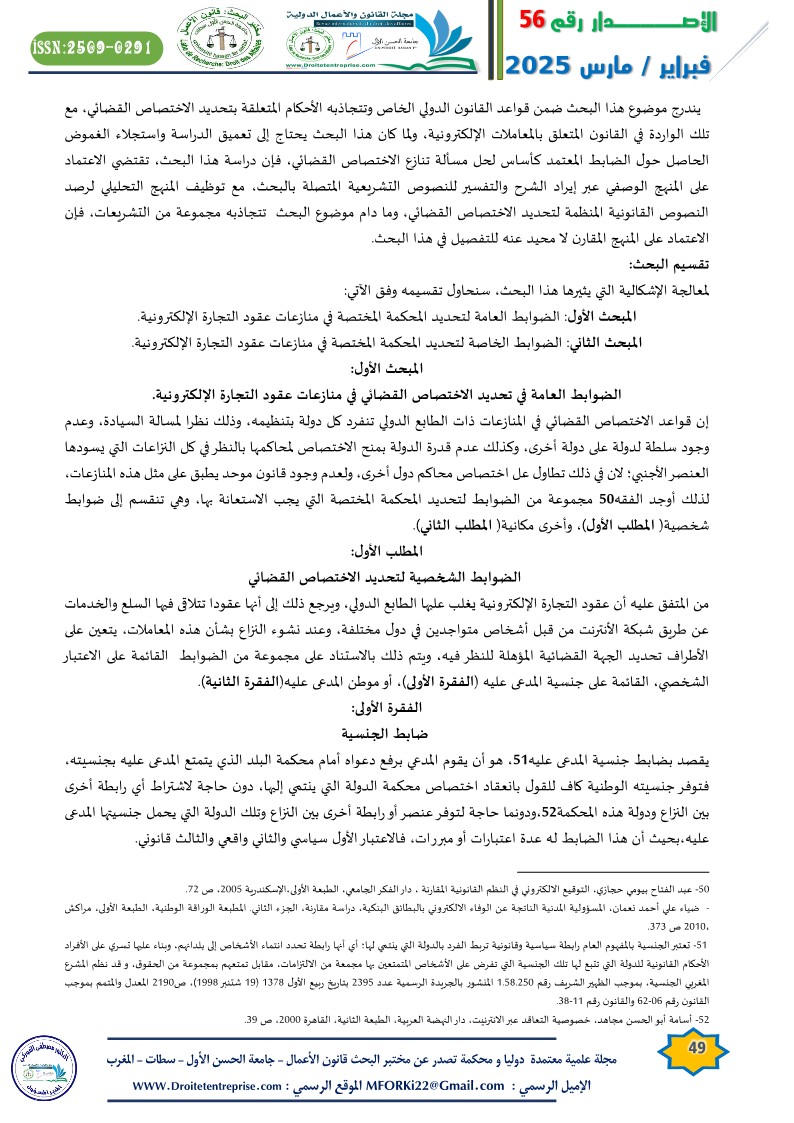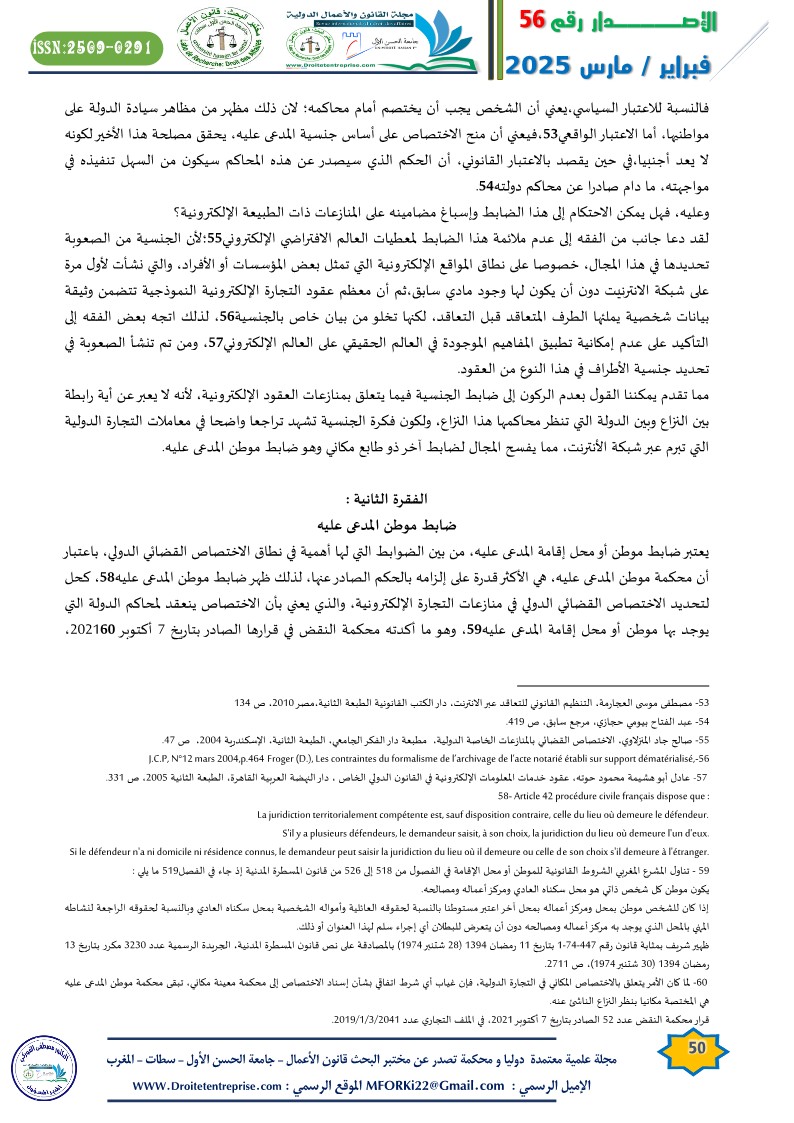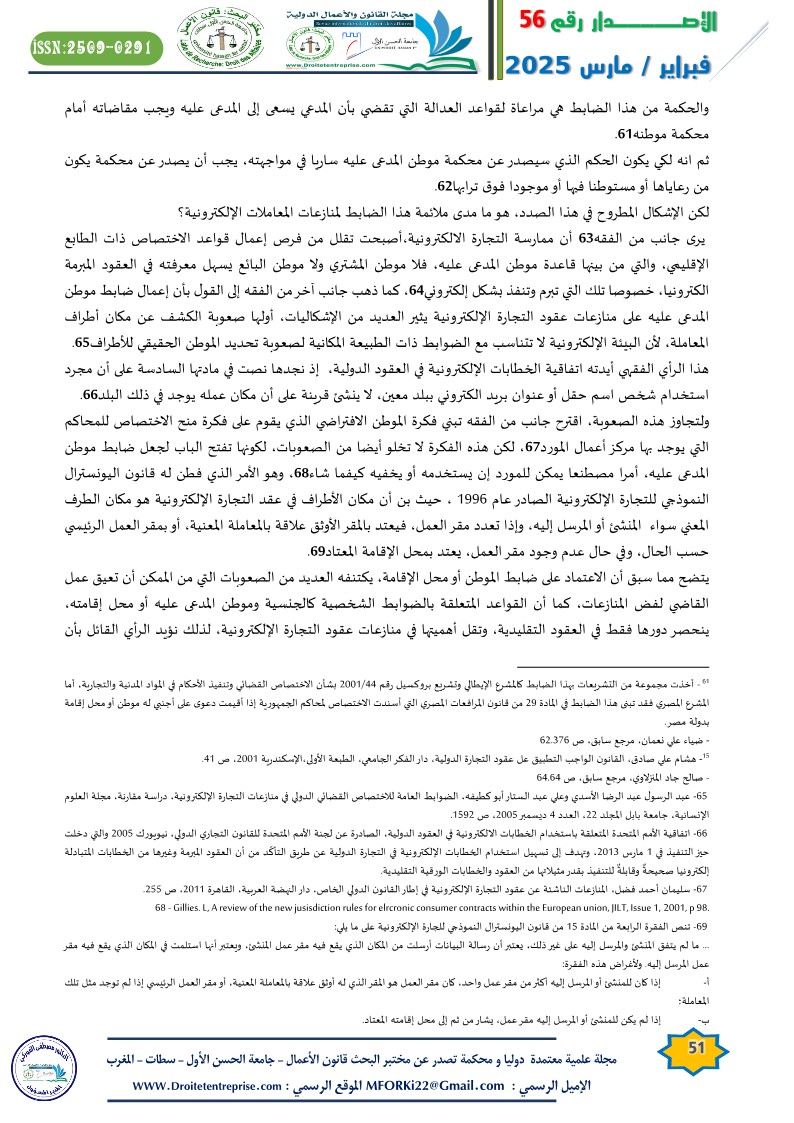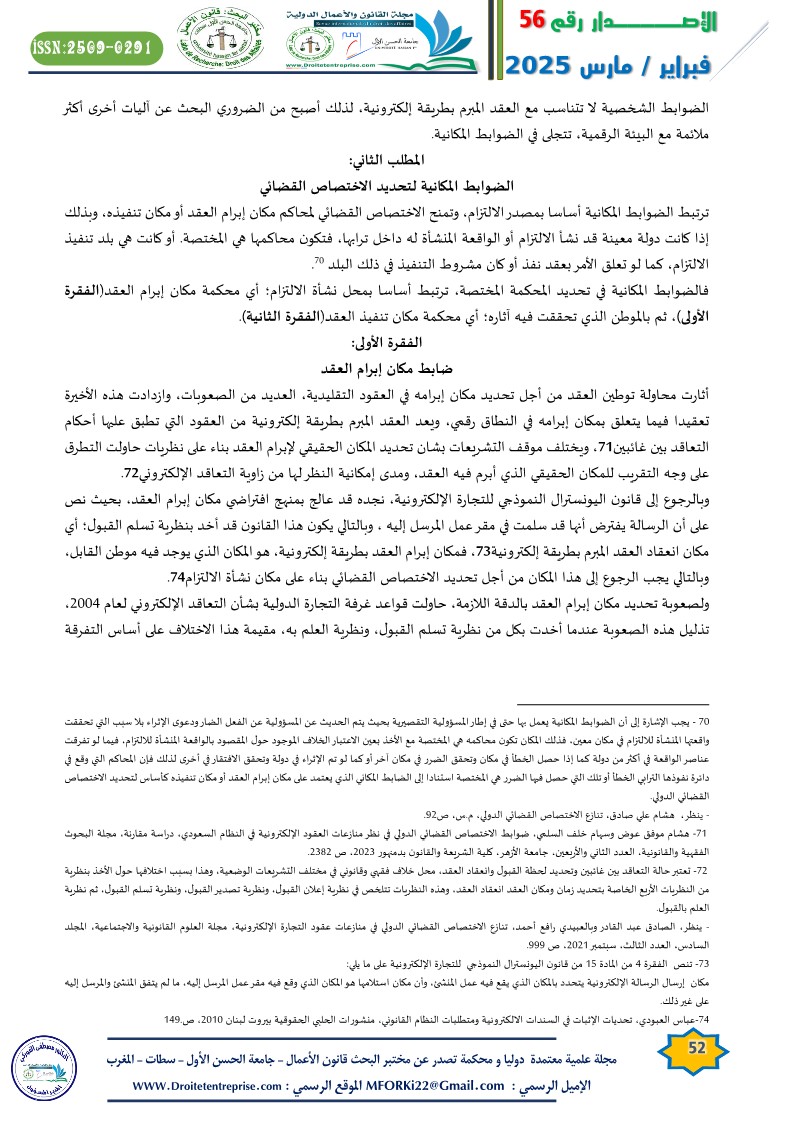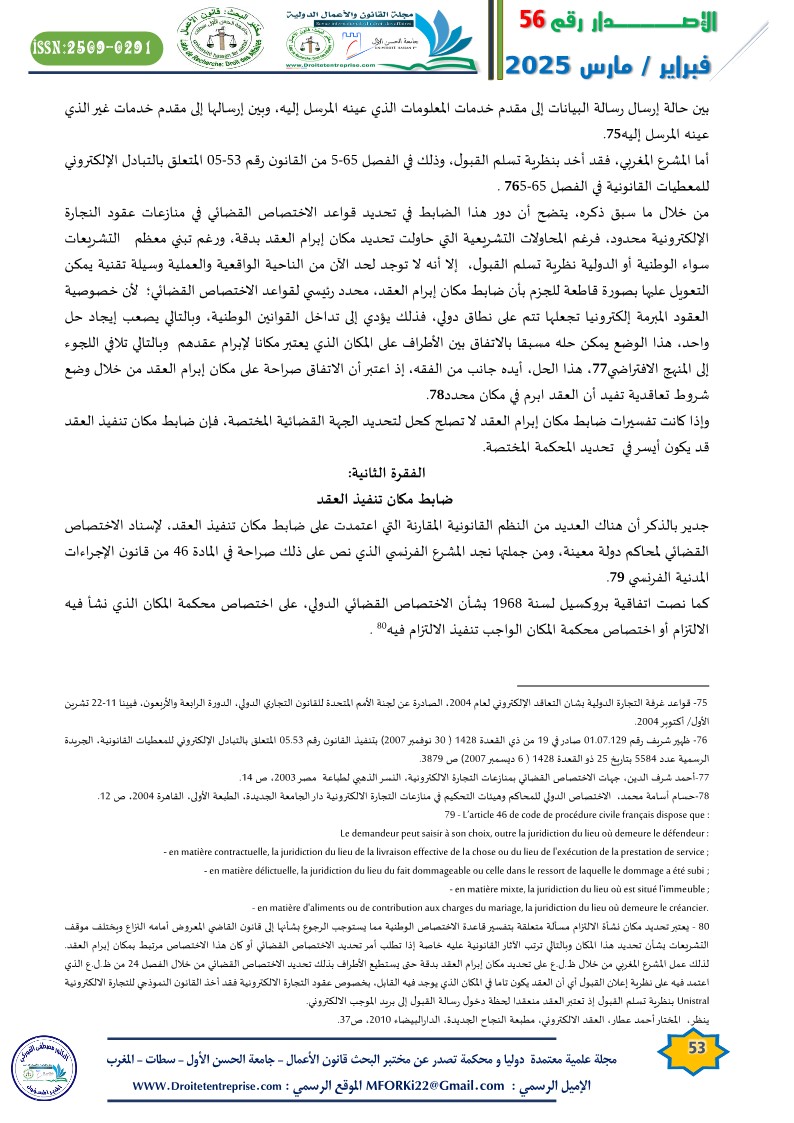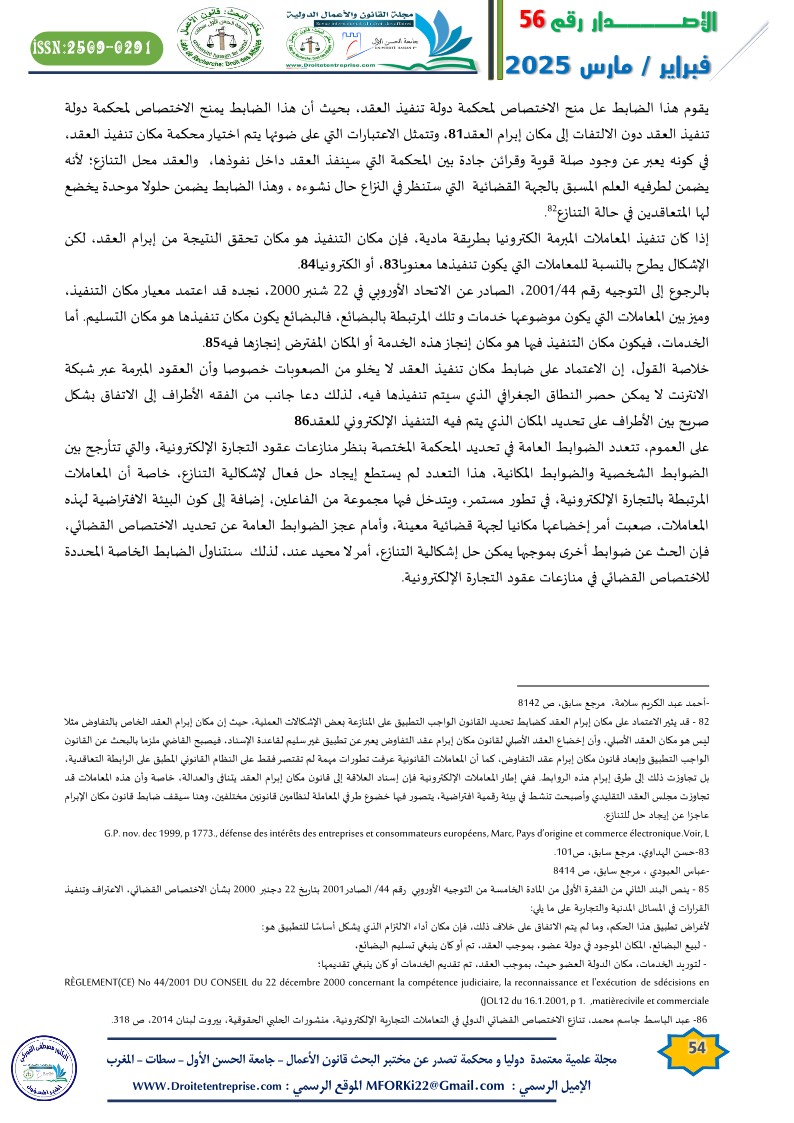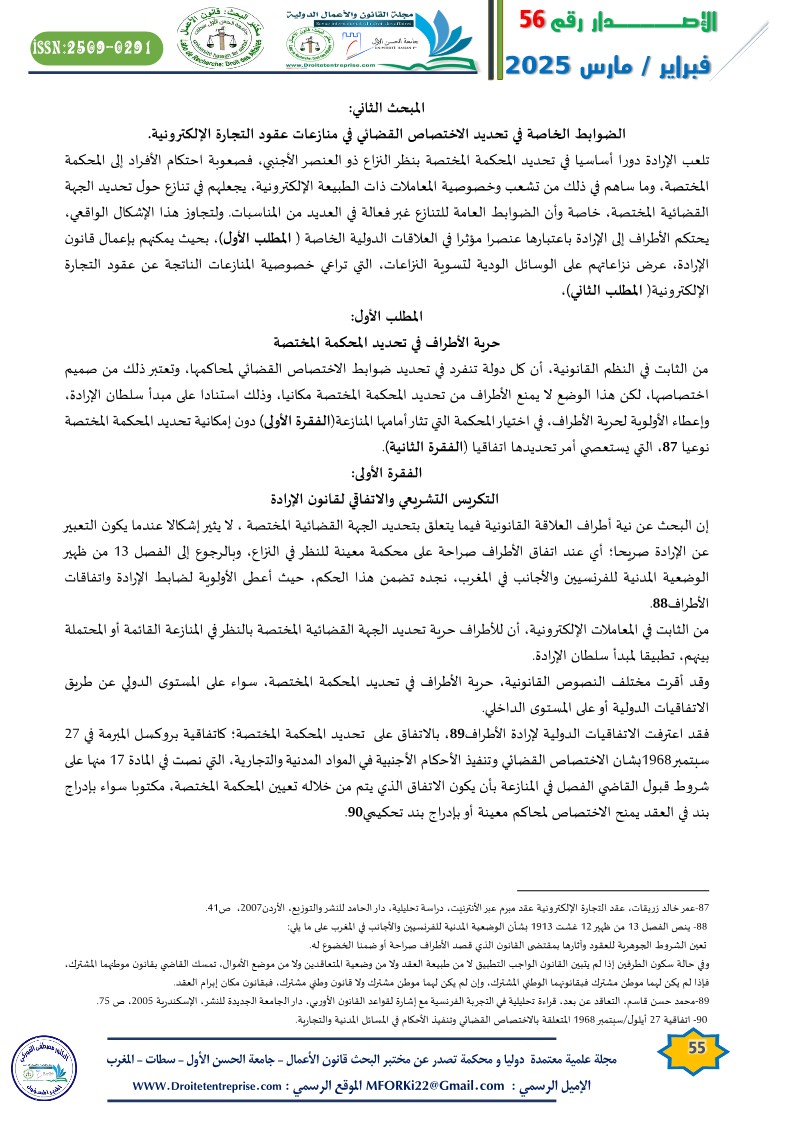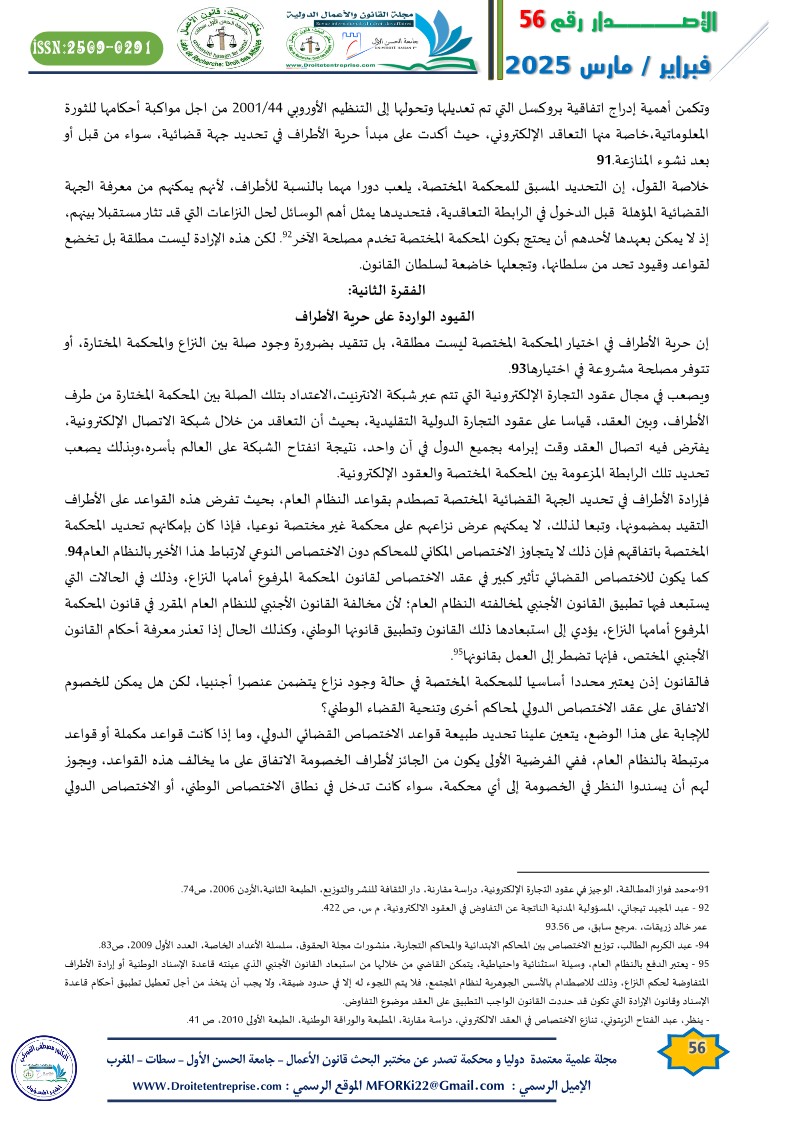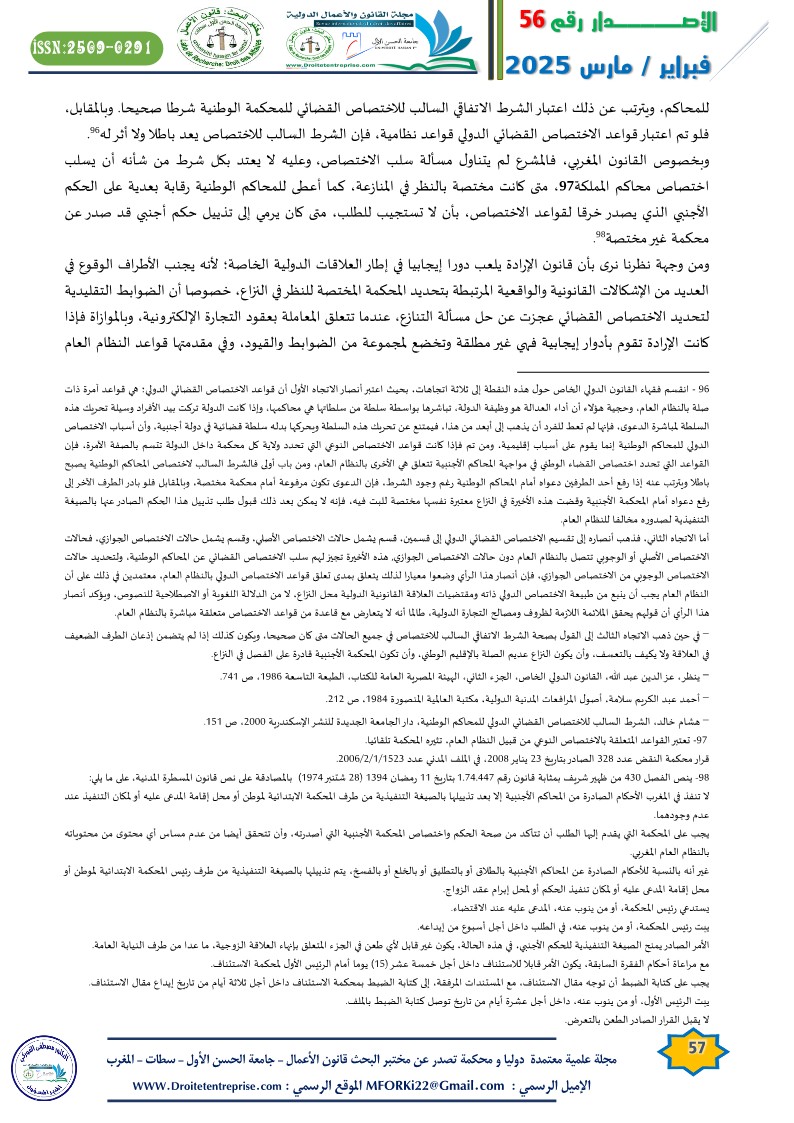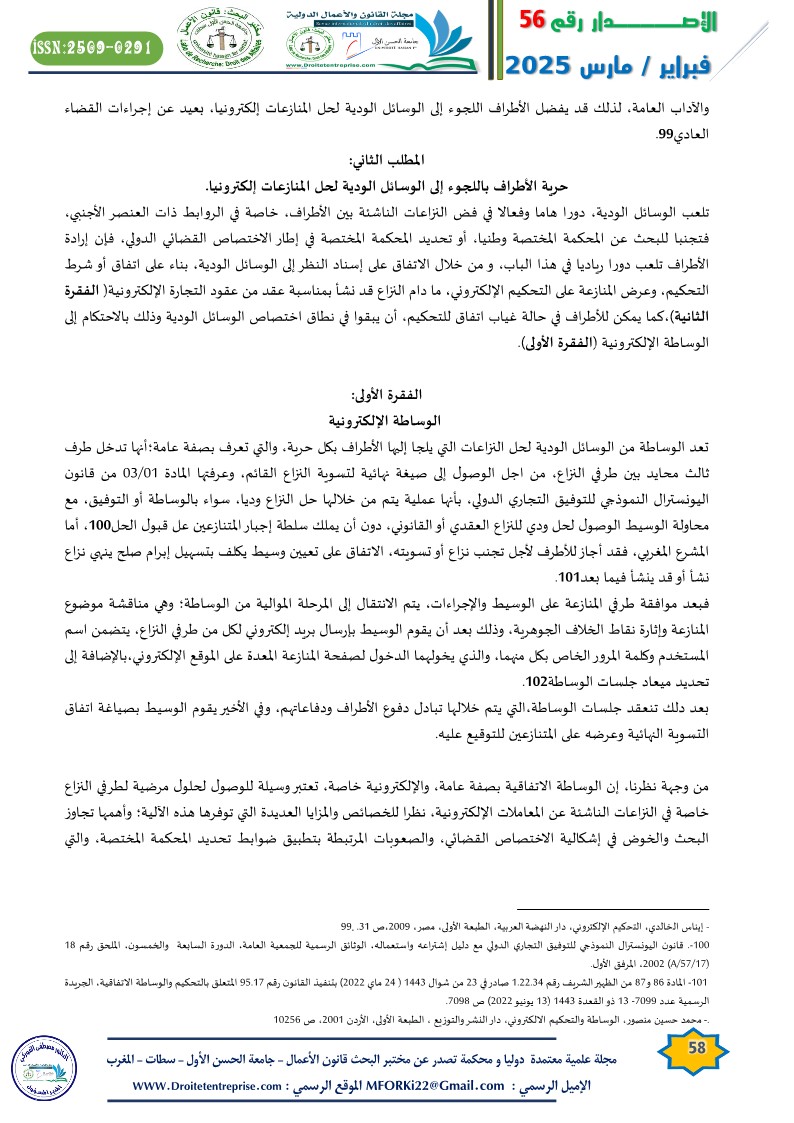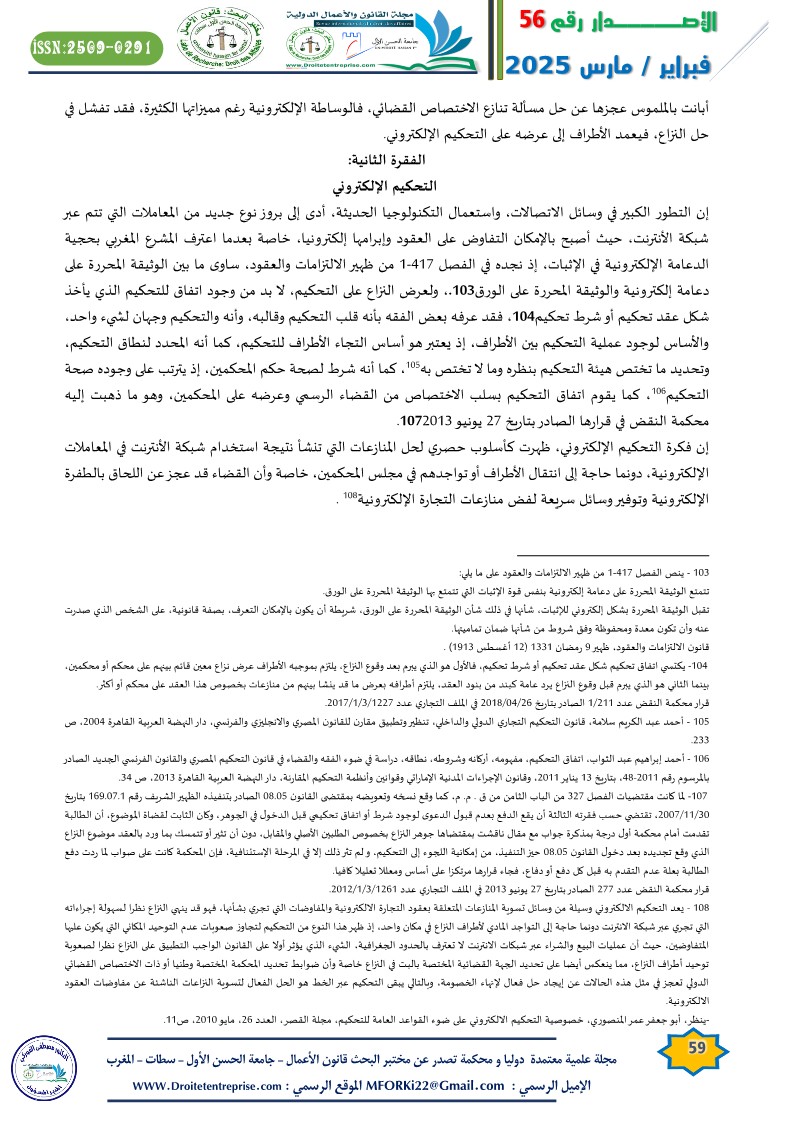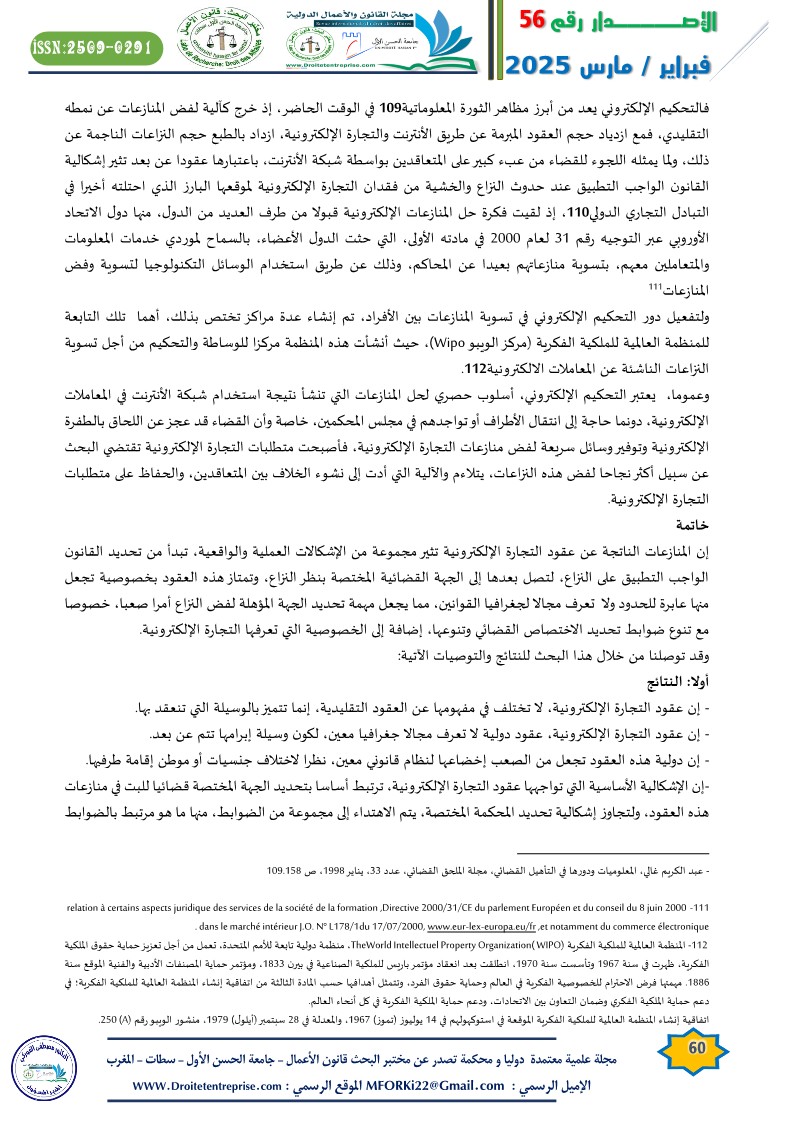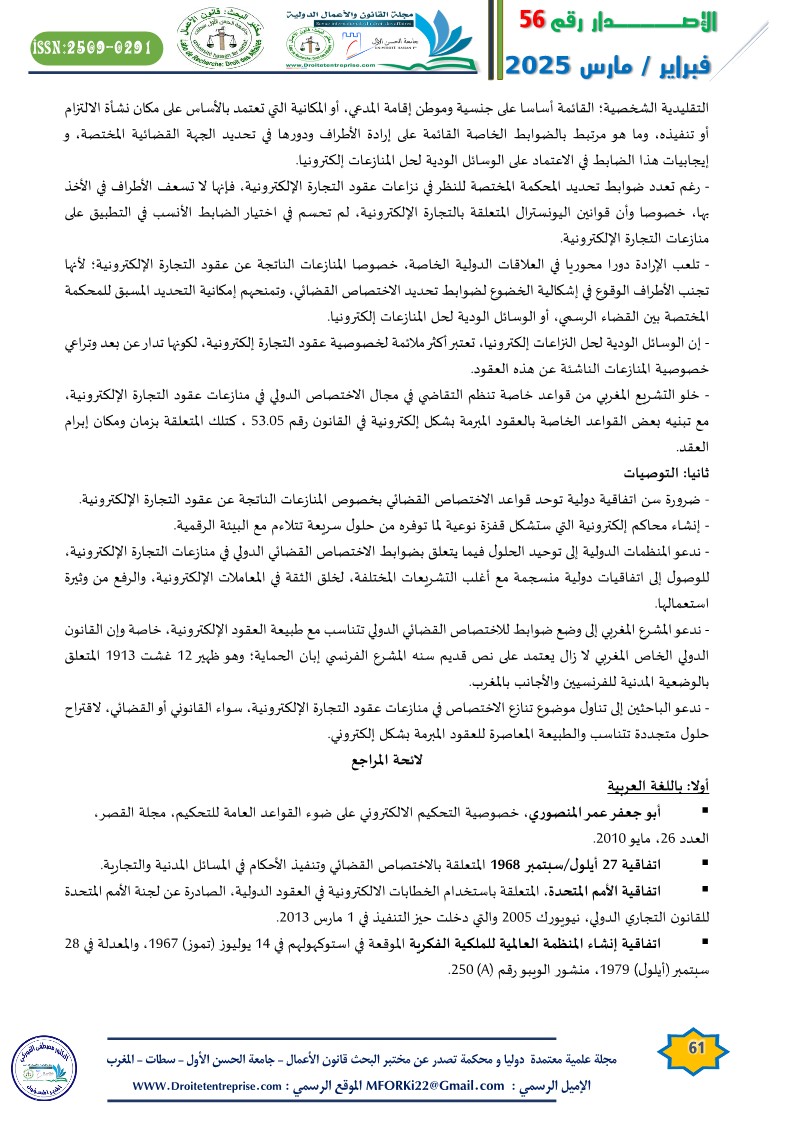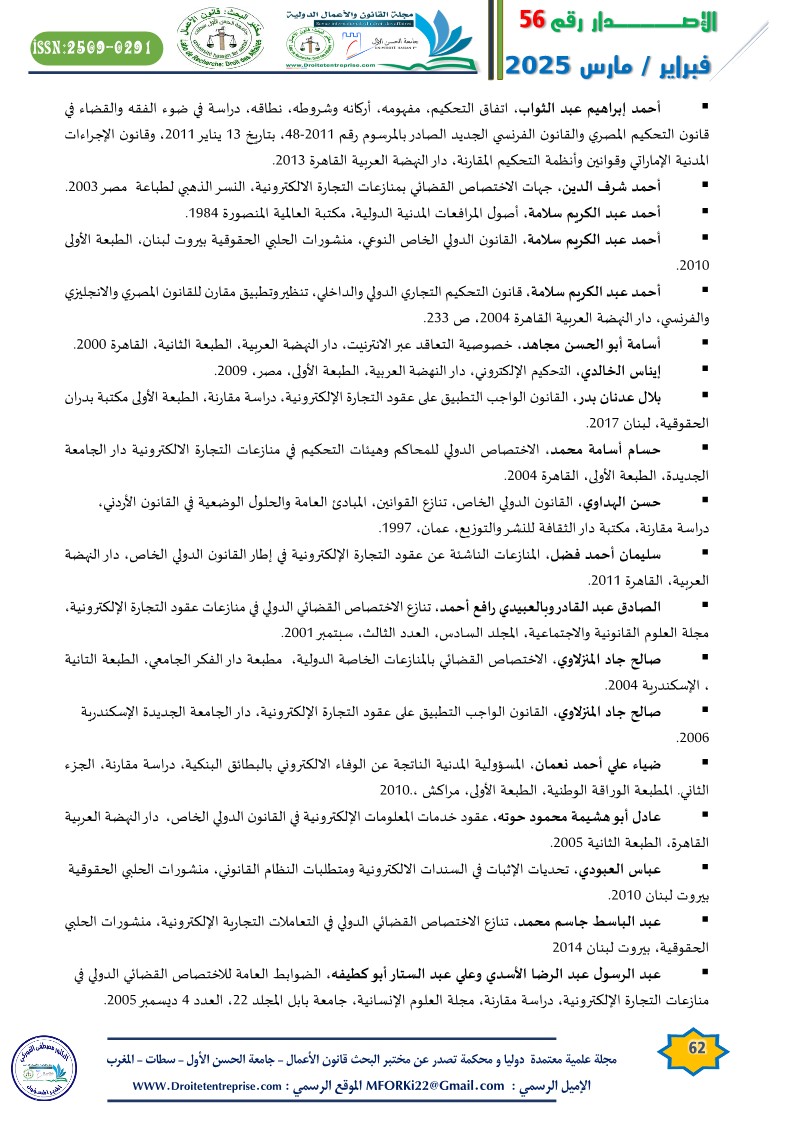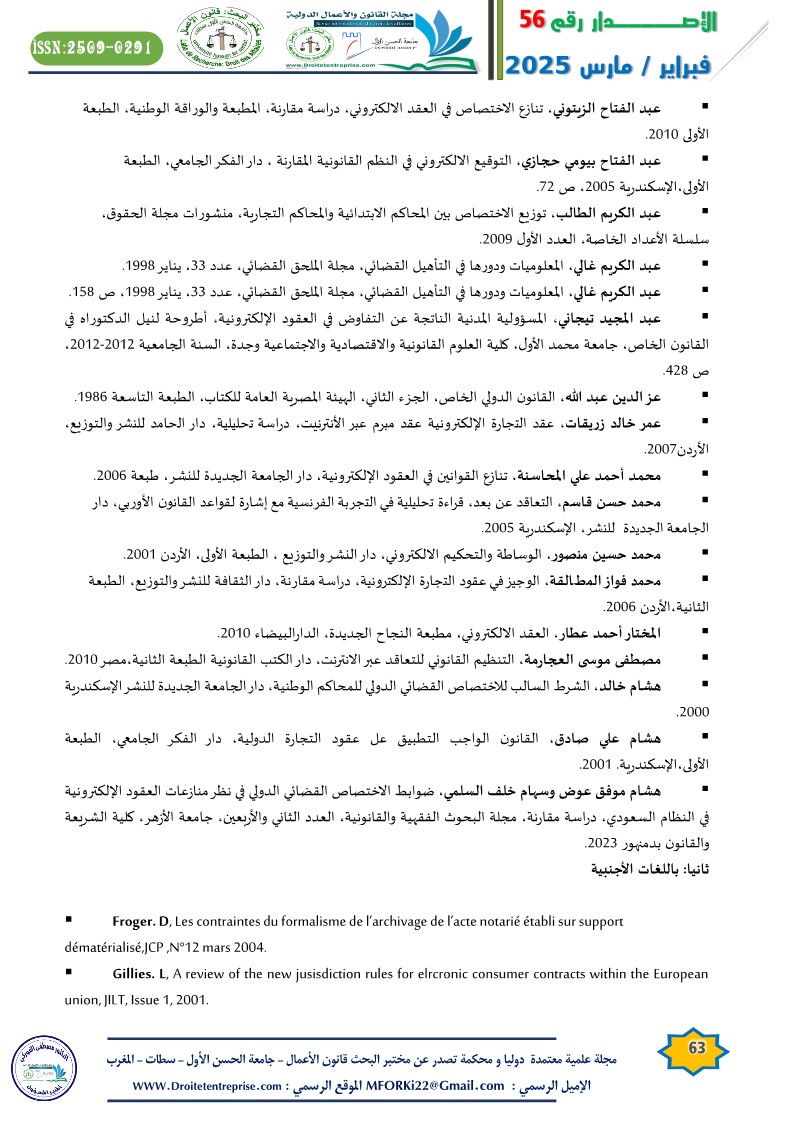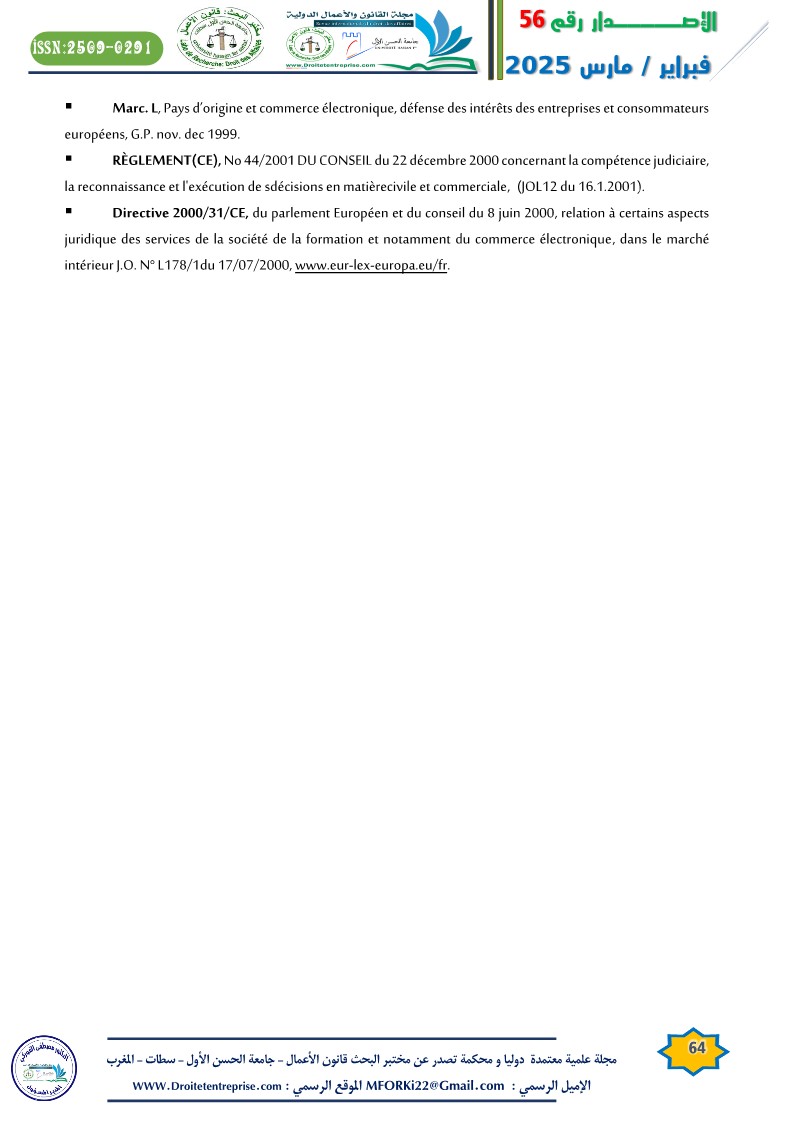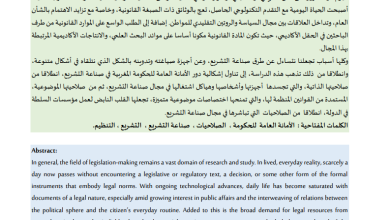في الواجهةمقالات قانونية
ضوابط إسناد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية الدكتور : محمد برهان الدين
15 فبراير, 2025

ضوابط إسناد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية
Controls for assigning judicial jurisdiction in e-commerce contract disputes.
الدكتور : محمد برهان الدين
أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض
MOHAMAED Borhaneddine
Research Professor, Cadi Ayyad University.
الملخص
يهدف هذا البحث، إلى دراسة الإشكالات العملية والواقعية التي تثيرها المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الالكترونية، ولمعالجة الإشكالية التي يطرحها هذا البحث، تم الاعتماد عل المنهج التحليلي؛ لتفسير نصوص القانون المغربي ومقارنتها بما نصت عليه بعض التشريعات الدولية. وقد خلصنا إلى أن عقود التجارة الالكترونية تمتاز بخصوصية، تجعلها عابرة للحدود ولا تعرف مجالا لجغرافيا القوانين، وتشترط احترام مجموعة من الضوابط الشخصية والمكانية، لتحديد الجهة القضائية المختصة في حالة نشوب نزاع.
الكلمات المفتاحية:
الاختصاص القضائي، المنازعات، عقود التجارة الإلكترونية، ضوابط الاختصاص.
Abstract:
This research aims to study the practical and realistic issues by disputes arising from electronic commerce contracts. To achive this goal, we conducte an analytical approach to interpret the Moroccan texts law and compare them with some international legislation. Our results suggest that electronic commerce contracts are characterized by their privacy, which makes them borderless and not subject to geographical jurisdiction. They require the respect of a set of personal and territorial controls to determine the competent judicial authority in the event of a dispute.
Key words:
Jurisdiction, Disputes, E-commerce contracts, Jurisdiction controls.
مقدمة
تعتبر العقود المبرمة عن بعد من المتغيرات العالمية الجديدة التي فرضت نفسها بقوة داخل نظام التعاقد، نظرا لما توفره من ميزات وخصائص تتجاوز الأنظمة التقليدية لإبرام العقود، ساعدها في ذلك، التقدم الحاصل في تقنيات الاتصال الالكترونية، وانتشار التعامل بها.
ونتيجة للتوسع الكبير في إبرام هذه العقود والمعاملات التجارية الالكترونية، فإنه من الطبيعي أن تظهر منازعات مرتبطة بهذه المعاملات، كما هو الحال في العالم الواقعي، ولعل أهم هذه المنازعات تلك المتعلقة بالجهة القضائية المختصة، خصوصا عندما لا يتم تحديد هذه الجهة باتفاق الأطراف، ما دامت هذه المعاملات تتصف بالعالمية ولا تعترف بجغرافيا القوانين، كما أن معظم العلاقات القانونية التي تتم عبر شبكة الانترنت، تبرم بين أطراف مختلفي الجنسيات، ولا يمكن حتى الجزم بالمكان الذي تجري فيه تلك العلاقات، لذلك، فتحديد المحكمة المختصة عند النزاع، يتطلب إسناد اختصاصها بموجب مجموعة من الضوابط، التي تصلح للتطبيق على المعاملات التقليدية ذات الطابع الدولي، لكنها قد لا تتناسب مع خصوصية المعاملات الناتجة عن عقود التجارة الالكترونية.
لقد أثار موضوع التجارة الإلكترونية جدلا فقهيا وقضائيا واسعا، فانهيار الحدود الجغرافية واكبته ولادة ونمو التقنية العالمية للاتصالات، بحيث أصبحت عملية إبرام العقود تتم عبر هذه التقنية، فتطورت نظرية العقد بما يجعلها تستوعب هذا التحول الرقمي في إبرام العقود، وكان لهذا التطور اثر بالغ على اقتصاديات الدول، فانتشار التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، ساعد على ظهور اقتصاد جديد يعرف باسم الاقتصاد الرقمي، يعتمد أساسا على المعلوميات وتقنيات الاتصال مما خلق طفرة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية.
فالعقد المبرم في إطار التجارة الإلكترونية، عقد ذو طبيعة خاصة؛ لكونه عقدا لا يعترف بالحدود الجغرافية، وتتجاذبه أنظمة قانونية مختلفة، نظرا لتوفر العنصر الأجنبي في الرابطة العقدية، الأمر الذي يؤثر على طبيعة العلاقات التعاقدية من حيث القانون الواجب التطبيق، وإشكالية تحديد مكان وزمان إبرام العقد، فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن مجتمع الانترنت، هو مجتمع افتراضي مصطنع، ينقسم إلى مناطق شبكية للاتصالات وليس إلى أقاليم ذات ركائز جغرافية أرضية، كما هو الحال في العالم الحقيقي، ومن تم فإن ضوابط الإسناد المتعارف عليها في القانون الدولي الخاص التي تقوم على ركائز مكانية، ليس لها أي دور في شأن التنظيم الدولي لعمليات الانترنت .
لذلك، أوجد الفقه مجموعة من المعايير تعتمد كضوابط لتحديد الجهة القضائية المختصة لفض النزاع الحاصل عن العقد .
أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحث في بيان الضوابط المعتمدة لتحديد الاختصاص القضائي الدولي، بما يتناسب مع خصوصية العقود المبرمة عن بعد، للوقوف على مدى وجود حماية قضائية لعقود التجارة الإلكترونية، خصوصا مع الانتشار الواسع لهذه العقود، والتطرق إلى التوجهات الحديثة في مجال الاختصاص القضائي المرتبط بهذه العقود، خاصة الحلول الواردة في الاتفاقيات الدولية والتوجيهات الأوروبية.
إشكالية البحث
تتعدد ضوابط تحديد الجهة القضائية المختصة بين الضوابط العامة المحددة في ضوابط شخصية؛ ترتبط بموطن أو جنسية أحد طرفي العقد، أو مكانية؛ تتحدد بمحكمة مكان إبرام العقد أو محل تنفيذه. وبين الضوابط الخاصة، التي يتحكم فيها قانون الإرادة. فهل ساهم تعدد هذه الضوابط في إيجاد حل لإشكالية تحديد الجهة القضائية المختصة البت في منازعات عقود المعاملات ذات الطبيعة الإلكترونية؟
منهج البحث
يندرج موضوع هذا البحث ضمن قواعد القانون الدولي الخاص وتتجاذبه الأحكام المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي، مع تلك الواردة في القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، ولما كان هذا البحث يحتاج إلى تعميق الدراسة واستجلاء الغموض الحاصل حول الضابط المعتمد كأساس لحل مسألة تنازع الاختصاص القضائي، فإن دراسة هذا البحث، تقتضي الاعتماد على المنهج الوصفي عبر إيراد الشرح والتفسير للنصوص التشريعية المتصلة بالبحث، مع توظيف المنهج التحليلي لرصد النصوص القانونية المنظمة لتحديد الاختصاص القضائي، وما دام موضوع البحث تتجاذبه مجموعة من التشريعات، فإن الاعتماد على المنهج المقارن لا محيد عنه للتفصيل في هذا البحث.
تقسيم البحث:
لمعالجة الإشكالية التي يثيرها هذا البحث، سنحاول تقسيمه وفق الآتي:
المبحث الأول: الضوابط العامة لتحديد المحكمة المختصة في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
المبحث الثاني: الضوابط الخاصة لتحديد المحكمة المختصة في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
المبحث الأول:
الضوابط العامة في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
إن قواعد الاختصاص القضائي في المنازعات ذات الطابع الدولي تنفرد كل دولة بتنظيمه، وذلك نظرا لمسالة السيادة، وعدم وجود سلطة لدولة على دولة أخرى، وكذلك عدم قدرة الدولة بمنح الاختصاص لمحاكمها بالنظر في كل النزاعات التي يسودها العنصر الأجنبي؛ لان في ذلك تطاول عل اختصاص محاكم دول أخرى، ولعدم وجود قانون موحد يطبق على مثل هذه المنازعات، لذلك أوجد الفقه مجموعة من الضوابط لتحديد المحكمة المختصة التي يجب الاستعانة بها، وهي تنقسم إلى ضوابط شخصية( المطلب الأول)، وأخرى مكانية( المطلب الثاني).
المطلب الأول:
الضوابط الشخصية لتحديد الاختصاص القضائي
من المتفق عليه أن عقود التجارة الإلكترونية يغلب عليها الطابع الدولي، ويرجع ذلك إلى أنها عقودا تتلاقى فيها السلع والخدمات عن طريق شبكة الأنترنت من قبل أشخاص متواجدين في دول مختلفة، وعند نشوء النزاع بشأن هذه المعاملات، يتعين على الأطراف تحديد الجهة القضائية المؤهلة للنظر فيه، ويتم ذلك بالاستناد على مجموعة من الضوابط القائمة على الاعتبار الشخصي، القائمة على جنسية المدعى عليه (الفقرة الأولى)، أو موطن المدعى عليه(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:
ضابط الجنسية
يقصد بضابط جنسية المدعى عليه ، هو أن يقوم المدعي برفع دعواه أمام محكمة البلد الذي يتمتع المدعى عليه بجنسيته، فتوفر جنسيته الوطنية كاف للقول بانعقاد اختصاص محكمة الدولة التي ينتمي إليها، دون حاجة لاشتراط أي رابطة أخرى بين النزاع ودولة هذه المحكمة ،ودونما حاجة لتوفر عنصر أو رابطة أخرى بين النزاع وتلك الدولة التي يحمل جنسيتها المدعى عليه،بحيث أن هذا الضابط له عدة اعتبارات أو مبررات، فالاعتبار الأول سياسي والثاني واقعي والثالث قانوني.
فالنسبة للاعتبار السياسي،يعني أن الشخص يجب أن يختصم أمام محاكمه؛ لان ذلك مظهر من مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها، أما الاعتبار الواقعي ،فيعني أن منح الاختصاص على أساس جنسية المدعى عليه، يحقق مصلحة هذا الأخير لكونه لا يعد أجنبيا،في حين يقصد بالاعتبار القانوني، أن الحكم الذي سيصدر عن هذه المحاكم سيكون من السهل تنفيذه في مواجهته، ما دام صادرا عن محاكم دولته .
وعليه، فهل يمكن الاحتكام إلى هذا الضابط وإسباغ مضامينه على المنازعات ذات الطبيعة الإلكترونية؟
لقد دعا جانب من الفقه إلى عدم ملائمة هذا الضابط لمعطيات العالم الافتراضي الإلكتروني ؛لأن الجنسية من الصعوبة تحديدها في هذا المجال، خصوصا على نطاق المواقع الإلكترونية التي تمثل بعض المؤسسات أو الأفراد، والتي نشأت لأول مرة على شبكة الانترنيت دون أن يكون لها وجود مادي سابق،ثم أن معظم عقود التجارة الإلكترونية النموذجية تتضمن وثيقة بيانات شخصية يملئها الطرف المتعاقد قبل التعاقد، لكنها تخلو من بيان خاص بالجنسية ، لذلك اتجه بعض الفقه إلى التأكيد على عدم إمكانية تطبيق المفاهيم الموجودة في العالم الحقيقي على العالم الإلكتروني ، ومن تم تنشأ الصعوبة في تحديد جنسية الأطراف في هذا النوع من العقود.
مما تقدم يمكننا القول بعدم الركون إلى ضابط الجنسية فيما يتعلق بمنازعات العقود الإلكترونية، لأنه لا يعبر عن أية رابطة بين النزاع وبين الدولة التي تنظر محاكمها هذا النزاع، ولكون فكرة الجنسية تشهد تراجعا واضحا في معاملات التجارة الدولية التي تبرم عبر شبكة الأنترنت، مما يفسح المجال لضابط آخر ذو طابع مكاني وهو ضابط موطن المدعى عليه.
الفقرة الثانية :
ضابط موطن المدعى عليه
يعتبر ضابط موطن أو محل إقامة المدعى عليه، من بين الضوابط التي لها أهمية في نطاق الاختصاص القضائي الدولي، باعتبار أن محكمة موطن المدعى عليه، هي الأكثر قدرة على إلزامه بالحكم الصادر عنها، لذلك ظهر ضابط موطن المدعى عليه ، كحل لتحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، والذي يعني بأن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة التي يوجد بها موطن أو محل إقامة المدعى عليه ، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2021، والحكمة من هذا الضابط هي مراعاة لقواعد العدالة التي تقضي بأن المدعي يسعى إلى المدعى عليه ويجب مقاضاته أمام محكمة موطنه .
ثم انه لكي يكون الحكم الذي سيصدر عن محكمة موطن المدعى عليه ساريا في مواجهته، يجب أن يصدر عن محكمة يكون من رعاياها أو مستوطنا فيها أو موجودا فوق ترابها .
لكن الإشكال المطروح في هذا الصدد، هو ما مدى ملائمة هذا الضابط لمنازعات المعاملات الإلكترونية؟
يرى جانب من الفقه أن ممارسة التجارة الالكترونية،أصبحت تقلل من فرص إعمال قواعد الاختصاص ذات الطابع الإقليمي، والتي من بينها قاعدة موطن المدعى عليه، فلا موطن المشتري ولا موطن البائع يسهل معرفته في العقود المبرمة الكترونيا، خصوصا تلك التي تبرم وتنفذ بشكل إلكتروني ، كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن إعمال ضابط موطن المدعى عليه على منازعات عقود التجارة الإلكترونية يثير العديد من الإشكاليات، أولها صعوبة الكشف عن مكان أطراف المعاملة، لأن البيئة الإلكترونية لا تتناسب مع الضوابط ذات الطبيعة المكانية لصعوبة تحديد الموطن الحقيقي للأطراف .
هذا الرأي الفقهي أيدته اتفاقية الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، إذ نجدها نصت في مادتها السادسة على أن مجرد استخدام شخص اسم حقل أو عنوان بريد الكتروني ببلد معين، لا ينشئ قرينة على أن مكان عمله يوجد في ذلك البلد .
ولتجاوز هذه الصعوبة، اقترح جانب من الفقه تبني فكرة الموطن الافتراضي الذي يقوم على فكرة منح الاختصاص للمحاكم التي يوجد بها مركز أعمال المورد ، لكن هذه الفكرة لا تخلو أيضا من الصعوبات، لكونها تفتح الباب لجعل ضابط موطن المدعى عليه، أمرا مصطنعا يمكن للمورد إن يستخدمه أو يخفيه كيفما شاء ، وهو الأمر الذي فطن له قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عام 1996 ، حيث بن أن مكان الأطراف في عقد التجارة الإلكترونية هو مكان الطرف المعني سواء المنشئ أو المرسل إليه، وإذا تعدد مقر العمل، فيعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو بمقر العمل الرئيسي حسب الحال، وفي حال عدم وجود مقر العمل، يعتد بمحل الإقامة المعتاد .
يتضح مما سبق أن الاعتماد على ضابط الموطن أو محل الإقامة، يكتنفه العديد من الصعوبات التي من الممكن أن تعيق عمل القاضي لفض المنازعات، كما أن القواعد المتعلقة بالضوابط الشخصية كالجنسية وموطن المدعى عليه أو محل إقامته، ينحصر دورها فقط في العقود التقليدية، وتقل أهميتها في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، لذلك نؤيد الرأي القائل بأن الضوابط الشخصية لا تتناسب مع العقد المبرم بطريقة إلكترونية، لذلك أصبح من الضروري البحث عن آليات أخرى أكثر ملائمة مع البيئة الرقمية، تتجلى في الضوابط المكانية.
المطلب الثاني:
الضوابط المكانية لتحديد الاختصاص القضائي
ترتبط الضوابط المكانية أساسا بمصدر الالتزام، وتمنح الاختصاص القضائي لمحاكم مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه، وبذلك إذا كانت دولة معينة قد نشأ الالتزام أو الواقعة المنشأة له داخل ترابها، فتكون محاكمها هي المختصة. أو كانت هي بلد تنفيذ الالتزام، كما لو تعلق الأمر بعقد نفذ أو كان مشروط التنفيذ في ذلك البلد .
فالضوابط المكانية في تحديد المحكمة المختصة، ترتبط أساسا بمحل نشأة الالتزام؛ أي محكمة مكان إبرام العقد(الفقرة الأولى)، ثم بالموطن الذي تحققت فيه آثاره؛ أي محكمة مكان تنفيذ العقد(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:
ضابط مكان إبرام العقد
أثارت محاولة توطين العقد من أجل تحديد مكان إبرامه في العقود التقليدية، العديد من الصعوبات، وازدادت هذه الأخيرة تعقيدا فيما يتعلق بمكان إبرامه في النطاق رقمي، ويعد العقد المبرم بطريقة إلكترونية من العقود التي تطبق عليها أحكام التعاقد بين غائبين ، ويختلف موقف التشريعات بشان تحديد المكان الحقيقي لإبرام العقد بناء على نظريات حاولت التطرق على وجه التقريب للمكان الحقيقي الذي أبرم فيه العقد، ومدى إمكانية النظر لها من زاوية التعاقد الإلكتروني .
وبالرجوع إلى قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية، نجده قد عالج بمنهج افتراضي مكان إبرام العقد، بحيث نص على أن الرسالة يفترض أنها قد سلمت في مقر عمل المرسل إليه ، وبالتالي يكون هذا القانون قد أخد بنظرية تسلم القبول؛ أي مكان انعقاد العقد المبرم بطريقة إلكترونية ، فمكان إبرام العقد بطريقة إلكترونية، هو المكان الذي يوجد فيه موطن القابل، وبالتالي يجب الرجوع إلى هذا المكان من أجل تحديد الاختصاص القضائي بناء على مكان نشأة الالتزام .
ولصعوبة تحديد مكان إبرام العقد بالدقة اللازمة، حاولت قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الإلكتروني لعام 2004، تذليل هذه الصعوبة عندما أخدت بكل من نظرية تسلم القبول، ونظرية العلم به، مقيمة هذا الاختلاف على أساس التفرقة بين حالة إرسال رسالة البيانات إلى مقدم خدمات المعلومات الذي عينه المرسل إليه، وبين إرسالها إلى مقدم خدمات غير الذي عينه المرسل إليه .
أما المشرع المغربي، فقد أخد بنظرية تسلم القبول، وذلك في الفصل 65-5 من القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية في الفصل 65-5 .
من خلال ما سبق ذكره، يتضح أن دور هذا الضابط في تحديد قواعد الاختصاص القضائي في منازعات عقود النجارة الإلكترونية محدود، فرغم المحاولات التشريعية التي حاولت تحديد مكان إبرام العقد بدقة، ورغم تبني معظم التشريعات سواء الوطنية أو الدولية نظرية تسلم القبول، إلا أنه لا توجد لحد الآن من الناحية الواقعية والعملية وسيلة تقنية يمكن التعويل عليها بصورة قاطعة للجزم بأن ضابط مكان إبرام العقد، محدد رئيسي لقواعد الاختصاص القضائي؛ لأن خصوصية العقود المبرمة إلكترونيا تجعلها تتم على نطاق دولي، فذلك يؤدي إلى تداخل القوانين الوطنية، وبالتالي يصعب إيجاد حل واحد، هذا الوضع يمكن حله مسبقا بالاتفاق بين الأطراف على المكان الذي يعتبر مكانا لإبرام عقدهم وبالتالي تلافي اللجوء إلى المنهج الافتراضي ، هذا الحل، أيده جانب من الفقه، إذ اعتبر أن الاتفاق صراحة على مكان إبرام العقد من خلال وضع شروط تعاقدية تفيد أن العقد ابرم في مكان محدد .
وإذا كانت تفسيرات ضابط مكان إبرام العقد لا تصلح كحل لتحديد الجهة القضائية المختصة، فإن ضابط مكان تنفيذ العقد قد يكون أيسر في تحديد المحكمة المختصة.
الفقرة الثانية:
ضابط مكان تنفيذ العقد
جدير بالذكر أن هناك العديد من النظم القانونية المقارنة التي اعتمدت على ضابط مكان تنفيذ العقد، لإسناد الاختصاص القضائي لمحاكم دولة معينة، ومن جملتها نجد المشرع الفرنسي الذي نص على ذلك صراحة في المادة 46 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي .
كما نصت اتفاقية بروكسيل لسنة 1968 بشأن الاختصاص القضائي الدولي، على اختصاص محكمة المكان الذي نشأ فيه الالتزام أو اختصاص محكمة المكان الواجب تنفيذ الالتزام فيه .
يقوم هذا الضابط عل منح الاختصاص لمحكمة دولة تنفيذ العقد، بحيث أن هذا الضابط يمنح الاختصاص لمحكمة دولة تنفيذ العقد دون الالتفات إلى مكان إبرام العقد ، وتتمثل الاعتبارات التي على ضوئها يتم اختيار محكمة مكان تنفيذ العقد، في كونه يعبر عن وجود صلة قوية وقرائن جادة بين المحكمة التي سينفذ العقد داخل نفوذها، والعقد محل التنازع؛ لأنه يضمن لطرفيه العلم المسبق بالجهة القضائية التي ستنظر في النزاع حال نشوءه ، وهذا الضابط يضمن حلولا موحدة يخضع لها المتعاقدين في حالة التنازع .
إذا كان تنفيذ المعاملات المبرمة الكترونيا بطريقة مادية، فإن مكان التنفيذ هو مكان تحقق النتيجة من إبرام العقد، لكن الإشكال يطرح بالنسبة للمعاملات التي يكون تنفيذها معنويا ، أو الكترونيا .
بالرجوع إلى التوجيه رقم 44/2001، الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 22 شنبر 2000، نجده قد اعتمد معيار مكان التنفيذ، وميز بين المعاملات التي يكون موضوعها خدمات و تلك المرتبطة بالبضائع، فالبضائع يكون مكان تنفيذها هو مكان التسليم. أما الخدمات، فيكون مكان التنفيذ فيها هو مكان إنجاز هذه الخدمة أو المكان المفترض إنجازها فيه .
خلاصة القول، إن الاعتماد على ضابط مكان تنفيذ العقد لا يخلو من الصعوبات خصوصا وأن العقود المبرمة عبر شبكة الانترنت لا يمكن حصر النطاق الجغرافي الذي سيتم تنفيذها فيه، لذلك دعا جانب من الفقه الأطراف إلى الاتفاق بشكل صريح بين الأطراف على تحديد المكان الذي يتم فيه التنفيذ الإلكتروني للعقد
على العموم، تتعدد الضوابط العامة في تحديد المحكمة المختصة بنظر منازعات عقود التجارة الإلكترونية، والتي تتأرجح بين الضوابط الشخصية والضوابط المكانية، هذا التعدد لم يستطع إيجاد حل فعال لإشكالية التنازع، خاصة أن المعاملات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، في تطور مستمر، ويتدخل فيها مجموعة من الفاعلين، إضافة إلى كون البيئة الافتراضية لهذه المعاملات، صعبت أمر إخضاعها مكانيا لجهة قضائية معينة، وأمام عجز الضوابط العامة عن تحديد الاختصاص القضائي، فإن الحث عن ضوابط أخرى بموجبها يمكن حل إشكالية التنازع، أمر لا محيد عند، لذلك سنتناول الضابط الخاصة المحددة للاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
المبحث الثاني:
الضوابط الخاصة في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.
تلعب الإرادة دورا أساسيا في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع ذو العنصر الأجنبي، فصعوبة احتكام الأفراد إلى المحكمة المختصة، وما ساهم في ذلك من تشعب وخصوصية المعاملات ذات الطبيعة الإلكترونية، يجعلهم في تنازع حول تحديد الجهة القضائية المختصة، خاصة وأن الضوابط العامة للتنازع غبر فعالة في العديد من المناسبات. ولتجاوز هذا الإشكال الواقعي، يحتكم الأطراف إلى الإرادة باعتبارها عنصرا مؤثرا في العلاقات الدولية الخاصة ( المطلب الأول)، بحيث يمكنهم بإعمال قانون الإرادة، عرض نزاعاتهم على الوسائل الودية لتسوية النزاعات، التي تراعي خصوصية المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية( المطلب الثاني)،
المطلب الأول:
حرية الأطراف في تحديد المحكمة المختصة
من الثابت في النظم القانونية، أن كل دولة تنفرد في تحديد ضوابط الاختصاص القضائي لمحاكمها، وتعتبر ذلك من صميم اختصاصها، لكن هذا الوضع لا يمنع الأطراف من تحديد المحكمة المختصة مكانيا، وذلك استنادا على مبدأ سلطان الإرادة، وإعطاء الأولوية لحرية الأطراف، في اختيار المحكمة التي تثار أمامها المنازعة(الفقرة الأولى) دون إمكانية تحديد المحكمة المختصة نوعيا ، التي يستعصي أمر تحديدها اتفاقيا (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى:
التكريس التشريعي والاتفاقي لقانون الإرادة
إن البحث عن نية أطراف العلاقة القانونية فيما يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة ، لا يثير إشكالا عندما يكون التعبير عن الإرادة صريحا؛ أي عند اتفاق الأطراف صراحة على محكمة معينة للنظر في النزاع، وبالرجوع إلى الفصل 13 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب، نجده تضمن هذا الحكم، حيث أعطى الأولوية لضابط الإرادة واتفاقات الأطراف .
من الثابت في المعاملات الإلكترونية، أن للأطراف حرية تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعة القائمة أو المحتملة بينهم، تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة.
وقد أقرت مختلف النصوص القانونية، حرية الأطراف في تحديد المحكمة المختصة، سواء على المستوى الدولي عن طريق الاتفاقيات الدولية أو على المستوى الداخلي.
فقد اعترفت الاتفاقيات الدولية لإرادة الأطراف ، بالاتفاق على تحديد المحكمة المختصة؛ كاتفاقية بروكسل المبرمة في 27 سبتمبر1968بشان الاختصاص القضائي وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، التي نصت في المادة 17 منها على شروط قبول القاضي الفصل في المنازعة بأن يكون الاتفاق الذي يتم من خلاله تعيين المحكمة المختصة، مكتوبا سواء بإدراج بند في العقد يمنح الاختصاص لمحاكم معينة أو بإدراج بند تحكيمي .
وتكمن أهمية إدراج اتفاقية بروكسل التي تم تعديلها وتحولها إلى التنظيم الأوروبي 44/2001 من اجل مواكبة أحكامها للثورة المعلوماتية،خاصة منها التعاقد الإلكتروني، حيث أكدت على مبدأ حرية الأطراف في تحديد جهة قضائية، سواء من قبل أو بعد نشوء المنازعة.
خلاصة القول، إن التحديد المسبق للمحكمة المختصة، يلعب دورا مهما بالنسبة للأطراف، لأنهم يمكنهم من معرفة الجهة القضائية المؤهلة قبل الدخول في الرابطة التعاقدية، فتحديدها يمثل أهم الوسائل لحل النزاعات التي قد تثار مستقبلا بينهم، إذ لا يمكن بعهدها لأحدهم أن يحتج بكون المحكمة المختصة تخدم مصلحة الآخر . لكن هذه الإرادة ليست مطلقة بل تخضع لقواعد وقيود تحد من سلطانها، وتجعلها خاضعة لسلطان القانون.
الفقرة الثانية:
القيود الواردة على حرية الأطراف
إن حرية الأطراف في اختيار المحكمة المختصة ليست مطلقة، بل تتقيد بضرورة وجود صلة بين النزاع والمحكمة المختارة، أو تتوفر مصلحة مشروعة في اختيارها .
ويصعب في مجال عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنيت،الاعتداد بتلك الصلة بين المحكمة المختارة من طرف الأطراف، وبين العقد، قياسا على عقود التجارة الدولية التقليدية، بحيث أن التعاقد من خلال شبكة الاتصال الإلكترونية، يفترض فيه اتصال العقد وقت إبرامه بجميع الدول في آن واحد، نتيجة انفتاح الشبكة على العالم بأسره،وبذلك يصعب تحديد تلك الرابطة المزعومة بين المحكمة المختصة والعقود الإلكترونية.
فإرادة الأطراف في تحديد الجهة القضائية المختصة تصطدم بقواعد النظام العام، بحيث تفرض هذه القواعد على الأطراف التقيد بمضمونها، وتبعا لذلك، لا يمكنهم عرض نزاعهم على محكمة غير مختصة نوعيا، فإذا كان بإمكانهم تحديد المحكمة المختصة باتفاقهم فإن ذلك لا يتجاوز الاختصاص المكاني للمحاكم دون الاختصاص النوعي لارتباط هذا الأخير بالنظام العام .
كما يكون للاختصاص القضائي تأثير كبير في عقد الاختصاص لقانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع، وذلك في الحالات التي يستبعد فيها تطبيق القانون الأجنبي لمخالفته النظام العام؛ لأن مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام المقرر في قانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع، يؤدي إلى استبعادها ذلك القانون وتطبيق قانونها الوطني، وكذلك الحال إذا تعذر معرفة أحكام القانون الأجنبي المختص، فإنها تضطر إلى العمل بقانونها .
فالقانون إذن يعتبر محددا أساسيا للمحكمة المختصة في حالة وجود نزاع يتضمن عنصرا أجنبيا، لكن هل يمكن للخصوم الاتفاق على عقد الاختصاص الدولي لمحاكم أخرى وتنحية القضاء الوطني؟
للإجابة على هذا الوضع، يتعين علينا تحديد طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وما إذا كانت قواعد مكملة أو قواعد مرتبطة بالنظام العام، ففي الفرضية الأولى يكون من الجائز لأطراف الخصومة الاتفاق على ما يخالف هذه القواعد، ويجوز لهم أن يسندوا النظر في الخصومة إلى أي محكمة، سواء كانت تدخل في نطاق الاختصاص الوطني، أو الاختصاص الدولي للمحاكم، ويترتب عن ذلك اعتبار الشرط الاتفاقي السالب للاختصاص القضائي للمحكمة الوطنية شرطا صحيحا. وبالمقابل، فلو تم اعتبار قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد نظامية، فإن الشرط السالب للاختصاص يعد باطلا ولا أثر له .
وبخصوص القانون المغربي، فالمشرع لم يتناول مسألة سلب الاختصاص، وعليه لا يعتد بكل شرط من شأنه أن يسلب اختصاص محاكم المملكة ، متى كانت مختصة بالنظر في المنازعة، كما أعطى للمحاكم الوطنية رقابة بعدية على الحكم الأجنبي الذي يصدر خرقا لقواعد الاختصاص، بأن لا تستجيب للطلب، متى كان يرمي إلى تذييل حكم أجنبي قد صدر عن محكمة غير مختصة .
ومن وجهة نظرنا نرى بأن قانون الإرادة يلعب دورا إيجابيا في إطار العلاقات الدولية الخاصة؛ لأنه يجنب الأطراف الوقوع في العديد من الإشكالات القانونية والواقعية المرتبطة بتحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع، خصوصا أن الضوابط التقليدية لتحديد الاختصاص القضائي عجزت عن حل مسألة التنازع، عندما تتعلق المعاملة بعقود التجارة الإلكترونية، وبالموازاة فإذا كانت الإرادة تقوم بأدوار إيجابية فهي غير مطلقة وتخضع لمجموعة من الضوابط والقيود، وفي مقدمتها قواعد النظام العام والآداب العامة، لذلك قد يفضل الأطراف اللجوء إلى الوسائل الودية لحل المنازعات إلكترونيا، بعيد عن إجراءات القضاء العادي .
المطلب الثاني:
حرية الأطراف باللجوء إلى الوسائل الودية لحل المنازعات إلكترونيا.
تلعب الوسائل الودية، دورا هاما وفعالا في فض النزاعات الناشئة بين الأطراف، خاصة في الروابط ذات العنصر الأجنبي، فتجنبا للبحث عن المحكمة المختصة وطنيا، أو تحديد المحكمة المختصة في إطار الاختصاص القضائي الدولي، فإن إرادة الأطراف تلعب دورا رياديا في هذا الباب، و من خلال الاتفاق على إسناد النظر إلى الوسائل الودية، بناء على اتفاق أو شرط التحكيم، وعرض المنازعة على التحكيم الإلكتروني، ما دام النزاع قد نشأ بمناسبة عقد من عقود التجارة الإلكترونية( الفقرة الثانية)،كما يمكن للأطراف في حالة غياب اتفاق للتحكيم، أن يبقوا في نطاق اختصاص الوسائل الودية وذلك بالاحتكام إلى الوساطة الإلكترونية (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى:
الوساطة الإلكترونية
تعد الوساطة من الوسائل الودية لحل النزاعات التي يلجا إليها الأطراف بكل حرية، والتي تعرف بصفة عامة؛أنها تدخل طرف ثالث محايد بين طرفي النزاع، من اجل الوصول إلى صيغة نهائية لتسوية النزاع القائم، وعرفتها المادة 01/03 من قانون اليونسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، بأنها عملية يتم من خلالها حل النزاع وديا، سواء بالوساطة أو التوفيق، مع محاولة الوسيط الوصول لحل ودي للنزاع العقدي أو القانوني، دون أن يملك سلطة إجبار المتنازعين عل قبول الحل ، أما المشرع المغربي، فقد أجاز للأطرف لأجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد .
فبعد موافقة طرفي المنازعة على الوسيط والإجراءات، يتم الانتقال إلى المرحلة الموالية من الوساطة؛ وهي مناقشة موضوع المنازعة وإثارة نقاط الخلاف الجوهرية، وذلك بعد أن يقوم الوسيط بإرسال بريد إلكتروني لكل من طرفي النزاع، يتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكل منهما، والذي يخولهما الدخول لصفحة المنازعة المعدة على الموقع الإلكتروني،بالإضافة إلى تحديد ميعاد جلسات الوساطة .
بعد دلك تنعقد جلسات الوساطة،التي يتم خلالها تبادل دفوع الأطراف ودفاعاتهم، وفي الأخير يقوم الوسيط بصياغة اتفاق التسوية النهائية وعرضه على المتنازعين للتوقيع عليه.
من وجهة نظرنا، إن الوساطة الاتفاقية بصفة عامة، والإلكترونية خاصة، تعتبر وسيلة للوصول لحلول مرضية لطرفي النزاع خاصة في النزاعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية، نظرا للخصائص والمزايا العديدة التي توفرها هذه الآلية؛ وأهمها تجاوز البحث والخوض في إشكالية الاختصاص القضائي، والصعوبات المرتبطة بتطبيق ضوابط تحديد المحكمة المختصة، والتي أبانت بالملموس عجزها عن حل مسألة تنازع الاختصاص القضائي، فالوساطة الإلكترونية رغم مميزاتها الكثيرة، فقد تفشل في حل النزاع، فيعمد الأطراف إلى عرضه على التحكيم الإلكتروني.
الفقرة الثانية:
التحكيم الإلكتروني
إن التطور الكبير في وسائل الاتصالات، واستعمال التكنولوجيا الحديثة، أدى إلى بروز نوع جديد من المعاملات التي تتم عبر شبكة الأنترنت، حيث أصبح بالإمكان التفاوض على العقود وإبرامها إلكترونيا، خاصة بعدما اعترف المشرع المغربي بحجية الدعامة الإلكترونية في الإثبات، إذ نجده في الفصل 417-1 من ظهير الالتزامات والعقود، ساوى ما بين الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية والوثيقة المحررة على الورق .، ولعرض النزاع على التحكيم، لا بد من وجود اتفاق للتحكيم الذي يأخذ شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم ، فقد عرفه بعض الفقه بأنه قلب التحكيم وقالبه، وأنه والتحكيم وجهان لشيء واحد، والأساس لوجود عملية التحكيم بين الأطراف، إذ يعتبر هو أساس التجاء الأطراف للتحكيم، كما أنه المحدد لنطاق التحكيم، وتحديد ما تختص هيئة التحكيم بنظره وما لا تختص به ، كما أنه شرط لصحة حكم المحكمين، إذ يترتب على وجوده صحة التحكيم ، كما يقوم اتفاق التحكيم بسلب الاختصاص من القضاء الرسمي وعرضه على المحكمين، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 27 يونيو 2013 .
إن فكرة التحكيم الإلكتروني، ظهرت كأسلوب حصري لحل المنازعات التي تنشأ نتيجة استخدام شبكة الأنترنت في المعاملات الإلكترونية، دونما حاجة إلى انتقال الأطراف أو تواجدهم في مجلس المحكمين، خاصة وأن القضاء قد عجز عن اللحاق بالطفرة الإلكترونية وتوفير وسائل سريعة لفض منازعات التجارة الإلكترونية .
فالتحكيم الإلكتروني يعد من أبرز مظاهر الثورة المعلوماتية في الوقت الحاضر، إذ خرج كآلية لفض المنازعات عن نمطه التقليدي، فمع ازدياد حجم العقود المبرمة عن طريق الأنترنت والتجارة الإلكترونية، ازداد بالطبع حجم النزاعات الناجمة عن ذلك، ولما يمثله اللجوء للقضاء من عبء كبير على المتعاقدين بواسطة شبكة الأنترنت، باعتبارها عقودا عن بعد تثير إشكالية القانون الواجب التطبيق عند حدوث النزاع والخشية من فقدان التجارة الإلكترونية لموقعها البارز الذي احتلته أخيرا في التبادل التجاري الدولي ، إذ لقيت فكرة حل المنازعات الإلكترونية قبولا من طرف العديد من الدول، منها دول الاتحاد الأوروبي عبر التوجيه رقم 31 لعام 2000 في مادته الأولى، التي حثت الدول الأعضاء، بالسماح لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم، بتسوية منازعاتهم بعيدا عن المحاكم، وذلك عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجيا لتسوية وفض المنازعات
ولتفعيل دور التحكيم الإلكتروني في تسوية المنازعات بين الأفراد، تم إنشاء عدة مراكز تختص بذلك، أهما تلك التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (مركز الويبو Wipo)، حيث أنشأت هذه المنظمة مركزا للوساطة والتحكيم من أجل تسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات الالكترونية .
وعموما، يعتبر التحكيم الإلكتروني، أسلوب حصري لحل المنازعات التي تنشأ نتيجة استخدام شبكة الأنترنت في المعاملات الإلكترونية، دونما حاجة إلى انتقال الأطراف أو تواجدهم في مجلس المحكمين، خاصة وأن القضاء قد عجز عن اللحاق بالطفرة الإلكترونية وتوفير وسائل سريعة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، فأصبحت متطلبات التجارة الإلكترونية تقتضي البحث عن سبيل أكثر نجاحا لفض هذه النزاعات، يتلاءم والآلية التي أدت إلى نشوء الخلاف بين المتعاقدين، والحفاظ على متطلبات التجارة الإلكترونية.
خاتمة
إن المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية تثير مجموعة من الإشكالات العملية والواقعية، تبدأ من تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، لتصل بعدها إلى الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، وتمتاز هذه العقود بخصوصية تجعل منها عابرة للحدود ولا تعرف مجالا لجغرافيا القوانين، مما يجعل مهمة تحديد الجهة المؤهلة لفض النزاع أمرا صعبا، خصوصا مع تنوع ضوابط تحديد الاختصاص القضائي وتنوعها، إضافة إلى الخصوصية التي تعرفها التجارة الإلكترونية.
وقد توصلنا من خلال هذا البحث للنتائج والتوصيات الآتية:
أولا: النتائج
– إن عقود التجارة الإلكترونية، لا تختلف في مفهومها عن العقود التقليدية، إنما تتميز بالوسيلة التي تنعقد بها.
– إن عقود التجارة الإلكترونية، عقود دولية لا تعرف مجالا جغرافيا معين، لكون وسيلة إبرامها تتم عن بعد.
– إن دولية هذه العقود تجعل من الصعب إخضاعها لنظام قانوني معين، نظرا لاختلاف جنسيات أو موطن إقامة طرفيها.
-إن الإشكالية الأساسية التي تواجهها عقود التجارة الإلكترونية، ترتبط أساسا بتحديد الجهة المختصة قضائيا للبت في منازعات هذه العقود، ولتجاوز إشكالية تحديد المحكمة المختصة، يتم الاهتداء إلى مجموعة من الضوابط، منها ما هو مرتبط بالضوابط التقليدية الشخصية؛ القائمة أساسا على جنسية وموطن إقامة المدعي، أو المكانية التي تعتمد بالأساس على مكان نشأة الالتزام أو تنفيذه، وما هو مرتبط بالضوابط الخاصة القائمة على إرادة الأطراف ودورها في تحديد الجهة القضائية المختصة، و إيجابيات هذا الضابط في الاعتماد على الوسائل الودية لحل المنازعات إلكترونيا.
– رغم تعدد ضوابط تحديد المحكمة المختصة للنظر في نزاعات عقود التجارة الإلكترونية، فإنها لا تسعف الأطراف في الأخذ بها، خصوصا وأن قوانين اليونسترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، لم تحسم في اختيار الضابط الأنسب في التطبيق على منازعات التجارة الإلكترونية.
– تلعب الإرادة دورا محوريا في العلاقات الدولية الخاصة، خصوصا المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية؛ لأنها تجنب الأطراف الوقوع في إشكالية الخضوع لضوابط تحديد الاختصاص القضائي، وتمنحهم إمكانية التحديد المسبق للمحكمة المختصة بين القضاء الرسمي، أو الوسائل الودية لحل المنازعات إلكترونيا.
– إن الوسائل الودية لحل النزاعات إلكترونيا، تعتبر أكثر ملائمة لخصوصية عقود التجارة إلكترونية، لكونها تدار عن بعد وتراعي خصوصية المنازعات الناشئة عن هذه العقود.
– خلو التشريع المغربي من قواعد خاصة تنظم التقاضي في مجال الاختصاص الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مع تبنيه بعض القواعد الخاصة بالعقود المبرمة بشكل إلكترونية في القانون رقم 53.05 ، كتلك المتعلقة بزمان ومكان إبرام العقد.
ثانيا: التوصيات
– ضرورة سن اتفاقية دولية توحد قواعد الاختصاص القضائي بخصوص المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية.
– إنشاء محاكم إلكترونية التي ستشكل قفزة نوعية لما توفره من حلول سريعة تتلاءم مع البيئة الرقمية.
– ندعو المنظمات الدولية إلى توحيد الحلول فيما يتعلق بضوابط الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، للوصول إلى اتفاقيات دولية منسجمة مع أغلب التشريعات المختلفة، لخلق الثقة في المعاملات الإلكترونية، والرفع من وثيرة استعمالها.
– ندعو المشرع المغربي إلى وضع ضوابط للاختصاص القضائي الدولي تتناسب مع طبيعة العقود الإلكترونية، خاصة وإن القانون الدولي الخاص المغربي لا زال يعتمد على نص قديم سنه المشرع الفرنسي إبان الحماية؛ وهو ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب.
– ندعو الباحثين إلى تناول موضوع تنازع الاختصاص في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، سواء القانوني أو القضائي، لاقتراح حلول متجددة تتناسب والطبيعة المعاصرة للعقود المبرمة بشكل إلكتروني.
لائحة المراجع
أولا: باللغة العربية
أبو جعفر عمر المنصوري، خصوصية التحكيم الالكتروني على ضوء القواعد العامة للتحكيم، مجلة القصر، العدد 26، مايو 2010.
اتفاقية 27 أيلول/سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية.
اتفاقية الأمم المتحدة، المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية، الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، نيويورك 2005 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2013.
اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولهم في 14 يوليوز (تموز) 1967، والمعدلة في 28 سبتمبر (أيلول) 1979، منشور الويبو رقم (A)250.
أحمد إبراهيم عبد الثواب، اتفاق التحكيم، مفهومه، أركانه وشروطه، نطاقه، دراسة في ضوء الفقه والقضاء في قانون التحكيم المصري والقانون الفرنسي الجديد الصادر بالمرسوم رقم 2011-48، بتاريخ 13 يناير 2011، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقوانين وأنظمة التحكيم المقارنة، دار النهضة العربية القاهرة 2013.
أحمد شرف الدين، جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية، النسر الذهبي لطباعة مصر 2003.
أحمد عبد الكريم سلامة، أصول المرافعات المدنية الدولية، مكتبة العالمية المنصورة 1984.
أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2010.
أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن للقانون المصري والانجليزي والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة 2004، ص 233.
أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنيت، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 2000.
إﯾﻧﺎس اﻟﺧﺎﻟدي، اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، الطبعة الأولى، ﻣﺻر، 2009.
بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة بدران الحقوقية، لبنان 2017.
حسام أسامة محمد، الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، القاهرة 2004.
حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997.
سليمان أحمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية في إطار القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 2011.
الصادق عبد القادر وبالعبيدي رافع أحمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد السادس، العدد الثالث، سبتمبر 2001.
صالح جاد المنزلاوي، الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية، مطبعة دار الفكر الجامعي، الطبعة التانية ، الإسكندرية 2004.
صالح جاد المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2006.
ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الالكتروني بالبطائق البنكية، دراسة مقارنة، الجزء الثاني. المطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، مراكش ،.2010
عادل أبو هشيمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية 2005.
عباس العبودي، تحديات الإثبات في السندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2010.
عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2014
عبد الرسول عبد الرضا الأسدي وعلي عبد الستار أبو كطيفه، الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل المجلد 22، العدد 4 ديسمبر 2005.
عبد الفتاح الزيتوني، تنازع الاختصاص في العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010.
عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الالكتروني في النظم القانونية المقارنة ، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،الإسكندرية 2005، ص 72.
عبد الكريم الطالب، توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد الأول 2009.
عبد الكريم غالي، المعلوميات ودورها في التأهيل القضائي، مجلة الملحق القضائي، عدد 33، يناير 1998.
عبد الكريم غالي، المعلوميات ودورها في التأهيل القضائي، مجلة الملحق القضائي، عدد 33، يناير 1998، ص 158.
عبد المجيد تيجاني، المسؤولية المدنية الناتجة عن التفاوض في العقود الإلكترونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2012-2012، ص 428.
عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة التاسعة 1986.
ﻋﻣر ﺧﺎﻟد زرﯾﻘﺎت، ﻋﻘد اﻟﺗﺟﺎرة الإلكترونية ﻋﻘد ﻣﺑرم ﻋﺑر الأنترنيت، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر والتوزيع، اﻷردن2007.
محمد أحمد علي المحاسنة، تنازع القوانين في العقود الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 2006.
ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم، اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋن ﺑﻌد، ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻷورﺑﻲ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، الإسكندرية 2005.
ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺻور، الوساطة والتحكيم الالكتروني، دار النشر والتوزيع ، الطبعة الأولى، الأردن 2001.
ﻣﺣﻣد ﻓواز اﻟﻣطﺎﻟﻘﺔ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،الأردن 2006.
المختار أحمد عطار، العقد الالكتروني، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء 2010.
مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانونية الطبعة الثانية،مصر 2010.
هشام خالد، الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2000.
هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق عل عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،الإسكندرية. 2001.
هشام موفق عوض وسهام خلف السلمي، ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في نظر منازعات العقود الإلكترونية في النظام السعودي، دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد الثاني والأربعين، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بدمنهور 2023.
ثانيا: باللغات الأجنبية
Froger. D, Les contraintes du formalisme de l’archivage de l’acte notarié établi sur support dématérialisé,JCP ,N°12 mars 2004.
Gillies. L, A review of the new jusisdiction rules for elrcronic consumer contracts within the European union, JILT, Issue 1, 2001.
Marc. L, Pays d’origine et commerce électronique, défense des intérêts des entreprises et consommateurs européens, G.P. nov. dec 1999.
RÈGLEMENT(CE), No 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de sdécisions en matièrecivile et commerciale, (JOL12 du 16.1.2001.(
Directive 2000/31/CE, du parlement Européen et du conseil du 8 juin 2000, relation à certains aspects juridique des services de la société de la formation et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur J.O. N° L178/1du 17/07/2000, www.eur-lex-europa.eu/fr.