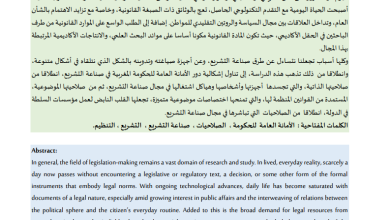مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة في ضوء أحكام النظام البحري التجاري السعودي الصادر لعام ١٤٤٠ هـ وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906 الباحثة: يسرى جابر الذبياني
مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة في ضوء أحكام النظام البحري التجاري السعودي الصادر لعام ١٤٤٠ هـ وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906
الباحثة: يسرى جابر الذبياني
طالبة ماجستير في قسم القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665





























مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة في ضوء أحكام النظام البحري التجاري السعودي الصادر لعام ١٤٤٠ هـ وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906
الباحثة: يسرى جابر الذبياني
طالبة ماجستير في قسم القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز
المستخلص:
يتناول هذا البحث مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري بوصفه أحد المبادئ الجوهرية في عقد التأمين، إذ يكفل للمؤمِّن حق الحلول محل المؤمَّن له في الرجوع على الغير المتسبب بالضرر، وذلك بعد وفائه بمبلغ التعويض. وقد تناولت الدراسة هذا المبدأ في ضوء أحكام لنظام البحري التجاري السعودي الصادر لعام 1440هـ، وذلك في إطار دراسة تحليلية مقارنة بما ورد في القانون التأمين الإنجليزي لعام ١٩٠٦، أُثرِيت باستنباط عدد من السوابق القضائية الإنجليزية المتخصصة في المجال البحري. وقد استُهلت الدراسة بتعريف عقد التأمين البحري، ثم تطرّقت إلى مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري وتكييّفه القانوني في هذا السياق. كما استعرضت الآثار القانونية الناشئة عن ممارسة هذا الحق، والشروط والقيود التي تحدّ من نطاق تطبيقه. تطرقت الدراسة كذلك إلى التزامات المؤمن له في الحفاظ على حقوق المؤمن، بما يُضمن تمكين الأخير من ممارسة حقه في المطالبة والتعويض وفقًا لمبدأ الحلول. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: النظام البحري التجاري السعودي يُقر مبدأ الحلول وفقًا للمادة (٣٢٤) دون بيان تفصيلي لشروطه أو حدوده أو آثاره، مما أحدث فراغًا تنظيميًا نتج عنه غياب السوابق القضائية الصادرة عن اللجنة الاستئنافية الصادرة من لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وأضعف من حماية حقوق المؤمن له. لم يُعرف النظام البحري التجاري السعودي كلًا من الخسارة الكلية والخسارة الجزئية وأثرها في حلول المؤمَّن محل المؤمن له بخلاف القانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦ وفقًا للمادة (٧٩) حيث وضع الطبيعة نوع الخسارة شرطًا أساسيًا ومعيارًا دقيقًا لحلول المؤمن محل المؤمن له بعد دفعه مبلغ التعويض. توصلت الدراسة لتوصيات أهمها: نوصي النظام البحري التجاري السعودي بتعديل المادة (٣٢٤) في حالة الخسارة الكلية إذا دفع المؤمن كامل مبلغ التأمين تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه وما قد يتبقى منه، ويحل محل المؤمن له في جميع الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء محل التأمين، اعتبارًا من تاريخ وقوع الخطر المؤمن منه ودفعه مبلغ التعويض. وإضافة فقرة (٢) في حال الخسارة الجزئية، فلا يترتب على دفع مبلغ التعويض انتقال الملكية إلى المؤمن، ويقتصر حقه على الرجوع على الغير في حدود ما دفعه. ونوصي المنظم السعودي بإيراد نصًا نظاميًّا صريحًا يُقر بأنه في حالات التأمين الجزئي تُمنح الأولوية للمؤمَّن له في استيفاء ما تبقّى من خسارته غير المعوَّض عنها من المبالغ المستردة من الغير، وذلك قبل أن يباشر المؤمِّن حقَّه في الحلول.
الكلمات المفتاحية: مبدأ الحلول، مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري، التأمين البحري، النظام البحري التجاري السعودي لعام ١٤٤٠هـ، قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦، قانون التأمين الإنجليزي لعام ٢٠١٥، الحلول محل الغير، الحلول القانوني.
The Principle of Subrogation in Marine Insurance Contracts: A Comparative Study in Light of the Provisions of the Saudi Commercial Maritime Law of 1440 AH and the English Marine Insurance Act of 1906
Yousra Jaber AL Thubyani
Master Student Private Law Department
Faculty of Law, King Abdulaziz University
Abstract:
This research examines the principle of subrogation in marine insurance contracts as one of the fundamental doctrines in insurance law. It guarantees the insurer the right to substitute the insured in pursuing claims against third parties responsible for the damage, after indemnification has been paid. The study analyzes this principle in light of the provisions of the Saudi Commercial Maritime Law issued in 1440 AH, within a comparative analytical framework that also considers the English Marine Insurance Act of 1906, enriched by selected English case law specializing in maritime matters.
The study begins by defining the marine insurance contract and proceeds to explore the concept and legal characterization of subrogation within this context. It further examines the legal implications arising from the exercise of this right, as well as the conditions and limitations that constrain its application. The research also addresses the obligations of the insured to preserve the insurer’s rights, thereby enabling the insurer to effectively exercise the right of subrogation.
The study concludes with several key findings, most notably: while the Saudi Commercial Maritime Law recognizes the principle of subrogation under Article (324), it fails to provide detailed provisions regarding its conditions, scope, or legal effects. This has resulted in a regulatory gap and a lack of relevant precedents from the Appellate Committee of the Insurance Disputes and Violations Committee, weakening the protection of the insurer’s rights. Furthermore, the Saudi law does not define total or partial loss, nor does it clarify their implications for the insurer’s right of subrogation—unlike the English Marine Insurance Act of 1906, which under Section (79) establishes the nature of the loss as a critical condition and standard for the insurer’s right to subrogation upon payment of compensation.
The study presents key recommendations, including amending Article (324) of the Saudi law to state that in the case of total loss, once the insurer pays the full insurance amount, ownership of the insured item and any remaining parts thereof shall transfer to the insurer. The insurer shall be subrogated to all rights and claims related to the insured object as of the date of the insured risk and payment of compensation. An additional paragraph is recommended to address partial loss, stipulating that ownership shall not transfer to the insurer upon indemnification; rather, the insurer’s right shall be limited to subrogation against third parties for the amount paid. The study further recommends that the Saudi legislator introduce an explicit provision establishing that in cases of partial insurance, priority shall be given to the insured to recover any uncompensated loss from third-party recoveries before the insurer exercises its subrogation rights.
Keywords: Subrogation, Subrogation in Marine Insurance, Marine Insurance, Saudi Commercial Maritime Law (1440 AH), Marine Insurance Act 1906, Insurance Act 2015, , Rights Against Third Parties, Legal Subrogation
المقدمة
يُعد التأمين البحري مركزًا بالغ الأهمية في القانون البحري، حيث نادرًا ما تُبحر سفينة أو تُنقل البضائع دون أن يُؤمن عليها من قِبَل مالكيها لضمان الحماية من المخاطر المختلفة[1]. ومن هنا، أصبح التأمين البحري أداة أساسية لضمان واستمرارية التجارة البحرية والتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن الحوادث البحرية، كالغرق، التصادم، الحرائق وغيرها من الحوادث، وعند وقوع إحدى هذه الحوادث، يكون للمؤمِّن له الحق في المطالبة بالتعويض من المؤمن وفقًا لعقد التأمين أو مقاضاة الطرف الثالث المسؤول عن هذا الضرر. في بعض الحالات قد يحصل المؤمِّن له على تعويض من الطرفين مما قد يؤدي ذلك إلى إشكالية ازدواجية التعويض. حيث يحصل المؤمِّن له على تعويض مزدوج من المؤمن والطرف المتسبب في الضرر عن نفس الخسارة، مما يُثير إلى ظهور إشكاليات قانونية ولمعالجة هذ الإشكالية يُطبق مبدأ الحلول الذي يُخول لشركة التأمين الحق في الحلول محل المؤمِّن له بعد دفع التعويض له في مطالبة الطرف المسؤول عن الضرر باسترداد المبلغ المدفوع. يهدف هذا المبدأ في ضمان عدم حصول المؤمن له على ما يعرف بازدواجية التعويض وضمان أن يتحمل الطرف المتسبب في الضرر المسؤولية الكاملة.
وفي هذا السياق، تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا بتنظيم قطاع التأمين البحري بما يواكب تطورات التجارة البحرية العالمية، حيث أصدرت، النظام البحري التجاري السعودي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/144٠هـ الذي جاء ليواكب المستجدات في القطاع البحري والتجاري، وينظم العلاقة بين أطراف النقل البحري والتأمين، مع استلهام عدد من المبادئ والممارسات الرائدة من التجربة البريطانية العريقة في هذا المجال، وتحديدًا مبدأ الحلول. حيث، تُعد المملكة المتحدة من أقدم الدول التي نظّمت التأمين البحري بشكل مؤسسي، إذ تعود بداياته إلى القرن السابع عشر، حين شكّلت التجارة البحرية محور الاقتصاد الإنجليزي. وقد ساهم هذا الواقع الاقتصادي في نشوء مؤسسات متخصصة بالتأمين، أبرزها شركة لويدز لندن (Lloyd’s of London)، التي تأسست عام 1688، وكانت آنذاك تمثّل تجمعًا من الممارسين البحريين، الذين طوروا أعرافًا وممارسات تأمينية شكلت النواة الأولى لتقنين هذا القطاع. في مراحله الأولى، أدى إلى صدور قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906[2]. الذي كرّس عددًا من المبادئ الأساسية، وفي مقدّمتها مبدأ الحلول لذي يُعد من الركائز الجوهرية في هذا السياق؛ إذ يكفل للمؤمِّن حق الرجوع على المسؤول عن الضرر بعد سداد التعويض، بما يخول دون حصول المؤمن له على تعويض مزدوج عن الخسارة ذاتها.
مشكلة الدراسة:
نصّت المادة (324) من النظام البحري التجاري السعودي في الباب السابع منه، على مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري، حيث يُمنح المؤمن الحق في الحلول محل المؤمَّن له في المطالبة بالتعويض من الطرف المسؤول. وذلك في حدود مبلغ التعويض الذي تم دفعه. إلا أن النص النظامي جاء خاليًا حيث لم يُبيّن آلية تطبيق هذا الحق على نحو تفصيلي، كما لم يُفصل في الأحكام والقيود القانونية التي تنظّم ممارسته، لا سيما ما يتعلق بتحديد نطاق حق الحلول في الحالات المختلفة، وعلى وجه الخصوص في حالتي الخسارة الكلية والجزئية وما يترتب على كل منهما من آثار قانونية في ممارسة هذا الحق. وقد أفرز هذا النقص في التنظيم إشكاليات عملية وتفسيرية في الواقع التطبيقي وأدى إلى وجود فراغ تنظيمي واضح زاد من حدّته غياب السوابق القضائية الصادرة عن اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، مما انعكس سلبًا على وضوح تطبيق هذا الحق وأدى إلى تباين في الفهم القانوني لدى الأطراف ذات الصلة. وعلى خلاف ذلك، نظم قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906 وفقًا للمادة (79) حيث نظّم بوضوح حالات حلول المؤمن محل المؤمن له في عقد التأمين البحري وبيّان الأثر القانوني لحالات الحلول وفق طبيعة الخسارة في حالة الخسارة الكلية والخسارة الجزئية الحقوق التي تؤول إلى المؤمن بعد دفعه مبلغ التعويض. حيث نصّت الفقرة (79/1) على أنه: عندما يدفع المؤمن تعويضًا عن خسارة كلية، سواء عن كامل موضوع التأمين، أو، في حالة البضائع، عن أي جزء يمكن تخصيصه من موضوع التأمين، فإنه يصبح من حقه أن يتملك مصلحة المؤمن له في أي شيء قد يبقى من موضوع التأمين الذي تم التعويض عنه، ويحلّ محل المؤمن له في جميع الحقوق ووسائل الرجوع المتعلقة بذلك الموضوع، وذلك اعتبارًا من وقت وقوع الحادث الذي تسبب في الخسارة. وفي ذات السياق، والفقرة (79/2)، فبيّنت أنه: مع مراعاة الأحكام السابقة، عندما يدفع المؤمن تعويضًا عن خسارة جزئية، فإنه لا يكتسب أي حق ملكية في موضوع التأمين، أو في أي جزء منه قد يبقى، ولكنه يُحلّ محل المؤمن له في جميع الحقوق ووسائل الرجوع المتعلقة بموضوع التأمين، وذلك اعتبارًا من وقت وقوع الحادث الذي تسبب في الخسارة، وبالقدر الذي تم التعويض عنه وفقًا لهذا القانون. وقد أرسى المشرّع الإنجليزي هذا الإطار القانوني استنادًا إلى منظومة قضائية ثرية، تجلّت في عدد من السوابق القضائية التي أرست مبادئ استرشادية في تفسير وتطبيق مبدأ الحلول في عقود التأمين البحري. ولا يقتصر دور هذه السوابق على إضفاء البعد العملي على النصوص النظامية فحسب، بل يُعدّ الرجوع إليها مسلكًا علميًا وعمليًا ضروريًا لفهم الأبعاد الحقيقية لهذا الحق، وتحديد نطاقه وحدوده بدقة، على نحو يرسّخ فهمًا مشتركًا وواضحًا لدى جميع الأطراف ذات الصلة في العلاقة التأمينية.
وعليه، تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتي: ما مدى كفاية التنظيم القانوني لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري في النظام البحري التجاري السعودي وفقًا للمادة (324) مقارنةً بما ورد في المادة (79) من قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906؟
ويتفرع منه التساؤلات الفرعية:
– ماهية مبدأ الحلول في عقد تأمين البحري؟
– ما لفرق بين الحلول الاتفاقي والحلول التعاقدي وأثرهما على حقوق الأطراف في عقد التأمين البحري؟
– ما التكييّف القانوني لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري؟
– ما هي الشروط القانونية التي يجب توافرها لكِ يحق للمؤمن ممارسة حقه في الحلول محل المؤمِّن له ضد الطرف الثالث؟
– كيف تؤثر نوع الخسارة (كلية أو جزئية) على حقوق شركة التأمين في الحلول، وحقها في ملكية الشيء المؤمن عليه والمطالبة بالتعويض من الأطراف المسؤولة؟
– ما الأثار المترتبة على تنازل المؤمِّن له عن حقه في الرجوع على الطرف المسؤول؟
أهداف الدراسة:
أولًا: بيان مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
ثانيًا: تحليل الفروقات الأساسية بين الحلول الاتفاقي والحلول التعاقدي وأثرهما على حقوق الأطراف في عقد التأمين البحري.
ثالثًا: تحليل اللّبس الذي يُحيط التكييف القانوني لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري من خلال عرض الآراء الفقهية والقانونية المتباينة حوله وإيضاح الحجج المستند إليها من كل اتجاه مؤيد أو معارض مع استعراض الحجج القضائية وما يُثار من اعتراضات بشأنها، ومن ثم إيراد ما يُرجَّح قبوله وما يّدعمهُ من مبررات.
رابعًا: إيضاح أهم الشروط القانونية التي تمكّن المؤمِّن من الحلول محل المؤمَّن له في الرجوع على الطرف الثالث المسؤول عن الضرر.
خامسًا: بيان الفروقات الأساسية بين الخسارة الكلية والخسارة الجزئية، وتأثير كل منهما على حق حلول شركات التأمين محل المؤمِّن له مع توضيح مدى انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه وفقًا لطبيعة الخسارة وقيمة تعويض المدفوع.
سادسًا: تحليل الآثار القانونية المترتبة على تنازل المؤمِّن له عن حقه في الرجوع على الطرف المسؤول وانعكاس ذلك على حقوق المؤمَّن في ممارسة الحلول.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في معالجة القصور التنظيمي في النصوص القانونية المتعلقة بمبدأ الحلول في النظام البحري التجاري السعودي تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد تصور قانوني يُنظم مبدأ الحلول تحديدًا في قطاع التأمين البحري، كما تهدف الدراسة إلى الاستفادة من التجربة التشريعية في القانون الانجليزي في تنظيم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري لما يتمتع به من خبره عريقة وتطبيقات قضائية في هذا المجال ممّا يعزّز في إثراء تطوير النظام السعودي وفق أفضل الممارسات ، بالإضافة إلى ذلك تهدف الدراسة في إثراء الأبحاث العلمية المتخصصة في عقود التأمين البحري، وذلك في ظل ما يُلاحظ من ندرة وشح الأبحاث العلمية المتعلقة بالموضوع الدراسة.
منهج الدراسة:
تم الاستعانة بالمنهج التحليلي والمنهج المقارن، لتحليل نصوص نظام البحري التجاري السعودي الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ (٥/٤/١٤٤٠ هـ) المتعلقة بمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري وتحديدا المادة (٣٢٤) ومقارنتها بما ورد في المادة (٧٩) من قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906م.وعرض السوابق القضائية التي احتوت على مشكلة الدراسة وتحليل وقائعها للوصول إلى تصور قانوني أوضح حوّل أهمية مشكلة الدراسة وماهية الآثار التابعة لها. من خلال إلقاء الضوء على الحلول الواردة في السوابق القضائية في التشريع الانجليزي، للاستفادة منها في معالجة الثغرات القانونية التي قد تُواجه تطبيق مبدأ الحلول في النظام البحري التجاري السعودي.
حدود الدراسة:
تقتصر على تحليل النظام البحري التجاري السعودي لعام ١٤٤٠هـ، ومقارنته بأحكام قانون التأمين البحري الانجليزي الصادر لعام 1906.
الدراسات السابقة: توجد بعض الأبحاث التي تشترك مع الدراسة في تناول مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري وتُعد مقاربة نوعًا وتتصل من جوانب أخرى وهي كالآتي:
– الدراسة الأولى: الحلول في المطالبات البحرية، الباحثان: البروفيسور روب ميركين ، وآيبكي ناز دورموش ، كلية الحقوق ، جامعة ريدينغ ، ( ٢٠٢٢م).
تهدف الدراسة إلى مناقشة مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري، حيث يتمتع المؤمن بحق رفع دعاوى ضد الأطراف المسؤولة عن الأضرار بعد دفع التعويض للمؤمن له، مثل مالكي السفن والمستأجرين وأصحاب البضائع. كما تستعرض الدراسة أوجه القصور في قانون التأمين البحري لعام 1906 خاصة فيما يتعلق بكيفية تطبيق الحلول، والعقبات القانونية التي تواجه شركات التأمين عند محاولة استرداد التعويضات من الأطراف المسؤولة عن الضرر. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومن أهمها: الحلول في التأمين البحري معقد بسبب تداخل القوانين الدولية وعقود النقل والتأمين. وبالإضافة إلى القانون الحالي لعام ١٩٠٦ غير كافٍ في بعض الحالات ويحتاج إلى تحديث ليتماشى مع التطورات القانونية الحديثة. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات وأهمها: توصي الدراسة إصلاح التشريعات بحيث توفر إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا وعملية للحلول في التأمين البحري، وتحسين صياغة عقود التأمين البحري لضمان أن تتضمن شروطًا أكثر وضوحًا فيما يتعلق بحق الحلول.
أوجه الشبه والاختلاف: تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في بيان مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري في القانون الانجليزي وتختلف انها قصرت الدراسة على القانون الانجليزي بخلاف الدراسة الحالية تتناول في نطاق النظام البحري التجاري السعودي والقانون الانجليزي.
– الدراسة الثانية: التأمين البحري وفقًا لنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية، للباحث: مرزوق خالد الذيابي، مجلة القضاء، (٢٠٢١م).
تبحث هذه الدراسة عن تأمين البحري وفقًا لنظام البحري التجاري السعودي، اعتمدت على منهج التحليلي الاستقرائي، وقد ركزت على توضيح مفهوم التأمين البحري من خلال تعريفه، وبيان خصائصه وأركانه. إضافة إلى تحليل الاثار القانونية لعقد التأمين البحري، توصلت الدراسة إلى نتائج وأهمها: أن عقد التأمين البحري هو عقد تجاريًا بالنسبة لشركة التأمين. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات وأهمها: نشر الأحكام القضائية الصادرة في دعاوي التأمين البحري بشكل دوري.
أوجه الشبه والاختلاف: تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية بيان مفهوم التأمين البحري في النظام البحري التجاري السعودي، وتختلف دراسة انها لم تتطرق إلى مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري واقتصرت في تحليل نصوص النظام البحري التجاري السعودي.
– الدراسة الثالثة: نطاق مبدأ الحلول في التأمين البحري -دراسة مقارنة-، الباحث: خليفة عبد الله حسن إبراهيم ، كلية الحقوق، جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين ، (٢٠٢٣م) .
تهدف الدراسة في البحث عن مبدأ الحلول في التأمين البحري تحديدًا في القانون البحريني، بوصفه امتدادًا لمبدأ التعويض، والذي يُنص على أن عقد التأمين لا يجب أن يكون مصدر ربح للمؤمن له، بل يهدف فقط إلى تعويض عن الضرر الذي لحق به، تم الاعتماد على منهج المقارن لمقارنة القانون البحريني وعدة قوانين عربية كالقانون المصري والأردني وبالإضافة إلى رأي الفقه والقضاء المصري والفرنسي نظرًا لقلة وشح التطبيقات القضائية الوطنية لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري. توصلت الدراسة لعدة نتائج وأهمها: مبدأ الحلول يمنح شركة التأمين الحق في استرداد المبلغ الذي دفعته للمؤمن له أو المستفيد، من خلال الحلول محله في جميع الحقوق والمطالبات القانونية ضد الطرف المتسبب بالضرر، ويقتصر حق المطالبة على قيمة التعويض الذي دفعته شركة التأمين للمؤمن له. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات ومن أهمها: توصي الدراسة المشرع البحريني أن ينص على مدة التقادم دعوى الحلول، وذلك نظرًا لأن المشرع على الرغم تنظيمه لمدد التقادم الدعاوى الناشئة عقد التأمين، إلا أنه لم يحدد مدة تقادم خاصة بدعوى الحلول.
أوجه الشبه والاختلاف: تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في مناقشة مبدأ الحلول تحديدًا في عقد التأمين البحري وتسعى كلًا من الدراستين في إيجاد وسد الثغرات القانونية المتعلقة بعدم تنظيم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري من خلال الاستفادة من التشريعات المقارنة، تختلف الدراسة عن الدراسة الحالية أنها قصرت الدراسة ضمن النطاق البحريني بخلاف الدراسة الحالية تناقش ضمن نطاق نظام البحري التجاري السعودي وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦.
خطة الدراسة:
المبحث الأول: ماهية مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
المطلب الأول: مفهوم عقد التأمين البحري
المطلب الثاني: مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
المطلب الثالث: التكييف القانوني لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
المبحث الثاني: الأثار القانونية لممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري
المطلب الأول: الشروط والقيود القانونية لممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري
المطلب الثاني: التزامات المؤمِّن له في الحفاظ على حقوق المؤمن في عقد التأمين البحري
المطلب الثالث: حق المؤمن في المطالبة والتعويض وفقًا لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
المبحث الأول
ماهية مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
يتناول هذا المبحث مبدأ الحلول بوصفه أحد المبادئ القانونية الجوهرية في عقد التأمين البحري، إذ يُخول هذا المبدأ للمؤمِّن بعد دفع مبلغ التعويض أن يحل محل المؤمَّن له في الرجوع على الطرف المسؤول عن الضرر. وتنبع أهمية هذا المبدأ في سياق التأمين البحري من الطبيعة الخاصة لهذه العقود، والتي تتسم بتعدد الأخطار البحرية وتنوع أطراف العلاقة التأمينية.
لتحقيق فهم أعمق، نتناول هذا المبحث ماهية مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري، سيتم تقسيم الدراسة إلى ثلاث مطالب أساسية: (المطلب الأول) مفهوم عقد التأمين البحري، ثم التعرّف في (المطلب الثاني) على مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري، وأخيرًا تناول في (المطلب الثالث) التكييف القانوني لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري. وذلك في إطار دراسة مقارنة بين أحكام النظام البحري التجاري السعودي الصادر لعام 1440هـ وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906م.
المطلب الأول
مفهوم عقد التأمين البحري
يُعد التأمين البحري من أقدم أنواع التأمين، وقد نشأ بهدف حماية السفن والبضائع والمصالح المرتبطة بالأنشطة البحرية من المخاطر التي قد تواجهها أثناء عمليات الشحن أو النقل عبر البحر. ونظرًا لأهمية هذا النوع من التأمين في دعم استقرار الأسواق البحرية، فقد قامت الدول بتنظيمه وفق أطر قانونية مختلفة. من أبرز هذه الأطر: النظام البحري التجاري السعودي الذي صدر في عام 1440 هـ، بالإضافة إلى قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906.
في هذا السياق، حتى يّتضح مفهوم عقد التأمين البحري بشكلٍ جلي، فلا بد عليّنا أن نبين تعريف التأمين من الناحية اللغوية، ومن ثم التعريف عقد التأمين من الناحية الاصطلاحية، ولذلك حتى تكتمل الصورة في تكوين مفهوم عقد التأمين البحري. وعليه، نعرض تعريفه على النحو التالي:
أولًا/ التأمين لغةً: مشتق من الأمن، والأمن مصدر للفعل (أَمِنَ) من باب فَهِم، والأمن ضد الخوف، وهو يعني سكون القلوب واطمئنانه وثقته، يقال: أمّن فلانٌٌ فلانًا على كذا وثق فيه واطمأن إليه[3]. ويُقال أمَّنهُ تأمينًا وائمته واستأمنه، مأخوذ من الأمان الذي هو ضد الخوف، وفيه معنى الطمأنينة، والسلامة، الأمانة التي هي ضد الخيانة[4].على نحو مغايرّ، يُعرف التأمين لغةً في قواميس اللغة الإنجليزية: تُشتقّ كلمة (التأمين) إلى أصلها اللاتيني. فالكلمة الإنجليزية (التأمين) مأخوذة من الكلمة اللاتينية والتي تعني “آمن” أو “مؤمَّن”، مما يشير إلى فكرة توفير الأمان أو الحماية من المخاطر والتهديدات المحتملة[5].
ثانيًا/ عقد التأمين اصطلاحًا: عُرَّف جانب من الفقه عقد التأمين اصطلاحًا بأنه “هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيراد مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن”[6]. نُلاحظ من هذا التعريف أن عقد التأمين هو اتفاق يترتب بموجبه التزام على عاتق المؤمن بدفع تعويض مالي للمؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر المحدد في العقد، مقابل ما يدفعه المؤمن له من قسط أو دفعة مالية. كما يبرز هذا التعريف الطابع التعاقدي للعقد، حيث تُحدَّد التزامات الأطراف استنادًا إلى تحقق الخطر، مما يسهم في ضبط العلاقة القانونية بينهما وبيان الحقوق والواجبات بوضوح.
على نحو مغايرّ، عرّف الفقه الإنجليزي عقد التأمين اصطلاحًا بأنه: عقد يلتزم فيه أحد الطرفين (المؤمن) بدفع مبلغ من المال أو تقديم منفعة للطرف الآخر (المؤمن له)، عند تحقق حادث معين غير مؤكد الوقوع، وذلك مقابل قسط يُدفع من قبل المؤمن له[7]. ويُلاحظ من هذا التعريف أنه يُركّز على عنصر الخطر غير المؤكد بوصفه جوهر العلاقة التأمينية، حيث لا ينشأ التزام المؤمِّن إلا بتحقق حادث محتمل. كما يُبرز الطابع الاحتمالي لعقد التأمين، ويُظهر أنه يقوم على مبدأ التبادل المالي، من خلال التزام المؤمِّن بدفع تعويض أو تقديم منفعة مقابل القسط المدفوع من المؤمَّن له.
انطلاقًا من تحليل هذه المفهومين، يتضح أن عقد التأمين اصطلاحًا هو عقد ذو طبيعة تبادلية وتعويضية، ينشأ بموجبه التزام على عاتق المؤمن بدفع مبلغ مالي أو تقديم منفعة عند تحقق خطر معين، في مقابل التزام المؤمن له بدفع قسط مالي. ويُعد الخطر غير المؤكد عنصرا جوهريًا في هذا العقد إذ إن التزام المؤمن لا ينشأ إلا بتحققه.
ثالثًا/ عقد التأمين البحري: يُصنَّف التأمين البحري ضمن أعرق أشكال التأمينات التجارية، وقد أسهم بدور بارز في تشجيع الاستثمار في قطاع الملاحة البحرية. ويُعتبر عقد القرض البحري بما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة النواة الأولى التي مهَّدت لظهور فكرة التأمين البحري، حيث كان المُقرِض يُقدّم قرضًا لمالك السفينة عند بدء الرحلة أو قبلها، بضمان السفينة، ويُشترط استرداد المبلغ مع الفوائد حال وصول السفينة سالمة إلى ميناء الوصول.[8].عرّف النظام البحري التجاري السعودي في المادة الأولى الفقرة (27) عقد التأمين البحري أنه:” العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يُسمى المؤمن بتعويض طرف آخر يسمى المؤمن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين”. ونُلاحظ أن المنظم السعودي قدّم تعريفًا دقيقًا لعقد التأمين البحري مبرزًا فيه الخطر البحري كعنصر جوهري يُبنى عليه التزام المؤمن بالتعويض. كما حدّد بوضوح التزامات الطرفين، من خلال التزام المؤمن له بدفع القسط، والتزام المؤمن بتحمل الضرر عند تحقق الخطر. ويُظهر هذا التعريف توازنًا قانونيًا يُسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان استقرارها.
على نحو مغايرّ، كما عرّف القانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906، عقد التأمين البحري وفقًا للمادة الأولى أنه: “العقد الذي يلتزم بموجبه المؤمن له، بالطريقة وبالقدر المتفق عليه، ضد الخسائر البحرية، أي الخسائر الناجمة عن الرحلة البحرية”. نلاحظ من هذا التعريف أن المشرع الإنجليزي لم يُحدد أطراف العقد حيث لم يذكر المؤمن، بل اكتفى انه العقد الذي يلتزم بموجبه المؤمن له كما أن لم يُشر إلى خطر بحري محدد، بل استخدم مصطلح الخسائر البحرية بشكل عام، مع التركيز على الخسائر الناتجة عن الرحلة البحرية. وعلى الرغم من أن هذا التعريف يسلط الضوء على الخسائر البحرية، فإنه يُبقي نطاق المخاطر أكثر شمولًا وعمومًا.
من هذا المنظور، يتضح أن النظام البحري التجاري السعودي يُعد أكثر دقة، حيث يُحدد بوضوح التزامات كل من المؤمن والمؤمن له ويضع إطارًا قانونيًا يوضح حقوق وواجبات كل طرف، حيث يُلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخسائر الناتجة عن خطر بحري محدد، بينما يُلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين مقابل هذه التغطية. هذا التفصيل يجعل العلاقة التعاقدية بين الطرفين أكثر وضوحًا وتنظيمًا، مما يعزز من استقرار العقود التأمينية ويضمن التوازن بين حقوق الأطراف المتعاقدة.
وفي هذا السياق، يقوم عقد التأمين على مبدأ حسن النية ليس فقط عند إبرامه، بل أيضًا طوال فترة سريانه. حيث يُلزم كلا الطرفين بالإفصاح عن جميع المعلومات الدقيقة والكاملة المتعلقة بالخطر المؤمن ضده. وقد نص النظام البحري التجاري السعودي وفقًا المادة (299) التي تنص على أن “عقد التأمين يقوم على مبدأ حسن النية، وإذا لم يُراعَ ذلك من أي من الطرفين، يكون للطرف الآخر حق إبطال العقد”. وفي السياق ذاته، ورد في المادة (300/١) ” للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدّم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة، أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين، وكان من شأن ذلك في الحالتين قدر أن المؤمن الخطر بأقل من حقيقته”. وتُجيز الفقرة الثانية من هذه المادة ” للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمن في الأحوال المبنية في الفقرة (١) من هذه المادة بمبلغ مساوٍ لقسط التأمين إذا أثبت سوء نية المؤمن له، أو بمبلغ لا يتجاوز نصف هذا إذا انتفى سوء النية”. ويُلاحظ أن النظام البحري التجاري السعودي قد فرض على المؤمن له التزامًا صارمًا بالإفصاح الكامل عن جميع المعلومات الجوهرية المؤثرة، دون تمييز بين الإخلال العمدي وغير العمدي، أو مراعاة لمدى علم المؤمن له بهذه المعلومات. ونتيجة لذلك، يتحمّل المؤمن له عبئًا ثقيلًا حتى في حالات الخطأ غير المقصود أو السهو، ويظل عرضة لجزاء الإبطال دون إتاحة أي وسيلة لتصحيح الخطأ أو إعادة التفاوض، وهو ما يُخل بمبدأ التوازن العقدي ويُثير تساؤلات حول مدى عدالة هذا التنظيم في ضوء التطورات التشريعية المقارنة وتحديدا القانون الإنجليزي. على نحو مغايرّ، يُعرف سابقًا وفقًا للمادة (١٧) من قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦عقد التأمين البحري هو عقد يقوم على أقصى درجات حسن النية وإذا لم يتم مراعاة ذلك من قبل أي طرف يجوز للطرف الآخر إبطال العقد. ويُفهم من هذا التعريف أن الجزاء الوحيد المترتب على الإخلال بواجب حسن النية – سواء من المؤمن أو من المؤمن له – كان يتمثل في إبطال العقد دون أن يُتيِح القانون أي بدائل أخرى كإعادة التفاوض، تعديل الشروط، أو تقليص الالتزامات التعويضية. وقد أدى هذا التنظيم الصارم إلى انتقادات واسعة في الفقه والقضاء إذ أُعتُبر غير متوازن وقد يؤدي إلى نتائج غير عادلة، خاصةً في الحالات التي يكون فيها الإخلال بواجب حسن النية طفيفًا أو غير متعمد. على سبيل المثال، في قضية[9] Drake Insurance plc v. Provident Insurance plc التي شكّلت نموذجًا لتطبيق جزاء الإبطال، رغم أن الإخلال لم يكن جوهريًا ولم يستند إلى سوء نية صريح، وهو ما كشف عن التفاوت بين جسامة الجزاء المطبق وطبيعة الإخلال المرتكب. واستجابةً لهذه الانتقادات، جاء قانون التأمين الإنجليزي لعام 2015 ليُحدِث تحولًا نوعيًا في الإطار القانوني المنظم لعقود التأمين، حيث ألغى صراحةً الجزاء المنصوص عليه في المادة (17) من قانون 1906، وذلك بموجب المادة (14) الفقرة (١) من قانون التأمين ٢٠١٥ التي نصّت على إلغاء سبل الانتصاف القائمة على إبطال العقد بسبب خرق واجب حسن النية[10] . وبهذا، فقد تم تجريد مبدأ حسن النية من قوته الإلزامية كوسيلة للإبطال مع الإبقاء عليه كقيمة توجيهية عامة تؤطر العلاقة التعاقدية بين الطرفين دون أن يرتب عليه جزاءً تلقائيًا. حيث نصت المادة بعد تعديل على عقد التأمين البحري هو عقد قائم على أقصى درجات حسن النية[11]. تبنّى القانون الجديد إطارًا أكثر مرونة وتحديدًا يتمثل في واجب العرض العادل للمخاطر والذي وردت أحكامه في عدة مواد من القانون[12]. تنص المادة (3/١) من قانون التأمين الإنجليزي لعام 2015 على “أن المؤمن له يلتزم قبل إبرام عقد التأمين بتقديم عرض عادل للمخاطر إلى شركة التأمين”[13]. ويُشار إلى هذا الالتزام في القانون بمسمى واجب العرض العادل ويتحقق هذا العرض عندما يتضمن إفصاحًا على النحو المبين في الفقرة (4)، ويُقدَّم هذا الإفصاح بطريقة واضحة ومعقولة، تُمكّن المؤمن الحصيف من فهمه والاطلاع عليه. كما يشترط أن تكون جميع التمثيلات الجوهرية المتعلقة بالحقائق صحيحة بدرجة كبيرة، بينما تُقدَّم التمثيلات المتعلقة بالتوقعات أو المعتقدات بحسن نية. ويُقصد بالإفصاح المطلوب مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (5) أنه في حال عدم توجيه استفسارات من شركة التأمين، يتعيّن على المؤمن له الكشف عن كل ظرف مادي يعلمه أو كان ينبغي أن يعلمه، أو أن يُقدِّم على الأقل ما يكفي من المعلومات لتنبيه شركة التأمين إلى الحاجة لإجراء المزيد من الاستفسارات لاكتشاف تلك الظروف المادية. وقد أقرّ القانون التأمين لعام ٢٠١٥ جزاءات متدرجة عند الإخلال بواجب العرض العادل. إذ لا يحق لشركة التأمين التمسك بأي جزاء إلا إذا أثبتت أن الإخلال قد أثر جوهريًا في قرارها بشأن قبول التأمين، سواءً بعدم إبرام العقد أصلًا أو بإبرامه بشروط مختلفة. ويُعرف هذا النوع من الإخلال بمصطلح الإخلال المؤهل الذي يُصنَّف إلى إخلال متعمد أو متهور، أو إخلال غير متعمد ولا متهور. ويُعتبر الإخلال متعمدًا أو متهورًا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم بالإخلال أو لم يهتم بما إذا كان قد أخل بواجب العرض العادل أم لا، ويقع عبء إثبات ذلك على عاتق شركة التأمين وبحسب جسامة الإخلال، تختلف الجزاءات المترتبة فترتفع إلى حد الإبطال الكامل للعقد في حال الغش أو الإخلال الجسيم، بينما تقتصر على تعديل شروط العقد أو تقليص مبلغ التعويض في حالات الإخلال غير العمدي.
يّتضح في ضوء ما تم طرحه وتحليله، أن النظام البحري التجاري السعودي لا يزال يأخذ بمفهوم تقليدي صارم لمبدأ حسن النية، يربط بين أي إخلال بواجب الإفصاح سواء أكان عمديًا أم غير متعمد وجزاء الإبطال دون منح المؤمن له فرصة لتصحيح الوضع أو إعادة التفاوض. هذا النهج يُحمّله عبئًا ثقيلًا، ويؤدي إلى اختلال التوازن العقدي. في المقابل، أحدث إصلاح تشريعي لمفهوم حسن النية المطلق في مجال التأمين البحري جاء بموجب قانون التأمين الإنجليزي لعام 2015، حيث مثّل هذا القانون تحولًا جوهريًا في الإطار المفاهيمي والتطبيقي للمبدأ، من خلال استبدال الالتزام المطلق بحسن النية بـ واجب العرض العادل للمخاطر. وقد تخلّى المشرّع الإنجليزي بموجبه عن فكرة الجزاء التلقائي المترتب على الإخلال بحسن النية، واعتمد بدلًا منها نظامًا مرنًا للجزاءات المتدرجة يُراعي جسامة الإخلال وظروفه، ويُعيد التوازن إلى العلاقة العقدية بين طرفي التأمين.
المطلب الثاني
مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
يُعد مبدأ الحلول من المبادئ الجوهرية في عقد التأمين البحري، وتنبع أهميته من الطبيعة التعويضية لهذا العقد، الذي يهدف إلى إعادة المؤمن له إلى الوضع المالي الذي كان عليه قبل تحقق الخطر البحري، دون أن يحقق إثراءً غير مشروع على حساب شركة التأمين.
بناء على ما تم ذكره، حتى يتضح مفهوم مبدأ الحلول بشكلٍ جلي، لا بد من بيان تعريف الحلول من الناحية اللغوية، ومن ثم تعريف مبدأ الحلول اصطلاحًا. ولذلك، لتكتمل الصورة في تكوين مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري، يتم تعريفه على النحو التالي:
أولًا-الحلول لغةً: اشتق الحُلول من مصدر للفعل(حلَّ)، ويُشير إلى نزول الشيء في مكان أو انتقاله إليه واستقراره فيه. كما عرف الحُلولُ: نُزُولُ الشيءِ في مكانٍ، يُقال: حلَّ بالمكان حُلولاً، أي نزل فيه واستقر[14]، ويُقال: حلّ به البلاء، إذا نزل عليه. كما قيّل الحلّ: نقيض العقد، وحلّ بالمكان: نزل فيه، ويدل أيضًا على دخول.[15] على نحو مغايرّ يُعرف معجم القاموس الإنجليزي الحلول لغةً: كلمة (الحلول) تعني الاستبدال وتُتسمد جذورها من نفس الجذور اللاتينية التي تنحدر منها الكلمة الأكثر شيوعاً البديل[16]. ومن ثم، فإن المعنى العام هو المطالبة باسم طرف آخر أو القيام مقام الغير في المطالبة بحق قانوني[17].
ثانيًا/ الحلول اصطلاحا: وأما عن معنّاه الاصطلاحي فقد عرّفه جانب من الفقه بأنه “أحقية هيئة التأمين محل المؤمن له في حقوقه قبل الغير الذي تسبب في إلحاق الخسارة به، والتي تلزم هيئة التأمين بتعويضه عنها طبقًا لعقد التأمين”[18]. ويُفهم من هذا التعريف أن مبدأ الحلول يهدف إلى تمكين شركة التأمين من الرجوع على غير المسؤول بعد أداء التعويض للمؤمن له، غير أن هذا التعريف يُعاب عليه غموضه في بيان الطبيعة القانونية للحلول، وافتقاره إلى تحديد نطاق الحقوق المنتقلة وآلية ممارستها على نحو دقيق.
على نحو مغايرّ، عُرًّف الحلول في الفقه الإنجليزي بأنه: استبدال طرف بآخر فيما يتعلق بالمطالبة القانونية أو الحق، بحيث يحل الطرف الذي قام بالدفع محل الطرف الأصلي، ويكتسب حقوقه ووسائل الرجوع ضد غير المسؤول عن الضرر[19]. يّتضح من هذا التعريف أن مبدأ الحلول يقوم على استبدال دائن بآخر في المطالبة القانونية، بحيث يحل الطرف الذي قام بالسداد وهو المؤمن محل الدائن الأصلي (المؤمن له)، ويكتسب حقوقه في الرجوع على المسؤول عن الضرر.
وانطلاقًا من تحليل كلا المفهومين، يتّضح أن الفقه الإنجليزي يتبنّى رؤية دقيقة للحلول، بوصفه انتقالًا قانونيًا في صفة الدائن من المؤمن له إلى شركة التأمين بعد السداد، بما يُمكّنها من مباشرة حقوق الرجوع بذات الأسس التي كانت متاحة للمؤمن له، دون إنشاء التزام جديد تجاه الغير، وهو ما يُرسّخ الطبيعة التعويضية لعقد التأمين ويُحقق التوازن في العلاقة القانونية.
يُعد مبدأ الحلول من المبادئ الجوهرية في عقود التأمين البحري، ويهدف بصورة رئيسة إلى منع الإثراء غير المشروع وتحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة التأمينية[20]. وتقوم فكرة الحلول على انتقال حق المؤمن له إلى المؤمن تجاه الغير المتسبب في الضرر، وذلك بعد قيام الأخير بدفع التعويض المستحق بموجب بويصلة التأمين. ويُعد هذا المبدأ من المفاهيم التقليدية الراسخة في إطار التجارة البحرية، وقد ظل معمولًا به منذ القدم، نظرًا لطبيعته العادلة ودوره في حماية مصالح شركات التأمين وضمان عدم ازدواجية التعويض.[21]. وفي هذا السياق، أقرّ النظام البحري التجاري السعودي مبدأ الحلول صراحةً في المادة (٣24) والتي نصّت: “يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين، وذلك، في حدود التعويض الذي دفعه.” ونُلاحظ من هذا التعريف أن المنظّم السعودي يُقرّ مبدأ الحلول، حيث يُمكن للمؤمن أن يحلّ محل المؤمن له في الأضرار التي يشملها عقد التأمين، أي يُشترط أن يكون الخطر أو الضرر منصوصًا عليه في عقد التأمين. كما قيّد هذا الحلول في حدود مبلغ التعويض المدفوع فقط دون أن يتجاوزه، وذلك حفاظًا على مبدأ التعويض ومنعًا للإثراء غير المشروع.
وعلى نحو مغايرّ، عرّف قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906مبدأ الحلول في المادة 79، التي تنص على ما يلي (٧٩/١) عندما يدفع المؤمن تعويضًا عن خسارة كلية، سواء عن كامل موضوع التأمين، أو، في حالة البضائع، عن أي جزء يمكن تخصيصه من موضوع التأمين، فإنه عندئذٍ يصبح من حقه أن يتملك مصلحة المؤمن له في أي شيء قد يبقى من موضوع التأمين الذي تم دفع التعويض عنه، وبذلك يُحلّ محل المؤمن له في جميع الحقوق ووسائل الرجوع الخاصة بالمؤمن له والمتعلقة بذلك الموضوع المؤمن عليه، وذلك اعتبارًا من وقت وقوع الحادث الذي تسبب في الخسارة. (٧٩/٢) مع مراعاة الأحكام السابقة، عندما يدفع المؤمن تعويضًا عن خسارة جزئية، فإنه لا يكتسب أي حق ملكية في موضوع التأمين، أو في أي جزء منه قد يبقى، ولكنه يُحلّ محل المؤمن له في جميع الحقوق ووسائل الرجوع الخاصة به والمتعلقة بموضوع التأمين، وذلك اعتبارًا من وقت وقوع الحادث الذي تسبب في الخسارة، وذلك بقدر ما تم تعويض المؤمن له عن تلك الخسارة وفقًا لهذا القانون عن طريق هذا الدفع.
وعلى نحو أكثر دقة ووضوحًا، يُتضح أن المشرّع الإنجليزي قد نظّم مبدأ الحلول في المادة (79) من قانون التأمين البحري لعام 1906، حيث ربط بشكل مباشر بين نوع الخسارة وبين مدى انتقال الحقوق، فميّز بين الخسارة الكلية التي تؤدي إلى انتقال الملكية والحقوق القانونية معًا إلى المؤمن، والخسارة الجزئية التي يقتصر فيها الحلول على الحقوق القانونية فقط دون المساس بملكية الشيء المؤمن عليه. كما حدّد نقطة بدء حلول شركة التأمين بأنها تكون اعتبارًا من وقت وقوع الحادث الذي تسبب في الخسارة، وليس فقط من تاريخ سداد التعويض، مما يُضفي على المبدأ طابعًا أكثر دقة واستقرارًا في التطبيق.
وبناء على ما سبق، يُستبان دقة التعريف المشرع الإنجليزي في تنظيم مبدأ الحلول، لما يتسم به من دقة تشريعية وتفصيل منهجي يراعي الفروق الجوهرية بين أنواع الخسائر، ويضبط الآثار القانونية المترتبة على كل نوع منها. ويُسهم هذا التنظيم في تحقيق التوازن بين أطراف عقد التأمين تحديدا في الحلول.
في هذا السياق، ينطوي تصنيف الخسارة إلى خسارة كلية وخسارة جزئية آثار قانونية لكل من المؤمن والمؤمن له، تحديدًا في سياق ممارسة حق الحلول. ويُلاحظ أن هذا التصنيف على الرغم من أهميته، لم يُنص النظام التجاري البحري السعودي أنواع الخسارة، بخلاف ما قرّره قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906، الذي تناول هذا التصنيف بدقة في المادة (56) حيث ورد على أن الخسارة قد تكون إما كلية أو جزئية، وكل خسارة غير الخسارة الكلية، كما سيُعرّف لاحقًا، تُعد خسارة جزئية. وقد تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية تقديرية. وما لم يظهر قصد مختلف من شروط وثيقة التأمين، فإن التأمين ضد الخسارة الكلية يشمل الخسارة الكلية التقديرية بالإضافة إلى الخسارة الكلية الفعلية. وإذا أقام المؤمن له دعوى بسبب خسارة كلية، وأثبتت الأدلة أنها في الواقع خسارة جزئية فقط، فيجوز له، ما لم تنص الوثيقة على خلاف ذلك، أن يطالب بالتعويض عن الخسارة الجزئية. وإذا وصلت البضائع إلى وجهتها بذاتها، ولكن، بسبب طمس العلامات أو لأي سبب آخر، أصبحت غير قابلة للتعرف عليها، فإن الخسارة، إن وُجدت، تُعتبر خسارة جزئية وليست كلية. كما عرّف قانون التأمين البحري البريطاني الخسارة الكلية الفعلية في المادة (57)، بأنها تتحقق عندما يتم تدمير موضوع التأمين، أو يتعرض لأضرار شديدة تجعله يفقد طبيعته كشيء من النوع المؤمن عليه، أو عندما يُحرَم المؤمن له منه بشكل لا يمكن استرداده، ولا يلزم في هذه الحالة تقديم إشعار بالتنازل. أما الخسارة الكلية البناءة، فقد عرّفها القانون في المادة (60)، تُقسم الخسارة إلى كلية أو جزئية، وتُعد الخسارة كلية عندما يكون الضرر قد أتى على موضوع التأمين بالكامل أو أفقده طبيعته أو قيمته كليًا، سواء كان ذلك بسبب تدميره، أو فقدانه بشكل لا رجعة فيه، أو إذا تَطلَّب الحفاظ عليه أو استرداده إنفاقًا يتجاوز قيمته بعد الإصلاح أو الاسترداد، وهو ما يُطلق عليه بالخسارة الكلية الفعلية أو التقديرية. وتتحقق الخسارة الكلية الفعلية عندما يُدمَّر الشيء المؤمن عليه كليًا أو يُصاب بضرر يفقده طبيعته كموضوع للتأمين، أو عندما يُحرَم المؤمن له من حيازته دون إمكانية الاسترداد. أما الخسارة الكلية التقديرية فتقوم على أساس المعقولية، حيث يجوز للمؤمن له أن يعتبر الشيء المؤمن عليه مفقودًا أو غير قابل للاسترداد أو الإصلاح إذا ثبت أن استعادته أو إصلاحه يتطلب نفقات تفوق قيمته المحتملة بعد الاستعادة أو الإصلاح، وتشمل هذه الحالات فقدان السفينة أو البضاعة دون أمل حقيقي في استردادها، أو إذا كانت تكلفة الإصلاح أو الإيصال إلى الوجهة المقصودة تتجاوز القيمة السوقية المتوقعة. ولا يُشترط في الخسارة الكلية الفعلية توجيه إشعار بالتخلي، على خلاف التقديرية التي تستلزم ذلك غالبًا، ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير التكاليف، مصاريف الإنقاذ المستقبلية والمساهمات في الخسائر المشتركة التي قد تترتب على الإصلاح أو الإيصال. وعند تطبيق مبدأ الحلول القانوني كما تم تقنينه في القانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦ وفقًا للمادة (79) من قانون التأمين البحري الإنجليزي يُشترط أن يكون المؤمن قد عوّض المؤمن له تعويضًا كاملاً حتى يستطيع أن يُمارس حق الحلول في حالة الخسارة الكلية لا يقتصر حق المؤمن على الرجوع على الطرف الثالث، بل يمتد ليشمل ملكية الشي المؤمن عليه. بخلاف، في حالة الخسارة الجزئية فإن المؤمن لا يكتسب أي مصلحة عينية في الشيء ذاته وإنما يقتصر حقه على الرجوع على الأطراف المسؤولة عن الضرر، من دون أن يكون له مصلحة مادية قائمة في الشيء المؤمن عليه نفسه. وتحل شركة التأمين بقوة القانون محل المؤمن له بمجرد تحقق الدفع الفعلي. ومع ذلك، يُمكن تعديل هذا الحق بموجب إرادة الأطراف المتعاقدة، حيث يمكن للطرفين، خاصة المؤمن تضمين شرط تعاقدي صريح في عقد التأمين يمنح المؤمن حق الحلول قبل أن يتم تعويض المؤمن له تعويضًا كاملاً عن الضرر الذي لحق به[22] و يُقصد بالحلول التعاقدي هو حق يُمنح لشركة التأمين بموجب اتفاق بينها وبين المؤمن له، حيث يُمكن لشركة التأمين أن تحل محل المؤمن له في المطالبة بحقوقه ضد الطرف الثالث المسؤول عن الضرر أو الخسارة، وذلك بهدف استرداد المبالغ التي دفعتها شركة التأمين للمؤمن له”[23].ويُتضح هذا النوع من الحلول لا يستند إلى النصوص القانونية بل يتم تنظيمه من خلال اتفاق صريح بين الأطراف في وثيقة التأمين. يعتمد الحلول التعاقدي على الرضا المتبادل بين الطرفين ويترتب عليه التزام المؤمن له بعدم التصرف بما يُعطل قدرة شركة التأمين في ممارسة هذا الحق. ويُعيد هذا التوجه توصيف حق الحلول من كونه حقًا قانونيًا تابعًا لا ينشأ إلا بعد استيفاء المؤمن له كامل التعويض، إلى كونه حقًا تعاقديًا مستقلًا ينشأ بمجرد توافر الشروط المتفق عليها، حتى وإن لم يتم تعويض المؤمن له بالكامل بعد عليه، فإن ممارسة شركة التأمين لحق الحلول بموجب هذا الشرط التعاقدي الوارد في وثائق التأمين لا تخلو من مخاطر على المؤمن له؛ إذ تُتيح للمؤمن حق الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر حتى وإن لم يّكن قد دفع كامل مبلغ التأمين. كما يُجيز له الرجوع على الغير بكامل التعويض المستحق للمؤمن له، حتى لو كان مبلغ التأمين الذي دفعه للمؤمن له أقل من قيمة التعويض المستحق [24].
لذا، ومن خلال تحليل كلا المفهومين، يتبيّن أن الحلول القانوني ينشأ بقوة النظام دون الحاجة إلى اتفاق صريح بين الأطراف؛ فبمجرد قيام شركة التأمين بدفع التعويض، فإنها تحل محل المؤمن له في جميع الحقوق والدعاوى تجاه الطرف الثالث بما في ذلك انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه في حالات الخسارة الكلية. بخلاف الحلول الاتفاقي فيقوم على نص صريح وارد في وثيقة التأمين ويستلزم رضا الطرفين، ويمنح شركة التأمين الحق في الحلول محل المؤمن له حتى دون أن تكون قد دفعت التعويض بعد. ورغم ما يوفره هذا النمط من مرونة تعاقدية، إلا أنه قد يُفضي إلى الإضرار بالمؤمن له، إذ قد يُقيّد حريته في المطالبة أو التفاوض مع الطرف الثالث، ويُنتقص من حقه حالَ لجوء شركة التأمين لمباشرة حق الحلول قبل تعويضه فعليًا. كما أن أي تسوية تُبرمها شركة التأمين مع الطرف الثالث قد تؤثر سلبًا على القيمة الفعلية المستحقة للمؤمن له، مما يُضعف مركزه القانوني ويُقوّض مبدأ العدالة العقدية.
المطلب الثاني
التكييف القانوني لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
اختلف الفقهاء القانونيين حول التكيّيف القانوني لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري، حيث يرى بعض الفقهاء يتخذ شكلين: الحلول الاتفاقي القائم على إرادة الأطراف. والحلول القانوني المستمد من قوة النظام، وامتد هذا الجدل إلى المحاكم الإنجليزية حيث تنوعت في تفسيره: بين اعتباره قاعدة قانونية مستمدة من مبادئ العدالة والإنصاف تهدف إلى منع الإثراء غير المشروع، وبين كونه حقًا تعاقديًا ينشأ ضمنيًا داخل عقد التأمين بمجرد دفع التعويض. تستعرض هذه الدراسة مختلف الآراء والتوجهات الفقهية بشأن هذا المبدأ وتحلّله في ضوء السياق القانوني مع استعراض السوابق القضائية، وبيان ما قد يُثار من اعتراضات بشأنها.
أثار جدل بين الفقهاء القانونيين حول التكيّيف القانوني لمبدأ الحلول حيث يرى جانب من الفقهاء أن شرط الحلول الذي تتضمنه عقود التأمين هو عبارة عن اتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له فإن لم يحضر النظام هذا الشرط فيكون الحلول اتفاقيًا حينئذٍ، حيث جرت العادة بأن يحل المؤمن محل المؤمن له مقدمًا على حوالة بحقوق هذا الأخير من تسبب بالضرر، وهذه الحوالة كانت توصل بأنها حلول اتفاقي وهي في الواقع حوالة من المؤمن له عن حق محتمل وهي مشروط بتحقق الخطر المؤمن منه[25] . إلا أن هذا رأي تعرَّض للانتقاد نظرًا للقواعد الوفاء مع الحلول يجب أن يتم الاتفاق على الحلول عند وفاء الدين وهذا شرط غير متوافر في علاقة المؤمن بالمؤمن له، ثم بالعلاقة الغير المسؤول، لأن المؤمن يتفق مع المؤمن له في الرجوع على الغير قبل تحقق الخطر المؤمن منه، وقبل وفائه بمبلغ التأمين، أي قبل نشوء حق المضرور قبل الغير المسؤول[26]. بينما يرى جانب من الفقهاء إلى القول بأن المؤمن يحل محل المؤمن له في سائر الدعاوى التي تنشأ له قبل غير المسؤول عن الحادث[27]، وبعد اتفق أنصار هذا الرأي على أن هذا الحلول تفرقت بهم السبل في تحديد الأساس الذي يستند إليه هذا الحلول، فمن هم رأى الحلول يرتكز على العرف التجاري البحري[28] .حين رأى فريق أخر أن هذا الحلول يندرج تحت إحدى حالات الحلول القانونية التي نص عليها القانون. إلا أن التكيّيف القانوني لمبدأ الحلول وفقًا للمنظَّم السعودي، حيث تَّبنى مبدأ الحلول من خلال عدة نصوص نظامية في نظام مراقبة الشركات التأمين التعاوني[29]. ومع ذلك، يُلاحظ أن القضاء السعودي استقر على تبني مبدأ الحلول وفقًا للقواعد العامة[30]، والذي يُشير أن مبدأ الحلول هو حلول قانوني يتم دون اتفاق بين المدين والدائن وإنما بقوة القانون ([31]). استنادًا إلى ماورد في نظام المعاملات المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١٩٣) وتاريخ ١٤٤٤هـ وفقًا للمادة (٢٦٢) التي نصت على أن:
“من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية”:
أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه.
ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.
ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.
د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.
والمادة (٢٦٣) التي نصت في الفقرة الأولى على أن “إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن، كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من ضمانات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله”. والفقرة الثانية من ذات المادة تُنص “إذا كان الحلول في جزء من الحق، فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي له على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.” وعلى خلاف المنظِّم السعودي، ذهب الفقه الإنجليزي حيث تنوع في تفسيره بين اعتباره قاعدة قانونية مستمدة من مبادئ العدالة والإنصاف تهدف إلى منع الإثراء غير المشروع، وبين كونه حقًا تعاقديًا ينشأ ضمنيًا داخل عقد التأمين بمجرد دفع التعويض. وأخذ جدلًا واسعًا في المحاكم الإنجليزية[32]. حيث ظهرت عدة تفسيرات قانونية لهذا المفهوم في عقد التأمين. هناك عدة: سلطات قانونية رئيسية تناولت هذا الجدل، وأبرزها: يرى الاتجاه الأول: الذي يدعمه فقهاء مثل غوف وجونز [33] أن مبدأ الحلول ليس حقًا قانونيًا مستقلاً، وإنما هو وسيلة قانونية تهدف إلى منع الإثراء غير المشروع للمؤمن له على حساب المؤمن ويُعتبر الإثراء الغير مشروع مبدأً قانونيًا يُعترف به النظام القانوني ويتم تطبيقه في نطاق واسع من الدعاوى، ويُشار إليه عادةً باعتبار أنه قاعدة إنصافيه[34]. وفقًا لهذا التفسير يُقال إنه مستمد من مبادئ العدالة والتي يُعتقد أن جذورها تعود إلى القانون الروماني. بناء وفقًا لهذا الرأي فإن الحلول يُعد قاعدة قائمة على العدالة والإنصاف. حيث يهدف إلى ضمان عدم حصول المؤمِّن له على تعويض مزدوج عن نفس الخسارة، سواء من شركة التأمين أو من الطرف الثالث المسؤول. إلا أن هذا رأي تعرَّض للنقد لكون الاعتماد على الأساس لإنصافي لمبدأ الحلول، معتبرًا أن الحلول شرط جوهري في وثيقة التأمين منذ لحظة إبرامها، مما يدل على تبنّيه لأساس تعاقدي لا إنصافي[35]. بينما يرى الاتجاه الثاني من الفقه الإنجليزي: أن الأساس القانوني لمبدأ الحلول في التأمين هو حق مستمد من القانون العام، يقوم على شرط ضمني يُفترض وجوده في عقد التأمين بين المؤمن والمؤمن له. ويُستند في ذلك إلى أن هذا الشرط الضمني يُعد وسيلة لضمان تنفيذ مبدأ التعويض الكامل دون أن يؤدي إلى إثراء غير مشروع للمؤمن له، مما يعني أن حق المؤمن في الحلول ينبع من العلاقة التعاقدية ذاتها، كآلية تُفهم ضمنًا من طبيعة عقد التأمين. ومع ذلك، إلا أن هذا الرأي تعرَّض إلى نقد من قبل كل من الفقه والقضاء، حيث يرى جانب من الفقه إلى أن الحلول لا يقوم على أي شرط صريح أو ضمني في العقد، بل ينشأ تلقائيًا بموجب القانون باعتباره أثرًا ملازمًا لعقد التأمين التعويضي[36].
انطلاقًا من دراسة معمّقة في تحليل للاتجاهات الفقهية والأحكام القضائية المختلفة بشأن التكييف القانوني لمبدأ الحلول، ترجّح الدراسة أن الحلول في عقد التأمين يتم بقوة القانون بمجرد دفع المؤمن للتعويض دون الحاجة إلى اتفاق صريح أو شرط ضمني. ويُعد هذا الحلول أثرًا قانونيًا تلقائيًا نابعًا من مبدأ التعويض العادل، ويهدف إلى منع الإثراء غير المشروع.
المبحث الثاني
الأثار القانونية لممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري
يُعد مبدأ الحلول من المبادئ الأساسية في عقد التأمين البحري، إذ يُمكّن المؤمن من استرداد ما دفعه من تعويض عبر حلولـه محل المؤمن له في مواجهة المسؤول عن الضرر. يستعرض هذا المبحث الآثار القانونية المترتبة على ممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري، وفق النظام البحري التجاري السعودي الصادر عام 1440هـ ومقارنته بما ورد في قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906. وذلك من خلال، ثلاثة مطالب رئيسة: (المطلب الأول) الشروط والقيود القانونية لممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري، (المطلب الثاني) التزامات المؤمن له في الحفاظ على حقوق المؤمن في عقد التأمين البحري، (المطلب الثالث) حق المؤمن في المطالبة بالتعويض وفقًا لمبدأ الحلول.
المطلب الأول
الشروط والقيود القانونية لممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري
يُعد مبدأ الحلول أحد المبادئ القانونية الجوهرية في عقد التأمين البحري، حيث يترتب إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى المتعلقة بالخسارة التي تم تعويضها. إلا أن هذا الحق لا يُمارس بصورة مطلقة، بل تُقيّد بمجموعة من الشروط والقيود القانونية المستمدة من الطبيعة الخاصة لعقود التأمين البحري، والتي تتسم بتعدد الأطراف وتنوع المخاطر البحرية.
وفي هذا السياق، يتناول هذا المطلب الشروط والقيود القانونية لممارسة حق الحلول. وذلك، وفقًا لكل من النظام البحري التجاري السعودي وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906م. وقد تبلّورت هذه الشروط والقُيود بشكل أوضح في القانون الإنجليزي من خلال السوابق القضائية، والتي تُعد مصدرًا تفسيريًا وتكميليًا ذا أهمية خاصة في تشَّكِيل القضاء الإنجليزي وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد التأمين البحري، يتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: (الفرع الأول) الشروط القانونية لممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري، القيود القانونية لممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري (الفرع الثاني)
الفرع الأول
الشروط القانونية لممارسة حق الحلول
الشرط الأول- أن يكون الضرر وقع ضمن نطاق التغطية التأمينية: يُشترط لمباشرة شركة التأمين لحق الحلول أن يكون الضرر الذي تعرض له المؤمن له قد وقع ضمن نطاق التغطية التأمينية المنصوص عليها في بويصلة التأمين[37].ويُعد هذا الشرط من المبادئ الأساسية التي تُقوم عليها فكرة الحلول في التأمين لأنه يرتبط مباشرة بمبدأ التعويض الذي يهدف إلى إعادة المؤمن له إلى الوضع المالي الذي كان عليه قبل وقوع الحادث، دون أن يؤدي إلى إثرائه بلا سبب. وقد نص النظام البحري التجاري السعودي وفقًا للمادة سالفة الذكر (234) صراحةً على: “يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين”. مما يقتضي أن نطاق الحلول يتحدد بالأضرار التي تشملها التغطية التأمينية فقط، ويقتصر عليها دون أن يمتد ليشمل الأضرار التي تقع خارج نطاق هذه التغطية. ويتفق هذا الاتجاه مع ما قرّره قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906حيث نص في المادة (79) على أن المؤمن يحل محل المؤمن له في الحقوق المتعلقة بموضوع التأمين. كما يُوكد الفقه الإنجليزي على أن هذه الحقوق يجب أن تكون متصلة اتصالًا وثيقًا بموضوع التأمين محل العقد، وإلا خرجت عن نطاق ما يجوز الحلول فيه. على سبيل المثال، إذا أمَّن شخص على سفينة ضد مخاطر البحر ثم اصطدمت هذه السفينة بأخرى، فإن شركة التأمين بعد دفعها التعويض للمؤمن له، يحق لها أن تحل محله في مقاضاة الطرف المتسبب في الحادث. وذلك لأن الضرر حادث الاصطدام يدخل ضمن المخاطر البحرية التي شملها التأمين، وبالتالي، فإن حق الرجوع على الغير مرتبط مباشرة بموضوع التأمين.[38]
الشرط الثاني- يشترط على المؤمن دفع مبلغ التعويض للمؤمِّن له: يُشترط لكي يستفيد المؤمن من حق الحلول محل المؤمِّن له أن يكون قد دفع مبلغ التأمين للمؤمِّن له، حيث يُعد تطبيقًا للقواعد العامة في الحلول التي تقضي بأنه الأصل لا حلول إلا بعد الوفاء[39]. الأصل عند وقوع الخطر البحري المؤمن منه وهلاك البضاعة محل عقد التأمين البحري من المقرر أن المؤمن لا يُخول له ممارسة حقه في الحلول محل المؤمن له إلا بعد دفع مبلغ التعويض للمؤمن له. وقبل أن يُقوم المؤمن بالدفع يظل المؤمن له هو صاحب السيطرة على الدعوى في مواجهة الغير[40]. مما يعني أنه يُملك الحق الحصري في اتخاذ القرارات القانونية بشأن المطالبة بالتعويض أو مقاضاة الأطراف المسؤولة عن الضرر. وقد نص النظام البحري التجاري السعودي وفقًا للمادة (٢٣٤) سالفة الذكر يحل المؤمن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها تأمين في “حدود مبلغ التعويض الذي دفعه”. وهدا يُشير إلى أنه لا يحق لشركة التأمين ممارسة حق الحلول محل المؤمن له إلا بعد سداد التعويض. كما نص القانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦، المادة (٧٩/٢) على أن المؤمن يحل محل المؤمن له في جميع الحقوق والتعويضات القانونية المتعلقة بالموضوع المؤمن عليه، وذلك من لحظة وقوع الحادث الذي تسبب في الخسارة ودفعه مبلغ التعويض[41]. كما أكد القضاء الإنجليزي أن حق الحلول لا ينشأ إلا بعد قيام المؤمن بسداد مبلغ التأمين إلى المؤمن له بموجب بويصلة التأمين، حيث يرتبط هذا الحق ارتباطًا وثيقًا بأداء الالتزام التأميني من جانب شركة التأمين[42].
وتعقيبًا على ما تقدم، فإن من أبرز الأحكام القضائية التي تُّعضِد الاتجاه القائل إن الحلول معلّق على شرط على أن المؤمن لا يُخول لها ممارسة حق الحلول إلا بعد دفع التعويض الفعلي على سبيل المثال ، في قضية Boag v. Standard Marine[43] حيث صرّح اللورد رايت في حكمه على مبدأ الحلول في التأمين البحري قائلاً: الحق في الحلول هو حق مشروط ينشأ منذ لحظة توقيع بوليصة التأمين، لكنه لا يصبح قابلاً للتنفيذ إلا إذا تحقق الشرط الأساسي وهو قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له[44].بمجرد تحقق الحدث وقوع الخسارة ودفع التعويض يتحول الحق من كونه معلقًا إلى حق نافذ وقابل للتنفيذ. وُيشترط في هذا الدفع أن يكون وفقًا لعقد تأمين صحيح وساري المفعول. فإذا كان عقد التأمين موقوفًا أو باطلًا لأي سبب، فلا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين، ويجوز له استرداد ما دفعه إذا تم السداد دون وجه حق.[45]
الشرط الثالث-أن يكون هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المؤمن له على الغير المسؤول: يُشترط لحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير، أن يكون الخطر المؤمن قد نشأ عن فعل صادر يُنسب قانونًا إلى طرف ثالث مع ثبوت مسؤوليته عن تحقق هذا الخطر والضرر اللاحق بالمؤمن له. يُستند هذا الشرط إلى أن الحلول القانوني يفترض وجود حق ثابت للمؤمن له تجاه الغير المسؤول عن ضرر، سواء كان هذا الحق ناشئًا عن المسؤولية التقصيرية أم على المسؤولية العقدية[46]. وذلك، لتمكين المؤمن من مباشرة حقه في الرجوع على الغير بما أداه من تعويض. وعلى الرغم أن النظام البحري التجاري السعودي نص على (٣٢٤) ” يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار ” إلا أن هذا النص يعد أكثر إيضاحًا في سياق القواعد العامة للوفاء مع الحلول، كما ورد في نظام المعاملات المدنية في المادة (261) حيث تُنص على ما يلي: “من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا، كان له الرجوع على المدين بقد ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أي مصلحة في الاعتراض على الوفاء “. وعليه، فإن في سياق التأمين إذا قامت شركة التأمين بسداد مبلغ التعويض للمؤمن له، فإنها في حكم من أوفى دين غيره تكتسب الحق في الرجوع على الطرف الثالث المتسبب في بما يعادل ما دفعته، ما لم تكن متبرعة هذا يشير إلى أن شركة التأمين لم تكن متبرعة بالمبلغ المدفوع، بل دفعته بناءً على العقد التأميني المُبرم مع المؤمن له. أي أن شركة التأمين دفعت مبالغ التعويض لأن العقد يفرض عليها ذلك، وليس لأن الشركة تتطوع للدفع من دون مقابل. يتسق هذا لاتجاه وفق ما استقر القضاء الإنجليزي على أن حلول المؤمن محل المؤمن له في حقوقه تجاه الغير يفترض بالضرورة قيام مسؤولية قانونية قائمة في ذمة الغير عن الضرر محل التأمين. وقد كرست محكمة اللوردات هذا المبدأ على سبيل المثال، في القضية الشهيرة Esso Petroleum Co Ltd v. Hall Russell & Co Ltd and Others[47] حيث قضى اللورد جوسي بأن حق الحلول لا يمنح المؤمن حقًا مستقلاً بل يجعله يباشر ذات الحقوق التي كان يملكها المؤمن له وباسمه دون زيادة أو نقصان. وقد نص صراحةً قائلًا: عندما يحل المؤمن محل حقوق شخص قام بتعويضه فإن ممارسته لهذه الحقوق تكون قاصرة على ما كان لذلك الشخص من حقوق، وباسمه. ويُتسق هذا الاتجاه بالإضافة على ما أيّدهُ الفقه الإنجليزي على أن مبدأ الحلول لا يُمكن أن يُمارس إلا إذا كان للمؤمَّن له حق قائم أو محتمل في مواجهة طرف ثالث؛ إذ لا محل للحلول إذا لم يكن هناك حق يمكن لشركة التأمين أن تحل فيه. كما أُكد أن الحلول يُخوِّل للمؤمِّن مباشرة أي حق تعويضي باسم المؤمن له ضد الغير، بشرط أن يكون هذا الحق قابلًا للتنفيذ فيما يتعلّق بالخسارة المؤمن عليها[48]. وعليه، يُعد وجود دعوى قانونية أو إمكانية قانونية للرجوع على الغير شرطًا جوهريًا لا يكتمل الحلول بدونه.
الفرع الثاني
قيود ممارسة حق الحلول في عقد التأمين البحري
مع أنَّ حق الحلول يُعد من الوسائل القانونية الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التأمينية، إلا أن ممارسته ليست مطلقة، بل تَحكُمها جملة من القيود التي تختلف باختلاف طبيعة العلاقة بين الأطراف وسياق العقد. وقد أغفل النظام البحري التجاري السعودي، لا سيّما في المادة (324)، من بيان هذه القيود أو التفصيل في أحكامها، مما أفضى إلى وجود فراغ تنظيمي في هذا الجانب. وعلى خلاف ذلك، رسّخ القضاء الإنجليزي قواعد واضحة ومستقرة تحد من إطلاق هذا الحق من خلال سوابق القضائية تقضي بعدم جواز ممارسته متى توفرت القيود معينة. ومن ثم، فإن استحضار ما استقر عليه القضاء المقارن يُعَدّ مسلكًا علميًا وعمليًا يمكن أن يسهم في معالجة أوجه القصور التنظيمي في النظام البحري التجاري السعودي. أبرز القيود ما يلّي:
القيد الأول- لا حلول ضد المؤمن له (No rights against the assured himself): يستند القانون العام الإنجليزي إلى مبدأ أساسي يُنص أن شركة التأمين لا يحق لها الاستفادة من أي تعويضات أو حقوق أو مزايا إلا بالقدر الذي يحق للمؤمن له نفسه الاستفادة منها. فإذا لم يكن للمؤمن له الحق في رفع دعوى قانونية إلا من خلال اتفاق أو تسوية فإن شركة التأمين لا يُمكن أن تكون في وضع أفضل منه [49]. وأفضل توضيح لهذا المبدأ ورد على سبيل المثال، في قضية Simpson v Thomson[50] أمام مجلس اللوردات، حيث تم دفع تعويض من قِبل شركات التأمين للمؤمن له عن فقدان سفينته التي اعُتبرت خسارة كلية نتيجةً اصطدامها بغرق سفينة أُخرى ناتج عن إهمال ربان السفينة. ولكن في هذه القضية، كان المؤمن هو مالك السفينتين. مما أثار التساؤل حول ما إذا كان يحق لشركة التأمين بعد دفع التعويض أن تُمارس حقها في الرجوع على المؤمن له باعتبارّه مالكًا للسفينتين؟ قضت المحكمة في البداية لصالح شركة التأمين باعتبار أن التخلي عن السفينة ينقل جميع الحقوق المتعلقة بها إلى الشركة. غير أن مجلس اللوردات ألغى هذا الحكم، مؤكدًا أن شركة التأمين لا يجوز لها الرجوع على المؤمن له إذا كان هو المتسبب في الضرر، لأن ذلك يعد دعوى ضد الذات، وهو أمر غير مقبول قانونًا. وصرح اللورد كيرنز في حكمه بشأن طبيعة ممارسة شركات التأمين لحق الحلول قائلًا: لا أجد أي أساس لحق شركات التأمين باستثناء القاعدة القانونية المعروفة التي تنص على أنه عندما يوافق شخص على تعويض شخص آخر فإنه يحق له أن يحل محل ذلك الشخص في كافة الوسائل والطرق التي كان يمكن للمؤمن له أن يستخدمها لحماية نفسه أو لاسترداد خسارته. وبناءً على هذا المبدأ، فإن شركات التأمين التي قامت بدفع تعويض عن سفينة مفقودة تكون مخولة باسترداد السفينة عينًا إذا وُجدت، وعلى نفس الأساس، يمكنها المطالبة بأي حق كان يحق لمالك السفينة المطالبة به ضد الطرف المتسبب في الضرر[51]. وأضاف، ولكن يجب أن يُمارس هذا الحق في المطالبة بالتعويضات ليس باسمهم هم، بل باسم الشخص المؤمن له، وإذا كان الشخص المؤمن عليه هو ذاته من تسبب في الضرر فلا أستطيع أن أرى كيف يمكن المطالبة بهذا الحق أصلًا.[52]
القيد الثاني- قيد التأمين المشترك على ممارسة حق الحلول ( Against the co-assured): أرست المحكمة العليا البريطانية مبدأً حاسمًا بشأن أثر التأمين المشترك على قابلية شركة التأمين لممارسة حق الحلول ضد أحد أطراف العلاقة التأمينية على سبيل المثال، في قضية [53] Gard Marine & Energy Ltd v. China National Chartering Co Ltd قضت المحكمة بأن إدراج المستأجر كمؤمَّن عليه ضمن الوثيقة ذاتها التي تؤمّن مالك السفينة (المؤمن له) ، يُنشئ علاقة تأمينية موحدة بين الطرفين، ويُعد بمثابة تنازل ضمني من المؤمن له الأصلي عن حق الرجوع على الطرف الآخر. وبناءً عليه، لا يجوز لشركة التأمين ممارسة حق الحلول ضد أحد المؤمن عليهم المشتركين في الوثيقة، ما لم يوجد نص صريح أو ضمني يُجيز ذلك. وقد أكد اللورد مانس في حيثيات الحكم قائلًا: أن المؤمِّن لا يمكنه أن يكتسب بموجب الحلول حقوقًا كان المؤمن له قد تنازل عنها صراحةً أو ضمنًا[54]. ومع ذلك، بيّنت المحكمة أن هذا القيد ليس مطلقًا، إذ يجوز ممارسة حق الحلول إذا ثبت ارتكاب المؤمن عليه المشترك غشًا أو سلوكًا متعمدًا، أو إذا تضمنت الوثيقة ما يسمح بذلك صراحةً. ومن ثم، فإن الحظر على الحلول في سياق التأمين المشترك يُعد قيدًا نسبيًا لا يسري في جميع الأحوال، بل يتوقف على مضمون التغطية التأمينية وسلوك الأطراف[55].
القيد الثالث- تضمين شرط التنازل عن الحلول (Waiver of Subrogation): قيد التنازل عن الحلول يُعد من أبرز القيود القانونية التي تُدرج في بوليصة التأمين، حيث يؤدي إلى منع شركة التأمين من الرجوع على الطرف ثالث، حتى في حال ثبوت مسؤوليته. وقد أُكد هذا القيّد على سبيل المثال، في قضية Enimont Supply SA v. Chesapake Inc. (Surf City)[56] ، حيث قامت شركة التأمين بدفع تعويض للمؤمن له عن الخسارة الناتجة عن حادث معين. وبصورة عامة عندما يسدد المؤمن التعويض، يكتسب بموجبه الحق في الرجوع على الطرف الثالث المتسبب في الخسارة (كالناقل أو مالك السفينة) إلا أن بوليصة التأمين في هذه الحالة اشتملت على بند صريح يقضي بالتنازل عن حق الرجوع، والذي حظر على شركة التأمين ممارسة هذا الحق تجاه الطرف الثالث.[57].
القيد الرابع- قيد ممارسة حق الحلول في حالات التأمين الجزئي: (Partial Insurance) رسّخت المحاكم البريطانية مبدأً قضائيًا مستقرًا مفاده أن المؤمن له يُقدَّم على شركة التأمين في استرداد ما لم يُعوض عنه من خسارته متى لم يحصل على تعويض كامل. ويهدف هذا القيد إلى ضمان التوازن في العلاقة التأمينية، ومنع شركة التأمين من ممارسة حق الحلول على نحو قد يُخل بحقوق المؤمن له. وقد أكدت محكمة الاستئناف المدنية في إنجلترا وويلز هذا المبدأ في حكمها الصادر على سبيل المثال، في قضية [58]Royal & Sun Alliance Insurance Plc v Textainer Group Holdings Ltd حيث قررت المحكمة أن شركة التأمين لا يحق لها المطالبة بأي مبالغ مستردة من الطرف الثالث، ما لم يكن المؤمن له قد حصل أولًا على تعويض كامل عن الجزء الذي لم تغطه وثيقة التأمين. يمثل هذا الحكم امتدادًا لمبدأ سابق أقرّته محكمة اللوردات على سبيل المثال، في قضية [59] Lord Napier v. Ettrick v Hunter والذي نص على أن المبالغ المستردة من الغير تُوزع وفق ترتيب يُعرف التوزيع من أعلى إلى أسفل بحيث تُخصّص أولًا لتغطية الخسائر غير المؤمن عليها للمؤمن له، ثم للخسائر المؤمن عليها لصالح المؤمن، وأخيرًا لأي مبالغ زائدة. وعليه، يُشكل هذا الترتيب قيدًا موضوعيًا على ممارسة حق الحلول، يُقر بأولوية المؤمن له في استيفاء ما لم يُعوض عنه ويُكرّس مبدأ العدالة التأمينية.
المطلب الثاني
التزامات المُؤْمَّنِ له في الحفاظ على حقوق المؤمن في عقد التأمين البحري
تبنَّى النظام البحري التجاري السعودي نهجًا صريحًا بإلزام المؤمن له باتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على حقوق المؤمن، وذلك وفقًا للمادة (316) التي نصت “على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر، ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات”. يتّضح من هذا نص بأنه يُلقى على عاتق المؤمن له عدة التزامات عند وقوع الخطر المؤمن ضده فقط، منها: ببذل أقصى جهد ممكن لإنقاذ الممتلكات المؤمن عليها من التلف أو الهلاك. ويعد هذا التزامًا يتجاوز التصرف العادي المتوقع لحماية الممتلكات ليُصبح واجبًا تعاقديًا بموجب عقد التأمين. كما يُشكل هذا الالتزام مكملاً لمبدأ منع تفاقم الضرر الذي يهدف إلى تقليل الخسائر التي قد تتحملها شركة التأمين. إضافة إلى ذلك، تفرض المادة على المؤمن له اتخاذ كافة التدابير التي تكفل لشركة التأمين حق الرجوع على الغير في حال كان هناك طرف ثالث مسؤول عن الضرر، مثل الاحتفاظ بالأدلة، أو الامتناع عن التنازل عن هذا الحق أو إبرام تسوية مع الطرف الثالث. واللافت أن المادة لم تكتفِ بتوجيهات عامة أو توصيات، بل رتّبت على الإخلال بها نتيجة الإهمال أو التقصير مسؤولية مباشرة يتحملها المؤمن له عن الأضرار التي قد تلحق بالمؤمن. مع ذلك، يُلاحظ أن المادة (316) أغفلت النص صراحةً على التزام المؤمن له بإبلاغ المؤمن عن وقوع الخطر أو المطالبة ذات الصلة. وقد أكّدت إحدى السوابق القضائية الصادرة عن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمينية هذا القصور، كما يظهر على سبيل المثال في القرار رقم (81/ر/1435هـ) لعام 2014م، المؤيد بالاستئناف رقم (181/أ/1435هـ)، حيث امتنعت شركة التأمين عن دفع التعويض بحجة أن المؤمن له لم يقم بإبلاغها فورًا عن مطالبة مرفوعة ضده، مما أفقد حقها في ممارسة حق الحلول تجاه طرف ثالث. ومع ذلك، رأت اللجنة القضائية أن وثيقة تأمين لم تتضمن نصًا صريحًا يحدد مهلة زمنية للإبلاغ مما أفقد هذا الشرط إلزاميته القانونية، واعتبرته بمثابة شرط تعسفي معتبرةً أن تصرف المؤمن له في الدفاع عن حقوقه دليل على التزامه بواجباته، ومن ثم قضت بإلزام الشركة بدفع التعويض كاملاً، بل ومنح المؤمن له تعويضًا إضافيًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سجنه خلال النزاع[60]. ويتسق هذا الاتجاه مع المبادئ المستقرة في القضاء الإنجليزي، الذي شدد على ضرورة صون حقوق الحلول للمؤمن على سبيل المثال، في قضية[61] In West of England Fire Insurance Co. v. Isaacs قضت المحكمة بأن قيام المؤمن له بإصدار تنازل عن حق الرجوع ضد طرف ثالث، بعد أن قامت شركة التأمين بسداد مبلغ التعويض، يُشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق الحلول التي تؤول إلى الشركة. وبناءً عليه، تقرر أن للمؤمن حقًا في استرداد مبلغ التعويض من المؤمن له، ما دام هذا التنازل قد حال دون ممارسته لحقه في الرجوع على الطرف المسؤول. وتُرسخ هذه السابقة القضائية مبدأ مفاده أن أي تصرف ينطوي على تسوية أو تنازل من قبل المؤمن له، يتم بعد تحقق التعويض ودون مراعاة لمصلحة شركة التأمين، يُعد إخلالًا يُرتب التزامًا بالتعويض لصالح الشركة.
وفي السياق ذاته، حيث أكد اللورد جيمس على سبيل المثال، في قضية Commercial v. Lister[62] بأن قيام المؤمن له بتسوية دعواه دون مراعاة مصالح المؤمن يُعد إخلالًا بواجب إنصاف. وقد أكدت الأدبيات الفقهية هذا الاتجاه، مشيرةً إلى أن التزام المؤمن له لا يقتصر على التصرف بنزاهة، بل يمتد ليشمل مراعاة مصالح المؤمن ولا سيما عند ممارستها لحق الحلول[63]. تُثار إشكالية قانونية جوهرية في ظل غياب نصوص تشريعية تُحدّد بوضوح التزامات المؤمن له قبل تحقق الخطر المؤمن منه، إذ قد يُبرم هذا الأخير اتفاقات أو تسويات مع أطراف ثالثة تُفضي إلى فقدان حق شركة التأمين في الحلول. وقد أفرز هذا القصور التشريعي عددًا من الإشكالات التطبيقية، كما أبرزتها السوابق القضائية، لا سيما في القضاء الإنجليزي. ويُلاحظ أن المادة (79) من قانون التأمين البحري الإنجليزي لا تُشكل سوى بيانًا غير مكتمل، بل وفي بعض الحالات غير دقيق، للقانون كما كان متطورًا لعام 1906، وهو ما كشف عن محدودية الحماية القانونية المتوفرة لحق الحلول. فقد بيّنت الأحكام القضائية أن غياب التنظيم التشريعي الدقيق مكّن المؤمن له من اتخاذ تصرفات تضعف فعليًا قدرة شركة التأمين على ممارسة هذا الحق، دون وجود نص قانوني يُحدّد مسؤوليته أو يترتب عليه أثر قانوني مباشر. وتتفاقم هذه الإشكالية في الحالات التي يُبرم فيها المؤمن له، بعد بدء سريان وثيقة التأمين، ولكن قبل تحقق الخطر، ترتيبات مع أطراف ثالثة من شأنها تقييد أو إلغاء حق شركة التأمين في الرجوع على الغير. وفي ظل غياب نص صريح في وثيقة التأمين يحظر مثل هذه التصرفات أو يُلزم المؤمن له بالحفاظ على حقوق الحلول، يُصبح من العسير إيجاد أساس قانوني يضمن لشركة التأمين ممارسة حقها. ويزداد الموقف تعقيدًا بالنظر إلى أن الالتزام بحسن النية لا يُعدّ التزامًا مستمرًا بعد إبرام العقد، كما أن مبدأ الحظر العام على زيادة الخطر لا ينطبق على هذه الفرضيات، إذ لا يطرأ تغير على طبيعة الخطر المؤمن عليه، بل على إمكانية استرداد التعويض من الغير لاحقًا.[64]قد تجلى هذا الإشكال بوضوح على سبيل المثال، في قضية State Government Insurance Office (Queensland) v Brisbane Stevedoring Pty Ltd[65] حيث قضت المحكمة بأن حق الحلول لا ينشأ إلا بعد وقوع الخسارة وأن التصرفات التي يُبرمها المؤمن له في الفترة ما بين سريان الوثيقة وقبل وقوع الخسارة لا تمنح شركة التأمين أي حق قانوني تلقائي في الرجوع ما لم يُنص على ذلك صراحة في وثيقة التأمين. كما من البديهي القول إن حقوق الحلول لا يمكن أن تنشأ قبل وقوع الخسار وهي حقوق تمكّن شركة التأمين، بعد أن تكون قد أوفت بالتزامها تجاه المؤمن له، من أن تحل محل هذا الأخير في الرجوع على المتسبب بالضرر – سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا – لاسترداد ما دفعته. غير أن هذا الحق يُمكن أن يُقيد أو يُحرم المؤمن في الحالات التي يُقدم فيها المؤمن له على إبرام اتفاقات مع أطراف ثالثة تعفيهم من أية مسؤولية محتملة قبل وقوع الضرر ثم يتعاقد بعد ذلك مع شركة التأمين في مثل هذه الحالة، تكون حقوق الحلول مفرغة من محتواها، إذ إن المسؤولية الأصلية للطرف الثالث قد أُزيلت بإرادة المؤمن له وفي مثل هذه الظروف، فإن الطريق الوحيد المفتوح أمام شركة التأمين للطعن في الوضع هو الاستناد إلى عدم الإفصاح أو، في الحالات القصوى، التضليل إذا ثبت أن المؤمن له قد تعمّد تقديم معلومات غير صحيحة ومع ذلك، فإن هذا المسار القانوني محفوف بعقبات جدّية، حيث إن الدفع بعدم الإفصاح لا يُعتد به إلا إذا كانت المعلومات المخفاة جوهرية وكان من الممكن أن تؤثر فعليًا في قرار شركة التأمين بشأن قبول الخطر أو تحديد شروطه أو قسطه. علاوة عن ذلك أن الفقه والقضاء ذهبا إلى أبعد من ذلك، فقررا أنه في حال كانت تلك الترتيبات تُعد ممارسة مألوفة أو عرفًا مستقرًا في مجال التجارة المعنية، فإن شركة التأمين تُعتبر على علم بها ضمنيًا، ولا يكون هناك التزام على المؤمن له بالإفصاح عنها[66].
وقد تكرر هذا القصور على سبيل المثال، في قضية [67] Tate & Sons v. Hyslop، حيث قررت هيئة المحلفين أن الاتفاق الذي أبرمه مالك البضاعة المؤمن له بعدم الرجوع على مشغّل الزورق في حال تعرضت البضاعة للتلف، يُعد ترتيبًا شائعًا لا يستدعي الإفصاح. ورغم أن محكمة الاستئناف وجدت لاحقًا أن هناك ما يكفي من الأدلة لنقض هذا الحكم، إلا أن الأساس القانوني ظل قائمًا. وعلاوة على ذلك، لا تملك شركة التأمين أي حق في الدفع بعدم الإفصاح ما لم يُثبت أن قبول الخطر لم يكن ليتم إلا مقابل قسط أعلى أو بشروط مختلفة. والواقع أن أقساط التأمين لا تُحسب عادةً على أساس افتراض وجود إمكانية لاسترداد المبالغ من الغير من خلال الحلول[68].
ويّتضح في ضوء ما تم طرحه، أن النظام البحري التجاري السعودي وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906، قد أوليا اهتمامًا بالغًا بالتزامات المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده؛ إذ عبّر المنظم السعودي عن ذلك من خلال نص نظامي صريح، بينما استقر القانون الإنجليزي عبر سوابق قضائية متواترة. ومع ذلك، يُلاحظ أن كلا النظامين يُغفلان تنظيم التزامات المؤمن له في المرحلة السابقة على تحقق الخطر، لا سيما في الحالات التي يُبرم فيها اتفاقات قبل وقوع الخطر ومن شأنها الحد من حق الحلول الذي قد يُمارسه المؤمن ضد
أطراف ثالثة مسؤولة عن الضرر وهي ذات الثغرة التي أفرزت تحديات عملية وقانونية في السياق القضاء الإنجليزي.
المطلب الثالث
مطالبة المؤمن بالتعويض وفقًا لمبدأ الحلول في عقد التأمين البحري
يقع الحلول بقوة النظام (القانون) متى توافرت الشروط السابقة من لحظة الوفاء مبلغ التأمين[69]. ولا يجوز لشركة التأمين أن تحل محل المؤمن له إلا في حدود ما دفعته له فعليًا من مبلغ التأمين، ومن ثمَّ إذا كان ما دفعته الشركة أقل من مبلغ التغطية التأمينية، فإن حقها في الرجوع على المسؤول عن الضرر ينحصر في حدود ذلك المبلغ المدفوع فقط، ويُعد باطلًا كل اتفاق يخالف هذا الحكم لتعلقه بالنظام العام[70]. وهذا ما أخذ به النظام البحري التجاري السعودي صراحة وفق المادة (٣٢٤) المشار إليها سابقًا بأنه: “يحل المومن محل المومن له في جميع الأضرار التي نشأت بمناسبة التأمين وحدود مبلغ التعويض الذي دفعه”. كما دعّمت القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية هذا الاتجاه، لا سيما من خلال أحكام الوفاء مع الحلول، التي قدّمت تفسيرًا أكثر دقة لمفهوم الحلول التي نصت على أن: “إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن، كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من ضمانات، وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله”. والفقرة الثانية التي تنُص أنه: “إذا كان الحلول في جزء من الحق، فيكون الدائن مقدمًا في استيفاء ما بقي له على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك”. تشير المادة في سياق التأمين، إلى أن شركة التأمين تُعد في حكم المُوفي، إذ تحل محل المؤمن له (الدائن الأصلي) في الرجوع على الغير (المدين)، بالحق ذاته وبما يترتب عليه من توابع وضمانات ودفوع، وذلك في حدود ما أدته من تعويض، ولا يُبنى رجوع شركة التأمين على دعوى مستقلة، وإنما يُستند إلى دعوى الحلول التي تُعد امتدادًا مباشراً لدعوى المؤمن له الأصلية مستندة إلى ذات الأساس القانوني، سواء أكان مصدر الحق مسؤولية تقصيرية أم عقدية.[71] بالإضافة إلى ما سبق تُشير الفقرة الثانية من ذات المادة في سياق الحلول، إلى أنه إذا كان الحلول في جزء من الحق فقط؛ فإن الأولوية في استيفاء ما تبقى من هذا الحق تُظل للدائن الأصلي (المؤمن له)، ويأتي الموفي (شركة التأمين) في المرتبة التالية، ما لم يُوجد اتفاق صريح بين الطرفين يُخالف ذلك الترتيب. ويُفهم من هذا أن الحلول الجزئي لا يُقصي المؤمن له عن الحق كاملاً، بل يُنشئ نوعًا من التزاحم المنظم في الاستيفاء بحيث يُحافظ النظام على مصلحة المؤمن له في استكمال حقه قبل انتقال ما تبقى إلى المؤمن. وهذا ما استقر عليه القضاء البريطاني حيث قضى القاضي قائلًا: إنَّ مبدأ الحلول لا يُنشئ حقًا جديدًا، بل يتيح للمؤمّن ممارسة نفس الحقوق التي كانت للمؤمّن له ضد الطرف الثالث بعد دفع التعويض [72]. وهذا يؤكد أن المؤمّن لا يكتسب حقوقًا جديدة؛ وإنما هو يحل محل المؤمن له في المطالبة ضد الطرف الثالث فقط بناءً على الحقوق التي كانت للمؤمّن، وهذا على خلاف النظام السعودي الذي لم يُفصّل أثر نوع الخسارة على ممارسة الحلول، فقد جاء قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906 في المادة (79) ليُقدم تنظيمًا دقيقًا يُميز بين الخسارة الكلية والخسارة الجزئية. استنادًا الفقرة (1) من هذه المادة أنه إذا دفع المؤمن تعويضًا عن خسارة كلية، سواء عن كامل موضوع التأمين أو عن جزء منه قابل للتخصيص، فإنه يُمنح حق تملّك مصلحة المؤمن له في الشيء المتبقي، ويحل محله في جميع الحقوق القانونية المرتبطة به، اعتبارًا من وقت وقوع الخطر. عندما يقوم المؤمن بدفع تعويض عن خسارة كلية، يصبح له، بموجب مبدأ الحلول الحق في جميع الحقوق العينية المتبقية في الشيء المؤمن عليه، بما في ذلك أي منافع ناتجة عن الإنقاذ أو العائدات المالية المرتبطة به. وقد رسّخ هذا المبدأ بوضوح على سبيل المثال، في قضية Burnand v. Rodocanachi[73] حيث أكد أن الحلول لا ينقل فقط حق التقاضي ضد الأطراف الثالثة، بل يمتد أيضًا ليشمل ملكية ما تبقى من محل التأمين المؤمن عليه. وهذا بخلاف حال الخسارة الجزئية، وفقًا للفقرة (2)، فإن المؤمن لا يكتسب أي حق في ملكية موضوع التأمين، وإنما يقتصر دوره على الحلول في حدود مبلغ التعويض فقط.
ويتضح من هذا التفصيل أن القانون الإنجليزي لعام ١٩٠٦ قد أرسى تفرقة دقيقة؛ إذ تنتقل الملكية في حالة الخسارة الكلية، بينما يقتصر الحلول على الحقوق القانونية فقط دون الملكية في حالة الخسارة الجزئية. بخلاف المنظم السعودي، فرغم إقراره بمبدأ الحلول إلا أنه لم يُعالج هذه التفرقة أو ينص على الأثر القانوني المترتب عليها، مما أحدث فراغًا تشريعيًا قد يؤدي إلى تباينٍ في التطبيق والتفسير.
وفي ذات السياق ، من ناحية إجراء المطالبات، تُباشر شركة التأمين بعد حلولها محل المؤمّن وسداد التعويض دعواها بذات الصفة القانونية للمؤمن له، وقد جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات التأمين التعاوني الصادر مرسوم ملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٢/٦/١٤٢٢هـ، بتحديد نموذج هذه المطالبة وهو أن المؤمن له يُخول توكيلًا للمؤمّن [74]. وفي السياق ذاته، أكدت محكمة مجلس اللوردات على سبيل المثال، في القضية البحرية [75] Esso Petroleum Co Ltd v. Hall Russell and Co Ltd مبدأ دقيقًا يُبيّن أن هذا الحق لا يجوز ممارسته استقلالًا من قبل شركة التأمين، بل يجب أن يُمارس باسم المؤمن له، ما لم يتم تحويل الحق صراحةً. وقد جاء في حيثيات الحكم حيث صرح اللورد جوف، ما يلي: في الحالات العادية، كما هو الحال في عقود التأمين، يطلب المؤمن من المؤمن له، عند الدفع، توقيع خطاب حلول، يُخوّل المؤمن مباشرة الإجراءات باسم المؤمن له ضد أي طرف تسبب في الضرر. وإذا رفض المؤمن له منح هذه السلطة، يمكن للمؤمن نظريًا رفع دعوى لإجباره على ذلك. ولكن في الوقت الحاضر، يمكن للمؤمن تجاوز هذه العملية المعقدة من خلال رفع دعوى ضد كل من المؤمن له والطرف الثالث، يطلب فيها أمران، هما:(1) أن يُخوّل المؤمن له مباشرة الدعوى ضد الطرف الثالث باسمه. (2) أن يسعى للمضي قدمًا بعد الحصول على هذا التفويض ضد الطرف الثالث. ولكن يجب ألا يُعتقد أنه، لمجرد وجود هذه الطريقة المريحة، يمكن للمؤمن مباشرة الدعوى باسمه الخاص ضد الطرف الثالث، فليس له الحق في ذلك، طالما أن الحق الذي يسعى إلى تنفيذه هو حق المؤمن له. فقط إذا تم تحويل هذا الحق إليه من قبل المؤمن له، يمكنه مباشرة الدعوى باسمه الخاص. كما لا يُجوز لشركات التأمين من خلال الطريقة التي تمارس بها حق الحلول، أن تتصرف بطريقة تُلحق ضررًا بالمؤمن له؛ فمثلاً: إذا قامت شركة التأمين بتسوية دعوى ضد طرف ثالث بشروط ضارة، في حالة يكون فيها الطرف الثالث مسؤولًا عن مبلغ يفوق مقدار التعويض بموجب وثيقة التأمين، فإنه يُفترض أن للمؤمن له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر من شركة التأمين[76]. وفي سياق مبدأ حسن النية في العلاقة التأمينية كما أولى القضاء الإنجليزي أهمية بالغة لمبدأ حسن النية في ممارسة حق الحلول على سبيل المثال، في قضية [77] Groom v. Crocker مبدأً قضائيًا هامًا، حيث قرر القاضي السير ولفريد غرين قائلًا: أن شركة التأمين عندما تتولى الدفاع في دعوى مرفوعة ضد المؤمن له، لا يجوز لها أن تنحاز إلى مصلحتها وحدها، بل يتعين عليها أن تراعي أيضًا مصلحة المؤمن له باعتبارها جزءًا من العلاقة التعاقدية التي تقوم على الثقة المتبادلة. وأكد الحكم أن شركة التأمين تخضع لواجب إنصافي يفرض عليها التصرف بحسن نية تجاه المؤمن له، لا سيما في الحالات التي قد تسعى فيها إلى التقليل من قيمة الأضرار المستحقة بموجب وثيقة تأمين ذات قيمة محددة سلفًا. ويُعد هذا الحكم تجسيدًا لمبدأ التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف في عقد التأمين. وفي ذات السياق اهتم الفقه القانوني الإنجليزي بتحديد الأثر القانوني لتصرفات الغير التي قد تُعيق أو تُضعف ممارسة شركة التأمين لحق الحلول، لا سيما في حال إبرام تسويات مبكرة بين الطرف الثالث والمؤمن له قبل دفع مبلغ التعويض، مع علم الطرف الثالث بأن تلك التسوية قد تُخل بحقوق شركة التأمين. وفي مثل هذه الحالات، يجوز لشركة التأمين رفع دعوى مستقلة ضد الطرف الثالث، استنادًا إلى إخلاله بمبدأ حسن النية وإضراره بحقوق قانونية محتملة ومعروفة لديه.[78]
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي، فإن المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بما في ذلك الناشئة عن عقد التأمين البحري تُصنَّف ضمن المنازعات التأمينية التي تختص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بالنظر والفصل فيها، وذلك استنادًا إلى التنظيم النظامي المقرر في المملكة العربية السعودية، الذي خوّل هذه اللجان صلاحية البتّ في جميع الخلافات التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية[79]. وبالاطلاع على السوابق القضائية الصادرة عن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التأمينية على سبيل المثال قرار الاستئناف رقم (76/أ) في عام 2015م الصادر عن اللجنة القضائية لتسوية المنازعات التأمينية تم الطعن فيها أن إحدى القضايا المهمة تعلّقت بدعوى رفعتها شركة التأمين ضد الطرف الثالث (الناقل)، تطالب فيها باسترداد مبلغ التعويض الذي دفعته للمؤمن له عن فقدان شحنة مؤمّن عليها بنظام “من الباب إلى الباب”، نتيجة أضرار وقعت أثناء النقل. ومع ذلك، تم رفض القضية لأن شركة التأمين لم تمارس حق الرجوع خلال المدة الزمنية المقررة نظامًا[80]. وهي سنتان من تاريخ وقوع الخسارة. وتستند هذه المدة إلى المادة (٢٢١(من النظام البحري التجاري السعودي[81] التي تحدد أن المطالبة ضد الناقل يجب أن تُرفع خلال عامين من تاريخ استلام البضائع في حال حدوث أي خسارة أو ضرر للبضائع[82]. كما أكدت قواعد العمل والإجراءات الخاصة بلجان تسوية نزاعات التأمين أنه لا يمكن النظر في أي مطالبة ناشئة عن عقد التأمين في المحكمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث[83]، ويُعتبر مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة بمثابة نزاع يتعلق بالحلول، ويصبح غير قابل للمناقشة في المحكمة.
ويُستدل مما سبق، أن دعوى الحلول التي ترفعها شركة التأمين لا تستقل بذاتها من حيث التقادم، بل تُعد دعوى تبعية تستند إلى الحق الأصلي للمؤمن له، وتسري عليها ذات القيود الزمنية التي تسري على الدعوى الأصلية. وبالتالي، فإن سقوط هذه الأخيرة بالتقادم يؤدي إلى سقوط دعوى الحلول تلقائيًا، حتى لو تم دفع مبلغ التعويض لاحقًا.
الخاتمة
تناولت هذه الدراسة مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري وذلك في ضوء أحكام النظام البحري التجاري السعودي لعام ١٤٤٠هـ، مع مقارنته بما ورّد في قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906. وذلك في إطار دراسة تحليلية مقارنة، أُثرِيت باستنباط عدد من السوابق القضائية البريطانية المتخصصة بالبحري. وقد استُهلت الدراسة بتعريف عقد التأمين البحري، ثم تطرّقت إلى مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري وتكييّفه القانوني في هذا السياق. كما استعرضت الآثار القانونية الناشئة عن ممارسة هذا الحق، والشروط والقيود التي تحدّ من نطاق تطبيقه. تطرقت الدراسة كذلك إلى التزامات المؤمن له في الحفاظ على حقوق المؤمن، بما يُضمن تمكين الأخير من ممارسة حقه في المطالبة والتعويض وفقًا لمبدأ الحلول.
النتائج:
١- يُعد مبدأ الحلول في التأمين البحري من الركائز الجوهرية التي تُجسد الطبيعة التعويضية لعقد التأمين إذ بمقتضاه يحل المؤمن بعد وفائه بمبلغ التعويض للمؤمن له عن الضرر الواقع محل هذا الأخير في مباشرة حقوقه تجاه الطرف الثالث المسؤول عن الضرر. ويهدف هذا المبدأ إلى منع الإثراء غير المشروع وضمان عدم ازدواجية التعويض للمؤمن له.
٢– أبرزت الدراسة تميزًا واضحًا بين الحلول القانوني والحلول التعاقدي؛ فالحلول القانوني ينشأ بقوة النظام بمجرد سداد المؤمن مبلغ التأمين، دون حاجة إلى اتفاق مسبق وفي حدود ما تم دفعته، مما يكفل حماية حقوق الأطراف وتحقيق التوازن في العلاقة التأمينية. في المقابل، يستند الحلول التعاقدي إلى اتفاق صريح يُدرج ضمن وثيقة التأمين، ويشترط رضا الطرفان لانعقاده. ويُتيح للمؤمن مباشرة حقه في الحلول حتى قبل أن يتلقى المؤمن له التعويض كاملًا، الأمر الذي قد يُلحق ضررًا بحقوق هذا الأخير.
٣- توصلت الدراسة إلى أن مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري يُعد أثرًا قانونيًا تبعيًا ينشأ بقوة النظام بمجرد قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له، دون الحاجة إلى اتفاق تعاقدي صريح. ويستند هذا الحق إلى أحكام الوفاء مع الحلول الواردة في القانون المدني، إذ تنتقل إلى شركة التأمين الحقوق التي كانت للمؤمن له قبل الغير وذلك في حدود ما دفعته من تعويض دون أن تترتب للمؤمن حقوق جديدة أو مستقلة عن الحق الأصلي. وقد كرّس القضاء الإنجليزي هذا التكيّيف، معتبرًا أن الحلول يُشكل وسيلة قانونية تهدف إلى منع الإثراء غير المشروع ويستمد مشروعيته من قوة النظام ذاته.
٤- توصلت الدراسة إلى أن ممارسة المؤمِّن لحق الحلول في التأمين البحري تستلزم توافر عدد من الشروط القانونية التي تضمن سلامة هذا الحق واستقامته. ومن أبرز هذه الشروط: أن يكون الضرر داخل نطاق التغطية التأمينية، وأن يكون المؤمِّن قد سدد مبلغ التعويض، وأن يكون للمؤمَّن له حق قانوني قائم ضد الغير وقت وقوع الضرر.
٥- توصلت الدراسة إلى أن المنظّم السعودي لم يُنص صراحةً على نطاق تطبيق مبدأ الحلول في ضوء طبيعة الخسارة، إذ لم يميز بين الخسارة الكلية والجزئية، واكتفى بالإشارة إلى أن حق المؤمن في الحلول يقتصر على حدود مبلغ التعويض المدفوع. وعلى النقيض من ذلك، قدّم قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906 تنظيمًا أكثر دقة، إذ اعتمد طبيعة الخسارة معيارًا حاسمًا في تحديد مدى حلول المؤمن محل المؤمن له؛ ففي حالة الخسارة الكلية، تنتقل ملكية الشيء المؤمن عليه بالكامل إلى المؤمن، بما يشمل الحقوق والدعاوى المرتبطة به، أما في حالة الخسارة الجزئية، فتبقى الملكية للمؤمن له، ويقتصر حق الحلول على مقدار ما تم دفعه من تعويض، دون أن يمتد إلى ملكية الشيء المؤمن عليه.
٦- لا يُفصّل المنظّم السعودي آثار تنازل المؤمن له عن حق الحلول تفصيلًا دقيقًا، لكنه يُلزمه بعد تحقق الخطر باتخاذ ما يلزم لحماية حق المؤمن في الرجوع، ويحمّله المسؤولية حال الإخلال بذلك. على نحو مغايّر، بيّن القضاء الإنجليزي من خلال السوابق القضائية أن تنازل المؤمن له عن هذا الحق يؤدي تلقائيًا إلى انقضاء حق المؤمن في الحلول.
التوصيات:
١- نوصي النظام البحري التجاري السعودي بتعديل المادة (٢٩٩) بحيث يُنص على أن عقد التأمين البحري يقوم على مبدأ حسن النية باعتباره التزامًا تعاقديًا جوهريًا، دون أن يُرتّب الإخلال به جزاء الإبطال تلقائيًا.
٢- نوصي النظام البحري التجاري السعودي تعديل المادة (٣٠٠) من الفقرة (١) لتُنص يلتزم المؤمن له قبل إبرام عقد التأمين بتقديم عرض عادل للمخاطر إلى المؤمن، يتضمن الإفصاح عن كل المعلومات الجوهرية التي يعلم بها أو كان ينبغي له أن يعلم بها، والتي من شأنها التأثير في قرار المؤمن بشأن قبول التأمين أو تحديد شروطه. ويجب أن يكون هذا الإفصاح واضحًا وكافيًا لتمكين المؤمن الحصيف من تقييم الخطر المؤمن ضده. وتعديل الفقرة (٢) وفي حال الإخلال بواجب العرض العادل للمخاطر، يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد أو تعديل شروطه أو تقليص مبلغ التعويض، بحسب طبيعة الإخلال وجسامته، وما إذا كان متعمدًا أو متهورًا أو غير متعمد. ويشترط في جميع الأحوال أن يُثبت المؤمن أن الإخلال لو لم يقع لما أبرم العقد أساسًا، أو كان سيبرمه بشروط مختلفة. ويقع عبء إثبات الإخلال وطبيعته وأثره على عاتق المؤمن، وتكون للمحكمة المختصة سلطة تقدير الجزاء المناسب في ضوء ملابسات كل حالة على حدة.
٣- نوصي المنظِّم السعودي بإيراد نص نظامي في الباب السابع من النظام البحري التجاري السعودي في الفصل الأول يُعرّف الخسارة الكلية والخسارة الجزئية تعريفًا دقيقًا، مع بيان أنواع الخسارة الكلية، وهي الخسارة الكلية الفعلية والخسارة الكلية التقديرية، وتوضيح الحالات التي يتحقق فيها كل نوع.
٤- نوصي النظام البحري التجاري السعودي بتعديل المادة (٣٢٤) في حالة الخسارة الكلية إذا دفع المؤمن كامل مبلغ التأمين، تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه وما قد يتبقى منه، ويحل محل المؤمن له في جميع الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء محل التأمين، اعتبارًا من تاريخ وقوع الخطر المؤمن منه ودفعه مبلغ التعويض. وإضافة فقرة (٢) في حال الخسارة الجزئية، فلا يترتب على دفع مبلغ التعويض انتقال الملكية إلى المؤمن، ويقتصر حقه على الرجوع على الغير في حدود ما دفعه.
٥- نوصي المنظم السعودي بإيراد نصًا نظاميًّا صريحًا يُقر بأنه في حالات التأمين الجزئي، تُمنح الأولوية للمؤمَّن له في استيفاء ما تبقّى من خسارته غير المعوَّض عنها من المبالغ المستردة من الغير، وذلك قبل أن يباشر المؤمِّن حقَّه في الحلول.
٦- نوصي النظام البحري التجاري السعودي إضافة فقرة للمادة (٣١٦) يلتزم المؤمن له، طوال مدة سريان وثيقة التأمين بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو إبرام أي اتفاق أو ترتيب من شأنه إضعاف أو تقييد أو إبطال حق المؤمن في الحلول محلّه تجاه الغير، سواء قبل وقوع الخطر المؤمن ضده أو بعده، ويُعد مسؤولًا عن أي ضرر يلحق بالمؤمن نتيجة الإخلال بهذا الالتزام. والفقرة (٢) يُلتزم المؤمن له بالإبلاغ الفوري عن أي حادث أو مطالبة تتعلق بالخطر المؤمن عليه، منذ علمه بوقوع الخطر، مع تحديد مهلة زمنية معقولة للإبلاغ لضمان حماية حقوق المؤمن في الرجوع على الغير.
٧- نوصي المنظِّم السعودي بإيراد نص نظامي يحدّد القيود القانونية على حلول المؤمن محل المؤمن له، ويُستحسن أن يتضمن ما يلي: لا يجوز للمؤمن الحلول محل المؤمن له في الحالات الآتية: أولًا: في مواجهة المؤمن له نفسه: لا يجوز ممارسة الحلول ضد المؤمن له بأي حال. ثانيًا- في حالات وجود بوليصة تأمين مشترك إذا كانت الوثيقة تغطي المؤمن له وأطرافًا أخرى (مثل مالك السفينة أو مستأجرها) تغطية مشتركة، فلا يجوز الحلول ضد أي منهم ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك. ثالثًا-عند وجود شرط بالتنازل عن حق الحلول.
٩- نوصي اللائحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني إضافة فقرة للمادة (٤٥) إلزام شركة التأمين عند ممارسة حق الحلول بعدم الإضرار بمصالح المؤمن له، ويُعد من قبيِل الإضرار:
١- التسوية مع الطرف الثالث بمبلغ يقل عن قيمة الضرر الفعلي دون موافقة المؤمن له.
٢- التنازل عن الحقوق يُمكن أن تُعود على المؤمن له بمنفعة لاحقة.
١٠- نوصي المشرّع الانجليزي بإدراج فقرة ضمن المادة (79) من قانون التأمين البحري لعام ١٩٠٦، تُنظّم التزامات المؤمن له خلال فترة سريان وثيقة التأمين وقبل تحقق الخطر، وتُلزمه بالامتناع عن اتخاذ أي تصرف أو إبرام أي اتفاق مع أطراف ثالثة من شأنه أن يُقيّد أو يُضعف حق المؤمن في ممارسة الحلول.
المصادر الأولية:
– المعاجم اللغوية:
- آبادي ، الفيروس ،(٢٠٠٥م) ، القاموس المحيط. الجزء 3،. بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 37.
ابن منظور، (١٩٩٩م) ، لسان العرب ، ط ٣ ، ( بيروت: دار إحياء التراث العربي) صفحة ١٦٧
- الرازي ، ز ، (١٩٩٩م) ، القاموس المحيط ، بيروت ، لبنان : المكتبة المصرية- الدار النموذجية ، صفحة ٢٦.
القوانين والأنظمة:
- قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار رقم (١٩٠) وتاريخ ٩/٥/١٤٣٥هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢ هـ
- مسودة تعليمات التغطيات التأمين البحري الصادرة بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٣م
- النظام البحري التجاري السعودي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/144٠هـ
- نظام المعاملات المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١٩٣) وتاريخ ١٤٤٤هـ
- نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ٦/٢/١٤٢٤هـ
السوابق القضائية:
- قرار ابتدائي رقم ١٧٢/ر/١٤٣٤هـ صادر عن اللجنة الابتدائية بالرياض، بتاريخ ١٠/٦/١٤٣٤هـ، منشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. نقلًا عن: غازي أبو عرابي، أحكام التأمين وفقًا للنظام السعودي – دراسة مقارنة- ، مرجع سابق ، صفحة ٢١٧ . مسترجع من: https://www.idc.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx.
- أكدت لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بمحافظة جدة هذا المبدأ في قرارها الابتدائي رقم (62/ج/1429هـ وقد صدر هذا القرار بتاريخ 4/8/1429هـ، وتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. نقلًا عن: غازي أبو عرابي، أحكام التأمين وفقًا للنظام السعودي – دراسة مقارنة-، مرجع سابق، صفحة ٢٢٦. مسترجع من: https://www.idc.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx
- الاستئناف رقم (76/أ) لعام 2015م، اللجنة القضائية لتسوية المنازعات التأمينية، الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المملكة العربية السعودية. نقلًا عن:
Alkhudair, Motaz (2022) , Marine Insurance in Saudi Law: A Comparative Study with English and Egyptian Law , PhD diss, University of Exeter, p. 196.
٤. اللجنة الابتدائية لتسوية المنازعات والمخالفات التأمينية القرار رقم (81/ر/1435هـ) لعام 2014م، والمؤيد بقرار الاستئناف رقم (181/أ/1435هـ) لعام 2014.
الكتب:
أبو ضيف، آسر، (٢٠٢٤م) ، القانون البحري بين النظرية والتطبيق وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي ، (الرياض: دار اجادة للنشر والتوزيع) ، صفحة٢٤٤.
أبو عرابي، غازي، (٢٠٢٤م)، أحكام التأمين وفقًا للنظام السعودي دراسة مقارنة ، ط١ ، الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع ، صفحة ٢١٥.
الدين، أحمد شرف، (١٩٩١م)، أحكام التأمين: دراسة في القانون والقضاء المقارنين ، ط ٣ ، (القاهرة: نادي القضاة ) ، صفحة ٣٣٢.
صادق، طارق عفيفي، (٢٠٢٤م)، عقد التأمين وفقًا لنظام المعاملات المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ ، لا يوجد رقم طبعة ، الرياض: دار الاجادة ، صفحة ١٥٣.
- طه، مصطفى كمال، (١٩٩٢) ، التأمين البحري: الضمان البحري ، بيروت: الدار الجامعية ، صفحة ٥
المرسى زهرة ، محمد ، (٢٠٠٦) ، أحكام عقد التأمين ، ط١ ، القاهرة: دار النهضة العربية ، صفحة٢٧٠.
مرسى، محمد كمال، (٢٠٠٥م)، شرح القانون المدني، العقود المسماة عقد التأمين، (مصر: منشأة المعارف) ، صفحة ٢٦٢.
موسى، خالد السيد محمد عبد المجيد ، (٢٠٢٥م)، الأحكام العامة لعقد التأمين في النظام السعودي، الرياض: دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، صفحة ٢٢٢.
موسى، خالد السيد محمد عبدالمجيد ، (٢٠٢٣م) ، أحكام الالتزام وفقًا لنظام المعاملات المدنية السعودي الجديد ، (الرياض: دار الكتاب الجامعي للنشر التوزيع) ، صفحة ٣٥٤.
الرسائل العلمية:
أبوعرابي ، غازي خالد أحمد (١٩٩٨) ، حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول عن تحقق الخطر ، رسالة تأمين ، مج١ ، ع٣ ، صفحة ١٦. مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/100849 .
- هلسا ، أيمن أديب (١٩٩٨م) ، حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول عند تحقق الخطر ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، عمان ، صفحة ٥٠. مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/554499
الأبحاث العلمية:
- أبو سرحان، أحمد شحده ،(٢٠١٦) ، مبدأ الحلول في التأمين التجاري الإسلامي ، مج ٤٣ ، عدد٣ ، صفحة ١٤٤٤.
- الذيابي ، خالد بن مرزوق بن سراج ، (٢٠٢١م) ، ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ، مجلة القضاء ، مج لا يوجد ، ع٢٥ ، صفحة ٥٣٤. مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1238350
- المطيري، دعيج، (٢٠٠٦م) ، مبدأ حق الحلول- دراسة مقارنة- ، مؤتمر وثاق التأمين التكافلي ، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي ، صفحة ٦-٧. مسترجع من: https://shorturl.at/GCwN5 .
ثانيًا: المراجع والمصادر باللغة الإنجليزية:
Primary Source:
1- Legislation
- Insurance Act 2015
- Marine Insurance Act 1906
2- Court Cases
- Boag v Standard Life Assurance Co [1937] 2 KB 113
- Burnand v Rodocanachos (1882) 7 App Cas 333
- Castellain v Preston (1883) 11 QBD 380
- Commercial Union Assurance Co v Lister (1874) LR 9 Ch App 483
- Drake Insurance plc v Provident Insurance plc [2004] QB 601 (CA)
- Enimont Supply SA v Chesapeake Inc (The Surf City) [1995] 2 Lloyd’s Rep 242
- Esso Petroleum Co Ltd v Hall Russell & Co Ltd [1989] 1 Lloyd’s Rep 391
- Gard Marine and Energy Ltd v China National Chartering Co Ltd (The Ocean Victory) [2017] UKSC 35, [2017] 1 WLR 1793
- Groom v Crocker [1939] 1 KB 194
- In West of England Fire Insurance Co v Isaacs [1896] 2 QB 377, aff’d [1897] 1 QB 226
- Lord Napier and Ettrick v Hunter [1993] AC 713, [1993] 1 Lloyd’s Rep 197
- Marc Rich & Co AG v Portman Steamship Co Ltd [1996] 1 Lloyd’s Rep 430, aff’d [1997] 1 Lloyd’s Rep 225
- Royal & Sun Alliance Insurance plc v Textainer Group Holdings Ltd [2024] EWCA Civ 547
- Simpson v Thomson (1877) 3 App Cas 279
- State Government Insurance Office (Queensland) v Brisbane Stevedoring Pty Ltd (1969) 123 CLR 228 (HCA)
- Tate & Sons v Hyslop (1885) 15 QBD 368
Secondary Sources
1- Books:
- Hodges, Susan, (2013), Law of Marine Insurance, 2nd ed, London: Routledge, p. 451
- Birds, John, (1997) , Modern Insurance Law, 4th ed, London: Cavendish Publishing, p. 297–298.
- Birds, John, (2016) , Modern Insurance Law, 10th ed , London: Sweet & Maxwell, p. 39.
- Clarke, Malcolm, (2009( , The Law of Insurance Contracts , 6th ed , London: Informa, para. 27-2.
- Derham, S. R, ( 2006), Subrogation in Insurance Law, 2nd ed , Sydney: Lawbook Co , chapter 11
- Garner, Bryan , (2019), Black’s Law Dictionary, 11th ed , St Paul, MN: Thomson Reuters, p.1721
- Gilman, Jonathan, (1981), Arnold’s Law of Marine Insurance and Average, 16th ed., vol. 1, para. 320. London: Stevens & Sons Ltd.
- Goff, Robert, and Gareth Jones, )1993( , The Law of Restitution , 4th ed. London: Sweet & Maxwell , p.35
- Hansell, D , (1996) , Introduction to Insurance ,1st ed , London: XYZ Publishing , p. 203
- Hodges, S, & Carlile, R, (1999), Cases and materials on marine insurance law, London: Cavendish Publishing, p. 45.
- Lvamy, Edward, Richard, (1993) , General Principles of Insurance Law, 6th ed ,London: Butterworths, p. 49
- Meagher, Heydon, and M. J. Leeming. Equity: Doctrines and Remedies, 2nd ed. Sydney: Butterworths, 1984, para. 903.
- Merkin, Robert , (2005), Marine Insurance Legislation, 3rd ed, London: LLP, p.97.
- Merkin, Robert , (2021) , Marine Insurance: A Legal History, 1st ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 103-104.
- Rubin, Harvey ,(2008) , Dictionary of Insurance Terms , 5th ed , New York: Barron’s Educational Series , p.344
- Wood, Barbara, (2005) , Dictionary of Insurance , Oxford: Oxford University Press, p. 26
2- Academic Theses:
- Alkhudair, Motaz, (2022) , Marine Insurance in Saudi Law: A Comparative Study with English and Egyptian Law , PhD diss, University of Exeter, p. 196 Available at: https://figshare.le.ac.uk/articles/thesis/Fundamental_Principles_in_Saudi_Arabia_s_Marine_Insurance_Law_with_Reference_to_the_Law_and_Practice_in_Egypt_and_the_UK_A_Comparative_Study/21695180?file=38476094
- Li, Tian (2012) , Right of Subrogation in Marine Insurance: A Comparative Study of English and Chinese Law , Master’s thesis, Lund University, p.20 . Available at: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/2862826
Noussia, Kyriaki, (2004) , The Principle of Indemnity in Marine Insurance Contracts: A Comparative Study , PhD thesis, University of Southampton,p.192.
- Sanming ,Chen , (1999) , Subrogation in the Law of Marine Insurance, PhD diss, University of Southampton, p. 22. Available at: https://eprints.soton.ac.uk/464287/1/771824.pdf
3- Working Papers
Bird, Richard , )2021(, Subrogation in Insurance Law, Journal of Insurance Law, vol 30, no. 4, p.192.
- Merkin, Robert , and Aybüke Naz Durmuş , (2022) , Subrogation of Maritime Claims , NUS Centre for Maritime Law Working Paper , University of Reading, October , p.24.
-
طه، مصطفى كمال ، (١٩٩٢) ، التأمين البحري: الضمان البحري ، لايوجد رقم طبعه ، بيروت: الدار الجامعية ، صفحة ٥ .
-
Merkin, Robert , (2021) , Marine Insurance: A Legal History, 1st ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 103-104.
-
ابن منظور، (١٩٩٩م) ، لسان العرب ، ط ٣ ، ( بيروت: دار إحياء التراث العربي) صفحة ١٦٧
- الرازي ، ز ، (١٩٩٩م) ، القاموس المحيط ، )بيروت ، لبنان : المكتبة المصرية الدار النموذجية )، صفحة ٢٦. ↑
-
Wood, Barbara, (2005) , Dictionary of Insurance , Oxford: Oxford University Press, p. 26.
- الذيابي ، خالد بن مرزوق ، (٢٠٢١م) ، ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ، مجلة القضاء ، مج لا يوجد ، ع٢٥ ، صفحة ٥٣٤. مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1238350 ↑
-
Birds, John, (2016) , Modern Insurance Law, 10th ed , London: Sweet & Maxwell, p. 39.
-
أبو ضيف ، آسر، (٢٠٢٤م) ، القانون البحري بين النظرية والتطبيق وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي ، (الرياض: دار اجادة للنشر والتوزيع) ، صفحة٢٤٤.
-
[2004] QB 601.
- Insurance Act (2015), section (14),(1) “Any rule of law permitting a party to a contract of insurance to avoid the contract on the ground that the utmost good faith has not been observed by the other party is abolished”. ↑
-
Marine Insurance Act 1906, section, (17) “A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good faith” .
- See at, section 40 – Explanatory Notes to the Insurance Act 2015:”The duty of fair presentation replaces the existing duties in relation to disclosure and representations contained in sections 18, 19 and 20 of the 1906 Act. However, it retains essential elements of those provisions. It is important that potential insureds provide insurers with the information they require to decide whether to insure a risk, and on what terms.” Available at https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/4/notes . ↑
- Insurance Act 2015, section 3(1): “Before a contract of insurance is entered into, the insured must make to the insurer a fair presentation of the risk.” ↑
- آبادي ، الفيروس ، (٢٠٠٥م) ، القاموس المحي، . ج3، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 37. ↑
- ابن منظور، مرجع سابق، الصفحة 163. ↑
- Hansell, D , (1996) , Introduction to Insurance ,1st ed , London: XYZ Publishing , p. 203 ↑
-
( (Rubin, Harvey ,(2008) , Dictionary of Insurance Terms , 5th ed , New York: Barron’s Educational Series , p.344
-
أبو سرحان، أحمد شحده ، (٢٠١٦) ، مبدأ الحلول في التأمين التجاري الإسلامي ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، مج ٤٣ ، ع٣ ، صفحة ١٤٤٤.
- ( (Garner, Bryan , (2019), Black’s Law Dictionary, 11th ed , St Paul, MN: Thomson Reuters, p.1721 ↑
- ( (Li, Tian, (2012) , Right of Subrogation in Marine Insurance: A Comparative Study of English and Chinese Law , Master’s thesis, Lund University, p.20 . Available at: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/2862826 ↑
-
هلسا، أيمن أديب، أبو عرابي ، (١٩٩٨م) ، حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول عند تحقق الخطر ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، عمان ، صفحة ٥٠. مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/554499 .
-
Noussia, Kyriaki (2004) , The Principle of Indemnity in Marine Insurance Contracts: A Comparative Study , PhD thesis, University of Southampton,p.192.
-
Bird, Richard, )2021(, Subrogation in Insurance Law, Journal of Insurance Law, vol 30, no. 4, p.192.
-
أبو عرابي، غازي، (٢٠٢٤م)، أحكام التأمين وفقًا للنظام السعودي دراسة مقارنة ، ط١ ، الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع ، صفحة ٢١٥.
-
المطيري، دعيج، (٢٠٠٦م) ، مبدأ حق الحلول دراسة مقارنة ، مؤتمر وثاق التأمين التكافلي ، صفحة ٦-٧ ، مسترجع من: https://shorturl.at/GCwN5.
- المرجع السابق، صفحة ١٠. ↑
-
الدين ، أحمد شرف، (١٩٩١م)، أحكام التأمين: دراسة في القانون والقضاء المقارنين ، ط ٣ ، (القاهرة: نادي القضاة ) ، صفحة ٣٣٢.
-
مكي، إبراهيم ، (١٩٧٣م) ، دعوى المسؤولية على الناقل البحري ، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر ، صفحة 49.مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/564903
- نصت المادة (٢٠) الفقرة (أ) “جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له “. ↑
- قرار ابتدائي رقم ١٧٢/ر/١٤٣٤هـ صادر عن اللجنة الابتدائية بالرياض، بتاريخ ١٠/٦/١٤٣٤هـ، منشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. نقلًا عن: أبو عرابي، أحكام التأمين وفقًا للنظام السعودي – دراسة مقارنة- ، مرجع سابق ، صفحة ٢١٧ . مسترجع من: https://www.idc.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx. ↑
-
موسى، خالد السيد محمد عبدالمجيد، (٢٠٢٣م) ، أحكام الالتزام وفقًا لنظام المعاملات المدنية السعودي الجديد ، (الرياض: دار الكتاب الجامعي للنشر التوزيع) ، صفحة ٣٥٤.
- Hansell, p.19 ↑
- Goff, Robert, and Gareth Jones, )1993( , The Law of Restitution , 4th ed. London: Sweet & Maxwell , p.35 ↑
-
Meagher, Heydon, and M. J. Leeming. Equity: Doctrines and Remedies, 2nd ed. Sydney: Butterworths, 1984, para. 903.
- وقد طُرِح هذا النقد في أكثر من قضية، حيث أثيرت الشكوك بشأن الطبيعة الإنصافية لحق الحلول،على سبيل المثال، في قضية Burnand v Rodocanachi، صرّح اللورد فيتز جيرالد عن تحفظه على الأساس لإنصافي لهذا الحق، في حين أكد اللورد رايت على سبيل المثال، في قضية Boag v Standard أن حق الحلول يُشكّل بندًا جوهريًا في وثيقة التأمين، مما يدل على طبيعته التعاقدية. وقد أيّد القاضي سكوت هذا الاتجاه في ذات القضية، مشيرًا إلى أن للمؤمن حقًا تعاقديًا في أي تعويض يحصل عليه المؤمن له من طرف ثالث.
Sanming ,Chen , (1999) , Subrogation in the Law of Marine Insurance, PhD diss, University of Southampton, p. 22. Available at: https://eprints.soton.ac.uk/464287/1/771824.pdf ↑
-
Clarke, Malcolm, (2009( , The Law of Insurance Contracts , 6th ed , London: Informa, para. 27-2.
-
موسى، خالد السيد محمد عبد المجيد، (٢٠٢٥م)، الأحكام العامة لعقد التأمين في النظام السعودي، الرياض: دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، صفحة ٢٢٢.
-
Parkinson, Mark , (2013), Insurance Law , 4th ed, London: Sweet & Maxwell , p.777.
-
مرسي، محمد كمال، (٢٠٠٥م)، شرح القانون المدني، العقود المسماة عقد التأمين، (مصر: منشأة المعارف) ، صفحة ٢٦٢.
- يُعد مصطلح ((Dominus Litis مصطلحًا لاتينيًا يُستخدم في الفقه والقضاء بمعنى سيد الدعوى أو صاحب الحق في مباشرة الدعوى القضائية، ويُقصد به الطرف الذي يملك السيطرة القانونية الكاملة على مجريات الدعوى، وله سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بها، مثل رفعها، توجيهها، تسويتها أو التنازل عنها. وفي سياق عقود التأمين، يُعتبر المؤمن له هو Dominus Litis طالما لم يتم تعويضه من قبل شركة التأمين، لأنه لا يزال يحتفظ بالحق القانوني المباشر في مواجهة الطرف الثالث المتسبب في الضرر. فطالما لم تُدفع له قيمة التعويض، تبقى له صفة الطرف المتضرر، وبالتالي يكون له الحق في رفع الدعوى باسمه الشخصي، وله حرية التصرف فيه
Susan, Houdge , (2013), Law of Marine Insurance, 2nd ed, London: Routledge, p. 451 ↑
- Birds, John, (1997) , Modern Insurance Law, 4th ed, London: Cavendish Publishing, p. 297–298. ↑
-
Lvamy, Edward, Richard, (1993) , General Principles of Insurance Law, 6th ed ,London: Butterworths, p. 49.
- [1937] 2 KB 113 ↑
- Ibid, at 122. ↑
-
أبوعرابي ، غازي خالد أحمد ، (١٩٩٨) ، حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغير المسؤول عن تحقق الخطر ، رسالة تأمين ، مج١ ، ع٣ ، صفحة ١٦. مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/100849 .
-
أبو عرابي، أحكام التأمين وفقًا لنظام السعودي، مرجع سابق، صفحة ٢٢٣.
-
[1989]3 WLR 730.
- Merkin, Robert , (2005), Marine Insurance Legislation, 3rd ed, London: LLP, p.97. ↑
- See: Castellain v. Preston, (1883) 1 QBD 380 at 388, per Brett L. J,” where he said that the
doctrine of subrogation must be carried to the extent …as between the insurer and the assured,
that the underwriter is entitled to the advantage of every right of the assured, whether such right
consists in contract, fulfilled or unfiilfilled, or in remedy for capable of being insisted on or
already insisted on”. ↑
-
)1877) 3 App. Cas. 279
-
Ibid, at 284.
-
Ibid, at 286.
- [2017] UKSC 35, para. 105. ↑
-
Sanming , p.110
-
Ibid
-
[1995] 2 Lloyd’s Rep 242.
- Hodges, S, & Carlile, R, (1999), Cases and materials on marine insurance law, London: Cavendish Publishing, p. 45. ↑
-
[2024] EWCA Civ 547
-
[1993] AC 713; [1993] 1 Lloyd’s Rep 197; [1993] 1 All ER 385
- اللجنة الابتدائية لتسوية المنازعات والمخالفات التأمينية القرار رقم (81/ر/1435هـ) لعام 2014م، والمؤيد بقرار الاستئناف رقم (181/أ/1435هـ) لعام 2014. ↑
-
[1896] 2 QB 377 affd. [1897] 1 QB 226.
-
(1874) L.R. 9 Ch App. 483, at (486–487)
- “The legal scholar Derham addressed this obligation in a separate chapter of his book, under the title Duties of the Insured, emphasizing that any conduct by the insured which prejudices the insurer’s rights constitutes a breach of the legal and ethical obligations arising from the insurance contrac”.
Derham, S. R, ( 2006), Subrogation in Insurance Law, 2nd ed , Sydney: Lawbook Co , chapter 11 ↑
- Merkin, Robert, and Aybüke Naz Durmuş (2022) , Subrogation of Maritime Claims , NUS Centre for Maritime Law Working Paper , University of Reading, October , p.24 ↑
-
(1969) 123 CLR 228
-
Merkin, Rob, and Aybüke Naz Durmuş , Subrogation of Maritime Claims. p. 23
-
( 1885) 15 QBD 368. See also Marc Rich & Co AG v Portman [1996] 1 Lloyd’s Rep 430, a point which did not arise on appeal: [1997] 1 Lloyd’s Rep 225.
-
Merkin, Rob, and Aybüke Naz Durmuş , Subrogation of Maritime Claims, p. 23.
- أكدت لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بمحافظة جدة حيث جاء في القرار قرار اللجنة الابتدائية رقم (62/ج/1429هـ)، على ما يلي: “طالما قامت شركة التأمين بجبر الضرر للمؤمن له، فإنها تحل محل المؤمن له في مطالبة المسؤول بالتعويض عن النقص في البضاعة المملوكة للمؤمن له.” وقد صدر هذا القرار بتاريخ ٤/٨/١٤٢٩ هـ ، وتم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. نقلًا عن: غازي أبو عرابي، أحكام التأمين وفقًا للنظام السعودي – دراسة مقارنة-، مرجع سابق، صفحة ٢٢٦. مسترجع من: https://www.idc.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx. ↑
-
صادق، طارق عفيفي، (٢٠٢٤م)، عقد التأمين وفقًا لنظام المعاملات المدنية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤هـ، لا يوجد رقم طبعة، الرياض: دار الاجادة ، صفحة ١٥٣.
-
المرسى زهرة، محمد (٢٠٠٦)، أحكام عقد التأمين، ط١، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة ٢٧٠.
-
(1882) 7 App. Cas. 333, at 339.
-
(1882) 7 App Cas 333 (HL)
-
وفقًا للمادة (٤٥) “على الشركة تكون إدارة لتسوية المطالبات ووضع إجراءات محددة لاستقبال مطالبات العملاء ودراستها وإنهائها، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء ودراستها وإنهائها، كما يجب على الشركة الاحتفاظ بملفات خاصة بمطالبات العملاء وتقسيمها إلى مطالبات مدفوعة، ومطالبات تحت الدراسة أو التسوية، ومطالبات مرفوضة، بحيث يشمل كل ملف الآتي”
وجاءت الفرقة (٧) توكيلًا رسميًا من المؤمن له للشركة في الحلول محله عند:
(أ) مطالبة أي طرف آخر بالتعويض عن الخسارة التي تسبب بها.
(ب) القيام بالدفاع عن المؤمن له في درء مسؤوليته أوي في تحديد مبلغ التعويض.
-
[1989] 1 AC 643، [1989] AC 643، [1989] 1 All ER 37، [1989] 1 Lloyds Rep 8، [1989] 1 All ER 37.
-
Sanming, p.139.
-
[1939] 1 KB 194.
- “Meanwhile, the editors submitted that there is no reason in principle why a settlement reached in advance of the payment by the underwriters, if made by the third party with knowledge that its effect is to prejudice their rights, should not also be treated as void. It may also open to the underwriters, in an appropriate case, to claim damages in their own right against the third party for tortious interference with their rights under the contract of insurance”.
Gilman, Jonathan, (1981), Arnold’s Law of Marine Insurance and Average, 16th ed., vol. 1, para. 320. London: Stevens & Sons Ltd. ↑
-
وفقًا للمادة (٣١) من مسودة تعليمات التغطية التأمين البحري الصادرة من البنك المركزي السعودي ٥/٧/٢٠٢٣م ” يخضع أي نزاع ينشأ عن تغطيات التأمين البحري للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيها لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني”.
-
قرار الاستئناف رقم (76/أ) لعام 2015م، اللجنة القضائية لتسوية المنازعات التأمينية، الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، المملكة العربية السعودية. نقلًا عن:
Alkhudair, Motaz (2022) , Marine Insurance in Saudi Law: A Comparative Study with English and Egyptian Law , PhD diss, University of Exeter, p. 196 ↑
-
وفقًا للمادة (٢٢١) الفقرة (١) ” لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم”.
- تُصنف بضائع بحرية، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة (345) من النظام البحري التجاري حيث نصّت: ” إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة، سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك”. ↑
-
وفقًا للمادة (١١) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار رقم (١٩٠) وتاريخ ٩/٥/١٤٣٥ هـ ” لا تسمع الدعاوي في المنازعات التأمينية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجان”.