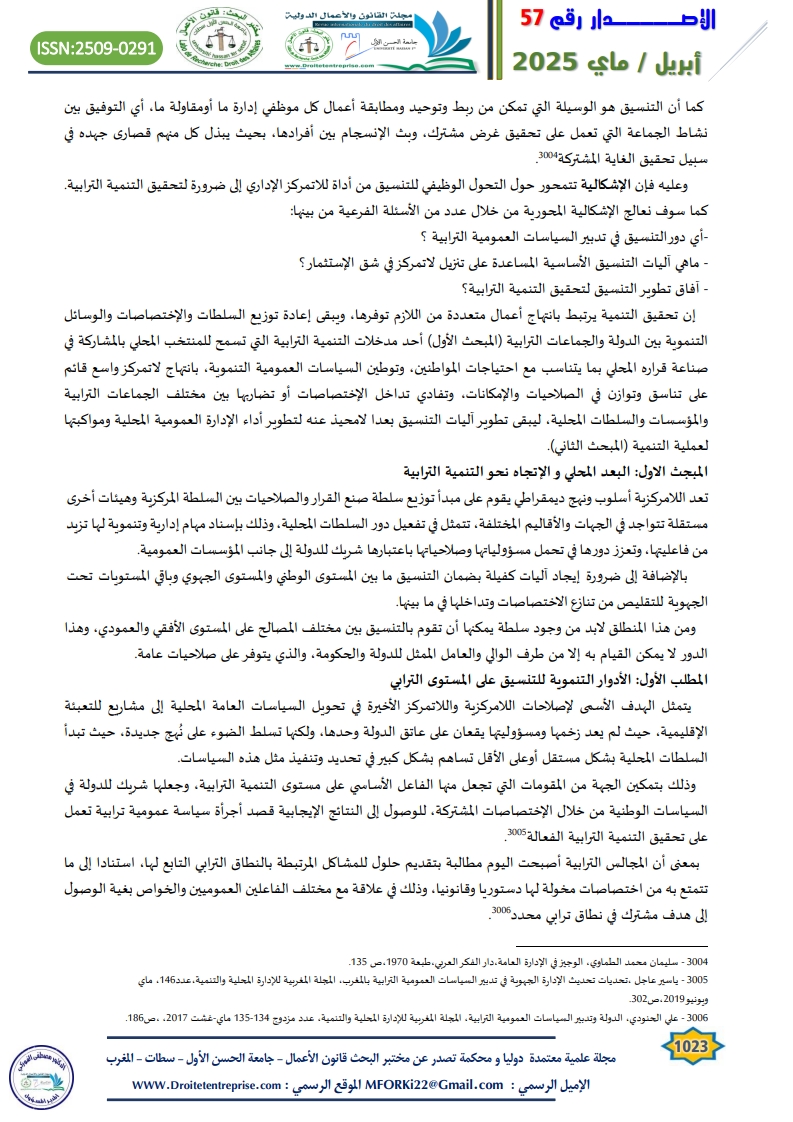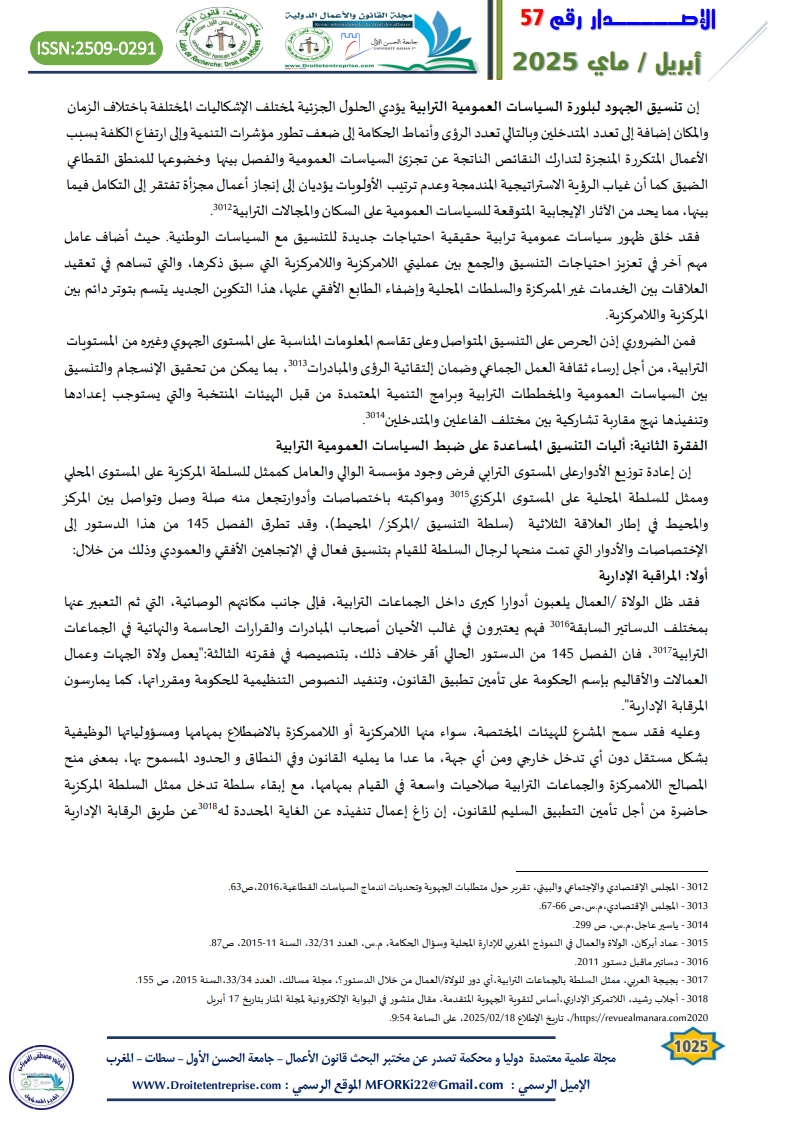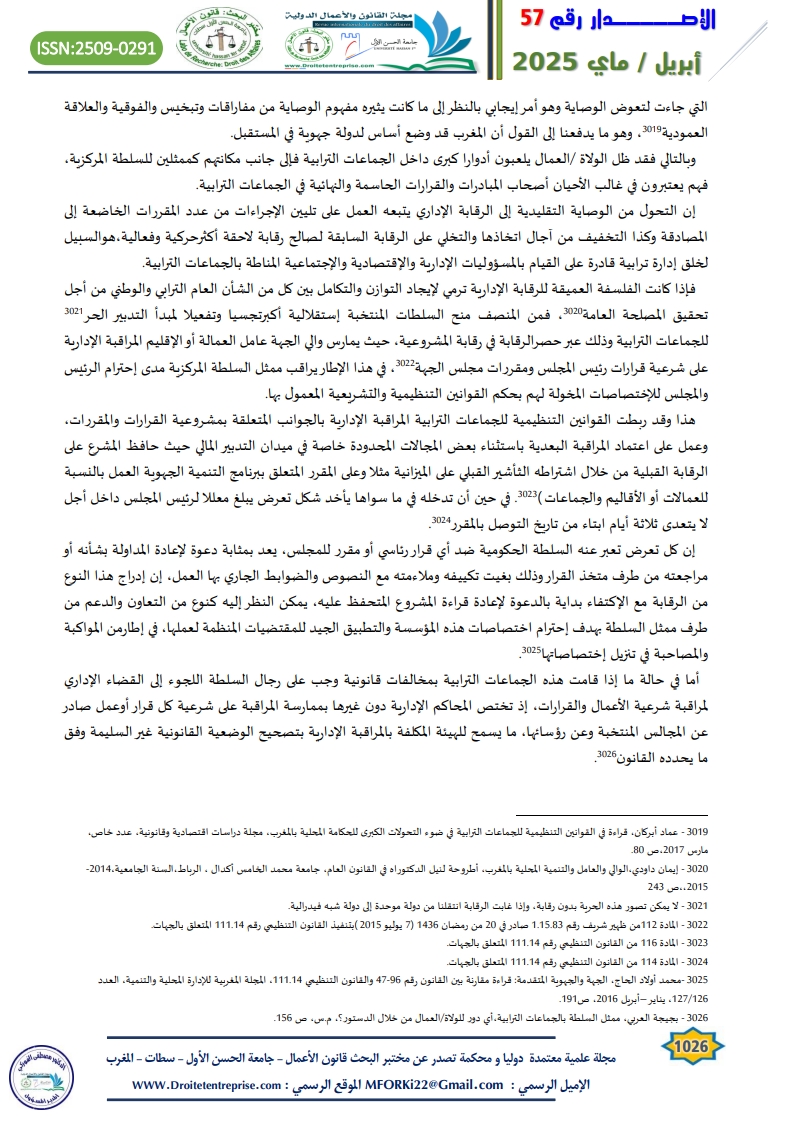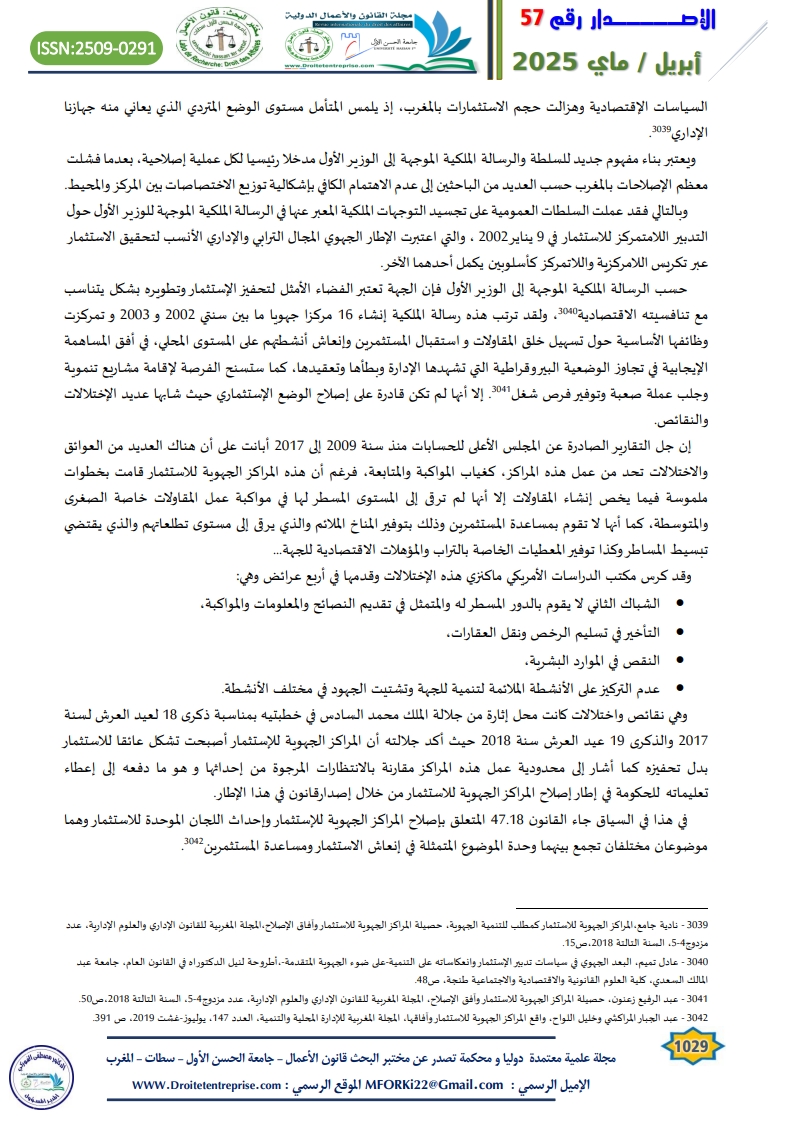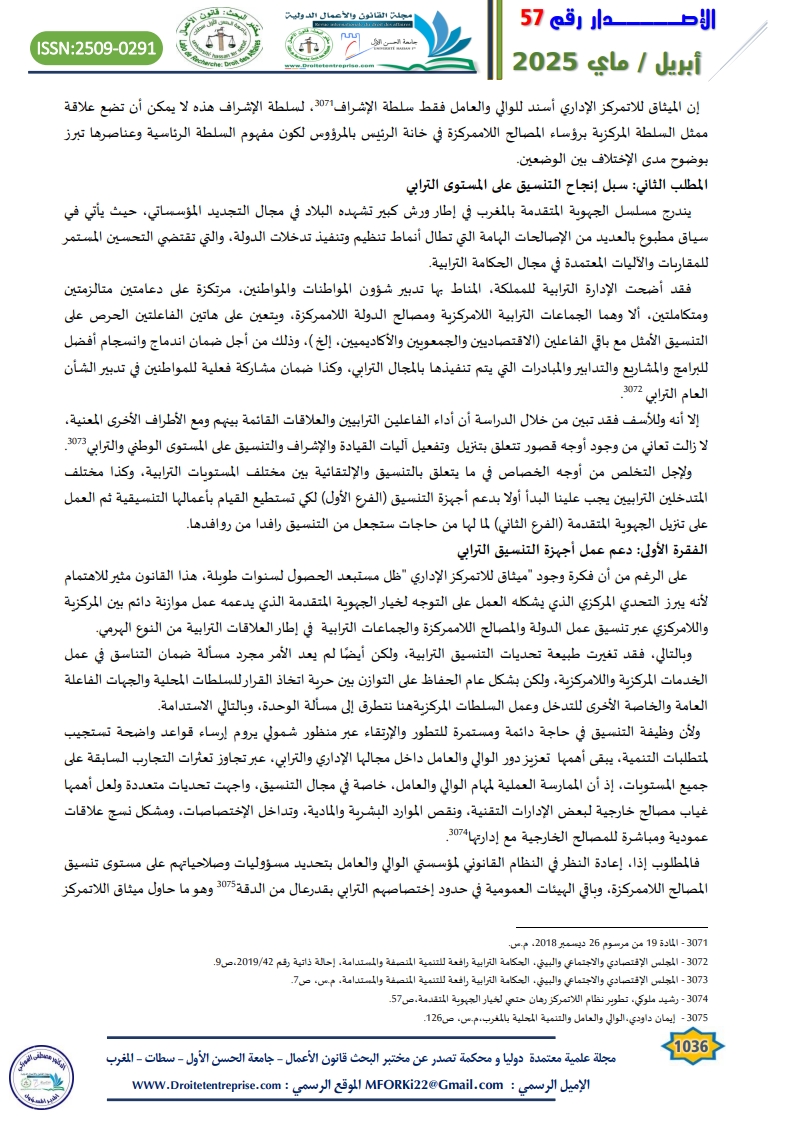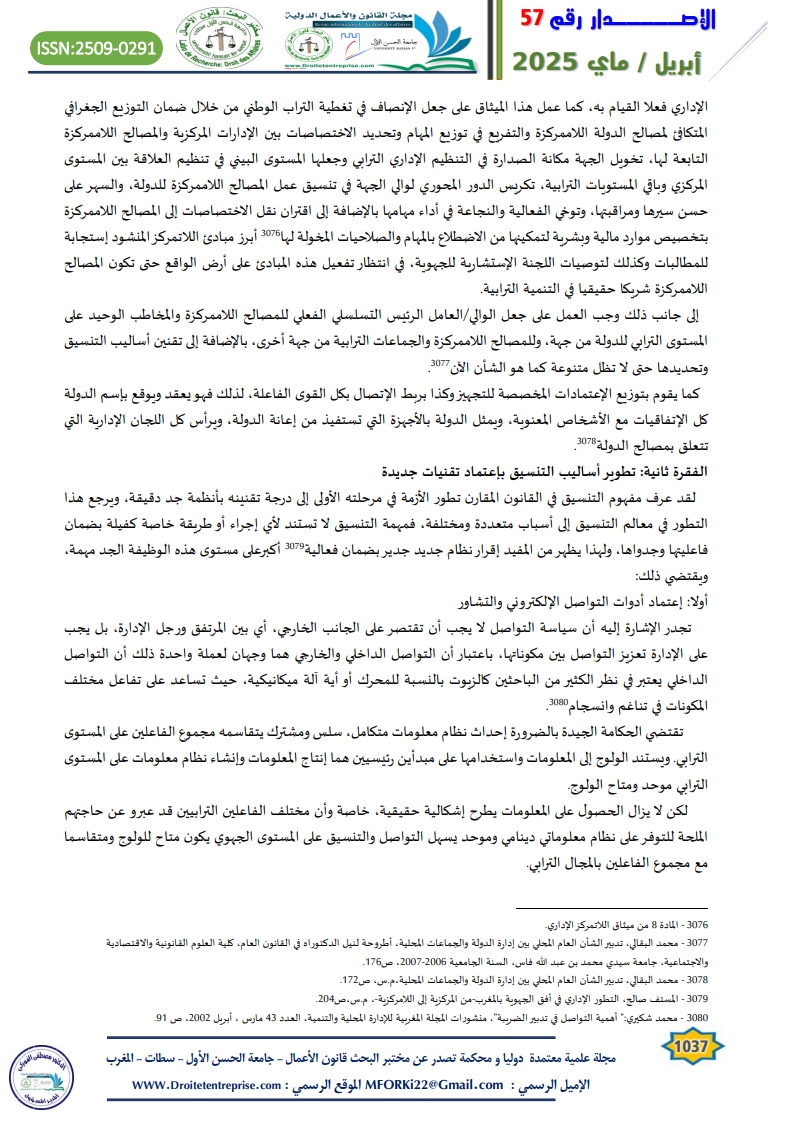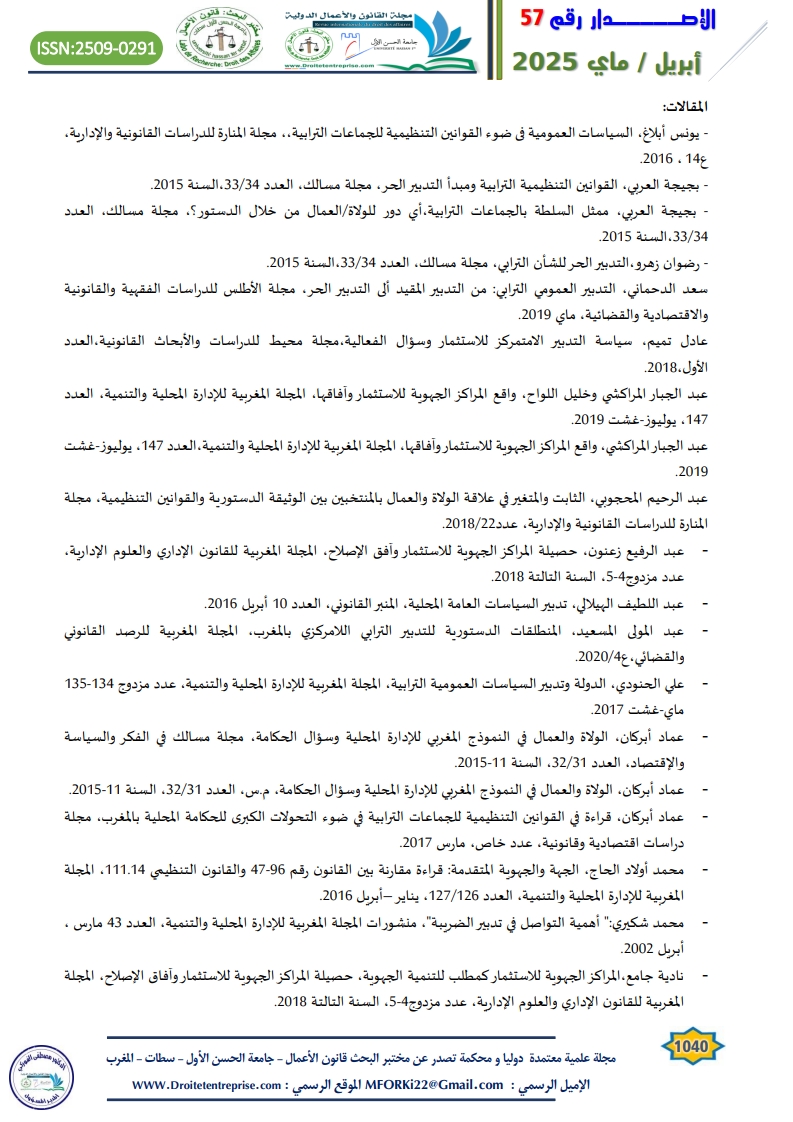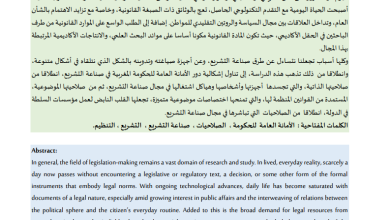التنسيق كآلية أساسية لتنزيل البرامج التنموية – الباحثة : زينب العشابي – الباحث : حسام مراس
التنسيق كآلية أساسية لتنزيل البرامج التنموية
Coordination as a key mechanism for implementing development” “programmes
الباحثة : زينب العشابي
باحثة بسلك الدكتوراه، مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية
الباحث : حسام مراس
باحث في المالية العمومية
رابط DOI
https://doi.org/10.63585/XIHU3154
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
ملخص:
تهدف هذه الورقة إلى إبراز الدورالمحوري لممثل السلطة المركزية على مستوى تنزيل وتفعيل برامج التنموية الترابية من خلال آلية التنسيق، عبر توضيح الأهمية التدبيرية والقانونية لهذه الآلية في ما يتعلق بالسياسات العمومية الترابية إلى جانب تفعيل الاستثمار على المستوى المحلي، من خلال التوفيق بين مراكز القرار وخلق نوع من التجانس بين الفاعلين الترابين، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج المرجوة بالكفاءة وحسن الأداء والحد من التكرار والتغرات في السياسات والبرامج المتعلق بشق التنمية على المستوى الترابي.
الكلمات المفتاحية: اللاتمركز الإداري- اللجنة الجهوية لتنسيق-التنمية الجهوية -المركز الجهوي للاستثمار- الولاة والعمال.
Abstract:
This paper aims to highlight the pivotal role of the representative of the central authority at the level of downloading and activating territorial development programs through the coordination mechanism, by clarifying the administrative and legal importance of this mechanism in relation to territorial public policies, as well as activating investment at the local level, through reconciling decision centers and creating a kind of homogeneity among the regional actors, in order to reach the desired results with efficiency and good performance and reduce repetition and changes in policies and programs related to the development at the territorial level.
Key words: Administrative Decentralisation – Regional Coordination Committee – Regional Development – Regional Investment Centre – Governors and Workers.
مقدمة
عرفت الإدارات المحلية تطورا كبيرا من خلال التحول الكبير في مهامها والتغير في طرق تدخلاتها، وهو تطور يعزى بالأساس للإنفتاح الواسع على الحريات العامة وإرساء قواعد الديموقراطية.
هذا التحول من دولة لحفظ النظام والأمن العامين والسهرعلى تطبيق واحترام القوانين، إلى دولة تقوم بجانب وظائفها التقليدية بوظائف جديدة كالتأطير، والبحث، والتنشيط، والتشجيع، والمراقبة، والتدخل في مختلف الميادين المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية،[1]جاء ردا عن المسؤوليات التي أضحت الدولة مطالبة بها سواء على المستوى الداخلي من إيجاد الحلول لإشكالية التنمية، فرض البحث عن مقاربة فعالة لتصريف مختلف الإكراهات التي تواجهها الدولة، دون تشتيت صرحها وكيانه[2].
غير أن النهوض بهذه الأعباء والوظائف يقتضي وضع ضوابط على المستوى المركزي وإشراك المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية في تصريف الشؤون العامة، إذ يستحيل عمليا أن تقوم الإدارة المركزية لوحدها بضمان حسن تدبير هذه الوظائف، خاصة أمام تعدد وتشعب الإحتياجات العمومية[3]، الأمر الذي وجد صداه على مستوى الإدارة المغربية، حيث عرفت هذه الأخيرة منذ الإستقلال وإلى يومنا تطورا كبيرا[4] وصولا إلى الإستجابة لتوسيع مهامها وتدخلاتها في المجالين الإقتصادي والإجتماعي، وهكذا تضاعفت الإدارات المركزية و الجماعات الترابية، وأجهزة التدخل العمومي أو الشبه عمومي على مختلف الأصعدة[5].محاولت بذلك خلق إدارة ترابية قادرة على التدبير الأمثل للتنمية الترابية.
إذا فالتنمية الترابية تستوجب التشاور حول الأهداف وتنسيق الأعمال بين جميع الفاعلين والمعنيين بها، عبر اعتماد برامج مترابطة ومتراصة للتنمية معدة ومنجزة بفضل الجهود المشتركة للمسؤولين الإداريين على المستوى الترابي، لضمان إنجاز مختلف الأوراش والمشاريع على صعيد الجهوي والمحلي، وضمان فعالية التدابير المتخذة وذلك بصهر كل المجهودات في نسق واحد تحقيقا للوحدة والفعالية[6].
ويفترض في التدبير الناجح أن يكون النسق العام متراص البناء محكم التناسق على مستوى بنياته الداخلية ووظائفها، حيث علاقات التفاعل بين البنيات بعضها البعض والوظائف بعضها البعض غير مختلفة والكل يصب في غاية واحدة وهي الوظيفة الأساس التي من أجلها وجد التنسيق والتي تتمثل في حسن التدبير للشأن المحلي[7]، فالتدبير عمل وظيفي يتأتى من خلال مختلف مجالات التدخل المسموح للجماعات الترابية حيث يتم استخدام عدة وسائل هي أدوات عمل فنية وبشرية لبنيات تنتظم بحسب ما تقيمه فيما بينها من روابط ضمن البنية العامة أو النسق العام.
الأمر الذي يفرض وجود قيادة إدارية قادرة على تحقيق وحدة العمل وتحقيق التناغم بين المصالح الترابية بحيث يعمل على تجنب القرارات المزدوجة وكذا التنافر بينها ماقد يتسبب في ضياع الوقت والجهد، ويؤمن لها استعمالا جيدا للموارد المالية والوسائل المادية والبشرية، علاوة على قيامه بتحكيم نزاعات الشركاء وتزويدهم بالقرارات والتدابير المناسبة عند الضرورة.
من حيث المبدأ فإن سلطة التنسيق تؤول بشكل طبيعي إلى أمناء السلطة وذلك في معظم الأنظمة الأساسية، والذين يسهرون على حماية المصالح الوطنية في حدود دوائر نفوذهم[8]، أما المغرب فقد أناط وظيفة التنسيق بداية بالعامل ثم الوالي بعد ذلك لكونهما يتواجدان بشكل مباشر أوغيرمباشر في معظم الأنشطة المعهودة للمستوى المحلي، إن على مستوى إدارة المركزية أوعلى مستوى الإدارة اللامركزية، بمستوياتها التلاث[9]. كما يستمد تلك القيمة من خلال اعتباره مؤسسة قائمة بذاتها، بفعل الموقع التي يحتله في البناء الإداري المغربي ودعامة لعدم التركيز الإداري.
كما أن التنسيق هو الوسيلة التي تمكن من ربط وتوحيد ومطابقة أعمال كل موظفي إدارة ما أومقاولة ما، أي التوفيق بين نشاط الجماعة التي تعمل على تحقيق غرض مشترك، وبث الإنسجام بين أفرادها، بحيث يبذل كل منهم قصارى جهده في سبيل تحقيق الغاية المشتركة[10].
وعليه فإن الإشكالية تتمحور حول التحول الوظيفي للتنسيق من أداة للاتمركز الإداري إلى ضرورة لتحقيق التنمية الترابية.
كما سوف نعالج الإشكالية المحورية من خلال عدد من الأسئلة الفرعية من بينها:
-أي دورالتنسيق في تدبير السياسات العمومية الترابية ؟
– ماهي آليات التنسيق الأساسية المساعدة على تنزيل لاتمركز في شق الإستثمار؟
– آفاق تطوير التنسيق لتحقيق التنمية الترابية؟
إن تحقيق التنمية يرتبط بانتهاج أعمال متعددة من اللازم توفرها، ويبقى إعادة توزيع السلطات والإختصاصات والوسائل التنموية بين الدولة والجماعات الترابية (المبحث الأول) أحد مدخلات التنمية الترابية التي تسمح للمنتخب المحلي بالمشاركة في صناعة قراره المحلي بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وتوطين السياسات العمومية التنموية، بانتهاج لاتمركز واسع قائم على تناسق وتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الإختصاصات أو تضاربها بين مختلف الجماعات الترابية والمؤسسات والسلطات المحلية، ليبقى تطوير آليات التنسيق بعدا لامحيذ عنه لتطوير أداء الإدارة العمومية المحلية ومواكبتها لعملية التنمية (المبحث الثاني).
المبجث الاول: البعد المحلي و الإتجاه نحو التنمية الترابية
تعد اللامركزية أسلوب ونهج ديمقراطي يقوم على مبدأ توزيع سلطة صنع القرار والصلاحيات بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة تتواجد في الجهات والأقاليم المختلفة، تتمثل في تفعيل دور السلطات المحلية، وذلك بإسناد مهام إدارية وتنموية لها تزيد من فاعليتها، وتعزز دورها في تحمل مسؤولياتها وصلاحياتها باعتبارها شريك للدولة إلى جانب المؤسسات العمومية.
بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آليات كفيلة بضمان التنسيق ما بين المستوى الوطني والمستوى الجهوي وباقي المستويات تحت الجهوية للتقليص من تنازع الاختصاصات وتداخلها في ما بينها.
ومن هذا المنطلق لابد من وجود سلطة يمكنها أن تقوم بالتنسيق بين مختلف المصالح على المستوى الأفقي والعمودي، وهذا الدور لا يمكن القيام به إلا من طرف الوالي والعامل الممثل للدولة والحكومة، والذي يتوفر على صلاحيات عامة.
المطلب الأول: الأدوار التنموية للتنسيق على المستوى الترابي
يتمثل الهدف الأسمى لإصلاحات اللامركزية واللاتمركز الأخيرة في تحويل السياسات العامة المحلية إلى مشاريع للتعبئة الإقليمية، حيث لم يعد زخمها ومسؤوليتها يقعان على عاتق الدولة وحدها، ولكنها تسلط الضوء على نُهج جديدة، حيث تبدأ السلطات المحلية بشكل مستقل أوعلى الأقل تساهم بشكل كبير في تحديد وتنفيذ مثل هذه السياسات.
وذلك بتمكين الجهة من المقومات التي تجعل منها الفاعل الأساسي على مستوى التنمية الترابية، وجعلها شريك للدولة في السياسات الوطنية من خلال الإختصاصات المشتركة، للوصول إلى النتائج الإيجابية قصد أجرأة سياسة عمومية ترابية تعمل على تحقيق التنمية الترابية الفعالة[11].
بمعنى أن المجالس الترابية أصبحت اليوم مطالبة بتقديم حلول للمشاكل المرتبطة بالنطاق الترابي التابع لها، استنادا إلى ما تتمتع به من اختصاصات مخولة لها دستوريا وقانونيا، وذلك في علاقة مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص بغية الوصول إلى هدف مشترك في نطاق ترابي محدد[12].
الفقرة الأولى: دورالتنسيق في تدبير السياسات العمومية الترابية
تقدم الجهوية المتقدمة الإطار المؤسساتي وتوزع المهام والأدوار والوسائل بين الدولة والجماعات الترابية ولا يعني ذلك رسم حدود فاصلة بين اختصاصات كل طرف وتسييجه كمجال محفوظ ، وإنما يعني بالأحرى تحري العقلنة في تنظيم المهام لبلوغ نفس الهدف، ذلك أن مختلف الفاعلين لن يتمكنوا من رفع التحديات، إلا إذا تضافرت جهودهم في إطار من الانسجام والتكامل[13].
تكون مدخلا لانخراط الوحدات اللامركزية في صياغة سياسات عمومية ترابية يشعر بها المواطن، وبالتالي تتميم لامركزية العمل العمومي التي تم إقرارها في المغرب بشكل متدرج مع تبني اللامركزية الترابية، وفي هذا الإطار فقد ارتبط مفهوم السياسات العمومية الترابية باختيار الجماعات الترابية كشريك في التنمية، ما قوى هو الآخر من الدعوة الى اعتماد أسلوب اللامركزية الإدارية في إدارة الشأن العام المحلي، بجعل المؤسسات والمرافق اللاممركزة هدفا وليس غاية في إدارة التراب المحلي، وتنميته سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي[14].
السياسات العمومية هي مجموعة منسجمة ومنظمة من الخدمات العمومية التي تُعنى بأكثر من قرار، عبر مجموع من التدخلات المتعلقة بهدف مُوجه، تحدده جماعة مُعينة، في منطقة ترابية محددة، وتندرج في إطارتحرير سلطة المبادرة المحلية التي طالما ظلت محتوية في تصاميم تهيمن عليها النزعة المركزية.
كما تصاغ فيما تتنازل عنه الدولة من اختصاصات للوحدات اللامركزية، خصوصا، أن بلورة السياسات العمومية تقترن في هذا الشأن بما يقدمه كل متدخل، وما ينتجه في الزمان والمكان[15] وبالتالي تتحقق السياسات العمومية الترابية بتدخل الجماعات العمومية، سواء كانت جماعات ترابية أو مصالح لاممركزة في إعمار المجال وضبطه، وجعلها وسيلة إنتاج المبادرة المحلية في سياسة واحدة تجمع كل التدخلات والمتدخلين.
إن إتخاذ أي قرار تنموي يجب أن يمر باستشارة الجميع بما في ذلك الفاعلين الآخرين وإشراكهم في العمل بشكل فعلي وحقيقي، ولا نود هنا أن نغفل الأهمية القصوى لوضوح الإختصاصات، فكلما كان هناك عدم تداخل وتشابك الإختصاصات كلما كانت الإلتقائية في البرامج العمومية حاضرة.
فلا شك أن الأمر يُولد تراكم ترابي فوق نفس الرقعة الترابية، ثم تراكم وظيفي لوسائل للسياسات العمومية الترابية)المخططات والتصاميم الجماعية والإقليمية والجهوية( كما أن التحديد الجيد والناجح للاختصاصات سيخفف ولا شك من هذا التراكم، وهي المسألة التي صعب تداركها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ما لم تحدد وتنصص على مخطط التماسك الترابي الذي يحفظ تنسيق التدخلات في الفضاء الجهوي.
وهو الطرح الذي يقود لوسيلة الحكامة الترابية التي تؤكد على تعدد الروابط والتدخلات، سواء على مستوى التنسيق أو التنافس بين كل الفاعلين والمتدخلين القادرين على تنظيم سياسات تكون نتاج المبادرة الترابية دون حاجة للد ولة[16].
وتضطلع العلاقة بين مختلف المؤسسات والجماعات الترابية وخاصة طبيعة العلاقة بين رئيس الجهة ووالي الجهة والعمال ورؤساء مجالس الوحدات الترابية الثلاثة بدورهام على مستوى التنشيط والتنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل كسب الرهانات المذكورة ذلك أن التفاهم والتعاون والتضامن بين هذه المؤسسات يؤدي إلى التكامل والتناسق بين تدخلات كل من السلطات العمومية والجهة والجماعات الترابية الأخرى.
فقيام الولاة والعمال بالدور الأساسي في تحقيق تناغم والتقائية توجهات المتدخلين على الصعيد الترابي، يؤدي إلى عدم الإضرار بالتنمية وخلق دينامية مجالية قادرة على تحقيق التنسيق بين مختلف السياسات العمومية[17].
إن تنسيق الجهود لبلورة السياسات العمومية الترابية يؤدي الحلول الجزئية لمختلف الإشكاليات المختلفة باختلاف الزمان والمكان إضافة إلى تعدد المتدخلين وبالتالي تعدد الرؤى وأنماط الحكامة إلى ضعف تطور مؤشرات التنمية وإلى ارتفاع الكلفة بسبب الأعمال المتكررة المنجزة لتدارك النقائص الناتجة عن تجزئ السياسات العمومية والفصل بينها وخضوعها للمنطق القطاعي الضيق كما أن غياب الرؤية الاستراتيجية المندمجة وعدم ترتيب الأولويات يؤديان إلى إنجاز أعمال مجزأة تفتقر إلى التكامل فيما بينها، مما يحد من الآثار الإيجابية المتوقعة للسياسات العمومية على السكان والمجالات الترابية[18].
فقد خلق ظهور سياسات عمومية ترابية حقيقية احتياجات جديدة للتنسيق مع السياسات الوطنية. حيث أضاف عامل مهم آخر في تعزيز احتياجات التنسيق والجمع بين عمليتي اللامركزية واللامركزية التي سبق ذكرها، والتي تساهم في تعقيد العلاقات بين الخدمات غير الممركزة والسلطات المحلية وإضفاء الطابع الأفقي عليها، هذا التكوين الجديد يتسم بتوتر دائم بين المركزية واللامركزية.
فمن الضروري إذن الحرص على التنسيق المتواصل وعلى تقاسم المعلومات المناسبة على المستوى الجهوي وغيره من المستويات الترابية، من أجل إرساء ثقافة العمل الجماعي وضمان إلتقائية الرؤى والمبادرات[19]، بما يمكن من تحقيق الإنسجام والتنسيق بين السياسات العمومية والمخططات الترابية وبرامج التنمية المعتمدة من قبل الهيئات المنتخبة والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها نهج مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين[20].
الفقرة الثانية: أليات التنسيق المساعدة على ضبط السياسات العمومية الترابية
إن إعادة توزيع الأدوارعلى المستوى الترابي فرض وجود مؤسسة الوالي والعامل كممثل للسلطة المركزية على المستوى المحلي وممثل للسلطة المحلية على المستوى المركزي[21] ومواكبته باختصاصات وأدوارتجعل منه صلة وصل وتواصل بين المركز والمحيط في إطار العلاقة الثلاثية (سلطة التنسيق /المركز/ المحيط)، وقد تطرق الفصل 145 من هذا الدستور إلى الإختصاصات والأدوار التي تمت منحها لرجال السلطة للقيام بتنسيق فعال في الإتجاهين الأفقي والعمودي وذلك من خلال:
أولا: المراقبة الإدارية
فقد ظل الولاة /العمال يلعبون أدوارا كبرى داخل الجماعات الترابية، فإلى جانب مكانتهم الوصائية، التي ثم التعبير عنها بمختلف الدساتير السابقة[22] فهم يعتبرون في غالب الأحيان أصحاب المبادرات والقرارات الحاسمة والنهائية في الجماعات الترابية[23]، فان الفصل 145 من الدستور الحالي أقر خلاف ذلك، بتنصيصه في فقرته الثالثة:”يعمل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بإسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيد النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المرقابة الإدارية”.
وعليه فقد سمح المشرع للهيئات المختصة، سواء منها اللامركزية أو اللاممركزة بالاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها الوظيفية بشكل مستقل دون أي تدخل خارجي ومن أي جهة، ما عدا ما يمليه القانون وفي النطاق و الحدود المسموح بها، بمعنى منح المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية صلاحيات واسعة في القيام بمهامها، مع إبقاء سلطة تدخل ممثل السلطة المركزية حاضرة من أجل تأمين التطبيق السليم للقانون، إن زاغ إعمال تنفيذه عن الغاية المحددة له[24]عن طريق الرقابة الإدارية التي جاءت لتعوض الوصاية وهو أمر إيجابي بالنظر إلى ما كانت يثيره مفهوم الوصاية من مفاراقات وتبخيس والفوقية والعلاقة العمودية[25]، وهو ما يدفعنا إلى القول أن المغرب قد وضع أساس لدولة جهوية في المستقبل.
وبالتالي فقد ظل الولاة /العمال يلعبون أدوارا كبرى داخل الجماعات الترابية فإلى جانب مكانتهم كممثلين للسلطة المركزية، فهم يعتبرون في غالب الأحيان أصحاب المبادرات والقرارات الحاسمة والنهائية في الجماعات الترابية.
إن التحول من الوصاية التقليدية إلى الرقابة الإداري يتبعه العمل على تليين الإجراءات من عدد المقررات الخاضعة إلى المصادقة وكذا التخفيف من آجال اتخاذها والتخلي على الرقابة السابقة لصالح رقابة لاحقة أكثرحركية وفعالية،هوالسبيل لخلق إدارة ترابية قادرة على القيام بالمسؤوليات الإدارية والإقتصادية والإجتماعية المناطة بالجماعات الترابية.
فإذا كانت الفلسفة العميقة للرقابة الإدارية ترمي لإيجاد التوازن والتكامل بين كل من الشأن العام الترابي والوطني من أجل تحقيق المصلحة العامة[26]، فمن المنصف منح السلطات المنتخبة إستقلالية أكبرتجسيا وتفعيلا لمبدأ التدبير الحر[27] للجماعات الترابية وذلك عبر حصرالرقابة في رقابة المشروعية، حيث يمارس والي الجهة عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة[28]، في هذا الإطار يراقب ممثل السلطة المركزية مدى إحترام الرئيس والمجلس للإختصاصات المخولة لهم بحكم القوانين التنظيمية والتشريعية المعمول بها.
هذا وقد ربطت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، وعمل على اعتماد المراقبة البعدية باستثناء بعض المجالات المحدودة خاصة في ميدان التدبير المالي حيث حافظ المشرع على الرقابة القبلية من خلال اشتراطه الثأشير القبلي على الميزانية مثلا وعلى المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية العمل بالنسبة للعمالات أو الأقاليم والجماعات )[29]. في حين أن تدخله في ما سواها يأخد شكل تعرض يبلغ معللا لرئيس المجلس داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام ابتاء من تاريخ التوصل بالمقرر[30].
إن كل تعرض تعبر عنه السلطة الحكومية ضد أي قرار رئاسي أو مقرر للمجلس، يعد بمثابة دعوة لإعادة المداولة بشأنه أو مراجعته من طرف متخذ القرار وذلك بغيت تكييفه وملاءمته مع النصوص والضوابط الجاري بها العمل، إن إدراج هذا النوع من الرقابة مع الإكتفاء بداية بالدعوة لإعادة قراءة المشروع المتحفظ عليه، يمكن النظر إليه كنوع من التعاون والدعم من طرف ممثل السلطة بهدف إحترام اختصاصات هذه المؤسسة والتطبيق الجيد للمقتضيات المنظمة لعملها، في إطارمن المواكبة والمصاحبة في تنزيل إختصاصاتها[31].
أما في حالة ما إذا قامت هذه الجماعات الترابية بمخالفات قانونية وجب على رجال السلطة اللجوء إلى القضاء الإداري لمراقبة شرعية الأعمال والقرارات، إذ تختص المحاكم الإدارية دون غيرها بممارسة المراقبة على شرعية كل قرار أوعمل صادر عن المجالس المنتخبة وعن رؤسائها، ما يسمح للهيئة المكلفة بالمراقبة الإدارية بتصحيح الوضعية القانونية غير السليمة وفق ما يحدده القانون[32].
ثانيا: مساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية
لقد أناط الفصل 101 من دستور 1996 مهمة تنفيذ مداولات مجالس الجهات والعمالات والأقاليم بالولاة والعمال، ماساهم بتقوية وضعيتهم بالمقابل تقييد حرية الجماعات الترابية، وهو مابيرز التفاوت وترجيح سلطة الوالي والعامل على رؤساء المجالس المنتخبة، حيث تبقى وظيفة التدبير المنصوص عليها دستوريا في صالح الوالي، في ظل غياب تمايز وظيفي واضح بين هذا الأخير وممثل الساكنة في الإختصاصات يوحي بعدم وجود فصل بين المؤسستين الدستوريتين.
كما أن ضمانات استقلالية السلطة المنتخبة عن السلطة المركزية تظهر ضعيفة نظرا لغياب تنظيم دستوري للعلاقة بين الدولة والجماعات الترابية، ما يؤكد ثانوية هذه العلاقة، بل على سمو السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية[33].
على خلاف دستور 1996 الذي كان يمنح لممثل السلطة المركزية تنفيذ مقررات المجالس المنتخبة فدستور 2011 حمل تصورا جديدا للتنظيم الترابي يسعى لتوسيع سلطات الوحدات الترابية في تدبير القضايا التنموية، بما يتيح للمجالس المنتخبة كامل الحرية في تحديد اختياراتها وبرامجها، بشكل يعزز قيم الديمقراطية وسيادة القانون[34]، فمن شأن تحصين هذه الإستقلالية من قبل المشرع الدستوري أن يضمن إنخراط الجماعات الترابية في تدبير فعال للمجال الترابي، ما يسمح لها بتبوأ مكانة حقيقية ودور ريادي في إطار التنمية الإقتصادية والإجتماعية المحلية[35]، وبالتالي تجاوز نواقص وعيوب الفترة السابقة التي أفرزتها الممارسة العملية من أجل تصحيح انحرافاتها وتقويمها.
إن السلطة التنظيمية[36] الممنوحة للمجالس الترابية والمنصوص عليها في الفصل 140 من الدستور هي سلطة يؤهلها القانون رغم أنها ثانوية حيث أن السلطة التنظيمية الوطنية هي الأصل، على العكس من ذلك فسلطة الولاة والعمال ورغم أهميتهاهي سلطة مخولة كممثلين للدولة ومتدخلين بإسم الحكومة فيما تخص العلاقة التي تربطهم بالدولة، وبالتالي فسلطة الحكم الضرورية لتنظيم وتدبير الوحدات والمؤسسات الترابية تشكل اختصاصا مبدئي وليس اختصاصا ممنوح[37]، وهو مايفسر ترجيح المشرع منح إختصاص التنفيذ لرئيس الجماعة الترابي على ممثل السلطة المركزية رغم النقاش الفقهي الحاد في هذا المجال[38].
بالرجوع للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تمتل مرجع أساسي ومؤطر لإختصاصات الجماعات وصلاحية مجلسها ورئيسها، نجد أن المادة 83 من القانون 111.14 تنص على أنه يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسه خلال السنة الأولى من مدة انتدابه، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أوإنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة و وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية[39].
وعلى نفس المنوال أضحى رئيس المجلس الجهوي بموجب المادة 88 من القانون 111.14 المشرف الأول على وضع التصميم الجهوي لإعداد التراب في إطار توجهات السياسة العامة على المستوى الوطني في هذا المجال بعد أن كانت مهامه منحصرة في إبداء الرأي بخصوص السياسات المتعلقة بإعداد التراب الوطني[40] زيادة على الإعداد، فإن الرئيس أصبح مسؤولا عن تنفيذه بمساعدة والي الجهة تطبيقا للفصل 145من الدستور.
اعتبارا لما سبق، يمكننا القول أنه أصبح لرؤساء المجالس الترابية وزن داخل المجال الترابي، فإسناد مثل هذه الإختصاصات لهم يعد نقلة نوعية، وخطوة أخرى في درب الجهوية، إلا أن السؤال الذي يطرح هل المجالس الترابية بتركيبتها وإمكاناتها الحالية قادرة على تنزيل وأجرأة مثل هذه الإختصاصات؟
إن الغرض من تخويل الوالي والعامل دور المساعد راجع لعدم توفر الإدارة الجهوية على الإمكانيات التي تمكنها من القيام بمهامها، لذلك تخذ شكل المساعدة من طرف ممثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية إتاحة استخدام الموارد البشرية أو المادية أو التقنية التي يتطلبها تنفيذ هذا البرنامج، بالإضافة إلى تقديم الآراء والخبرات والتوجيهات التي يطلبها التنزيل السليم للمشاريع والمخططات التنموية، إنطلاقا مما يمتلكه هذا الأخير من اختصاصات تنظيمية في تنسيق استثمارات وأنشطة الإدارات اللاممركزة، خصوصا وأنهم يرأسون المراكز الجهوية للإستثمار[41].
فمثل هذه التدابير من شأنها تعزيز العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية،إذ مافتئ رؤساءها يشتكون من غياب شريك حقيقي يمثل الدولة ويملك سلطة القرار على المستوى الترابي؛ فبفعل الإجراءات المسطرية المعمول بها، كثيرا ما يكون الرجوع الى الإدارة المركزية بشأن العديد من القضايا المحلية المطروحة إجباريا هذا في الوقت الذي سيكون من الأفضل، من حيث التكلفة وسرعة وحسن الأداء، معالجتها على المستوى المحلي[42].
هذه الوضعية الجديدة ستضع المنتخبين أمام مسؤولياتهم، لأن النظام السابق كان يسمح لهم بالتحرر من أية مسؤولية وذلك بالإحتماء وراء الوالي أو العامل الذي كان سلطة تنفيذية للإقليم والجهة، كما كانت له سلطات مراقبة على أعمال الجماعات الترابية في ظل النظام الجديد السلطة التنفيذية هي موكولة لرئيس الجهة والإقليم والمراقبة موكولة للقضاء الذي يمارس مراقبة مستمرة على كل الأعمال بما في ذلك السلطة التنظيمية الممارسة من طرف السلطات اللامركزية[43] .
المطلب الثاني: التنسيق وتفعيل الإستثمار
لقد أبانت سياسة التدبير المركزي كمقاربة لحل إشكالية الاستثماروتشجيعه عن محدوديتها وعجزها في تخطي صعوبات وعوائق العملية الإستثمارية ونتيجة عدم مد جسورالتواصل بين السلطة اللامركزية واللاممركزة ونظرا للأهمية الاستراتيجية التي يحتلها المفهوم يعتبرالاستثمار آلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأداة ناجعة للاندماج في الاقتصاد العالمي[44]، حيث سارعت الدول بما فيها المغرب لإدخال إصلاحات نوعية على أنظمتها الإدارية والاقتصادية بما يتيح التحول إلى نظام لامتمركز للإستثمار.
الفقرة الأولى: التدبير اللاتمركز شق لإستثمار –السياق والدلالات
من المؤكد أن تجارب المغرب في ميدان الإستثمار قد راكمت العديد من العوائق حدت من استقدام الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، كما حال جميع المجالات الإجتماعية الأخرى إن الطابع المتشعب لمساطر إحداث المقاولات بالمغرب، ومشكل إقتناء العقارات وإلزامية حصول الأجانب على تأشيرة الخروج والعودة عند مغادرة التراب الوطني، كلها أسباب أدت إلى تعثر السياسات الإقتصادية وهزالت حجم الاستثمارات بالمغرب، إذ يلمس المتأمل مستوى الوضع المتردي الذي يعاني منه جهازنا الإداري[45].
ويعتبر بناء مفهوم جديد للسلطة والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول مدخلا رئيسيا لكل عملية إصلاحية، بعدما فشلت معظم الإصلاحات بالمغرب حسب العديد من الباحثين إلى عدم الاهتمام الكافي بإشكالية توزيع الاختصاصات بين المركز والمحيط.
وبالتالي فقد عملت السلطات العمومية على تجسيد التوجهات الملكية المعبر عنها في الرسالة الملكية الموجهة للوزير الأول حول التدبير اللامتمركز للاستثمار في 9 يناير 2002، والتي اعتبرت الإطار الجهوي المجال الترابي والإداري الأنسب لتحقيق الاستثمار عبر تكريس اللامركزية واللاتمركز كأسلوبين يكمل أحدهما الآخر.
حسب الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول فإن الجهة تعتبر الفضاء الأمثل لتحفيز الإستثمار وتطويره بشكل يتناسب مع تنافسيته الاقتصادية[46]، ولقد ترتب هذه رسالة الملكية إنشاء 16 مركزا جهويا ما بين سنتي 2002 و 2003 و تمركزت وظائفها الأساسية حول تسهيل خلق المقاولات و استقبال المستثمرين وإنعاش أنشطتهم على المستوى المحلي، في أفق المساهمة الإيجابية في تجاوز الوضعية البيروقراطية التي تشهدها الإدارة وبطأها وتعقيدها، كما ستسنح الفرصة لإقامة مشاريع تنموية وجلب عملة صعبة وتوفير فرص شغل[47]. إلا أنها لم تكن قادرة على إصلاح الوضع الإستثماري حيث شابها عديد الإختلالات والنقائص.
إن جل التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2009 إلى 2017 أبانت على أن هناك العديد من العوائق والاختلالات تحد من عمل هذه المراكز، كغياب المواكبة والمتابعة، فرغم أن هذه المراكز الجهوية للاستثمار قامت بخطوات ملموسة فيما يخص إنشاء المقاولات إلا أنها لم ترقى إلى المستوى المسطر لها في مواكبة عمل المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، كما أنها لا تقوم بمساعدة المستثمرين وذلك بتوفير المناخ الملائم والذي يرقى إلى مستوى تطلعاتهم والذي يقتضي تبسيط المساطر وكذا توفير المعطيات الخاصة بالتراب والمؤهلات الاقتصادية للجهة…
وقد كرس مكتب الدراسات الأمريكي ماكنزي هذه الإختلالات وقدمها في أربع عرائض وهي:
- الشباك الثاني لا يقوم بالدور المسطر له والمتمثل في تقديم النصائح والمعلومات والمواكبة،
- التأخير في تسليم الرخص ونقل العقارات،
- النقص في الموارد البشرية،
- عدم التركيز على الأنشطة الملائمة لتنمية للجهة وتشتيت الجهود في مختلف الأنشطة.
وهي نقائص واختلالات كانت محل إثارة من جلالة الملك محمد السادس في خطبتيه بمناسبة ذكرى 18 لعيد العرش لسنة 2017 والذكرى 19 عيد العرش سنة 2018 حيث أكد جلالته أن المراكز الجهوية للإستثمار أصبحت تشكل عائقا للاستثمار بدل تحفيزه كما أشار إلى محدودية عمل هذه المراكز مقارنة بالانتظارات المرجوة من إحداثها و هو ما دفعه إلى إعطاء تعليماته للحكومة في إطار إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال إصدارقانون في هذا الإطار.
في هذا في السياق جاء القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار وهما موضوعان مختلفان تجمع بينهما وحدة الموضوع المتمثلة في إنعاش الاستثمار ومساعدة المستثمرين[48].
الفقرة الثانية: آليات التنسيق المساعدة على تنزيل لاتمركز الإستثمار
لقد نص خطاب جلالة الملك على أهمية اللاتمركزالإداري في تقليص حجم الظاهرة البيروقراطية، والتقريب الوظيفي للإدارة من المواطنين والمستثمرين، فقد أولى عناية خاصة في رسالته الموجهة إلى الوزير الأول بضرورة تفويض العديد من السلطات إلى الولاة، و ذلك كإجراء عملي إلى جانب إحداث المراكز الجهوية للاستثمار، نظرا لما يتطلبه الاستثمار من سرعة في اتخاذ القرارات، فالدعوة الملكية إلى توسيع دائرة التفويضات تهدف إلى إدخال قيم جديدة وأشكال حديثة لاتخاذ القرار عبر قنوات الاتصال والحوار[49] ويعتبر تقوية الدور التنسيقي للوالي أحد هذه القنوات.
أولا: رئاسة الوالي للمراكز الجهوية للإستثمار
إن التزام المغرب بتحصين وتعزيز ماتم تحقيقه من مكتسبات في مجال التنمية المستدامة وإنعاش الإستثمار، دفع بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في آليات التدبير المركزي بالنسبة لهياكل الإدارة على الصعيد اللامركزي، وذلك بإعطاء والي الجهة قدرا كافيا من الصلاحيات، وتوسيع اختصاصاته وعقلنة طرق عمله، قصد تمكينه من توجيه جهوده على نحو أفضل من تنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية[50].
وفي هذا الإطار،عملت الحكومة على ملائمة التمثيلية الترابية للمراكز الجهوية للإستثمار مع التقسيم الجهوي الجديد، مع إحداث ملحقات لجعلها أكثر قربا ووضع آليات جديدة لتخويل هاته المراكز صلاحيات ومهام جديدة وفق نمودج يتماشى مع الجهوية المتقدمة.
إذا كان المركز الجهوي للاستشمار هو المؤسسة التي راهنت عليها السلطات العمومية لتدبير الاستثمار على المستوى الترابي فإن ذلك لم يكون إلا تحت سلطة وإشراف أعلى سلطة تقريرية بالجهة المتمثلة في مؤسسة الوالي.
ومن تم واعتبارا لتموقعه في أعلى هرم السلطة على الصعيد الترابي لكونه ممثل السلطة المركزية والذي يشكل أول فاعل اقتصادي، فهو بذلك يضطلع بمهام أساسية في ميدان الإستثمار إذ أنه يتوفر على نظرة شاملة ودقيقة حول ميادين التنمية وذلك بالارتكاز على مجموعة من المعطيات والمؤهلات التي تختزنها منطقته[51]، وهذا من شأنه أن يؤهله محاورا فعليا لمختلف المصالح التابعة للدولة والتي تدخل في إنجازالمشاريع الاستثمارية، وهو ما يمثل جوهر وظيفة التنسيق في مجال الاستثمار.
ولضمان تقوية الوظيفة التنسيقية للوالي عمل القانون رقم 47.18 المتعلق بإحداث المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الموحدة للإستثمار[52] على توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار التي يرأسها لتمكينه من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين.
ونص القانون أيضا على إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل كافة اللجان الجهوية والمحلية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار.
ويعهد إلى هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة، البت في طلبات الرخص والقرارات والإجراءات الادارية اللازمة لانجاز المشاريع الاستثمارية وكذا في طلبات الاستثناء في مجال التعمير، والتي حدد القانون شروط وكيفيات معالجتها ومنح الرخص المتعلقة بها للمستثمرين.
كما تعتبر القرارات المتخذة على مستوى اللجنة التي تتكون من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، ملزمة لكافة أعضائها وللإدارات التي ينتمون إليها[53].
يمكن للوالي من خلال موقع متقدم يمكنه من ضمان تدبير لامركزي للاستثمارات حيث يعتبر إحدى الآليات المستعملة في مجال السياسات الاقتصادية لتحفيزالاستثمار وتبسيط آلياته ويمكن إعتبارالتدبير اللامتمركزللأستثمار مجموعة التدابير اللازمة للقضاء على جمود الإدارة الاقتصادية وتكسير الحواجز المعيقة للاستثمار بتفويض عملية إتخاذ القرار الإقتصادي من المركز إلى المحيط[54]، ومن تم فهو لا يعتبر مجرد إجراء تقني يسمح بتجاوز المعيقات وتحقيق الأهداف، وإنما فلسفة تندرج ضمن الأسس الكبرى للتحول جعلت منه شرط للبحث عن نجاعة أكبر للعمل الإداري وإعطاء اللاتمركز مبرراته الاقتصادية[55].
غير أن منح الولاة والعمال صلاحيات مهمة يجب أن يلازمه أليات التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين عبر قيادة عمل متواصل وحوار دائم مع كل المعنيين وتجاوز الهاجس الأمني إلى الهاجس الاقتصادي والاجتماعي في إطار الرؤية الجديدة للجهوية المتقدمة.
ثانيا: تفويض الإختصاص في مجال الإستثمار لممثل السلطة المركزية
ترتب عن الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول أنا ذاك حول التدبير اللامتمركز للاستثمار،
مجموعة من الإجراءات القانونية التي تشمل الآليات اللازمة لإنعاش الاقتصاد الجهوي، هذه الإجراءات تكتسي طبيعة قانونية تجلت في إصدار مجموعة من المراسيم والقرارات الوزارية[56]، والتي من خلالها تم التفويض لولاة الجهات مجموعة من الاختصاصات الضرورية لإنعاش الاستثمار الجهوي[57]، وتمت عملية التفويض على أربع مستويات:
- المستوى الأول: التفويضات من المصالح المركزية للوزارت إلى المصالح الجهوية؛
- المستوى الثاني: التفويضات من المصالح المركزية إلى الولاة؛
- المستوى الثالث: التفويضات من وزارة الداخلية إلى الولاة؛
- المستوى الرابع: التفويضات من الولاة إلى العمال.
يتعلق الأمر بمجموعة من القرارات المهمة أوالتي ترتبط خاصة بالأنشطة والإنتاجية والإستمرارية إذ يتعين على أعضاء الحكومة والموظفون السامون في الإدارة المركزية أن يفوضوا لهم الصلاحيات اللازمة بإسم الدولة.
وبالإضافة إلى الاختصاصات الممنوحة للعامل فقد عملت الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار من تعزيز سلطاته، وذلك بتركيزها على نوع أخر من التفويضات، وهي تفويضات من الوالي إلى العامل وقد نصت الرسالة الملكية على كون العمال يتحملون مسؤوليتهم كاملة لدى الولاة في تطبيق السياسة المتعلقة بالاستثمار، كما تم إلزامهم إلى جانب الولاة على المشاركة الفعالة في تفعيل سياسة اللاتركيز، والعمل على إعداد البنيات اللازمة حتى يمكن أن تمارس على صعيدي العمالة والإقليم الاختصاصات التي ستمارس في مرحلة أولى على الصعيد الجهوي[58].
وفي المقابل لقد وجهت سهام النقد لمجموع السلطات المفوضة للوالي والعامل في مجال التدبير اللامتمركز للإستثمار حيث اعتبرها البعض تقليصا لسلطة الحكومة وتساءلوا عما إذا كان الاستثمار في حاجة إلى تفويضه للولاة، وهل يمكن تسريع وثيرة الإستثمار بسلطة مركزية تستقوي بكل السلط باعتبار الولاة ليسوا بمجالس منتخبة ولا هم بحكومة تحاسب أمام البرلمان[59]، بينما ذهب البعض الآخر إلى إثارة “البعد الإقتصادي لهذه التفويضات”، ما سيمكن المستثميرين والمنعشين العقاريين من التوجه لمخاطب وحيد يتمتح بسلطة حقيقية تمكنهم من إخراج مشاريعهم إلى أرض الواقع، بل هناك إجماع على ضرورة تفعيل البعد الجهوي للتدبير وذلك بتهيء ظروف جيدة لجلب الإستثمار[60].
وأخيرا فتفويض السلطة للولاة تأكيد لروح سياسة اللاتمركز الإداري في بعدها الإقتصادي والتي تقوم على مبدأ توزيع الإختصاصات، وهذه الحمولة تعطي لتوافق اللامركزية مع اللاتمركز تطبيقا ملموسا[61].
المبحث الثاني: آفاق تطوير التنسيق لتحقيق التنمية الترابية
إن المجال الترابي اليوم في حاجة إلى تجديد أساليبه التدبيرية وإعطاءها الواقعية اللازمة، والتنسيق كغيره من الأساليب التدبيرية يتطلب بحثا مستمرا ومتجددا عن الوسائل والآليات والمناهج الكفيلة بتطويرها حتى تصبح قاعدة راسخة في النشاط الإداري اليومي وتعطي القائد الإداري أدوات عملية للقيام بمهامه التنسيقية (المطلب الثاني ) على أن الطموح في تطوير هذه الأدوات يلزمنا أولا بتجاوز العوائق (المطلب الأول ).
المطلب الأول: واقع العلاقة بين السلطة المركزية و المصالح اللاممركزة
يتبين من خلال تشخيص واقع التنسيق الإداري، أنه مازال يعاني من عدة إختلالات وأعطاب تؤثر على تطوره وتحول دون تحقيقه للأهداف المرجوة، ويمكن إجمال هذه العراقيل في:
الفقرة الأولى: الهيمنة المركزية على صناعة القرارالترابي
يقصد بهيمنة الإدارة المركزية على مراكز القرار حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة في أيدي الإدارات المركزية في العاصمة، فطبيعة السلطة المركزية في المغرب لا تسمح بوجود فاعل محلي حقيقي قادر على صناعة القرار الترابي بعيدا عن هيمنة الفاعل المركزي[62] وهو مايظهر من خلال مركزية إتخاذ القرارات (الفقرة الأولى) و هيمنتها على الوسائل المالية والبشرية (الفقرة الثانية).
أولا: تنامي المركزية المفرطة على مستوى اتخاذ القرار
من المعلوم أن العقليات والسلوكات لا تتطور بنفس إيقاع تطور النصوص والمؤسسات لهذا يغدو من الضروري كما هو الشأن في أي عملية للتغيير انخراط مجموع الفاعلين واستيعابهم الجيد للإصلاح وتملكهم مبادئه وأهدافه وإدراكهم لتداعياته على اعتبار أن هذا الانخراط يشكل تحديا كبيرا وعاملا أساسيا في إنجاح المرحلة الأولية لإطلاق عملية الإصلاح، بل وفي إنجاح كل المراحل اللاحقة من عملية التفعيل.
فتجدر التركيز الإداري لا يعود فقط إلى كون مسؤولي الإدارة المركزية يرفضون توزيع سلطاتهم واختصاصاتهم، بل يرجع أيضا إلى تخوف ممثلي الإدارة اللامركزية من المسؤولية و تهربهم من تحمل الأعباء الإدارية وفي الوقت الذي نجد فيه المسؤولين المركزيين يرفضون التنازل عن اختصاصاتهم ويحاولون استرجاعها دائما، لإعتبارهم ذلك تنقيصا من قيمتهم ومسا بشخصيتهم فإن الموظفين في الإدارة الترابية يفضلون البقاء تحت مسؤولية الإدارة المركزية نظرا لما توفره تلك الوضعية من تحرر وانفلات من تحمل المسؤوليات[63].
إن المقاربة الأحادية المبنية على التدبير الممركز والتي كان المغرب قد تبناها بعد الاستقلال لم تفسح المجال للمشاركة الديمقراطية كما أنها لم تؤدي الى تنمية حقيقية ولعل ذلك راجع إلى أن التنمية المحلية يصعب تحقيقها الفوق بل لا بد من وجود إدارة قريبة و فعالة تربط الدولة بالمجتمع المحلي مع منحها من الإمكانات ما يجعلها قادرة على الاضطلاع بمهام التنمية وهكذا وجب اتخاذ في المكان والميدان الذي تطبق فيه بواسطة المسؤولين الأقرب الى الجهة المعنية بالمشاكل المطروحة[64].
ومن المؤكد أن المغرب يتوفرعلى هيكلة مؤسساتية إدارية وسياسية، أفرزها مسلسل تشييد الدولة العصرية، حيث يعتبر تحديث نظام رجال السلطة إحدى أهم إصلاحاتها الكبرى، فإذا كانت مؤسسة العامل ومن بعدها الوالي برزت للوجود كمؤسسة مخزنية صرفة تضطلع بالحفاظ على الأمن والنظام العامين، فهي اليوم مطالبة بتحقيق التنمية الترابية وجلب الإستثمارات الوطنية والأجنبية[65].
إلا أن المركزية الشديدة في عملية صنع القرارات الإدارية وضعف تفويض السلط الشيء الذي يتسبب في العديد من الأضرار المادية والمعنوية كتأخر إنجاز العمليات الإدارية وتكدس الأعمال غير المنجزة نتيجة لانتظار موافقة المستويات العليا.[66] الأمر الذي يضعف لامحالة من القدرات التدبيرية للمدبرين الترابيين، الشيء الذي ينعكس بالسلب على تنسيق هذه المصالح .
بالإضافة إلى ذلك، لا يملك رؤساء الأجهزة اللامركزية سلطة اتخاذ القرار ولا يمكنهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه الولاة والعمال. غالبا ما يتعين عليهم العودة إلى خدماتهم المركزية وخطواتهم المصغرة لاتخاذ القرار هذه هي الأسباب الرئيسية لفشل أداة التحويلات النقدية، التي لم يسمح “تنفيذها” بتحقيق نتائج مقنعة.
ثانيا: هيمنة المركز على وسائل العمل المتعلقة بالتنسيق
إن ممارسة النشاط الإداري يتطلب إلى جانب توفر إطار قانوني ملائم، وجود وسائل عمل مادية وبشرية كفيلة بترجمة نشاط هذه المصالح، غير أن الملاحظ هو تردد الإدارات المركزية في تفويض التصرف في الإعتمادات لفائدة مصالحها اللاممركزة، وهو ما يظهر من منطوق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مرسوم اللاتركيز الإداري الذي جاء فيه أنه يمكن تعيين رؤساء المصالح غير الممركزة آمرين نوابا بالصرف للنفقات فيما يتعلق بجميع أو بعض الإعتمادات الموضوعة رهن تصرفهم.
ولتجاوز ذلك عمل الميثاق الجديد للاتمركزعلى تخويل الاعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاذ المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة، عن طريق تخويل رؤساء المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي، صفة آمرين بالصرف جهويين، لتمكينهم من تدبير الاعتمادات المرصودة لهذه المصالح[67]، نفس الإشكال يتعلق بوجود أطر مؤهلة كما وكيفا حيث عانة المصالح اللاممركزة من ضعف قدرة مواردها البشرية على التدخل واتخاذ المبادرة دونما الرجوع إلى السلطة المركزية، فإتاحة سرعة اتخاذ القرارات على المستوى المحلي تنعكس بالإيجاب على سهولة التنسيق بين الإدارات الترابية ما سينتج عنه ارتباط متناغم لورشي الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
ولأجل ذلك عمل ميثاق اللاتمركز الإداري تمكين الرؤساء المصالح اللاممركزة للدولة، من صلاحيات تدبيــر المسار المهني للمــوارد البشــرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي[68]، ما سينعكس على جودة وفعالية هذه المصالح، خصوصا أن مسيري هذه المصالح هم الأدرى بإحتياجاتها البشرية، والتخصصات التي تنقصها.
كما أن توزيع أعداد موظفي الدولة إلى غاية 2021 ما بين 31.586 موظفة وموظفا بالمصالح المركزية و496.138 موظفة وموظفا بالمصالح اللامركزية، مما يشكل نسبة لا تمركز للموظفين تصل إلى94,01%.
يوجد تفاوت كبير في التوزيع بين الجهات مع تمركز مرتفع على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة (بما في ذلك المصالح المركزية بنسبة تناهز 21% من مجموع الموظفين، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بحوالي 15.6%، ثم جهة فاس-مكناس بحوالي 12%.
ويتمركز 76% من مجموع الموظفين على مستوى ست جهات من أصل 12 جهة، وهي جهات الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس- ماسة[69].
هذا التفاوت في توزيع موظفي الدولة هو الآخر له تأثير سلبي على جودة وفعالية الخدمات العمومية، وعلى قدرة مؤسسة التنسيق على القيام بمهامها التنسيقية بناء على مبادئ الوحدة والكفاءة والفعالية.
لأجل ذلك عمل الميثاق على إعادة إنتشار الموظفين بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة من خلال تشجيع الحركية الإدارية، قصد تمكين المصالح المذكورة من التوفر على الكفاءات اللازمة التي تؤهلها للقيام بمهامها في أحسن الظروف[70].
الفقرة الثانية: العوائق القانونية والتنظيمية التي تحد من دور التنسيق
غير أن تحليلنا للعوائق التي يصطدم بها التنسيق لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يختزل في مجرد الإطار القانوني الذي رصد له، لأن هذا الأخير وإن كان عاملا محددا في توجيه هذه السلطة وتكريسها وبيان مضمونها ومداها ضمن النظام الذي ستمارس فيه، فإن وظيفة كهذه وبقدر دقتها وارتباطها الجدلي بالتنظيم الإداري ككل تتطلب رصد جميع المعطيات والمؤثرات المميزة للوسط الإداري الخاضع للتنسيق حتى نفهم الأسباب الكامنة وراء تعثر هذه العملية[71].
أولا :ضعف المقتضيات القانونية للتنسيق
بعد مرور سنوات طويلة على دخول ظهير 15 فبراير 1977 حيز التطبيق والذي شكل خطوة رائدة ونقلة نوعية في ميدان التنسيق ووظيفته بشكل عام، إلا أن القراءة المتأنية لهذا الظهير تبرز لنا وجود عدة معضلات تحول دون تحقيق وحدة وفعالية النشاط الإداري.
ومن ثم ذهب بعض الباحثين إلى اعتبار مفهوم التنسيق كما هو وارد ومنصوص عليه في النظام المغربي يعتبر مفهوما غامضا، إذ يتم تأويل مقتضيات ظهير 1977، الذي يشكل الركيزة الأساسية في هذا المجال بشكل يتسم بالعمومية، في حين أن أي نص من جملة مختلف النصوص التي تنظم اختصاصات العامل وعلاقته بالمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المحلية، لم يحدد وبدقة سلطة التنسيق المخولة للعامل، ويضع الآليات العملية لقيام هذا الأخير بحسن تدبير الشؤون المحلية، وإكساب تدخلاته الفاعلية اللازمة بما يمكن فعلا إقرار وحدة العمل وتفادي إهدار الجهد والوقت[72].
كما أن قدم المقتضى القانوني المؤطر لإختصاصات العامل “ظهير 1977″يعتبر هو الآخر عائقا أما التطبيق الجيد والفعال لهذه الوظيفة ، فبالرغم من النصوص القانونية التي جاءت لتعزيز اللاتمركز الإداري ومهمة التنسيق الموكولة لممثل السلطة المركزية، والتي لازالت تعتريها بعض الثغرات والتي تشكل بالتأكيد عائقا أمامه. ويعثبر استمرار عدم تنصيص مرسوم 26 ديسمبر 2018 على وجود سلطة رئاسية للوالي والعامل على المصالح اللاممركزة للدولة أهمها. وبالتالي فاختصاص ممثل السلطة إزاء هذه المصالح يظل محدودا، حيث تبدو هذه السلطة هشة[73].
كما أن عدم وضوح المقصود بالتنسيق هو الآخر يتسبب في إضعاف سلطة التنسيق لدى ممثل السلطة المركزية، فبالرجوع إلى المادة 24 التي أكدت على أن السلطات الحكومية هي المسؤولة عن تقييم أداء المصالح اللاممركزة المعنية، بتنسيق مع والي الجهة أوعامل العمالة أوالإقليم حسب الحالة، عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع وبرامج عمومية مشتركة بين هذه المصالح من قبل السلطات الحكومية المعنية.
لكنها لم توضح ما المقصود بالتنسيق هل هو بمشاركة الوالي أو العامل أو فقط عن طريق المساعدة أم يتم فقط توجيه نسخة عن تقرير التقييم إلى والي الجهة أو عامل العمالة أوالإقليم حسب الحالة، كما هو الحال بالنسبة لتقيم الأنشطة ذات طابع قطاعي.
عموما رغم احتفاظ ميثاق اللاتمركز الإداري للسلطات الحكومية بالحق في تقييم أداء المصالح اللاممركزة، إلى أن التنصيص على التنسيق مع ممثل السلطة المركزية عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع وبرامج عمومية مشتركة بين هذه المصالح يعتبرخطوة إيجابية نحو منح الوالي والعامل سلطة رئاسية كاملة على تلك المصالح.
ثانيا: العراقيل التنظيمية لوظيفة التنسيق
إذا كان جل الباحثين يتفقون على أهمية التنسيق لبلوغ وحدة وانسجام مختلف الهيئات والوحدات الإدارية على المستويين المركزي والترابي، إلا أن الواقع العملي والممارسة الميدانية لهذا الإختصاص تثبت أن الهدف بلوغه مازال بعيدا، فجل التدابير والإجراءات التي تم إتخاذها لم تصل بعد إلى حل المشاكل المرتبطة بالتنسيق.
ومن هذا المنطلق يمكن حصر أهم العوائق التنظيمية التي تقف عثرة أمام سلطة التنسيق”الوالي والعامل” في ما يلي:
- عدم مسايرة المصالح اللاممركزة لتطور التقسيم الإداري
لقد تم خلق المصالح اللاممركزة من أجل تقريب الإدارة من المواطنين، غير أن الملاحظ هو غياب تمثيلية بعض الوزارات على مستوى بعض الأقاليم والعمالات، لتتأكد فكرة غياب المنظور التنسيقي بين الوزارات من أجل إحداث مصالح خارجية لها، وعدم تطبيق المقاربة الشمولية لهذا الإحداث، التي تقوم بالأساس على التشاور والحوار بين مختلف المسؤولين،
إضافة إلى عائق عدم ضبط الخريطة الإدارية، باستثناء وزارة الداخلية والتي منذ 1969 وهي متوفرة على مصالح لا ممركزة بل يمكن الجزم بكونها الممثل الوحيد للدولة على ترابيا على المستويات الثلاث للجماعات الترابية[74].
ب- علاقة التبعية بين الوالي والعامل مع رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة
يعتبرغياب علاقة التبعية بين الوالي والعامل مع رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة من أبرز الأسباب التي تعيق الوظيفة التنسيقية للوالي والعامل، فعلاقة هذا الأخير بالمصالح اللاممركزة تتأثر إلى حد كبير بغياب علاقات تسلسلية بين الطرفين، فإذا كان ممثل السلطة المركزية هو الموظف الأسمى على المستوى الترابي والساهر على حسن سير شؤونه، فهو من حيث التسلسل الوظيفي يخضع للسلطة العليا لوزير الداخلية، ومن جهتها تعتبر المصالح اللاممركزة جزءا مندمجا في الوزارة التي تنشئها وبالتالي فهي خاضعة للسلطة الرئاسية للوزير التابعة له.
ومنه فإن رؤساء هذه المصالح يعتبرون ممثلين للوزارات التي ينتمون إليها ويستمدون منها جميع سلطاتهم، وبالتالي يمكنهم التخاطب معهم مباشرة دون وساطة الوالي أو العامل والذي يمكن أن يجهل في مثل هذه الأوضاع القرارات الكبرى المتخذة من قبل هذه المصالح في إطار دائرة نفوذه[75].
كما إن عدم خضوع موظفي المصالح اللاممركزة للسلطة الرئاسية للوالي أو العامل، هذه السلطة التي تخوله الحق في فرض سلطة مباشرة على موظفي هذه المصالح وأعمالهم، حيث تتجلى سلطته في التأذيب والتنقيط وإمكانية نقل المرؤوس من مصلحة إلى أخرى تبعا لمصلحة المرفق، وكذا تكليفه ببعض المهام[76].
إن الميثاق للاتمركز الإداري أسند للوالي والعامل فقط سلطة الإشراف[77]، لسلطة الإشراف هذه لا يمكن أن تضع علاقة ممثل السلطة المركزية برؤساء المصالح اللاممركزة في خانة الرئيس بالمرؤوس لكون مفهوم السلطة الرئاسية وعناصرها تبرز بوضوح مدى الإختلاف بين الوضعين.
المطلب الثاني: سبل إنجاح التنسيق على المستوى الترابي
يندرج مسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب في إطار ورش كبير تشهده البلاد في مجال التجديد المؤسساتي، حيـث يأتي فـي سياق مطبوع بالعديد مـن الإصالحات الهامة التي تطال أنماط تنظيم وتنفيذ تدخلات الدولة، والتي تقتضي التحسـين المسـتمر للمقاربات والآليات المعتمدة في مجال الحكامة الترابية.
فقد أضحت الإدارة الترابية للمملكة، المناط بها تدبير شؤون المواطنات والمواطنين، مرتكزة على دعامتين متالزمتين ومتكاملتين، ألا وهما الجماعات الترابية اللامركزية ومصالح الدولة اللاممركزة، ويتعين على هاتين الفاعلتين الحرص على التنسيق الأمثل مع باقي الفاعلين (الاقتصاديين والجمعويين والأكاديميين، إلخ )، وذلك من أجل ضمان اندماج وانسجام أفضل للبرامج والمشاريع والتدابير والمبادرات التي يتم تنفيذهـا بالمجال الترابي، وكذا ضمان مشاركة فعلية للمواطنين في تدبير الشأن العام الترابي.[78]
إلا أنه وللأسف فقد تبين مـن خلال الدراسة أن أداء الفاعليـن الترابيين والعلاقات القائمة بينهم ومع الأطراف الأخرى المعنية، لا زالت تعاني من وجود أوجه قصور تتعلق بتنزيل وتفعيل آليات القيادة والإشراف والتنسيق على المستوى الوطني والترابي.[79]
ولإجل التخلص من أوجه الخصاص في ما يتعلق بالتنسيق والإلتقائية بين مختلف المستويات الترابية، وكذا مختلف المتدخلين الترابيين يجب علينا البدأ أولا بدعم أجهزة التنسيق (الفرع الأول) لكي تستطيع القيام بأعمالها التنسيقية ثم العمل على تنزيل الجهوية المتقدمة (الفرع الثاني) لما لها من حاجات ستجعل من التنسيق رافدا من روافدها.
الفقرة الأولى: دعم عمل أجهزة التنسيق الترابي
على الرغم من أن فكرة وجود “ميثاق للاتمركز الإداري “ظل مستبعد الحصول لسنوات طويلة، هذا القانون مثير للاهتمام لأنه يبرز التحدي المركزي الذي يشكله العمل على التوجه لخيار الجهوية المتقدمة الذي يدعمه عمل موازنة دائم بين المركزية واللامركزي عبر تنسيق عمل الدولة والمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية في إطار العلاقات الترابية من النوع الهرمي.
وبالتالي، فقد تغيرت طبيعة تحديات التنسيق الترابية، ولكن أيضًا لم يعد الأمر مجرد مسألة ضمان التناسق في عمل الخدمات المركزية واللامركزية، ولكن بشكل عام الحفاظ على التوازن بين حرية اتخاذ القرار للسلطات المحلية والجهات الفاعلة العامة والخاصة الأخرى للتدخل وعمل السلطات المركزيةهنا نتطرق إلى مسألة الوحدة، وبالتالي الاستدامة.
ولأن وظيفة التنسيق في حاجة دائمة ومستمرة للتطور والإرتقاء عبر منظور شمولي يروم إرساء قواعد واضحة تستجيب لمتطلبات التنمية، يبقى أهمها تعزيز دور الوالي والعامل داخل مجالها الإداري والترابي، عبر تجاوز تعثرات التجارب السابقة على جميع المستويات، إذ أن الممارسة العملية لمهام الوالي والعامل، خاصة في مجال التنسيق، واجهت تحديات متعددة ولعل أهمها غياب مصالح خارجية لبعض الإدارات التقنية، ونقص الموارد البشرية والمادية، وتداخل الإختصاصات، ومشكل نسج علاقات عمودية ومباشرة للمصالح الخارجية مع إدارتها[80].
فالمطلوب إذا، إعادة النظر في النظام القانوني لمؤسستي الوالي والعامل بتحديد مسؤوليات وصلاحياتهم على مستوى تنسيق المصالح اللاممركزة، وباقي الهيئات العمومية في حدود إختصاصهم الترابي بقدرعال من الدقة[81] وهو ما حاول ميثاق اللاتمركز الإداري فعلا القيام به، كما عمل هذا الميثاق على جعل الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة والتفريع في توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها، تخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية، تكريس الدور المحوري لوالي الجهة في تنسيق عمل المصالح اللاممركزة للدولة، والسهر على حسن سيرها ومراقبتها، وتوخي الفعالية والنجاعة في أداء مهامها بالإضافة إلى اقتران نقل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة بتخصيص موارد مالية وبشرية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام والصلاحيات المخولة لها[82] أبرز مبادئ اللاتمركز المنشود إستجابة للمطالبات وكذلك لتوصيات اللجنة الإستشارية للجهوية، في انتظار تفعيل هذه المبادئ على أرض الواقع حتى تكون المصالح اللاممركزة شريكا حقيقيا في التنمية الترابية.
إلى جانب ذلك وجب العمل على جعل الوالي/العامل الرئيس التسلسلي الفعلي للمصالح اللاممركزة والمخاطب الوحيد على المستوى الترابي للدولة من جهة، وللمصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقنين أساليب التنسيق وتحديدها حتى لا تظل متنوعة كما هو الشأن الآن[83].
كما يقوم بتوزيع الإعتمادات المخصصة للتجهيز وكذا بربط الإتصال بكل القوى الفاعلة، لذلك فهو يعقد ويوقع بإسم الدولة كل الإتفاقيات مع الأشخاص المعنوية، ويمثل الدولة بالأجهزة التي تستفيذ من إعانة الدولة، ويرأس كل اللجان الإدارية التي تتعلق بمصالح الدولة[84].
الفقرة ثانية: تطوير أساليب التنسيق بإعتماد تقنيات جديدة
لقد عرف مفهوم التنسيق في القانون المقارن تطور الأزمة في مرحلته الأولى إلى درجة تقنينه بأنظمة جد دقيقة، ويرجع هذا التطور في معالم التنسيق إلى أسباب متعددة ومختلفة، فمهمة التنسيق لا تستند لأي إجراء أو طريقة خاصة كفيلة بضمان فاعليتها وجدواها، ولهذا يظهر من المفيد إقرار نظام جديد جدير بضمان فعالية[85] أكبرعلى مستوى هذه الوظيفة الجد مهمة، ويقتضي ذلك:
أولا: إعتماد أدوات التواصل الإلكتروني والتشاور
تجدر الإشارة إليه أن سياسة التواصل لا يجب أن تقتصر على الجانب الخارجي، أي بين المرتفق ورجل الإدارة، بل يجب على الإدارة تعزيز التواصل بين مكوناتها، باعتبار أن التواصل الداخلي والخارجي هما وجهان لعملة واحدة ذلك أن التواصل الداخلي يعتبر في نظر الكثير من الباحثين كالزيوت بالنسبة للمحرك أو أية آلة ميكانيكية، حيث تساعد على تفاعل مختلف المكونات في تناغم وانسجام[86].
تقتضي الحكامة الجيدة بالضرورة إحداث نظام معلومات متكامل، سلس ومشترك يتقاسمه مجموع الفاعلين على المستوى الترابي. ويستند الولوج إلى المعلومات واستخدامها على مبدأيـن رئيسيين هما إنتاج المعلومات وإنشاء نظام معلومات على المستوى الترابي موحد ومتاح الولوج.
لكن لا يزال الحصول على المعلومات يطرح إشكالية حقيقية، خاصة وأن مختلف الفاعلين الترابيين قد عبرو عن حاجتهم الملحة للتوفر على نظام معلوماتي دينامي وموحد يسهل التواصل والتنسيق على المستوى الجهوي يكون متاح للولوج ومتقاسما مع مجموع الفاعلين بالمجال الترابي.
وينبغي أن يتم الإضطلاع بحكامة لمنظومة المعلومات الترابية في إطار تعاون فعلي بين مختلف هياكل الدولة والجماعات الترابية، وذلك ما تم بإنشاء مرصد للإعلام والإتصال على مستوى كل جهة، يتعلق الأمر هنا بتزويد الجهات بإستراتيجية للذكاء الترابي. فبدل أن تظل مجرد طالب للمعلومات، يتعين على الجهات أن تكون قادرة على إحداث وتدبير منظومة للمعلومات خاصة بها. وقد يتخذ المرصد المشار إليه شكل مجموعة ذات نفع عام GIP))بشراكة مع الجامعات والمندوبية السامية للتخطيط وجمعيات المنتخبين والمجتمع المدني، وينبغي أن تمكــن هندسة هذه الآلية من مظافرة موارد الجهة وتجميع المعطيات المتأتية من مختلف المصادر اعتمادا على معايير وبروتوكولات للتبادل محددة مسبقا[87].
ومن جهة أخرى تنظيم ملتقى جهوي سنوي للتشاور، يضم مجموع الفاعلين بالمجال الترابي المعنيين، وتكون الغاية منه بالأساس تعزيز اقتسام المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة بشكل مستمر، والنهـوض بالتنسيق والإلتقائية واندماج السياسات الترابية.
وفي اتجاه الأجرأة الفعلية لهذه العمليات التشاورية والتنسيقية، يبقى من اللازم وجود سلطة عليا تتكفل بمسؤولية الإشراف، وتدبير هذا التشاور وأجرأة مقتضيات التنسيق والتعاون اللازمين بين هؤلاء الفاعلين الترابيين، لضمان أقصى مستويات الفعالية في أنشطتهم[88].
وهنا الوالي أو العامل ركيزة أساسية للعب دورالمؤطر والقائد لهذه الإجتماعات ماقد يعطيها أهمية لدى مختلف الحاضرين، ويزيد من قيمة نتائجها وخلاصاتها، بالإضافة تفعيل تفعيل دور ممثلي السكان بتفعيل دورهم التشاوري والإستشاري لإثراء أشغال اللجان الجهوية للتنسيق وأيضا اللجان التقنية للعمالة والإقليم حتى تتم الموازنة بين ماهو تقني وما هو تمثيلي عبر إيصال رغبة المواطنين لإجتماعات اللجنة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قرارات اللجان.
ثانيا: السرعة والفعالية في تنزيل اللاتمركز الإداري
من خلال وحدة القيادة وتنسيق العمل الإداري لا يكفلان بعد وبصورة مرضية النتائج المتوقعة على مستوى الجماعات الترابية، فالتنسيق لن يتحقق إلا بفتح جاد لورش اللاتركيز الذي يشكل في فلسفته سندا موازيا للامركزية، يخول بمقتضاه للوحدات اللاممركزة السلطة الفعلية في اتخاذ القرار، من أجل تضافر جهود الإدارة الترابية في شقيها المنتخب والمعين، حيث أن الغاية في الأخير تتحد لخدمة المواطن وتحقيق فرص موسعة للتنمية المستدامة[89].
واليوم بادر المغرب إلى إصدار ميثاق للاتمركز الإداري، يهدف من خلاله إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي لإجراء إصلاح شامل لإدارة الترابية على أساس مبادئ الحكامة وتعزيز سياسة إدارة القرب[90]، هذا في وقت الذي لا يمكن فيه أن يثار مرة أخرى مسألة تحديد المستوى الرئيسي الذي لا غنى عنه للتنسيق والقيادة الترابية. وإذا كان لا بد من حل مشكلة وضع الخريطة الإدارية، سواء كانت الإدارة العامة أو الإدارة المتخصصة، من حيث ضرورة تقريب الخدمات من المواطنين الذين هم بحاجة إليها، فإن هذا شرطمهم، ولكنه غير كاف لتحقيق هذا الإدماج الذي لا غنى عنه للإدارة في المجتمع[91].
وعموما إن الميثاق الحالي للاتمركز سيشكل تحولا قد يساعد على تنسيق ترابي أنجع يخدم مرامي وغايات التنمية الترابية، وسيتماشى وفق نظام اللاتمركز ومع نظام اللامركزية بالنظر إلى أهمية المحاور التي تضمنتها أبوابه السبعة وخاصة حجم الإختصاصات التي ستنقل من المركز إلى المصالح اللاممركزة وفق جدول زمني ملزم للإدارة المركزية[92].
إن لللاتمركز في المغرب آثار عديدة وبالنسبة لموظفي المصالح اللاممركزة فإن عملية تخفيف الأعباءعن السلطة المركزية أمر مهم، ولكنها تسمح للإدارة أيضا بأن تكون قريبة قدرالإمكان من الواقع المحلي. وبالنسبة لموظفي المصالح اللاممركزة، الذين يندمجون في الخدمات الخارجية للدولة، فإن عدم التركيز يسمح لهم باكتساب سرعة في اتخاذ الإجراءات غير المقيدة بتوقع اتخاذ قرار من الإدارة المركزية، كما إن عدم التركيز يسمح في الواقع بتقسيم أفضل للعمل[93].
يضع التدبير الترابي الجديد مركزية القرار السياسي والنشاط العمومي في المغرب على المحك، والسؤال هنا هو حول مدى استعداد الفاعل الحكومي للانتقال من الدولة المركزية إلى الدولة الجهوية فيما يخص صناعة القرار ووضع السياسات العمومية، كما تضع الوحدات الترابية في المحك، من حيث أهلية وكفاءة مجالسها التداولية في القيام بوظائفها التنمية.
فالتداخل الموجود بين أدوار الفاعلين في التنمية الترابية أدى إلى تقاطع مختلف الإشكالات ومشاكل الوطنية بالمحلية والذاتية بالموضوعية وذلك إلى درجة يصعب معها التمييز بين أسباب ضعف نظام اللاتمركز ومظاهره، بل حتى مع نتائجه. وهنا تتجلى إحدى الخصوصيات الأخرى للمقاربة الترابية للمسألة التنموية بالمغرب.
إن التنمية المحلية وكما هو معلوم ميدان تتقاسمه وبنسب متفاوتة الوحدات اللامركزية والهيئات الغير ممركزة، أي أنها مجال لتدخل كل من الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، بناء على مفاهيم اللامركزية واللاتمركز وأيضا الإلتقائية، عبر نهج مقاربة تكاملية بين مكونات الإدارة المركزية والترابية يكون أساسها التنسيق.
وهكذا أصبح موضوع التنسيق الترابي يشكل اليوم، أحد المرتكزات الأساسية للسياسات العمومية،وصناعة القرار المحلي إعتبارا للدور لذي أصبحت تلعبه الجماعات الترابية، كفاعل أساسي وشريك حقيقي في تدبير المجالات الترابية، وتحقيق التنمية بمختلف أبعادها، وبالنظر أيضا إلى أهمية تدبير المرافق الترابية، لذلك فإن تطوير وظيفة التنسيق يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغييرات التي تمر بها الدولة، إن تطوير إجراءات التنسيق الهادفة إلى ترشيد أداء الخدمات بشكل أفضل هو أمر مشترك على نطاق أوسع مع عملية تكييف القواعد القانونية مع الإختصاصات العملية التي قامت عليها المؤسسة الإدارية ؛ نتيجة مؤكدة على المستوى المركزي ولكن أيضًا على المستوى الترابي.
كما المقاربة المجالية للتنمية تقتضي فسح المجال للوحدات الترابية في التوفرعلى أنظمة تمثيلية ومؤسسات وقواعد ووسائل التقييم والتقدير، ومسلسلات وهيئات إجتماعية قادرة على تسيير الترابطات وتنسيق الروابط بطريقة سليمة، وإعادة التفكير في العلاقة بين المركز والمحيط، وكذلك العلاقة بين صناع القرار الترابيين بما يضمن تحسين فعالية العمل.
لائحة المراجع:
الكتب:
- سعيد نكاوي، مسثاق اللاتمركز الإداري والتدبير اللامتمركز للإستثمار، دار الآفاق المغربية طبعة 2019.
- سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة،دار الفكر العربي،طبعة 1970.
- صالح المستف ، التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب-من المركزية إلى اللامركزية- منشورات مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر،الدار البيضاء ،سنة 1989.
- محمد نبيه، الجهوية المتقدمة بين اللامركزية واللاتمركزالجانب القانوني والمحاسبي،طبعة 2019.
- ميشيل روسي، المؤسسات الإدارية المغربية: تعريب إبراهيم الزياني بالتعاون مع المصطفى أجدبا ونور الدين الراوي، مطبعة النجاح الجديدة’ البيضاء1993.
المقالات:
– يونس أبلاغ، السياسات العمومية فى ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية،، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، ع 14، 2016.
– بجيجة العربي، القوانين التنظيمية الترابية ومبدأ التدبير الحر، مجلة مسالك، العدد 34/33،السنة 2015.
– بجيجة العربي، ممثل السلطة بالجماعات الترابية،أي دور للولاة/العمال من خلال الدستور؟، مجلة مسالك، العدد 34/33،السنة 2015.
– رضوان زهرو،التدبير الحر للشأن الترابي، مجلة مسالك، العدد 34/33،السنة 2015.
سعد الدحماني، التدبير العمومي الترابي: من التدبير المقيد ألى التدبير الحر، مجلة الأطلس للدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية والقضائية، ماي 2019.
عادل تميم، سياسة التدبير الامتمركز للاستثمار وسؤال الفعالية،مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية،العدد الأول،2018.
عبد الجبار المراكشي وخليل اللواح، واقع المراكز الجهوية للاستثمار وآفاقها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 147، يوليوز-غشت 2019.
عبد الجبار المراكشي، واقع المراكز الجهوية للاستثمار وآفاقها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد 147، يوليوز-غشت 2019.
عبد الرحيم المحجوبي، الثابت والمتغير في علاقة الولاة والعمال بالمنتخبين بين الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد22/2018.
- عبد الرفيع زعنون، حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار وآفق الإصلاح، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج4-5، السنة التالتة 2018.
- عبد اللطيف الهيلالي، تدبير السياسات العامة المحلية، المنبر القانوني، العدد 10 أبريل 2016.
- عبد المولى المسعيد، المنطلقات الدستورية للتدبير الترابي اللامركزي بالمغرب، المجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي،ع4/2020.
- علي الحنودي، الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 134-135 ماي-غشت 2017.
- عماد أبركان، الولاة والعمال في النموذج المغربي للإدارة المحلية وسؤال الحكامة، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد، العدد 31/32، السنة 11-2015.
- عماد أبركان، الولاة والعمال في النموذج المغربي للإدارة المحلية وسؤال الحكامة، م.س، العدد 31/32، السنة 11-2015.
- عماد أبركان، قراءة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في ضوء التحولات الكبرى للحكامة المحلية بالمغرب، مجلة دراسات اقتصادية وقانونية، عدد خاص، مارس 2017.
- محمد أولاد الحاج، الجهة والجهوية المتقدمة: قراءة مقارنة بين القانون رقم 96-47 والقانون التنظيمي 111.14، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 126/127، يناير –أبريل 2016.
- محمد شكيري:” أهمية التواصل في تدبير الضريبة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 43 مارس ، أبريل 2002.
- نادية جامع،المراكز الجهوية للاستثمار كمطلب للتنمية الجهوية، حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار وآفاق الإصلاح، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج4-5، السنة التالتة 2018.
- ياسير عاجل ،تحديات تحديث الإدارة الجهوية في تدبير السياسات العمومية الترابية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد146، ماي ويونيو2019.
الأطاريح والرسائل:
-عبد الكريم بخنوش، التنسيق الإداري للمصالح الإقليمية التابعة للدولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001.
– محمد البقالي، تدبير الشأن العام المحلي بين إدارة الدولة والجماعات المحلية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2006-2007.
-عبد الجليل عمرانة، مؤسسة العامل بين تثبيت عدم التركيز وتفعيل مسار اللامركزية،،أطروحةالدكتوراه في القانون العام،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس أكدال،الرباط،السنة الجامعية 2008-2009.
– حليمة الهادف، التدبير العمومي المحلي وإشكالية التحديث، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محود الخامس أكدال، الرباط2011- 2012.
-إيمان داودي،الوالي والعامل والتنمية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال ، الرباط،السنة الجامعية،2014-2015.
-عند حفصة الرمحاني، التدبير الإستراتيجي للتراب والمخططات الدماعية للتنمية أية آفاق وأية رهانات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة،السنة الجامعية 2014-2015.
-عادل تميم، البعد الجهوي في سياسات تدبير الإستثمار وانعكاساته على التنمية-على ضوء الجهوية المتقدمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة 2015-2016.
-فؤاد بلحسن، التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط 2017-2018.
-إلهام بخوشي، الحكامة وتدبير الشأن العام المحلي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، الموسم الجامعي 2016-2017.
المواقع الالكترونية:
- أجلاب رشيد، اللاتمركز الإداري،أساس لتقوية الجهوية المتقدمة، مقال منشور في البوابة الإلكترونية لمجلة المنار بتاريخ 17 أبريل 2020https://revuealmanara.com/.
- الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة، https://www.mmsp.gov.ma
التقارير:
-المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تقرير حول متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية،2016.
-المجلس الإقتصاديوالاجتماعي والبيئي، الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة، إحالة ذاتية رقم 42/2019.
المراجع الاجنبية:
- Les Ouvrages:
- Michel Rousset, le rôle du ministre de l’intérieur et sa place au sein de l’administration marocaine, Annuaire de l’Afrique du nord ; 1969
- Rousset Michel. Administration et société au Maroc. In:Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°15-16, 1973. Mélanges Le Tourneau
- Malik Boumediene, La question de la modernisation de l’Etat dans le monde arabe. L’exemple du Maroc, revue du centre d’étude et de recherche en administration publique, anné 2010
- Michel Rousset, le décret de 26 décembre 2018 portant charte de la déconcentration administrative, Remald n° 146, mars-juin,2019.
[1] – صالح المستف ، التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب-من المركزية إلى اللامركزية- منشورات مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر،الدار البيضاء ،سنة 1989،ص 5.
[2] – مذكورة عند حفصة الرمحاني، التدبير الإستراتيجي للتراب والمخططات الدماعية للتنمية أية آفاق وأية رهانات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة،السنة الجامعية 2014-2015.
[3] – عبد الكريم بخنوش، التنسيق الإداري للمصالح الإقليمية التابعة للدولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001، ص2.
[4] – عملية تغيير، ذا ت طبيعة معيارية من الناحية القيمية؛ وهي لا تحيد عن كونها مسار تجديدي ودينامي، طويل وغير يسير؛ يرمي الوصول إلى و ضع مثالي، مخالف لما كان عليه الحال في الماضي، لكن دون أن ينفلت ذلك بطبيعة لحال، عن إطار المؤسسات والقواعد العامة التي تحكم الدولة والمجتمع، وإلا غدا ثورة ضد الأمن والاستقرار وثوابت الأمة
[5] – ميشيل روسي، المؤسسات الإدارية المغربية: تعريب إبراهيم الزياني بالتعاون مع المصطفى أجدبا ونور الدين الراوي، مطبعة النجاح الجديدة’ البيضاء.1993.
[6] – عبد الكريم بخنوش، التنسيق الإداري للمصالح الإقليمية التابعة للدولة،م.س، ص7-8.
[7] – حليمة الهادف، التدبير العمومي المحلي وإشكالية التحديث، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محود الخامس أكدال، الرباط، ص12-13.
[8] – عبد الكريم بخنوش، التنسيق الإداري للمصالح الإقليمية التابعة للدولة،م.س، ص8.9.
[9] – عماد أبركان، الولاة والعمال في النموذج المغربي للإدارة المحلية وسؤال الحكامة، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد، العدد 31/32، السنة 11-2015، ص88.
[10] – سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة،دار الفكر العربي،طبعة 1970،ص 135.
[11] – ياسير عاجل ،تحديات تحديث الإدارة الجهوية في تدبير السياسات العمومية الترابية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،عدد146، ماي ويونيو2019،ص302.
[12] – علي الحنودي، الدولة وتدبير السياسات العمومية الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 134-135 ماي-غشت 2017، ،ص186.
[13] -المجلس الإقتصاديوالاجتماعي والبيئي، الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة، إحالة ذاتية رقم 42/2019 ص66
[14] -عبد اللطيف الهيلالي، تدبير السياسات العامة المحلية، المنبر القانوني، العدد 10 أبريل 2016، ص143.
[15] – يونس أبلاغ، السياسات العمومية فى ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية،، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، ع14، 2016، ص،247.
[16] – يونس أبلاغ، مرجع سابق،ص248.
[17] – ياسير عاجل،م.س، ص305.
[18] – المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، تقرير حول متطلبات الجهوية وتحديات اندماج السياسات القطاعية،2016،ص63.
[19] – المجلس الإقتصادي،م.س،ص 66-67.
[20] – ياسير عاجل،م.س، ص 299.
[21] – عماد أبركان، الولاة والعمال في النموذج المغربي للإدارة المحلية وسؤال الحكامة، م.س، العدد 31/32، السنة 11-2015، ص87.
[22] – دساتير ماقبل دستور 2011.
[23] – بجيجة العربي، ممثل السلطة بالجماعات الترابية،أي دور للولاة/العمال من خلال الدستور؟، مجلة مسالك، العدد 34/33،السنة 2015، ص 155.
[24] – أجلاب رشيد، اللاتمركز الإداري،أساس لتقوية الجهوية المتقدمة، مقال منشور في البوابة الإلكترونية لمجلة المنار بتاريخ 17 أبريل 2020https://revuealmanara.com/، تاريخ الإطلاع 18/02/2025، على الساعة 9:54.
[25] – عماد أبركان، قراءة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في ضوء التحولات الكبرى للحكامة المحلية بالمغرب، مجلة دراسات اقتصادية وقانونية، عدد خاص، مارس 2017،ص 80.
[26] – إيمان داودي،الوالي والعامل والتنمية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس أكدال ، الرباط،السنة الجامعية،2014-2015،،ص 243
[27] – لا يمكن تصور هذه الحرية بدون رقابة، وإذا غابت الرقابة انتقلنا من دولة موحدة إلى دولة شبه فيدرالية.
[28] – المادة 112من ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 )بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
[29] – المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
[30] – المادة 114 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
[31] -محمد أولاد الحاج، الجهة والجهوية المتقدمة: قراءة مقارنة بين القانون رقم 96-47 والقانون التنظيمي 111.14، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 126/127، يناير –أبريل 2016، ص191.
[32] – بجيجة العربي، ممثل السلطة بالجماعات الترابية،أي دور للولاة/العمال من خلال الدستور؟، م.س، ص 156.
[33] – عبد الرحيم المحجوبي، الثابت والمتغير في علاقة الولاة والعمال بالمنتخبين بين الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد22/2018،ص275.
[34] – بجيجة العربي، القوانين التنظيمية الترابية ومبدأ التدبير الحر، مجلة مسالك، العدد 34/33،السنة 2015، ص42.
[35] – رضوان زهرو،التدبير الحر للشأن الترابي، مجلة مسالك، العدد 34/33،السنة 2015، ص9.
[36] – يقصد بالسلطة التنظيمية سلطة اتخاذ قرار عامة ومجردة .
[37] – سعد الدحماني، التدبير العمومي الترابي: من التدبير المقيد ألى التدبير الحر، مجلة الأطلس للدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية والقضائية، ماي 2019،ص240.
[38] – حيث يرى البعض إلى ضرورة الحد من الإنفراج التشريعي للامركزية مايضمن الإبقاء على السلطة في يد الوالي أو العامل، اما البعض الآخر فيطالب بتفعيل مبادئ التدبير الحر لتمكين الجماعات الترابية من القيام بمهامها على أحسن وجه.
[39] – المادة 78 من القانون 113.14، المادة 80 من القانون 112.14.
[40] – المادة 9الفقرة 4 من ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 )2 أبريل 1997 )بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 03/04/1997 الصفحة 556.
[41] – بجيجة العربي، القوانين التنظيمية الترابية ومبدأ التدبير الحرم.س، ص46.
[42] – فؤاد بلحسن، التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، ص 216.
[43] – محمد نبيه، الجهوية المتقدمة بين اللامركزية واللاتمركزالجانب القانوني والمحاسبي،طبعة 2019، ص267.
[44] عبد الجبار المراكشي، واقع المراكز الجهوية للاستثمار وآفاقها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد 147، يوليوز-غشت 2019،ص385.
[45] – نادية جامع،المراكز الجهوية للاستثمار كمطلب للتنمية الجهوية، حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار وآفاق الإصلاح،المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج4-5، السنة التالتة 2018،ص15.
[46] – عادل تميم، البعد الجهوي في سياسات تدبير الإستثمار وانعكاساته على التنمية-على ضوء الجهوية المتقدمة-،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، ص48.
[47] – عبد الرفيع زعنون، حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار وآفق الإصلاح، المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، عدد مزدوج4-5، السنة التالتة 2018،ص50.
[48] – عبد الجبار المراكشي وخليل اللواح، واقع المراكز الجهوية للاستثمار وآفاقها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 147، يوليوز-غشت 2019، ص 391.
[49] – عادل تميم، سياسة التدبير اللامتمركز للاستثماروسؤال الفعالية،م.س، ص 52.
[50] – عادل تميم، سياسة التدبير الامتمركز للاستثمار وسؤال الفعالية،م.س، ص49.
[51] – عبد الكريم بخنوش،التنسيق الإداري للمصالح الإقليمية التابعة للدولة،م.س، ص229.
[52] – ظهير شريف رقم 1.19.18صادر في 7 جمادى اآخرة 1440 13 فبراير 2019 بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ج.ر ع 6754.
[53] – أنظر القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار49.18.
[54] -عادل تميم، سياسة التدبير الامتمركز للاستثمار وسؤال الفعالية،مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية،العدد الأول،2018، ص48.
[55] – مولاي عبد الله الغزاوي، الإدارة العمومية والإستثمار: م.س، ص218
[56] – أنظر قرار لوزير الداخلية رقم 365.02 صادر في 20 من ذي الحجة 1422(5 مارس2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 07/03/2002 الصفحة 484. بالإضافة إلى قرار للمدير العام للأمن الوطني رقم 371.02 الصادر بنفس التاريخ الذي يفوض للوالي سلطة تسليم رخصة استغلال أناكن المشروبات من الصنفين الأول والثاني إلى المؤسسات السياحية المرتبة، وكذا قرار للوزير المنتذب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات رقم 370.20 بتفويض إلى ولاة الجهات سلطة تسليم رخص الاحتلال المؤقت للملك الغابوي، وغيرها من التفويضات.
[57] – عادل تميم، البعد الجهوي في سياسات تدبير الإستثمار وانعكاساته على التنمية-على ضوء الجهوية المتقدمة، م.س، ص 110.
[58] – عادل تميم، البعد الجهوي في سياسات تدبير الإستثمار وانعكاساته على التنمية-على ضوء الجهوية المتقدمة،م.س،ص 112-113.
[59] – عبد الرفيع زعنون، حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار وآفاق الإصلاح، م.س ،ص58-59.
[60] – نادية جامع،المراكز الجهوية للاستثمار كمطلب للتنمية الجهوية، حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار وآفاق الإصلاح،م.س،ص23.
[61] – مولاي عبد الله الغزاوي، الإدارة العمومية والإستثمار: المعيقات وسؤال الإصلاح، ، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 14، ماي 2018، ،ص219.
[62] – سعيد نكاوي، مسثاق اللاتمركز الإداري والتدبير اللامتمركز للإستثمار، دار الآفاق المغربية طبعة 2019،ص129.
[63] – عماد أبركان، التنمية الترابية بالمغرب بين الخصوصيات ومتطلبات الحكامة،م.س ص193.
[64] – نفس المرجع ،نفس الصفحة.
[65] – إلهام بخوشي، الحكامة وتدبير الشأن العام المحلي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، الموسم الجامعي 2016-2017، ص262.
[66] – حليمة الهادف، التدبير العمومي المحلي وإشكالية التحديث، م.س، الرباط، ص26.
[67] – فق3 من المادة 17 من ميثاق اللتمركز الإداري.
[68] – نفس المادة.
[69] – الموقع الإلكتروني لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة، https://www.mmsp.gov.ma/ ، تاريخ الإطلاع 15 فبراير 2025 على الساعة 12:26.
[70] – الفقرة الأخيرة من المادة 8 من ميثاق اللاتمركز.
[71] – عبد الكريم بخنوش،التنسيق الإداري للمصالح الإقليمية التابعة للدولة،م.س، ص243.
[72] – عبد الجليل عمرانة،مؤسسة العامل بين تثبيت عدم التركيز وتفعيل مسار اللامركزية،،أطروحةالدكتوراه في القانون العام،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس أكدال،الرباط،السنة الجامعية 2008-2009،ص89.
[73] – إيمان داودي،الوالي والعامل والتنمية المحلية بالمغرب،م.س،ص120.
[74] -Michel Rousset, le rôle du ministre de l’intérieur et sa place au sein de l’administration marocaine, Annuaire de l’Afrique du nord ; 1969, p91.
[75] – عبد الجليل عمرانة،مؤسسة العامل بين تثبيت عدم التركيز وتفعيل مسار اللامركزية،م.س،ص94-95.
[76] – عبد الكريم بخنوش،التنسيق الإداري للمصالح الإقليمية التابعة للدولة،م.س، ص158.
[77] – المادة 19 من مرسوم 26 ديسمبر 2018، م.س.
[78] – المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة، إحالة ذاتية رقم 42/2019،ص9.
[79] – المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحكامة الترابية رافعة للتنمية المنصفة والمستدامة، م.س، ص7.
[80] – رشيد ملوكي، تطوير نظام اللاتمركز رهان حتمي لخيار الجهوية المتقدمة،ص57.
[81] – إيمان داودي،الوالي والعامل والتنمية المحلية بالمغرب،م.س، ص126.
[82] – المادة 8 من ميثاق اللاتمركز الإداري.
[83] – محمد البقالي، تدبير الشأن العام المحلي بين إدارة الدولة والجماعات المحلية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، السنة الجامعية 2006-2007، ص176.
[84] – محمد البقالي، تدبير الشأن العام المحلي بين إدارة الدولة والجماعات المحلية،م.س، ص172.
[85] – المستف صالح، التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب-من المركزية إلى اللامركزية-، م.س،ص204.
[86] – محمد شكيري:” أهمية التواصل في تدبير الضريبة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 43 مارس ، أبريل 2002، ص 91.
[87] – المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، م.س،ص20.
[88] – رشيد ملوكي، تطوير نظام اللاتمركز رهان حتمي لخيار الجهوية المتقدمة، م.س، ص57.
[89] – عبد المولى المسعيد، المنطلقات الدستورية للتدبير الترابي اللامركزي بالمغرب، المجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي،ع4/2020، ص19.
[90] – Malik Boumediene, La question de la modernisation de l’Etat dans le monde arabe. L’exemple du Maroc, revue du centre d’étude et de recherche en administration publique, anné 2010, P 136.
[91] Rousset Michel. Administration et société au Maroc. In: Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, n°15-16, 1973. Mélanges Le Tourneau, P305.
[92] – عبد المولى المسعيد، المنطلقات الدستورية للتدبير الترابي اللامركزي بالمغرب،م.س، ص21.
[93] Malik Boumediene, La question de la modernisation de l’Etat dans le monde arabe, op. cit , P135.