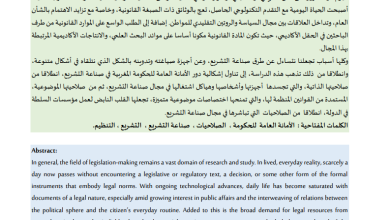قراءة في نازلة الأحداث المتابعين بجنحة السرقة، الحدث على ضوء قانون المسطرة الجنائية، قراءة جزئية – يوسف بنشهيبة
قراءة في نازلة الأحداث المتابعين بجنحة السرقة، الحدث على ضوء قانون المسطرة الجنائية، قراءة جزئية

يوسف بنشهيبة باحث في العلوم الجنائية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض بمراكش
في هذه النازلة والتي تابعت فيها النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، طفلان شقيقان (حدث) بجنحة السرقة، وتمت إحالتهما على قاضي مختص بالأحداث بنفس المحكمة، بعد ذلك صدر حكم قضى بإدانة الحدث بما نسب إليه، والحكم بتسليمه لوليه القانوني مع تحميل هذا الأخير الصائر والإجبار في الأدنى.
تم تأطير هذه القراءة أو المقال من خلال : مجموعة القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفصل 138 من مجموعة القانون الجنائي والذي نص بشكل صريح على انعدام المسؤولية الجنائية، وجاء في هذا الفصل ما يلي :
الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.
لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وهذا بمثابة إحالة على الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية.
المادة 468 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها : لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
والمادة 480 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها : إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة كاملة، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك لأبويه أو إلى الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته.
وبذلك في الحكم أعلاه فقد تم تسليم الحدث لوليه القانوني.
في هذه الأسطر سوف نجيب عن سؤال تكرر في العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو لماذا تمت متابعة الطفلان الشقيقان الحدثان؟ ومن خلال هذا السؤال سنعمل على مقارنة مضمون المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية الحالي ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية الحالي والتي جاء فيها : يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
جوابا على السؤال الأول والذي تم تداوله بشكل واسع، لماذا تم تسطير المتابعة في حق أطفال سنهم صغير ولم يصل إلى 12 سنة، ولم يبلغ أي منهم سن الرشد الجنائي والمحدد في 18 سنة، والجواب يظهر بوضوح من خلال مضمون المادة الثانية أعلاه، أن كل فعل يعتبر جريمة بنص القانون ومعاقب عليه، يكون معه في جميع الأحوال ولو كان مرتكب الفعل الجرمي صغير غير مميز، ( لفظ خاص يستعمل في القانون المدني)، إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، والعبرة هنا في ارتكاب ووجود جريمة، تحدث اضطراب في المجتمع، وليس المحدد من ارتكب الجريمة، وكم سنه، وهل يخضع للمساءلة الجنائية أم لا، كما أن الدعوى العمومية حق ينشأ عن المجتمع في جميع الأحوال، وأن النيابة العامة تمثل المجتمع وتنوب عنه، وهنا نتوقف عن مدى أهمية إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، في الكشف عن ملابسات وظروف إرتكاب الجريمة، وهذا ما سنتطرق إليه في الأسطر التالية.
في مستهل الحديث سنتطرق لمسألة في غاية الأهمية، كان من المحتمل في نازلة هؤلاء الأحداث، أن يكون وراء هذا الفعل الجرمي المرتكب (السرقة) فاعل معنوي، وهذا الفاعل نصت عليه المادة 131 من مجموعة القانون الجنائي والتي جاء فيها : من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.
والفاعل المعنوي أو المحرض أو كما يسميه البعض، رجل الظل، أو المجرم الجبان، هو الذي يتولى وتتولد لديه الفكرة الإجرامية ويخطط لها، ويوجه الفاعل المادي الذي لا يخضع للمساءلة الجنائية من أجل ارتكابها بدلا عنه، وينتفع هو بالنتيجة الإجرامية، وفي نازلة الحال، الإنتفاع بالمسروق المحصل عليه من جريمة السرقة، لو افترضنا أن الأبحاث التمهيدية، أو التحقيقات كشفت عن وجود فاعل معنوي.
ومعنى من حمل شخصا غير معاقب، هو أن يكون هذا الشخص الغير المعاقب عديم المسؤولية، إما لجنون أو عته، أو صغر سن، ويصدر عن هذا الفاعل المعنوي تجاه عديم المسؤولية، إكراه أو تهديد أو وعد… أو استغلال نفوذ أو سلطة أو استعمال حيلة، في حق الشخص الغير المعاقب، وإجباره على ارتكاب جريمة ما مكانه، ويصبح عديم المسؤولية هذا أداة ووسيلة في يد المحرض، وقد يكون وراء هذا الفاعل المعنوي كأن تقترن هذه السرقة في النازلة التي أمامنا، بوجود شبكة نشيطة في الاتجار في البشر، وطنيا أو لها إمتداد دولي، تستغل الأطفال إما في التسول، أو السرقة أو النصب والاحتيال… لذلك في هذه النازلة التي أمامنا، ونطرح الفرضية الآتية، ماذا لو كشفت الأبحاث التمهيدية أن هذا الفعل الجرمي المرتكب من طرف الأطفال، كان عن طريق التهديد أو الوعد، أو الاكراه، من طرف فاعل معنوي فإنه يعاقب بالجرم الذي ارتكبه الحدث، وفي العديد من القضايا ذات الطابع الجنائي المعروضة لدى القضاء، قد يتبادر للمواطن من أول لحظة أنها جريمة عادية ومألوفة لديه، ولكن الأبحاث التمهيدية والتحقيقات قد تكشف عن وجود جرائم أخرى مستترة وجناة مطلوبين للعدالة، وامتداد لشبكات إجرامية.
وقد يكون هذا الفاعل المعنوي إما أحد الأبوين أو هما معا، أو فرد من أفراد العائلة أو شخص أجنبي عن العائلة، لذلك كان لزوما على النيابة العامة إقامة أو ممارسة الدعوى العمومية لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة، في جميع الأحوال وهذا ما حرص عليه المشرع من خلال المادة. أعلاه، ومن شروط قيام صفة الفاعل المعنوي :
1 اتيان الفاعل المعنوي النشاط الاجرامي في شكل أمر أو تحريض…
2 انتفاء المسؤولية الجنائية والعقوبة عن الفاعل المادي
المادة 2 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، نصت على تطبيق تدابير الحماية والتهذيب المتخدة بالنسبة للأحداث، وجاء في هذه المادة على أنه يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات والتدابير الوقائية وكذا تدابير الحماية والتهذيب المتخدة بالنسبة للأحداث والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
من خلال المادة أعلاه حرص المشرع على حماية حق الحدث، مع تمتيعه بمجموعة من الضمانات في جميع مراحل المحاكمة، كما أننا في بعض الأحيان قد نلاحظ مدى صعوبة التوفيق بين حق المجتمع في توقيع العقاب، ونقصد بذلك الردع الخاص، وحق الحدث في محاكمة عادلة، فيقع خلط لدى البعض بهذا الخصوص، فهناك فرق شاسع بين الأحداث الذين خصهم المشرع بمقتضيات قانونية ومعاملة خاصة والرشداء، و الظاهر في النقاش العمومي حول نازلة هؤلاء الأحداث أن هناك اتجاهين، اتجاه يرى أن الدعوى العمومية لا يجب أن تقام في حق من هم دون سن 18 سنة، وعلى وجه الخصوص من هم دون سن 12 سنة، واتجاه آخر يرى وتولد لديه اقتناع كبير بضرورة توقيع العقاب أي كان سن مرتكب الفعل الجرمي، ولعل كل هذه الآراء تتعارض بشكل صارخ مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالكتاب الثالث الخاص بقواعد الأحداث بقانون المسطرة الجنائية والاتفاقيات الدولية، التي تنصب في إطار حماية الحدث المخالف من الانحراف، لأن الحدث (الجانح) اليوم هو (مجرم) الغد، إذا لم يتم تقويم سلوكه وتهذيبه وتوفير الحماية اللازمة له.
نصت المادة 481 أنه يمكن لغرفة الاحداث أن تتخذ في شأن الحدث واحداً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:
1 – تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته.
كما نصت المادة على ست تدابير أخرى…
الحكم الصادر في حق الحدثان، والأحكام القضائية الصادرة في قضايا الاحداث، تحيلنا على طرح مجموعة من الاشكالات من بينها : هل يمكن اعتبار تدابير الحماية والتهذيب المتخدة بالنسبة للأحداث حلا ناجعا في الحفاظ على الأحداث من الجنوح في المستقبل؟ وماهي تدابير الحماية والتهذيب المتخدة بالنسبة للأحداث ؟ وما مدي تطبيق هاته التدابير جميعا علي أرض الواقع؟ ثم ماذا لو لم يتم تنفيذ هذه التدابير؟، إشكالات بعضها نجيب عنه، والبعض الآخر سنخصص له مساهمة مستقلة خاصة بموضوع الحدث في انتظار صدور مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، مع قراءة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
بالعودة للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط والذي قضت فيه المحكمة بتسليم الحدث لوليه القانوني، هذا الاجراء القانوني المنصوص عليه ضمن المواد 468 و471 و481 و510 من قانون المسطرة الجنائية، وبذلك تعين علينا طرح إشكالية جوهرية في غاية الأهمية، وهو مدى أهلية الشخص المسلم له الحدث؟ وهذا ما حرص عليه المشرع من خلال المادة 480 من ق م ج والتي جاء فيها : إذا كان الحدث مهملا أو كان أبواه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته لا يتوفرون على الصفات الأخلاقية المطلوبة، فإنها تسلمه إلى شخص جدير بالثقة أو إلى مؤسسة مرخص لها.
ويمكنها أن تأمر، علاوة على ذلك، بوضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة، إما بصفة مؤقتة لفترة اختبار واحدة أو أكثر تحدد مدتها، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يمكن أن يتجاوز 18 سنة.
وفي هذه المادة اشترط المشرع صراحة أن التسليم لا يكون لشخص لا تتوفر فيها الصفات الأخلاقية، وبالتالي فهو شخص غير جدير بالثقة مما يكون معه حرمانه من التسليم، لهذا فإن نفس المادة تفرض على القاضي الحرص والسهر على تحقق شرط أن يكون هذا الشخص المسلم له الحدث، ممن تتوفر فيهم الصفات الاخلاقية، وأن يكون جدير بالثقة طبقا للمادة 481
من ق م ج، ويفهم من الصفات الأخلاقية وهي على سبيل المثال : الاستقامة، الأخلاق الحسنة، الابتعاد عن الشبهات …الخ، ولعل القاضي بحرصه على تسليم الحدث لشخص جدير بالثقة، كان وراءه الحرص، على أن يكون الشخص المسلم له الحدث، ذا أثر إيجابي في تهذيب الحدث، وقيمة مضافة للحدث من أجل إعادة تأهيله، وفي حالة تخلف الشرط فقد يسلم الحدث للحاضن عوض أحد الابوين، حرصا من القاضي على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، وتبرز هنا العديد من الاشكالات من بينها : اذا كانت الأم إهل لتسلم الحدث والأب عكس ذلك، أو الأب أهل لتسلم الحدث والأم عكس ذلك، فإن أحدهما سيكون مقيما بالمكان الذي حددته المحكمة ليقيم فيه الحدث مع الولي القانوني، وبذلك نتساءل هل في هذه الحالة يمكن أن يتحقق تدبير تهذيب الطفل وإعادة إدماجه في حين أن أحد الابوين قد يشكل عائقا ومانعا من أجل تحقق تدبير التهذيب، وهو مقيم بنفس المكان الذي يقيم فيه الحدث، هذا الإشكال أجابت عنه المادة 481 من ق م ج من خلال ضرورة احترام الترتيب في حالة عدم تحقق شرط توفر الصفات الأخلاقية، أو أن أحد الابوين غير جدير بالثقة، وبالتالي كان ضروريا احترام الترتيب الآتي : تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أولكافله أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته.
بالرغم من أننا نسجل تحفظ فيما يخص هذه المسألة.
كما أن المادة 508 من ق م ج جاء فيها أن تسليم الحدث قد يكون بشكل مؤقت أو نهائي إلى غاية لا تتعدى سن 18 سنة، وحسب المادة أعلاه، يجب أن يتضمن الحكم القاضي بتسليم الحدث إلي شخص جدير بالثقة بصورة مؤقتة أو نهائية لغير أبيه أو أمه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنة، تحديد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها، وتعفي في حالة عوزها، وتستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي كما جاء في المادة أعلاه، كما يراعى في تسليم الحدث الترتيب، كما سبق الذكر، كما أن تسليم الحدث لغير الأبوين في حالة عدم تحقق الشروط السالفة الذكر، يطرح إشكال امتناعهم في بعض الأحيان عن تقديم مبلغ الإعالة أو المصاريف للأشخاص المسلم لهم الحدث، وهذا بدوره يطرح مجموعة من الاشكالات، من بينها كيف يمكن استخلاص مبلغ الإعالة والمصاريف ?، كيف ستتم مواجهة هذا الامتناع ? على أي أساس يتم تحديد هذه المبالغ ?
إلى جانب مجموعة من الاشكالات تطرح.
وجدير بالذكر أن إجراء تسليم الحدث لأحد الأشخاص المؤهلين لذلك، هو إجراء ذات طبيعة حساسة وفي غاية الأهمية بما كان، ومن شأنه أن يحقق نوع من الاستقرار النفسي لدى الطفل وإعادة تكييفه في المجتمع في ظروف طبيعية، إذا ما تحقق بالشكل المطلوب، ونكون بذلك قد اجهضنا مشروع طفل جانح كان في طور الإعداد من أجل أن يصبح شخص خارج عن القانون، وغير متحكم فيه مستقبلا، يكلف اعتقاله وسجنه… للدولة ملايين الدراهم.
توبيخ الحدث على ضوء قانون المسطرة الجنائية
في البدء يجب علينا أن نؤسس تعريفا لكلمة توبيخ، ويقصد بها، لوم وعتاب الحدث عما صدر منه من فعل مخالف للقانون والأخلاق، هو قيام القاضي بإظهار مدى سوء وخطورة الفعل الذي ارتكبه الحدث، مستعملا بذلك قولا زاجرا معاتبا مخيفا، مهددا له بالعقاب الشديد إن عاد لارتكاب فعلته، ولا مانع من أسلوب التهديد، اذا كان يرجى منه اظهار خطورة الفعل الذي ارتكبه الحدث وردعه، وهذا يطرح ضرورة التوفيق بين التوبيخ وما يحمله من أساليب لردع الحدث، وبين ضرورة الحفاظ على نفسيته وعدم التأثير عليه سلبا دون سب أو إهانة أو تنقيص.
وفي النازلة التي أمامنا تم تسليم الحدث لوليه القانوني، وكون هذا الاجراء أو التدبير يغلب عليه الطابع الوقائي، دون توبيخ لأن التوبيخ يتخذ بشأن المخالفات المرتكبة من قبل الحدث البالغ من العمر اثني عشرة سنة، ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة أما من لم يبلغ سن الثانية عشرة فلا يتخذ في مواجهته أي توبيخ بل فقط تسليمه لأحد الأشخاص عملا بنص المادة 468 من ق م ج، التي نصت : لا يتخد في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
ويمكن الاكتفاء بتنبيه الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة، بمقتضى المادة 480 من قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها : إذا كان عمر الحدث يقل عن 12 سنة كاملة، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك لأبويه أو إلى الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته، وتجدر اﻹشارة أنه قبل صدور قانون المسطرة الجنائية لسنة 2003 كانت المحكمة المختصة بتوجيه التوبيخ هي محاكم الجماعات والمقاطعات بمقتضي ظهير 15 يوليوز 1974.
سرية الجلسات على ضوء قانون المسطرة الجنائية
حرص المشرع على أهمية تحقيق مبدأ سرية محاكمة الحدث، باعتبار هذا المبدأ ضمانة مهمة يتمتع بها الحدث، من خلال حماية حقه في الخصوصية، كما أن محاكمة الحدث تختلف كل الإختلاف عن المحاكمات العادية في حق الرشداء التي يغلب عليها طابع الصرامة والزجر، بالإضافة إلى أسلوب التعامل والحديث الذي يخاطب به قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة الأحداث تختلف عن الرشداء، ولعل هناك العديد من صور الاختلاف بين محاكمة الحدث ومحاكمة الرشداء، كما أن علنية الجلسات من شأنها أن تضر بمصلحة الحدث لأنها وسيلة تشهير غير مباشرة في حقه، وبهذا فقد يشعر الحدث أنه منحرف أو مجرم وأن يتأثر بجو المحاكمة والحضور والمناقشة، مما ينعكس سلبا على وضعه النفسي، كما أن تعامل ضباط الشرطة القضائية مع الاحداث يجب أن يكون لطيفا ومرنا، وتحرص النيابة العامة على تكليف قضاة متخصصين لمتابعة قضايا الأحداث، وهذا التكليف يحسب لصالح الحدث كضمانة من الضمانات التي خولها القانون له، تم التنصيص على مبدأ سرية الجلسات المتعلقة بالأحداث من خلال المادة 478 من ق م ج والتي جاء فيها : يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة الحدث أو ممثله القانوني من الحضور، وكذلك المادة 479 التي نصت على أنه “……. لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن…
كما أن سرية محاكمة الحدث أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات في المادة 466 من ق م ج أهمها منع نشر بيانات جلسات الأحداث في الكتب والصحف ومنع نشر رسوم أو صور تتعلق بشخصية الحدث والهدف من ذلك هو الحفاظ على سمعة الحدث وهو تدبير في نظرنا وقائي للحد من الاثار النفسية التي قد تضر بالحدث.
و لايفوتنا في هذا الصدد أن نتطرق للركن المعنوي في النازلة التي أمامنا، والتي ينعدم فيها عنصر التمييز لدى الحدث مما يكون معه الحدث غير قادر على فهم ماهية الجريمة التي ارتكبها ولا مدركا لنتائجها، المادة 132 من مجموعة القانون الجنائي التي نصت على أن كل شخص سليم العقل وقادر على التمييز مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها، مع استثناء نصت عليه الفقرة السادسة من نفس المادة والتي جاء فيها : ولا يستثنى من هذا المبدأ الا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
ومن خلال ذلك ميز المشرع المغربي بين الأفراد فيما يخص المسؤولية الجنائية بناءً على قدراتهم العقلية والتمييزية، ولا يعتبر متساوون من هذه الناحية.
خلاصة : موضوع حماية حقوق الاحداث الجانحين جعل العديد من دول العالم تولي لهذا الموضوع أهمية كبيرة وقصوى، ويهدف هذا الاهتمام إلى تجويد المنظومة التشريعية والسياسة الجنائية، ووضع برامج لحماية هؤلاء الأحداث، والمشرع المغربي بدوره أولى عناية كبيرة للحدث من خلال، إصلاح منظومة العدالة الجنائية، بتخصيص الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية للأحداث، وتمتيع الحدث بمجموعة من الضمانات في جميع مراحل المحاكمة، كما أن هذا القانون سيشهد بعض المستجدات سواء تلك المتعلقة بقضاء الأحداث أو القانون ككل والتي من شأنها حماية الاحداث، وضمان المزيد من الحقوق والتدابير الوقائية والتهذيبية لهم، ونتحدث هنا عن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وبهذا يمكن القول أن المقتضيات القانونية المنظمة للأحداث في قانون المسطرة الجنائية، أصبحت تجاري توصيات المؤتمرات العالمية وقواعد المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي سبق وأن ذكرناها، ويجب أن نعلم أن المشرع ومن خلال النصوص القانونية المتعلقة بالأحداث، عمل على تغليب التدابير الوقائية والتهذيبية والتربوية على التوجه العقابي، إلى جانب الدور المهم الذي يقوم به قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة والضابطة القضائية في قضايا الاحداث، والمؤسسات…
وتأسيسا لما سبق، مسؤولية حماية الحدث وإصلاحه واعادة تكييفه في المجتمع…، ليست مسؤولية القضاء والاجهزة الأمنية فقط، بل هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها كل من : الأسرة المجتمع المدني، المؤسسات التعليمية، الفاعلين، الاعلام…
كانت هذه قراءة جزئية لهذا الحكم، في انتظار أن يخصص لموضوع الحدث مساهمة خاصة على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية بحول الله وقوته