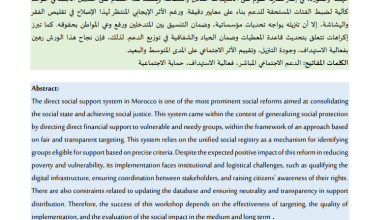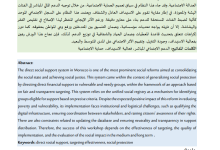المجال الدستوري للمالية العمومية بالمغرب اية مرتكزات؟ الباحث: محمد البشير الكسكاس
المجال الدستوري للمالية العمومية بالمغرب اية مرتكزات؟
“The Constitutional Framework of Public Finance in Morocco: What Are the Foundations?”
الباحث: محمد البشير الكسكاس
طالب باحث بسلك الدكتوراه، بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا.
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665













المجال الدستوري للمالية العمومية بالمغرب اية مرتكزات؟
“The Constitutional Framework of Public Finance in Morocco: What Are the Foundations?”
الباحث: محمد البشير الكسكاس
طالب باحث بسلك الدكتوراه، بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا.
يعد المجال الدستوري للمالية العمومية بالمغرب إطارًا قانونيًا يحدد المبادئ والقواعد التي تنظم النشاط المالي للدولة، ويستمد مشروعيته من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ذات الصلة، وخاصة دستور 2011. هذا المجال لا ينحصر في الدستور فقط، بل يمتد ليشمل ما يعرف بـ”الكتلة الدستورية” التي تضم أيضًا اجتهادات القضاء الدستوري. تشكل مبادئ كالتوازن والسنوية والشفافية والصدقية والعدالة الضريبية جوهر التدبير المالي العمومي. تاريخيًا، تطور النظام المالي المغربي عبر ثلاث مراحل رئيسية: ما قبل الحماية، فترة الحماية، وفترة ما بعد الاستقلال، حيث تم ترسيخ مأسسة الميزانية والرقابة التشريعية عليها. وقد أسهم دستور 2011 بشكل نوعي في تقوية مكانة المالية العمومية من خلال أكثر من ثلاثين فصلًا يعكس التزامات الدولة بالحكامة المالية الجيدة. ورغم الانفتاح على الاتفاقيات الدولية، يحتفظ المشرع المغربي بسمو الدستور الوطني، مما يجعل المجال الدستوري أداة لضبط السياسات المالية وحمايتها من التعسف أو الانحراف.
Abstract
The constitutional domain of public finance in Morocco defines the legal and institutional rules governing state financial activity. It is based on the Constitution of 2011, related organic laws, and constitutional jurisprudence. This domain includes not only the constitutional text but also the broader “constitutional bloc” concept. Key principles such as budgetary balance, annuality, transparency, credibility, and tax fairness are central. Public finance in Morocco has evolved through three stages: pre-protectorate, protectorate, and post-independence. Since 1962, financial legislation has gradually become constitutionalized. The 2011 Constitution marked a turning point by integrating over 30 articles related to public finance and financial governance. It emphasizes accountability, performance-based budgeting, and fiscal discipline. Despite Morocco’s adherence to international treaties, national constitutional supremacy is maintained. Ultimately, this framework ensures responsible public financial management and safeguards the public interest.
مقدمة:
إن دراسة المالية العمومية تستدعي استحضار مجموعة من الابعاد المحيطة بها، فلال يمكن دراسة مالية عمومية لاي بلد دون استحضار البعد التاريخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني… وكذلك الحقول العلمية الأخرى والتي تربها علاقة بالمالية العمومية ولعل دراسة المجال الدستوري للمالية العمومية تستحضر هذه العلاقة من خلال تداخل مجموعة من الحقول المعرفية والمتمثلة في القانون الدستوري والقانون الدولي وعلاقتها بالمالية العمومية.
والمالية العمومية تدخل في نطاق القانون العام، وهي حقل معرفي يدرس النشاط المالي للدولة والميكانيزمات التي تشتغل بها، بغية اشباع الحاجات العامة، عبر تنظيم النفقات العامة والإرادات العامة بشكل يتوافق وأهداف الدولة.
المالية العمومية تحتل مكانة استراتيجية في بنية الدولة، مما يفسر الاهتمام المتزايد بها. فالدولة لا تستطيع القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية دون موارد مالية خاصة، وتلبية احتياجات المواطنين ضرورية لضمان استقرار الدولة واستمراريتها.
فالدولة اليوم، لم تعد مطالبة بتوفير الموارد لتغطية النفقات فقط، بل مدعوة للتوجيه الأحسن لها، لخدمة التنمية الشمولية، وضمان استمرارية الموارد. فالمداخيل المتوفرة إن لم تستخدم في المشاريع التنموية، وبنظرة استشرافية، سيكون مصيرها الانقراض، خصوصا بالنسبة للدول التي تعرف صعوبات في توفير الموارد وحسن توجيهها، لأنه حتى الدول المتقدمة، أصبحت تعاني من الانكماش الاقتصادي، وثقل الخدمات الاجتماعية وعواقبها على الميزانية. وعلى هذا المنحى يظهر علم المالية العامة، على أنه العلم الذي يمكنه أن يبين الخلل الحاصل في تدبير الموارد والنفقات، وحل المعوقات التي تحول دون أداء الميزانية لدورها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.[1]
وقد جاء دستور المملكة المغربية لسنة 2011، بمجموعة من الفصول المتعلقة بتدبير المالية العمومية، مما شكل إطارا مؤسسيا يعزز مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات والحكامة الجيدة. هذه الأحكام تركز على معايير الجودة والمساواة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة والصدقية في إدارة المالية العامة.
وقد ارتكزت النصوص الدستورية المتعلقة بتدبير المالية العمومية في شقيها سواء المتعلق بالمبادئ المالية العمومية أو المتعلق بالقواعد الدستورية، على تكريس الشفافية والمسؤولية المراقبة والمحاسبة في تدبير الموارد العمومية.
ويمثل مبدأ الهرمية القانونية أهم المبادئ في دولة القانون فهو يتضمن مطابقة القانون الأدنى للقانون الأعلى، ويقع الدستور وهو الوثيقة الأسمى في قمة هرم المعايير القانونية، حيث يجب أن تحترمه القوانين الأدنى منه، وحرصا على حماية سمو الدستور استحدث المشرعون هيئات مكلفة بمطابقة القوانين للدستور ضمن مسمى الرقابة على دستورية القوانين والتي يقوم بها القضاء الدستوري. وفي المقبل فإن تطور وتوسع صلاحيات القضاء الدستورية ومتطلبات ارساء دولة القانون أدت إلى توسيع مجال الرقابة الدستورية إلى مجموعة أوسع من المصادر التي تتمتع بالسمو في كل دولة، وهو ما أدى إلى ظهور مفهوم جديد في القانون العام، وهو مفهوم المجال الدستورية أو كتلة الدستورية.
الأهمية
يكتسي موضوع الدراسة “المجال الدستوري للمالية العمومية بالمغرب” أهميته، من خلال تسليط الضوء على مسألة غاية في الأهمية مرتبطة بالأسس والمرتكزات المرجعية للمشرع المغربي في المجال المالي. وكذلك الدور الذي يلعبه المجال الدستوري للمالية العامة في التأثير على اجتهادات القضاء الدستوري المغربي.
الإشكالية
من خلال هذه الاهمية تثار الإشكالية التالي، هل يؤثر المجال الدستوري للمالية العمومية المغربية على هرمية القوانين؟
تتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:
- ما المقصود بالمجال الدستوري للمالية العمومية؟ وماهي حدوده؟
- ما الفرق بين الكتلة الدستورية للمالية العمومية والدستور المالي؟
- هل تدخل المعاهدات الدولية ضمن عناصر الكتلة الدستورية؟
- اين تبرز المرتكزات الدستورية للمالية العمومية المغربية؟
- ماهي تمظهرات المالية العمومية في المجال الدستوري؟
خطة الدراسة
المحور الأول: أسس المالية العمومية المغربية
المحور الثاني: مرتكزات المجال الدستورية للمالية العمومية المغربية
المحور الثالث: تمظهرات المالية العمومية في المجال الدستوري
المحور الأول: أسس المالية العمومية المغربية
إن الغوص في دراسة المجال الدستوري للمالية العمومية، يستوجب منا أولا، وقبل كل شي، التأصيل المفاهيمي والتاريخي في إطار المنطلقات النظرية، وكذا المحطات المساهمة في تطور المالية العمومية، وهو ما سيتم تناوله تباعا في الفرعين التاليين.
الفرع الأول: المنطلقات النظرية
في هذا الفرع سنتطرق لأهم المفاهيم التي تؤسس لمعالجة موضوع الدراسة، والتمييز بينهما لرفع اللبس عن التداخل بين هذين المفهومين. حيث سنتناول أولا الكتلة الدستورية (المجال الدستوري)، وكذلك الدستور المالي ثانيا.
أولا: الكتلة الدستورية (المجال الدستوري)
الكتلة الدستورية هي مجموعة المبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية، الواجبة الاحترام، وتفرض أحكامها على السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبصورة أشمل على كل السلطات بما فيها السلطات القضائية والإدارية. وقد ظهر هذا الاصطلاح في الحقل الدستوري مع الفقه الدستوري الفرنسي بداية السبعينات، للتعبير عن تلك المجموعة من النصوص المتعلقة أساسا بالحقوق والحريات الموجودة خارج الوثيقة الدستورية والتي أضفى عليها المجلس الدستوري الطاب الدستوري، انطلاقا من ديباجة الدستور التي أشارت إليها باعتبارها مبادئ وقيم يتمسك بها الشعب الفرنسي. وتعد البروفيسورة الفرنسية (Elsabethzoller) من بين الذين طرحوا مفهوم الكتلة الدستورية، ويشير البعض إلى أ، أول استعمال لهذه العبارة كان على يد كل من Claude Emeri وj.L.Seurin بمناسبة تعليقهما على المجلس الدستوري رقم 37-69 الصادر في 1989.11.20 المتعلق بنظام الجمعية الوطنية، في حين يذهب الفقهيه G.Drago إلا أن أول من استعمل العبارة هو العميد Favoreu والذي صاغ عبارة الكتلة الدستورية لتعيين جميع المعايير الدستورية التي يجب أن تحترمها القوانين تحت رقابة المجلس الدستوري[2].
والذي يهمنا هنا هو المجال الدستوري للمالية العمومية، أي الكتلة الدستورية المالية. وقد عرفه الدكتور محمد البقالي” هي ذلك الجسم المتراص والمتطور من القواعد والمبادئ، التي لا تقتصر على الدستور، والتي تلزم وتؤطر ما دونها من القواعد والأنظمة القانونية” بالإضافة لاجتهادات القضاء الدستوري، وأضاف “الكتلة الدستورية للمالية العمومية تضم إلى جانب الدستور وديباجته التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، مكونا ثانيا يتمثل في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمالية، سواء القانون التنظيمي التاريخي لقوانين المالية أو النصوص المالية المتناثرة في باقي القوانين التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بالجماعات الترابية”. غير أن محمد البقالي قد استثنى الاتفاقيات الدولية، حتى لو صادق المغرب عليها مالم يراجع الدستور.
ثانيا: الدستور المالي
بالرجوع للمالية العمومية، تستحضر فكرة الكتلة الدستورية عبارة الدستور المالي التي استعملت للترويج للقانون التنظيمي لقانون المالية الفرنسي لسنة 2001 على غرار عبارة الدستور المدني التي اقترنت بالقانون المدني الفرنسي لسنة 1804، وهي عبارة تفتقد للسند الفقهي، حيث يراها الأستاذ الأسكندر كويك صاحب أطروحة أصول وتطور التصويت على ميزانية الدولة في فرنسا وانجلترا سنة 2005 غير معتمدة لا في فرنسا ولا في بريطانيا[3].
وعليه فقد استورد الباحثون المغاربة هذا المصطلح وتم ربطه بالقوانين التنظيمية للمالية فأضحى مفهوم الدستور المالي يعبر عن القانون التنظيمي المالي. وهذا ما لم يتبناه المشرع المغربي، حيث إن هذا المصطلح لم يد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية للمالية ولا في قوانين المالية.
الفرع الثاني: اهم المحطات التاريخية المساهمة في تطور المالية العمومية
مرت المالية العمومية في المغرب بمجموعة من المحطات التي ساهمت في تطويرها وتعزيز مكانتها ضمن المجال الدستورية، وتمثلت في فترات زمنية متتالية، استحضرناها تباعا عبر مرحلة ما قبل الحماية، وفترة الحماية ثم مرحلة الاستقلال.
أولا: ما قبل الحماية
ان النظام السياسي في المغرب في مرحلة ما قبل الحماية لم يكن يعرف المؤسسة البرلمانية، بل كان نظام المخزن هو المسير للشؤون العامة، وكانت السلطة المركزية هي المختصة في المجال المالي. وتجسدت سلطة السلطان في جني الضرائب ورفع موارده من الضريبة، والتي كانت تعد المصدر الرئيسي للصراع بين بين السلطة السياسية والقبائل.
جسد واقع تحكم السلطة السياسية بالمغرب القديم في المالية العامة، وفي ظل عدم استقرار الأوضاع في القرن التاسع عشر وازدياد الضغط الأوروبي، دفع الى محاولة إصلاح المالية العامة كأحد مضامين استقلال البلاد.
وقد تجسدت أولى محاولات هذ الإصلاح، مذكرة عبد الله بن سعيد لسنة 1901، والتي تطرقت لبعض جوانب التدبير المالي، حيث ربط ازدهار الموارد بالأمن. وثاني وثيقة، مذكرة علي زنيبر سنة 1906، والتي كانت موجزة في التطرق للمقتضيات المالية. حيث تمثلت اهم مضامينه في هذا المجال في مساوات جميع المغاربة في الضرائب والجبايات، وتأسيس بنك باسم الحكومة. وثالث وثيقة هي مذكرة عبد لكريم مراد سنة 1906، والتي أكدت على أهمية المال كأحد مداخل الإصلاح ومقوم لوجود الدولة. أما رابع وثيقة والتي تشكل أول مشروع دستور حقيقي يتعلق الامر بمشروع دستور لسان المغرب لسنة 1908، يسجل على هذه الوثيقة على أنها خصصت 12 مادة من أصل 93 مادة للتنصيص على قواعد المالية العامة.[4]
ثانيا: اثناء فترة الحماية
عرفت سنة 1912 إحداث المديرية العامة للمالية، كانت أول ميزانية للإمبراطورية الشريفة برسم سنة 1913/1914، وتهييئ الميزانية، كان يخضع لمسطرة خاصة. وكأول وثيقة برزت في هذا الصدد هي مذكرة مطالب الشعب المغربي 1934 التي تضمنت حزمة من الإصلاحات وتضمن العديد من القواعد المالية.[5]
ثالثا: فترة الاستقلال
مع انتخاب أول برلمان 1963، بدأت قوانين المالية التي تضعها الحكومة تخضع لترخيص البرلمان قبل المرور إلى حيز التنفيذ، فالمناقشة السنوية للقانون المالي تكتسي أهمية كبيرة، فهي وسيلة فعالة لمراقبة نشاط الحكومة ومناسبة لإنقاذ سياستها في مختلف المجالات خاصة في المجال المالي. ومع الاستقلال ومع توالي الدساتير المتعاقبة منذ أول دستور للمغرب لسنة 1962 إلى الدستور الحالي لسنة 2011 سيبرز ازدياد دسترة المقتضيات المتعلقة بالمالية العامة وهو ما يبرز أهمية الحديث ومناقشة مضمون الدستور المالي في المغرب، كمفهوم رئيسي في دراسة القانون الدستور المغربي.[6]
المحور الثاني: مرتكزات المجال الدستورية للمالية العمومية المغربية
يرتكز المجال الدستوري للمالية العمومية في القانون المغربي عل مجموعة من النصوص القانونية الدستورية الفرع الأول، وعلى المبادئ الدستورية العامة للمالية العمومية الفرع الثاني.
الفرع الأول: النصوص القانونية للمالية العمومية
اقتصرت دراستنا في هذا الفرع على النصوص القانونية الدستوري المؤطرة للمالية العمومية المغربية، وكذلك القوانين التنظيمية وهو ما تطرقنا له تباعا.
أولا: النصوص القانونية الدستورية
شكل أول دستور للمملكة الغربية سنة 1962 اللبنة الاساسية للدستور المالي أو المالية العمومية من خلال رسم المعالم الأساسية للقوانين التنظيمية للمالية العمومية. غير أن الوثيقة الدستورية طالتها مجموعة من التعديلات كان أولها سنة 1970وتوالت التعديلات حسب السياقات التاريخية 1972، 1992، 1996، وكان آخرها دستور 2011.
شكل صدور أول دستور للمملكة المغربية بتاريخ 14 دجنبر 1962 مستهلا لسلسلة من الإصلاحات الأساسية على مستوى الإطار القانوني المؤطر لميزانية الدولة وكرس الفصل 50 من هذا النص الدستوري مبدأ الترخيص الميزانياتي الذي يضطلع به البرلمان عبر تصويته على قانون المالية[7]. وكرس الفصل 39 على أن الضرائب لا تحدث ولا تجبى الا بمقتضى قانون، مما يعني أن فرض الضرائب أو تعديلاها يجب ان يتم عبر قوانين يصادق عليها البرلمان،
وقد شهدت التعديلات الدستورية اللاحقة تقليص من صلاحيات البرلمان على مستوى الترخيص الميزانياتي، حيث لم يعد للبرلمان السلطة المباشرة في التعديل، إضافة إلى تنفيذ الميزانية بواسطة مرسوم ملكي في حالة عدم التصويت داخل أجل 30 يوم. وهو ما كرسته الفصول، الفصل 38 من دستور 1970، ومن دستور 1972، والفصل 50 من الدستورين 1992 و1996، أما فيما يخص الضرائب فهي تحدث بقانون وتختص الحكومة بالمبادرة التشريعية، وهو ما نصت عليه الفصول. الفصل 35 من الدستورين 1970 و1972، والفصل 39 من الدستورين 1992 و1996.
أما فيما يتعلق بدستور المغرب لسنة 2011، واستحضار الاستعمالات اللفظية، فالحضور الدستوري للمالية العمومية يتجاوز تنصيص الفصول التاريخية لمشروعية التصويت على قانون المالية والفرض الجبائي والضريبي. لقد انخرطت المالية العمومية في رهانات تقويمية بأبعاد حقوقية، تدبيرية وإصلاحية، تتجاوز البعد التقني، لتغدو مجال تجديد التعاقدات الاجتماعية والسياسية بامتياز، محك العمل التنموي ومختبر الحكامة المؤسساتية. هكذا، فيتضمنه لأزيد من ثلاثين فصلا عن المال العام والحكامة المالية، يكتسي دستور 2011 قيمة بارزة؛ تكرس من جهة، طابع الاستقرار الذي ميز ميكانيزمات التمفصل المؤسساتي للعمليات المالية الأساسية للدولة ولأدوار فاعليها؛ لكنها ترتقي من جهة أخرى، بهذه الميكانيزمات والقواعد لتمنحها بعدا آخر، يدمجها في صميم مسلسل الإصلاحات البنيوية التي تتوخاها السلطات العمومية[8].
ثانيا: القوانين التنظيمية
بمجرد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، فإن أول خطوة بناءة تم إنجازها هي إرساء دعائم نظام مالي وطني مستقل، ارتكز على وضع ميزانية وطنية تغطي جميع مناطق المغرب الموحد بعيدا عن كل تدخل أجنبي في سنة 1958، وفي ظل غياب مجلس تشريعي يعهد له بدراسة والتصويت على ميزانية الدولة، تمت المصادقة على ميزانية المغرب المستقل من طرف مجلس الديوان ومجلس الوزراء. وبالموازاة مع ذلك تم إصدار عدة قوانين تنظيمية للمالية ارتبطت بشكل وثيق بالتجارب الدستورية المغربية. ابتداء من دستور 1962 الذي أفرز قانون تنظيمي للمالية لـ 9 نونبر 1963. ودستور سنة 1970 مع قانون تنظيمي للمالية لـ 3 أكتوبر (1970)، وكذلك الأمر بالنسبة لدستور سنة 1972 مع القانون التنظيمي للمالية 1972، هذا الأخير تم العمل به حتى في ظل مقتضيات دستور 1992، إلى أن جاء دستور 1996 بالقانون التنظيمي للمالية رقم 7.98 الصادر في 25 نونبر 1998، كما وقع تغييره وتتميم بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19) أبريل (2000) (12)، دون أن ننسى المرحلة التجريبية للإصلاح الميزانياتي المرتكز على النتائج سنة 2001، لتصل مع الدستور الجديد لسنة 2011 إلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية”، الذي يعتبر إطارا مرجعيا لتقنين مختلف العمليات الموازناتية والمالية وتأطيرها في جميع أبعادها التقنية والتنظيمية[9].
الفرع الثاني: المبادئ الدستورية العامة للمالية العمومية
تنقسم المبادئ الدستورية العامة للمالية العمومية لمبادئ قديمة مترسخة، وأخرى حديثة يحكمها الطابع الحقوقي، وهو ما أكسبها قيمتها القانوني ضمن المجال الدستوري. سنحاول من خلال هذا الفرع الثاني التطرق لهذه المبادئ الدستورية الأساسية، والتي يمكن تصنيفها ضمن المبادئ العامة والمبادئ الموازنتية والمبادئ المحاسبية والمبادئ الضريبية.
جدول 1: المبادئ الكبرى للمالية العمومية
| مبادئ الميزانية العمومية | |||
| المبادئ العامة | المبادئ الموازنتية | المبادئ المحاسبية | المبادئ الضريبية |
| • م. السنوية
• م. الصدقية •م. التوازن |
• م. وحدة قانون المالية
• م. شمولية الميزانية • م. تخصيص الميزانية |
• م. وحدة الصندوق
• م. الصدق المحاسبي • م. عدم التخصيص |
• م. ضرورة الضريبة
• م. مشروعية الضريبة • م. العدالة الضريبية |
أولا: مبدأ سنوية قانون المالية
يقضي مبدأ السنوية بأن توضع تقديرات نفقات الدولة ومداخيلها لحول كامل، اثنا عشر شهرا، أي أن تتقدم الحكومة بتوقعاتها وتقديراتها إلى البرلمان كل سنة وأن هذا الأخير يطلع ويصادق على مشروع الحكومة كل سنة وأن ترخيصه صالح لمدة سنة[10].
ويشكل مبدأ “سنوية الميزانية عاملاً يتوخى المرونة في سياق تقنية وضع خطة مالية محددة من قبل الدولة (La tactique financière de l’Etat) وهو السبب الحقيقي وراء الاحتفاظ به في أغلب القوانين الوضعية”. وتبرز قيمة مبدأ سنوية الميزانية في تحديد مدة استحقاق الميزانية، إذ تتجلى قاعدة السنوية في بعدين أساسيين[11]:
– لا يمكن أن يتجاوز الترخيص السنوي للبرلمان السنة الواحدة، أي أن مدة الميزانية هي اثنا عشر شهراً، ولا يعني ذلك بالضرورة أن تقترن السنة المالية بالسنة المدنية.
– على الحكومة أن تستعمل الترخيصات الممنوحة لها من قبل البرلمان خلال سنة منحها، وهو ما يعني أن جميع العمليات خاصة ميزانية الاستغلال) يجب أن تنفذ من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر من نفس السنة
يستمد مبدأ السنوية أساسه الدستوري من الفصل 75 الذي نص على: “إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية او لم يصدر الامر بتنفيذه”، وكذلك من الفصل 68 الذي ينص على: “عرض مشروع قانون المالية السنوي في جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه “.
وهو نفس ما جاء به القانون التنظيم للمالية رقم 130.13، حيث ينص القانون في مادته الأولى على ما يلي: “يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي الناتج عنها”.
كما يؤكد نفس القانون في مادته الثالثة على: “يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5” (من نفس القانون). وجاء في الفقر المولية ومن نفي المادة، “تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة”.
ثانيا: مبدأ التوازن المالي
لا يتحقق التوازن المالي في ميزانية الدولة إلا عندما تكون الإيرادات والمصروفات متوازنة[12]، وهو ما يسمى بالقاعدة الذهبية وهو ما كرسته المالية العمومية التقليدية، بحيث لا تزيد النفقات العامة للدولة على إراداتها العامة العادية فيحصل عجز في الميزانية، كما لا يجب أن تزيد الارادات العامة العادية للدولة على نفقاتها العامة العادية، فيحصل فائض في الميزانية[13].
وفي المقابل نجد أن الفكر الحديث، يرى أن يتحقق هذا التوازن لا يمكن إلا بربط المالية بالاقتصاد، إذ تعد السياسة المالية جزءاً لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية، وبالتالي يصبح التوازن المالي غير ذي أهمية بالنظر إلى التوازن الاقتصادي[14].
وفي هذا السياق نص الدستور المغربي لسنة 2011، من خلال الفقرة الاولى من الفصل 77 على ما يلي: “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة” وتماشيا مع المشرع الدستوري، كرس المشرع العادي لمبدأ التوازن المالي، من خلال المادة الأولى من القانون لتنظيمي للمالية رقم 130.13 “يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعي في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددا هذا القانون”.
ثالثا: مبدأ الصدق المالي (صدقية الميزانية)
ينص مبدأ صدقية الميزانية على ان الأرقام الواردة في القانون المالي والمتعلقة بالتكاليف والموارد يجب أن تكون على درجة عالية من الصدقية وقريبة أكثر إلى الحقيقة، ولا يمكنها أن تكون كذلك بدون أن تنبني على معطيات حقيقة وعلى توقعات تراعي الظرفية الاقتصادية، ومستوى التوازنات المالية للبلاد.[15]
يكرس مبدأ الصدقية، لصدقية الحسابات المقيدة في سجلات الموارد والنفقات، والذي يتعين أن تستوفي معايير الاستحقاق. وقد نص القانون التنظيمي للمالية 130.13 في مادته العاشرة على أنه: “تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها”. وتنص المادة 31على ما يلي “يجب أن تكون حسابات الدولة شرعية وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ووضعيتها المالية”. ونصت المادة 32 على أنه “تقدم قوانين المالية بصورة صادقة من مجموع موارد ونفقات الدولة وعلى المعطيات المتوفرة وتوقعات تراعي الظرفية الاقتصادية”.
من خلال القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 تكرس مبدأ الصدقة وهو المبدأ الذي يعكس متطلبات الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور المغرب لسنة 2011.
مبدأ وحدة القانون
يقصد بهذا المبدأ إدراج جميع نفقات الدولة وإراداتها العامة ضمن وثيقة واحدة، وهذا هو الأصل. ومبدأ وحدة القانون (الموازنة) يسهل الرقابة التشريعية:
– الرقابة الفعالة: يمكن البرلمان من الرقابة على النفقات العامة والإيرادات العامة بفعالية.
– معرفة التوازن المالي: يمكن من معرفة ما إذا كانت الموازنة في توازن أو تتضمن عجزًا أو فائضًا.
كما يمكن هذا المبدأ من تحديد نسبة النفقات العامة أو الإيرادات العامة إلى الدخل القومي، ويكون الأمر صعبا في حالة تعدد القوانين (الموازنات)[16].
مبدأ شمولية القانون
يراد من هذا المبدأ شمولية القانون، أن تكون موازنة الدولة شاملة تقديرات جميع نفقاتها وجميع إراداتها. دون إجراء أي اقتطاع منها أو تقاص بينهما. أي أن يذكر في الموازنة تقديرات إرادات الدولة كافة، أيا كان مصدرها، ونفقاتها كافة، أيا كانت أنواعها[17].
وفي نفس السياق، قال رينه ستورم Rene Stourm بفضل مبدأ الشمول، لا يتاح للموظفين العموميين أن يقتطعوا على هواهم، ما شاءوا من الإيرادات التي يجبونها لتغطية نفقاتهم، ولن يكون هناك مخبأ تلوذ به العمليات المشبوهة، واتفق كل من غاستون جيز Gaaston Jeze وادغار الليكس Edgarol Allix على القول: بأن مبدأ شمول الموازنة هو الشرط الأساسي لرقابة الجمعية الوطنية[18].
إن الأصل هو مبدأ شمولية القانون والذي يكرس لعدم التخصيص غير أنه ترد عليه بعض الاستثناءات والتي يتجلى أبرزها في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. والتي يمكن أن تعطي بعض نفقاتها بمواد ذاتية ليس لها صلة بالاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة.
وفي هذا السياق جاءت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ” يمكن رصد بعض المداخيل لبعض النفقات في إطار ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو في إطار إجراءات محاسبية خاصة كما هو منصوص عليها في المادتين [19]34 و[20]35″.
مبدأ وحدة الصندوق
تفيد قاعدة وحدة الصندوق أن كل المداخيل مهما كان مصدرها تصب في وعاء واحد، صندوق المحاسب العمومي الذي يؤمن كل الأداءات ويقيد مجموع العمليات المحاسبية ويضبط التوازنات. هكذا، نصت الجملة الثانية من المادة 31 من الفصل السادس المتعلق بحسابات الدولة في القانون التنظيمي لقانون المالية على التزام الدولة بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها. وطبقا لهذه القاعدة، لا يتضمن قانون المالية السنوي إلا جدولا واحدا للتوازن المالي. والغاية من هذا الأمر تمكين جدول التوازن من إبراز كافة عناصر التوازن الميزانياتي وحاجيات التمويل بحسب ما نصت عليه المادة 36 من القانون التنظيمي لقانون المالية: “يقدم جدول التوازن بكيفية تبرز كافة عناصر التوازن الميزانياتي وحاجيات التمويل”[21].
مبدأ الصدق المحاسبي
يعد هذا المبدأ من المبادئ الحديثة التي تبناها المشرع المغربي من خلال القوانين التنظيمية المتمثلة في القانون التنظيمي للمالية والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية مما جل هذا المبدأ من المبادئ التي تدخل في المجال الدستوري بناء على توجهات الدولة وإرادة المشرع.
حيث جاء في القانون التنظيمي للمالية العمومية رقم 130.13، في مادته العاشرة. “تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع تكاليف وماورد الدولة، ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها”[22].
وعلى نفس المنوال جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في المواد التالية:
- تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.[23]
- تقدم ميزانية العمالة أو الاقليم بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.[24]
- تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها. ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.[25]
يعتبر مبدأ الصدقية وصدقية التوقعات والحسابات الميزانياتية قاعدة حديثة تتفرع من مبدأ الحكامة الجيدة في مجال التدبير الرقمي، إنها ترجمة لمعاني الشفافية والنزاهة والوضوح التي يجب أن يرتكز عليها إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة فضلا على أنها تمكن البرلمان من ممارسة سلطته المالية، تشرعا ومراقبة، على الوجه الأكمل.[26]
مبدأ التخصيص
يتكرس هذا المبدأ من خال تدخل الدولة في تخصيص موارد أو مجموعة من المواد لمجال معين يعاني من القصور، وخاصة بالنسبة للسلع العامة، وهي السلع التي تشبع حاجة عامة، كالحاجة إلى الامن أو الدفاع أو العدالة والتي تقوم الدولة بمهمة إشباعها. ونظرا لأن الموارد الاقتصادية في مجموعها محدودة بطبيعتها فإن ما يخصص منها لإشباع الحاجات العامة لا بد وأن يكون محدودا كذلك. ما ينتج عنه مشكلة توجيه الموارد المحدودة لإشباع أكبر قدر من الحاجات العامة والفردية. وهذه مشكلة اقتصادية يتطلب مواجهتها حسن استخدام الموارد وتوجيهها وتوزيعها بين مختلف الاستخدامات والأغراض[27].
مبدأ ضرورة الضريبة
وهذا يعني أن الضريبة عندما يتم تقريرها وتنظيمها فنيا طبقا للقواعد المحددة، فإنها تأخذ الطابع الإلزامي الجبري أي يجبر الأفراد على دفعها وليس لهم خيار في ذلك ولا يتعارض ذلك مع ما تنص عليه الدساتير من وجوب تصديق البرلمان أو السلطة التشريعية على الضرائب في صورتها الكلية الضريبة أو تقتطع جبرا على مستوا الفرد دون شرط توافر رضاه أو اخد رغبته، وما يؤكد ذلك أن الدولة تنفرد بوضع النظام القانوني للضريبة حيث تحدد وعاء الضريبة وسعرها وكيفية تحصيلها وكافة الإجراءات المتعلقة بها، كما أن الدولة تستطيع من خلال وسائل التنفيذ الجبري أن تحصل على الضريبة في حالة امتناع المكلف عن أداء الضريبة المستحقة عليه فضلا عن تمتع الدولة بامتياز على أمواله.[28]
مبدأ مشروعية الضريبة
يعني مفهوم المشروعية الضريبية، التوافق مع القانون ومن ثم قيام الإدارة الضريبية بتحديده وعند تطبيقه، مثلما يجب أن يكون معمولا به في جميع أعمال الإدارة. أما المفهوم الضيق للمشروعية الضريبية، فيعني أن قرار فرض الضريبة وأسس النظام الضريبي إنما ينبع من القانون، أي من اختصاص المشرع وحده[29].
مبدأ العدالة الضريبة
حسب هذا المبدأ يجب أن يراعى في فرض الضريبة المقدرة المالية لكل مكلف، لتحقيق المساواة في تحمل الأعباء العامة، حيث تفرض على الجميع بنفس المقدار وبما يتناسب مع حجم الدخل الذي يحصل عليه الفرد، إضافة إلى أن الجميع خاضع للضريبة من أفراد وأموال للضريبة (عمومية الضريبة) دون تمييز بين نوع الارادات ومصدرها، ولا حتى في المبلغ الضريبي أو الوقت أو النسب المئوية[30].
كما أن مفهوم العدالة بمفهومها الحديث تستلزم منح إعفاءات ضريبية لأصحاب الدخل المنخفض من أداء الضريبة بالنسبة للحد الأدنى اللازم للمعيشة بالإضافة لضرورة مراعاة الأعباء الأسرية بما يتوافق مع مستوى المعيشة في المحيط المجتمعي. ومن متطلبات العادلة كذلك تناسب سعر الضريبة مع النشاط المفروضة عليه سواء كان عمل أو رأس مال.
المحور الثالث: القيمة المعيارية في المجال الدستوري للمالية العمومية
عند الحديث عن المجال الدستوري للمالية العمومية، يثار تساؤل عن مكونات هذا المجال وطبيعة العلاقة التي تربط بين مكوناته، من حيث السمو والتبعية. أو أن هذه الهرمية قد تلاشت عند الحديث عن المجال الدستورية. أم أن هناك هرمية داخل المجال الدستورية. سنحاول في هذا المحور التطرق للقيمة المعيارية في المجال الدستوري للمالية العمومية. وذلك من خلال دور القضاء الدستوري المغربي وتكريسه لهرمية نصوص المالية العمومية. ثم الوقوف عند قيمة النصوص المكونة للمجال الدستوري للمالية العمومية. ثم نبين سمو القواعد الدستورية الوطنية.
أولا: القضاء الدستوري وتكريسه للقيمة المعيارية للنصوص المالية العمومية
لا تقتصر الكتلة الدستورية للمالية العمومية على الدستور وامتداداته من قوانين تنظيمية، بل تشمل أيضا اجتهادات القضاء الدستوري، خاصة المتعلقة بقوانين المالية السنوية أو التعديلية منذ عهد الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في فرنسا انطلقت سنة 1974 وتجلت سافرة في 24 دجنبر 1979 مع إعلان عدم دستورية قانون مالية 1980 جملة وتفصيلا رغم تصويت البرلمان عليه ،غير إن هذه الكتلة الدستورية لا تشمل باقي القوانين العادية التي لا يعتد بها في مراقبة المطابقة الدستورية ولا في الدفع بعدم الدستورية وهذا بتأكيد القضاء الدستوري، حيث اعتبرت المحكمة الدستورية المغربية، في قرارها بتاريخ 23 دجنبر 2017، أن مراقبة دستورية القوانين، ومن ضمنها قانون المالية، لا تتم إلا قياسا بالدستور وبالقوانين التنظيمية، وليس عبر الإحالة على قوانين تتقاسم معها ذات المرتبة والدرجة في التراتبية القانونية.[31]
ما يتضح من قرار القضاء الدستوري الفرنسي ومن خلال اجتهاده بأن قانون المالية لسنة 1980 غير دستوري ورغم تصويت البرلمان عليه قد أعطى قيمة معيارية لقراراته تسمو على قانون المالية وبالتالي القضاء الدستور الفرنسي كرس المعيارية.
وفي اجتهاد القضاء الدستوري المغربي يتضح على أن القاضي الدستوري المغربي ومن خلال قرار المحكمة الدستورية قد أخرج القوانين العادية من نطاق المجال الدستوري واعتبر أن مرجعية مراقبة دستورية القانين هي الدستور والقوانين التنظيمية.
القضاء الدستوري له دور محوري داخل الكتلة الدستورية، من خلال اجتهاداته والتي لا تخرج عن نطاق الكتلة الدستورية.
ثانيا: القيمة المعيارية للنصوص المكونة للمجال الدستوري للمالية العمومية
لا تقتصر المرتكزات الدستورية للمالية العمومية على الدستور، بل ترتبط داخل البنية القانونية بمفهوم أرحب، يضم قواعد واجتهادات أخرى تؤسس لما بات يعرف لدى جانب من الفقه الدستوري بفكرة الكتلة الدستورية، ككناية على ذلك الجسم المتراص والمتطور من القواعد والمبادئ، التي لا تقتصر على الدستور، والتي تلزم وتؤطر ما دونها من القواعد والأنظمة القانونية. والعميد لويس فافورو هو من ابتدع عبارة الكتلة الدستورية لتعيين مجموع المبادئ والقواعد ذات القيمة والحمولة الدستورية الملزمة للسلطة التشريعية والتي يمكن الاستناد إليها، على قدم المساواة مع الدستور، لتقييد السلطة التشريعية. بهذا، تتربع هذه الكتلة على قمة هرم الضوابط القانونية ولا وجود لتدرج أو هرمية بين كافة مكوناتها بتأكيد من القضاء الدستوري. ولقد مكنت فكرة الكتلة الدستورية القاضي الدستوري من إجراء مراقبة صارمة على القوانين اعتمادا على قواعد ومبادئ عديدة.[32]وهذا بخلاف ما تبناه المشرع المغربي التدرج الصارم للقوانين، ورغم أن المشرع المغربي تبنى فكرة المجال الدستور غير أنه لم يتخل عن هرمية القوانين وما كرسه قرار المحكمة الدستورية المغربية، في قرارها بتاريخ 23 دجنبر 2017 الذي رأيناه في الفقرة السابقة.
ثالثا: سمو القواعد الدستورية الوطنية
إن المشرع المغربي ومن خلال منطوق دستور 2011، كرس لسمو القواعد الدستورية الوطنية على حساب الاتفاقيات الدولية. وذلك للحفاظ على خصوصيته الوطنية، وثوابه الدستورية، وهويته الدينية، حيث جاء في تصدير الدستور، “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليه المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.” كما صرح المشرع أن هذا التصدير يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
وقد جاء في الفقرة الثانية من الفصل 55 من دستور المغرب لسنة 2011، ” يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنع لا يصادق على معاهدات السلام أو الاتحاد أو التي تهم رسوم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة…إلا بعد الموافقة عليها بقانون “.
يتضح من هاتين الفقرتين أن المشرع المغربي، لم يقر بسمو المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية حتى وإن تم التوقيع عليها، أو المصادقة عليها، إلا بشرط أن يتم مراجعة الدستور. ومنه فإن المجال الدستوري للمالية العمومية يسمو على المعاهدات الدولية من المنظور الوطني. وهذا بخلاف بعض التشريعات التي تنص ديباجتها الدستورية على ملاءمتها مع ما تتطلبه المصادقة على الالتزامات الدولية.
خاتمة
يتضح من خلال هذه الدراسة أن المجال الدستوري للمالية العمومية في المغرب لم يعد يقتصر على تأطير الإجراءات المالية، بل أصبح يشكل أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ دولة القانون. فالمقتضيات الدستورية، خاصة بعد دستور 2011، منحت للمالية العمومية بعدًا معيارياً يرتكز على الشفافية، والتوازن، والمحاسبة، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وقد أسهم الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية في بلورة تفسير دقيق للمقتضيات المالية ذات الطابع الدستوري، من خلال التمييز بين النصوص التشريعية والتنظيمية وتدقيق شروط المصادقة والمراقبة. غير أن تفعيل هذه المبادئ يظل رهيناً بإرادة سياسية قوية، وبإصلاحات مؤسساتية تضمن الانسجام بين النصوص القانونية والممارسات الفعلية.
إن التحدي المستقبلي الأكبر يتمثل في تعميق التنزيل الديمقراطي لهذه المقتضيات، وتوسيع دائرة إشراك المواطنين في مراقبة السياسات المالية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات السيادة الوطنية.
لائحة المراجع
الكتب
- أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة التاسعة، 2015.
- البرعي عزت عبد الحميد، مبادئ الاقتصاد المالي (المالية العامة) النفقات العامة – الإيرادات العامة – القروض العامة – الموازنة العامة، دار الولاء للطبع والتوزيع – شبين الكوم، 2005.
- اضريف عبد النبي، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التنظيمية، مطبعة بني ازناسن، 2016.
- شكران الحسين وصدوقي محمد، الوجيز في المالية العامة: دراسة معيارية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2023.
- عسو منصور، قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2018.
- كريم لحرش، تدبير المالية العمومية بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، مكتبة الرشاد، سطات، 2018.
- رمضان صديق، الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبي، نسخة إلكترونية، موقع المنظمة العامة [https://amo1.org/].
- محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية: مساهمة في رصد المرتكزات الدستورية لمالية الدولة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 2019.
الأطروحات والرسائل الجامعية
- الليلي محمد سالم، مرجعية القانون الدولي في عمل القاضي الدستوري بالمغرب – دراسة في التأثيرات المتبادلة بين قواعد القانون الدستوري ومنظومة القانون الدولي -، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، سلا، 2021/2022.
المقالات والأبحاث المحكمة
- جواد النوحي، “فكرة الدستور المالي في المغرب قبل الاستقلال”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 146، يونيو 2019، ص 70–73.
- شيعاوي وفاء، “تفسير النصوص الضريبية في إطار مبدأ المشروعية”، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثالث، ص 138.
- معمري مصطفى، “التوازن المالي والعقلنة المالية للبرلمان: قراءة في مضامين الفصل 77 من الدستور المغربي”، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 22، أكتوبر 2022، ص 24، وص 92.
- محرزي مي، “الصلة بين مبدأ الشمول ومبدأ الوحدة في الموازنة العامة”، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 38، العدد 3، 2016، ص 168.
- مودن عثمان والإدريسي زهير، “الإصلاح المحاسبي بالمغرب بين هاجس الصدقية ومطلب الحكامة”، مجلة اقتصاد المال والأعمال، المجلد 5، العدد 1، جوان 2020، جامعة الشهيد حمه لخضر، الجزائر، ص 380.
النصوص القانونية
- دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
- القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في 14 شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6370، 18 يونيو 2015، ص 5810.
- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ظهير شريف رقم 1.15.83، 7 يوليو 2015، الجريدة الرسمية عدد 6380، ص 6585.
- القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ظهير شريف رقم 1.15.84، الجريدة الرسمية عدد 6380، ص 6648.
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ظهير شريف رقم 1.15.85، الجريدة الرسمية عدد 6380، ص 6688.
المصادر الإلكترونية
القحطاني عبد الوهاب، “مفهوم وكيفية التوازن المالي في ميزانية الدولة”، موقع العربية، تم الاطلاع عليه بتاريخ 19/05/2025، www.alarabiya.net.
- عبد النبي اضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التنظيمية، مطبعة بني ازناسن، طبعة 2016، ص 9. ↑
- محمد سالم الليلي، مرجعية القانون لدولي في عمل القاضي الدستوري بالمغرب -دراسة في التأثيرات المتبادلة بين قواعد القانون الدستوري ومنظومة القانون الدولي-، أطروحة مناقشة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس، الموسم الدراسي 2021/2022، ص 72. ↑
- محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية مساهمة في رصد المساهمات المرتكزات الدستورية لمالية الدولة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية 2019، ص 12. ↑
- جواد لنوحي، فكرة الدستور المالي في المغرب قبل الاستقلال، المجلة لمغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 146، يونيو 2019، ص 70-73. ↑
- معمري مصطفى، التوازن المالي والعقلنة المالية للبرلمان قراءة في مضامين الفصل 77 من الدستور المغربي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 22، أكتوبر 2022، ص 92. ↑
- معمري مصطفى، التوازن المالي والعقلنة المالية للبرلمان قراءة في مضامين الفصل 77 من الدستور المغربي، نفس المرجع السابق، ص 92. ↑
- شكران الحسين وصدوقي محمد، الوجيز في المالية العامة دراسة معيارية، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى 2023، ص 59. ↑
- محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية مساهمة في رصد المساهمات المرتكزات الدستورية لمالية الدولة، مرجع سابق، ص 10. ↑
- كريم لحرش، تدبير المالية العمومية بالمغرب في ظل مستجدات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13، مكتبة الرشاد، سطات، طبعة 2018، ص 153-154. ↑
- محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية مساهمة في رصد المساهمات المرتكزات الدستورية لمالية الدولة، مرجع سابق، ص 33.
- شكراني الحسين وصدوقي محمد، الوجيز في المالية العامة دراسة معيارية، مرجع سابق، ص 82. ↑
- عبد الوهاب القحطاني، مفهوم وكيفية التوازن المالي في ميزانية الدولة، تم الاطالع على المقال بتاريخ 2025/05/19 على الساعة 07:36، www.alarabiya.net ↑
- منصور عسو، قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2018، ص80. ↑
- مصطفى معمري، التوازن المالي والعقلنة المالية للبرلمان قراءة في مضامين الفصل 77 من الدستور المغربي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 22، أكتوبر 2022، ص 24. ↑
- عبد النبي اضريف، قانون ميزانية الدولة على ضوء القانون التنظيمي للمالية 130.13 ونصوصه التنظيمية، مرجع سابق، ص 60. ↑
- عزت عبد الحميد البرعي، مبادئ الاقتصاد المالي (المالية العامة) النفقات العامة – الإيرادات العامة – القروض العامة – الموازنة العامة، الولاء للطبع والتوزيع – شبين الكوم، 2005، ص 535. ↑
- مي محرزي، الصلة بين مبدأ الشمول ومبدأ الوحدة في الموازنة العامة، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (38) العدد(3) 2016، ص 168. ↑
- مي محرزي، نفس المرجع، ص 168. ↑
- تنص المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية “تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة أموال المساعدة المدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا. ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مصدر أموال المساعدة من موارد ضريبية.
غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو إلى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو إلى الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها. جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.
يجب أن تكون عمليات رصد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.
ويدرج المتبقى من أموال المساعدة في المداخيل بالميزانية العامة”. ↑
- تنص المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية “يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة المبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”. ↑
- محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية مساهمة في رصد المساهمات المرتكزات الدستورية لمالية الدولة، مرجع سابق، ص 121. ↑
- المادة 10 القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في 14 من شعبان 1436 (2يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6370 – فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) ص 5810. ↑
- الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات، ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380 – 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6585. ↑
- الفقرة الثانية من المادة 144 من القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والاقاليم، ظهير شريف رقم 1.15.84، صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380 – 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6648. ↑
- الفقرة الثانية من المادة 152 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، ظهير شريف رقم 1.15.85، صادر في 20 رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6380 – 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6688. ↑
- عثمان مودن، زهير الادريسي، الإصلاح المحاسبي بالمغرب بين هاجس الصدقية ومطلب الحكامة، مجلة اقتصاد المال والاعمال، المجلد 05، العدد 01، جوان 2020، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر، ص 380. ↑
- رمضان صديق، الوجيز في لمالية العامة والتشريع الضريبي، مصدر الكتاب أعضاء المنظمة العامة، نسخة الكتاب الكترونية، موقع التحميل https://amo1.org/ ص 28. ↑
- عزت عبد الحميد البرعي، مبادئ الاقتصاد المالي (المالية العامة) النفقات العامة – الإيرادات العامة – القروض العامة – الموازنة العامة، مرجع سابق، ص 251. ↑
- وفاء شيعاوي، تفسير النصوص الضريبية في إطار مبدأ المشروعية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثالث، ص 138. ↑
- أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة التاسعة 2015، ص 128. ↑
- محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية مساهمة في رصد المساهمات المرتكزات الدستورية لمالية الدولة، مرجع سابق، ص 14. ↑
- محمد البقالي، نفس المرجع، ص 11. ↑