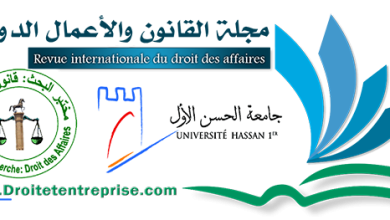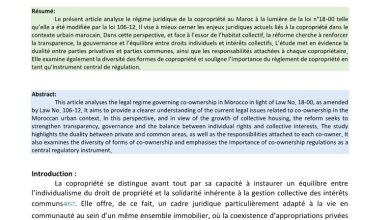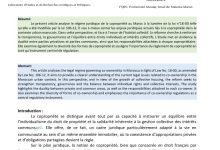نقد ذاتي لوجهة نظري في توصيف اضطراب الوسواس القهري (OCD) إعداد: عبد الصمد نيت أكني

نقد ذاتي لوجهة نظري في توصيف اضطراب الوسواس القهري (OCD)
إعداد: عبد الصمد نيت أكني
بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، أما بعد (1):
فمعلوم أن الأصل الذي ينبغي للباحث استصحابه أثناء دراسته للمسائل والوقائع، هو تحري الحقيقة، والتوقف عندها حين التبيّن، بدل المضيّ على منهج التبرير لِمَا بان عوره، وانجلى اعوجاجه، إذ من العار “على الرجل إذا سمع الحق أن يكون مع ذلك مصرا على إنكاره، جامحا في زمام أوهامه، ذاكرا لحجج واهية، ودلائل عنكبوتية” (2)، لا تزيد الرأي إلا ركاكة وسفولية، ومن عيوب النفس كما يقول شيخ الصوفية أبو عبد الرحمان السلمي -رحمه الله – (ت 412 هــ) ” أنها لا تألف الحق أبدا” (3).
والأظهرُ أن صاحب المنهج التبريري هذا إما أن يكون مقلدا أو متوهما، والدراسةُ العلمية تمجّ الأمرين معا، لنشدانها البرهان المفيد لليقين.
يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزّالي -رحمه الله- (ت 505 هـ) : “وليعتقد الحق في الأشياء على ما هي عليه، عن براهين قاطعة مفيدة لليقين، لا عن تقليدات ضعيفة، ولا عن تخييلات مقنعة واهية” (4) ؛ ولا يتلبس بالمنهج البرهاني سوى الباحث عن الحق في الأمور، الساعي إلى فهم بواطن الأشياء، بعيدا عن “منطق الشوارع” (5) بتعبير الأستاذ علال الفاسي -رحمه الله- (ت 1394 هــ)، الذي يؤسس –أي الشارع- معرفته على الخرافة والذائع، بدل التحلي بخصال ما سماه الأستاذ نفسه “بالأرستقراطية الفكرية” (6) التي تتغيا اليقين بواسطة “التفكير الرفيع” (7).
وقد سبق لي أن دعوتُ إلى ضرورة تأسيس القول في توصيف فِعال مريض الوسواس القهري على المنهج العلمي الذي قعّد له العلماء في علم أصول الفقه، وساروا عليه في ممارستهم الفقهية، وذلك حتى يكون القول قابلا للتفاعل معه بالنقد والتقويم، وإلا كان قولا لا تقع عليه قيمة، ولا ترجى منه فائدة.
وبعد تأمل في الرأي الذي طرحتُه في توصيف هذه المسألة، أبى الحق إلا أن يصرّح عن محضه، ويُبِين عن ضعف قائله، وقصر نظره فيما اتكل عليه من اعتبارات وتعليلات، لم ترق إلى ما ينبغي أن يكون عليه الأمر من الدقة والانسجام، وذلك لما يلي:
- المطلوب هو بناء الرأي وليس مجرد الطرح، والظاهرُ أني من جملة مَن طرح، لا من بنى وأسس.
- وضعُ الموضوع دقيق، لا يخوض فيه إلا الحاذق في خبايا النفس وأسرارها، ولستُ منهم لا من قبيل ولا دبير.
- في الرأي تعميم فاسد، لم يُبن على استقراء تام لمفردات المسألة، ولم يراع خصوصية كل مفردة على حدة.
وتفصيلُ ذلك على النحو التالي:
أولا: أمور متفَق عليها
- كون التصور ركنا مهما في أي عمل علمي لا نزاع فيه، بناء على القاعدة المنطقية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
- كون الأدلة الصادقة والصريحة لا تتعارض مدلولاتها لا خلاف فيه، لأن الحق لا يمكن -عقلا- أن يعارض الحق.
- كون احترام التخصص مبدأ شرعيا ومنهجا فقهيا لا جدال فيه، وممن نص عليه في تخصص الطب قبل الفقيه ابن قدامة -رحمه الله- (ت 620 هــ) الإمامُ الشافعي -رحمه الله- (ت 204 هــ) بقوله: “ثم جميع الأوجاع التي لم تسم على ما وصفت، يسأل عنها أهل العلم” (8).
- كون الاتفاق في المصطلح لا يلزم منه اتفاق المفهوم لا نقاش فيه، لتأثر المفهوم بالسياق.
ثانيا: أمور فيها نظر
الأمر الأول: قَصرُ الخبير بمرض الوسواس القهري على علماء الطب النفسي فيه نظر، من جهة أن منهج علم الطب النفسي إمبريقي تجريبي، يقوم على الملاحظة المنظمة، وبناءً عليها يفهم، ويفسر، ويتحكم، والأوْلى توسيع مصادر المعرفة في هذا المرض، حتى يتوصل إلى أسبابه الحقيقية، ومنابعه الأصلية؛ فيرجع كذلك إلى الوحي، وإلى إنتاجات العقل المسلم في تفاعله مع نصوص الوحي ذات الصلة بأمراض النفس.
ولهذا فلا بد من اعتبار ما تقرر ذكره في التشخيص الديني والوصفات الوقائية والعلاجية، لوساوس الشيطان، ووساوس النفس الأمارة بالسوء، وقد كفانا العلماء والأدباء مؤونة التشخيص، وما يناسبه من أدوية دينية، وذلك في كتبهم ورسائلهم، مثل: كتب التفسير، وكتب شروح الحديث، وكتب التصوف، وكتب الأدب، وغيرها.
وأشهر هؤلاء العلماء: شيخ الصوفية أبو عبد الرحمان السلمي (ت 412 هــ)، والقاضي أبو الحسن الماوردي (ت 450 هــ)، وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت 505 هــ)، والعلامة ابن الجوزي (ت 597 هــ)، والإمام ابن قيم الجوزية (ت 751 هــ)، رحمهم الله.
وأشهر هؤلاء الأدباء: أبو عثمان الجاحظ (ت 255 هــ)، وأبو منصور الثعالبي (ت 429 هــ)، رحمهما الله.
وسيتبدى لكل من رام الإنصاف عمق هؤلاء الأفذاذ من العلماء والأدباء في تحليلهم لٱثار الشيطان في الإنسان، ولأسباب أمراض النفوس، وإنما يتضح المقال بالمثال، ومثال ذلك:
- يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزّالي -رحمه الله- (ت 505 هــ) في بيان ٱثار الشيطان في الإنسان: “وقد انكشف لأولي الأبصار بنور اليقين، أن الانسان ينزع منه عرق إلى الشيطان الرجيم اللعين، فمن استفزته نار الغضب؛ فقد قويت فيه قرابة الشيطان” (9).
- ويقول الأديب أبو منصور الثعالبي -رحمه الله- (ت 429 هــ) في بيان أسباب مرض النفس: “ومن ذلك قوله: (لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس: من الآية 62]، فقد أدرج فيه ذكر إقبال كل محبوب عليهم، وزوال كل مكروه عنهم.
ولا شيء أضر بالإنسان من الحزن والخوف، لأن الحزن يتولّد من مكروه ماض أو حاضر، والخوف يتولد من مكروه مستقبل، فإذا اجتمعا على امرئ لم ينتفع بعيشه، بل يتبرم بحياته.
والحزن والخوف، أقوى أسباب مرض النفس، كما أن السرور والأمن أقوى أسباب صحتها، فالحزن والخوف موضوعان بإزاء كل محنة وبليّة، والسرور والأمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنيّة” (10).
وما أحوجنا إلى من يتتبع أنظار العلماء والأدباء في أمراض النفوس، ويعيد صياغة ما فيها من مبادئ وقوانين بدقة وإحكام، حتى يتيسر لكل ذي رغبة في معرفة التفسير الديني لهذه الأمراض، ووصفاتها الوقائية والعلاجية، أمرُ الاطلاع عليها والانتفاع بها، إذ كل ذلك مفيد في تبيّن حقيقة مرض النفس، والمداخل المؤدية إليه.
الأمر الثاني: الظاهر أن النظريات التي تفسر أسباب مرض الوسواس القهري في علم الطب النفسي غير كافية لاستجلاء الحقيقة الكامنة وراء ظهوره، لأنها –غالبا- أسباب مفتقرة إلى معرفة أسبابها الأصلية، فنظرية نقص هرمون السيروتونين سبب محتاج إلى تفسير سببه، وهكذا في باقي النظريات.
فلا بد من توسيع مصادر تفسير هذا المرض، مع استصحاب مبدأ التكامل بين التفسير الديني والتفسير العلمي الإمبريقي.
الأمر الثالث: إلحاق الفقيه النفراوي الأزهري -رحمه الله- (ت 1126 هــ) وساوس المستنكح في الصلاة بالشيطان له مسوغه الشرعي، فلعله استند إلى حديث عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني (11).
قال القاضي عياض –رحمه الله- (ت 544 هــ): ” خنزب بالخاء المعجمة والنون والزاي اسم الشيطان الذي يلبس في الصلاة، واختلف في ضبط الخاء، فضبطناها على القاضي الشهيد بكسرها، وضبطناها على أبي بحر بفتحها، وكذا قيدها الجياني” (12).
الأمر الأخير: القول باختلاف المفهوم الديني للوسواس عن مفهومه في علم الطب النفسي يحتاج إلى دراسة علمية مستوعبة لمصطلح الوسواس في المجال الديني، وفي مجال الطب النفسي، وذلك على وَفق ما يقتضيه منهج الدراسة المصطلحية بأركانها الخمسة (الإحصاء، والدراسة المعجمية، والدراسة النصية، والدراسة المفهومية، والعرض المصطلحي)، وأما غير ذلك فخرصٌ لم يستو على جودي المنهج المذكور، إذ المقام مقام تفصيل لا إجمال، والكلامُ الجملي في مقام التفصيل خُلْفٌ كما قيل.
هذه نُبَذٌ سريعة خُطّتْ بغرض نقد الذات فيما طرحتُه من رأي حول توصيف مرض الوسواس القهري، ومن حسن حظي أني لم أتكلم بلغة جزمية في طرحي، وإنما اتكلتُ على الشك في إلحاق هذا المرض بالشيطان أو النفس الأمارة بالسوء، ولم أكن -بإطلاق- موفقا في ذلك، لما سبق إيراده من اعتبارات تبدّت لي عند مراجعة الطرح، وإعادة التأمل في تعليلاته.
غير أن هذا الشك لو لم أستفد منه سوى نقد الذات لكفاني ذلك، وتلك ميزته التي تحدث عنها حجة الإسلام أبو حامد الغزّالي -رحمه الله- (ت 505 هــ) بقوله: “إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق، فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر، بقي في العمى والضلال” (13).
وليس كل شيء يشك فيه (الشك المطلق) كما هو مذهب الفيلسوف الإغريقي بيرو (14) (ت 270 ق. م) ومن تقيّله، وسلك سبيله، إذ ذاك من قبيل العبث الذي يترفع عنه العقلاء والفضلاء، وإنما الشك المعتبر تابع لطبيعة المشكوك فيه، فإن كان ممن أمكن تطرق الاحتمال إليه من وجه ما، ساغ الشك في صدقه بِنِيّة تبيّن الحق لاحقا، وإنما “مدار الأمر على البيان والتبيّن” (15) بتعبير الأديب الجاحظ -رحمه الله- (ت 255 هــ)، لا بنيّة العناد والجحود، لأن ذلك ضرب من الجهل المقصود في المثل القائل: “كفى بالشك جهلا”، ولا شيء أجهل ممّن يُطيِّن عين الشمس، فاعْلَمْــــهُ واعْمَــــــلاَ.
وفقنا الله إلى العلم والعمل، وألهمنا اتباع الحق إذا أبلج، وأعاذنا من الكبر والغرور وسائر أمراض النفس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهــوامــش:
1)- ينظر على الرابط التالي تعليلات وجهة نظري السابقة في مقالة بعنوان: “جدلية الدين والعلم في اضطراب الوسواس القهري إلماحات منهجية”، المنشورة بالموقع الإلكتروني: مجلة القانون والأعمال الدولية، في 8 فبراير 2025م:
2)- ينظر: ابن المؤقت، الرحلة المراكشية (مرءاة المساوئ الوقتية)، دار الرشاد الحديثية، ج: 1، ص: 63.
3)- أبو عبد الرحمان السلمي، عيوب النفس، ، تحقيق: مجدي فتحي السيد، مكتبة الصحابة طنطا، سنة النشر: 1987م، ص: 10.
4)- أبو حامد الغزّالي، ميزان العمل، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعارف مصر، ط: 1/ 1964م، ص: 255.
5)- علال الفاسي، النقد الذاتي، المطبعة العلمية القاهرة، ط: 1 / 1952م، ص: 38.
6)- علال الفاسي، النقد الذاتي، ص: 39.
7)- علال الفاسي، النقد الذاتي، ص: 39.
8)- الشافعي، الأم، دار الفكر بيروت، ط: 2 / 1983م، ج: 4، ص: 113.
9)- أبو حامد الغزّالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، دار الآفاق الجديدة بيروت، ط: 2 / 1975م، ص: 82.
10)- أبو منصور الثعالبي، الإعجاز والإيجاز، مكتبة القرآن القاهرة، ص: 15-16.
11)- مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح، كتاب السلام، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة.
12)- القاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة تونس، ودار التراث القاهرة، سنة النشر: 1987م، ج: 1، ص: 171.
13)- أبو حامد الغزّالي، ميزان العمل، ص: 409.
14)- ينظر مذهبه: نايجل واربرتون، مختصر تاريخ الفلسفة، ترجمة: محمد مفضل، تقديم: علي حسين، دار الكتب العلمية، ط: 1 / 2019م، من ص: 40 إلى ص: 47.
15)- الجاحظ، البيان والتبيّن، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بمصر، ط:2/ 1961م، ج: 1، ص: 11.